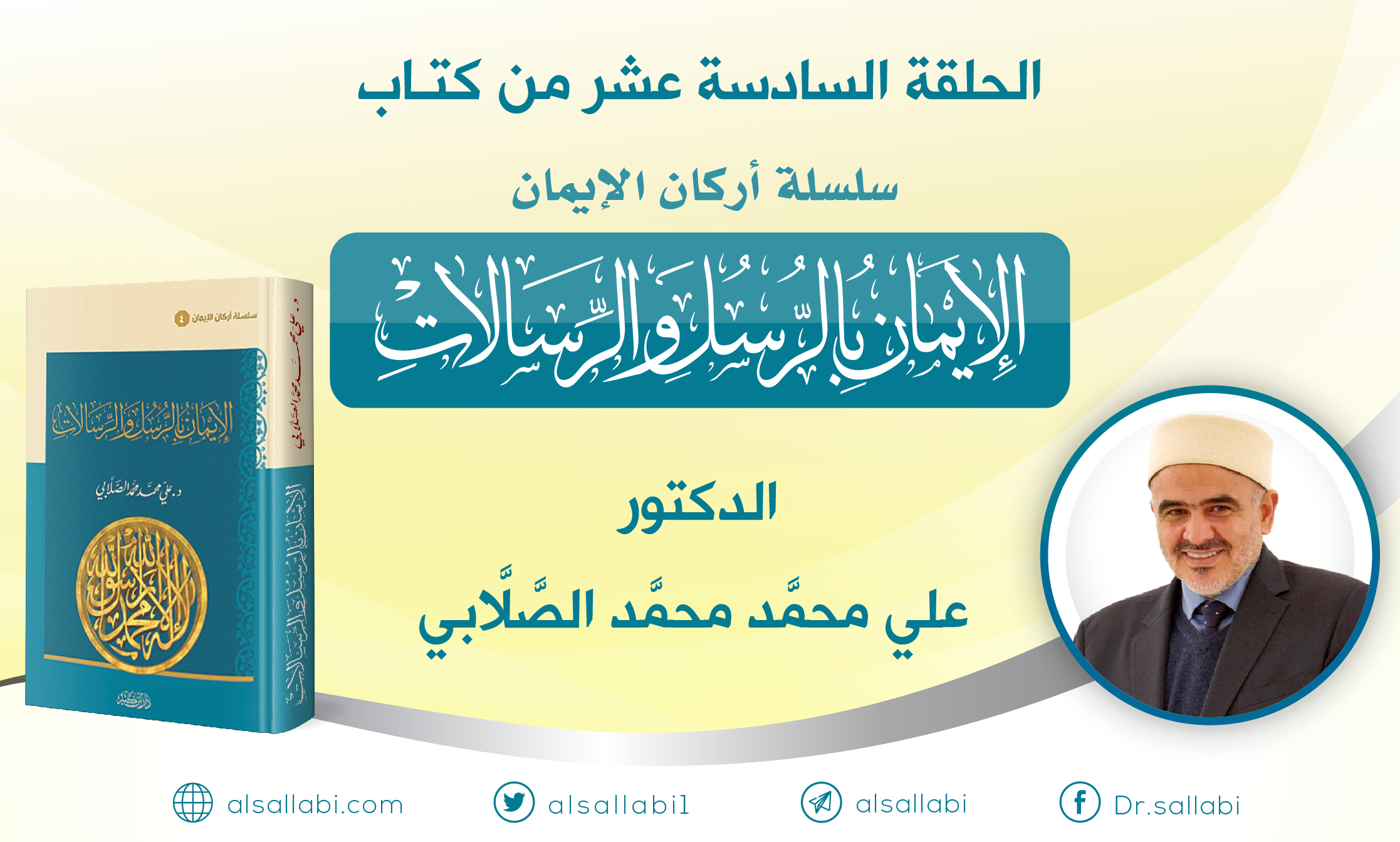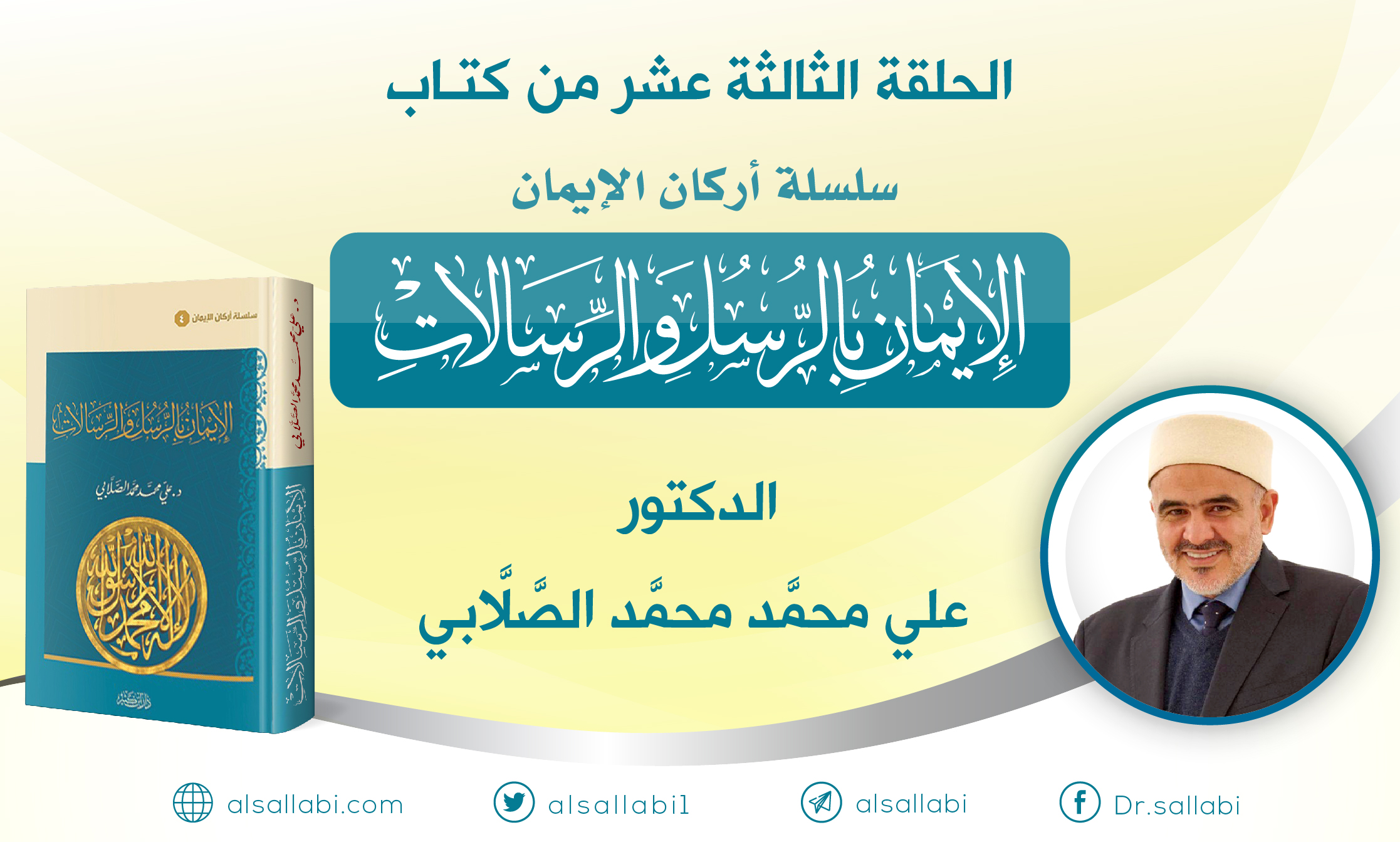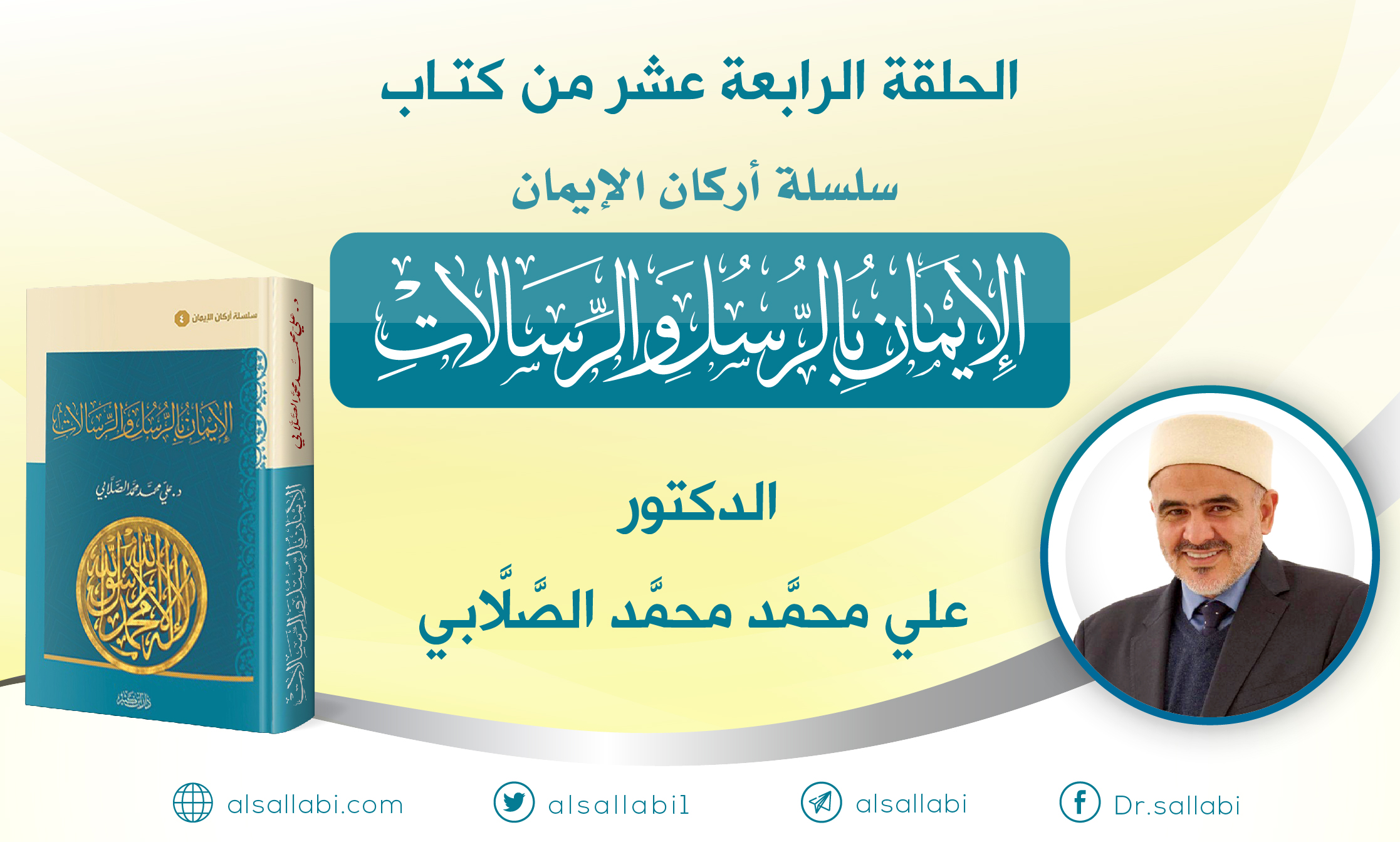عصمة النبي صلى الله عليه وسلم (1)
الحلقة: السادسة عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يونيو 2020
أدلة عصمته صلى الله عليه وسلم:
دلّتْ نصوصُ القران والسنة على عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرع الله إلى الخلق.
وقد عُرِّفت عصمة النبيِّ بأنها: لطفٌ من الله تعالى يحمِلُ النَبيَّ على فعلِ الخير، ويزجُرُه عن الشرِّ ، مع بقاءِ الاختيار تحقيقاً للابتلاء.
1 ـ فمن القران الكريم:
أ ـ قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم : 3 ـ 4] فالاية نصٌّ في عصمة لسانه صلى الله عليه وسلم من كل هوى وغرض ، فهو لا ينطق إلا بما يوحى إليه من ربه ولا يقول إلا ما أُمر به ، فيبلّغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان ، وهذه الاية شهادةٌ وتزكيةٌ من الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه للناس من شرع الله.
ب ـ وقوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ *لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ *فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ *} [الحاقة : 44 ـ 47].
فالاياتُ نصّت على أنّ الله سبحانه وتعالى لا يؤيّدُ من يكذِبُ عليه ، بل لابد أن يظهر كذبه ، وأن ينتقم منه ، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس ، كما ما يزعمُ الكافرون فيما حكاه الله عنهم: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الشورى : 24] لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الايات ، وحيث إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك ، فلم يهلكه الله ، ولم يعذبه ، فهو على هذا لم يتقوّل على الله ما لم يقله ، ولم يفتر شيئاً من عند نفسه ، وبهذا ثبتتْ عصمتُه في كلِّ ما بلّغه عن ربه عز وجل.
قال ابن كثير بعد أن فسّر هذه الايات: والمعنى في هذا أنّـه صادقٌ راشدٌ ، لأنّ الله عزّ وجلّ مقرٌّ له ما يبلّغه عنه ، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات.
ج ـ وقوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً *ولَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً *إِذًا لأََذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا *} [الاسراء : 73 ـ 75].
فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وتثبيته وعصمته ، وسلامته من شر الأشرار ، وكيد الفجار ، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره ، وأنّه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه ، بل هو وليه وحافظه ، وناصره ومؤيده ، ومظهره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها.
2 ـ من السنة النبوية:
أ ـ حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكن إذا حدثتُكم عنِ اللهِ شيئاً فخُذُوا به ، فإنِّي لنْ أكذبَ على الله».
ب ـ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدُ حفظَه ، فنهتني قريشٌ ، فقالوا: إنك تكتبُ كلَّ شيءٍ تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلّم في الغضبِ والرضا ، فأمسكتُ عن الكتابِ ، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرجَ منِّي إلا حقٌّ».
ج ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّي لا أقولُ إلا حقّاً» قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: «إني لا أقول إلا حقاً».
عصمته صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه:
دلت النصوص الثابتةُ على أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ من الكفر والشرك منذ نشأته ، فلم يُعْهَدْ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لصنم ، أو استلمه ، أو غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلُها قومُه ، فقد فطره الله على معرفته ، والاتجاه إليه وحده ، وهذا هو المعلومُ من سيرته ، فمن النصوص التي يُسْتَدَلّ بها على هذا الأمر ما يلي:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه ، فشق عن قلبه ، فاستخرج القلبَ ، فاستخرجَ منه علقةً ، فقال: «هذا حظُّ الشيطانِ منك» ثم غسله في طِسْتِ من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يَسْعَوْنَ إلى أمه ـ يعني ظِئْرَه ـ ، فقالوا: إنَّ محمداً قد قُتِلَ ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال أنس: وقد كنتُ أرى أثرَ ذلك المخيطِ في صدره.
فالحديث نصَّ على إخراجِ جبريل لحظِّ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم وتطهيره لقلبه ، فلا يقدرُ الشيطانُ على إغوائه ، إذ لا سبيل له عليه ، وهذا دليلٌ على تنزيهه من الشرك منذ صغره صلى الله عليه وسلم.
والنصوص في مثل هذا كثيرةٌ ، وقد عُني بجمعها مَنْ ألّف في (دلائل النبوة) مثل الحافظ أبي نُعيم الأصفهاني ، فقد عقد فصلاً في كتابه (دلائل النبوة) بعنوان: ذكر ما خصّه الله عزّ وجل به من العصمةِ ، وحماه من التديّن بدينِ الجاهلية.. وقد أورد تحت هذا العنوان العديدَ من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن.
وكذلك فعل البيهقي في (دلائل النبوة) أيضاً فعقد عنواناً لهذا الموضوع فقال: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسولَه صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولاً.
ومثلهما السيوطي في (الخصائص الكبرى) حيث قال: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحفظ الله إياه في شبابه عمّا كان عليه أهل الجاهلية.
إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته:
وردت بعضُ النصوص التي قد يتوهّمُ منها البعضُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على كفرٍ وضلالٍ قبل بعثته ، فمن تلك النصوص:
أ ـ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ} [الشورى : 52].
فقد يتوهّمُ البعضُ أنّ هذه الاية تعني انتفاء معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالكلية قبل بعثته ، بمعنى أنّه لم يكن مؤمناً.
والجواب على ذلك أنّ هذا الفهمَ خاطىءٌ ، لأنّ الإيمان في قوله: {وَلاَ} مصدرٌ بمعنى {الإِيمَانُ} ، فيكون المراد: أي ما يجبُ الإيمانُ به من الفرائض والأحكام الشرعية التي كُلّف بها علماً وعملاً ، فالمنفي هو الإيمان التفصيلي لا الإجمالي ، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إليه مبغِضاً للشرك وعبادةِ الأصنام ، ومتّجهاً إلى الله وحده ، فلما نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي امن بها وطبقها ، فهذا هو المعنى الصحيح للاية ، كما ذكر ذلك علماءُ التفسير عند تفسيرها، قال ابن كثير:
على التفصيل الذي شرع لك في القران قال الشوكاني: ومعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم {وَلاَ الإِيمَانُ} يعرِفُ تفاصيل الشرائع ، ولا يهتدي إلى معالمها ، وخَصَّ الإيمان لأنه رأسها وأساسها.
ب ـ ومن النصوص كذلك قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى *} [الضحى : 7].
فقد يتوهّم البعضُ أنّ الاية تعني أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم كان على ضلال قبل مبعثه ، وهذا فهمٌ خاطأى ، وباطلٌ تردّه النصوص التي سبق إيرادها ، والتي نصّت على أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوماً من عبادة الأوثان ، وقاذوراتِ أهل الفسق والعصيان.
وقد أشار القرطبيُّ عند تفسيره لهذه الاية إلى بطلان هذا الفهم حيث قال: فأمَّا الشرك فلا يُظنُّ به.
وأمّا المعنى الصحيح لهذه الاية فقد أشار العلماء إلى عِدّةِ معانٍ صحيحة لهذه الاية تشترك جميعاً في تنزيه النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أن يُنْسَبَ إليه شيءٌ من الشرك ، أو الكفرِ قبل بعثته ، ومن تلك المعاني ما يلي:
أن يفسَّر الضلالُ هنا بمعنى الغَفْلةِ ، كما في قوله تعالى: {لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى *} [طه : 52] وكما في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ *} [يوسف : 3]. والمعنى أنّه وجدك غافلاً عما يُرادُ بك من أمر النبوة.
وقال بعضُهم: معنى (ضالاً) لم تكن تدري ما القران والشرائع؟ فهداك الله إلى القرانِ وشرائعِ الإسلام ، وهو بمعنى قوله تعالى: وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي وجدك ضالاً عن شريعتك التي أوحاها {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ} ، لا تعرفها قبل الوحي إليك فهداك إليها
وقال بعضهم: معنى الاية أي وجدك في قوم ضُلاّل فهداهم الله بك.
ولقد أورد العلماء عدداً من المعاني لهذه الاية منها ما هو معنوي ، ومنها ما هو حسي، وهي معانٍ كلها حسان.
ومن النصوص كذلك قوله تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ *} [يوسف : 3].
فليس المقصودُ بالغفلة هنا الشرك والغواية ، إنّما المقصودُ منها الغفلة عن قصة يوسف مع أبيه وإخوته ، كما يوضّحُ ذلك سياقُ الاية ، فهذه القصة وأمثالها لا تُعْلَمُ إلا من الوحي ، فلهذا لا يلحقه نقصٌ بسببها ، وهذا هو ما ذكره علماء التفسير عند هذه الاية، قال الشوكاني: والمعنى أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة.
عصمته من الكذب في غير الوحي والتبليغ:
من المعروف عن سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أنه متّصفٌ بكل خُلُقٍ فاضلِ من صدقٍ ، وأمانةٍ ، وبرٍّ ، وصلة رحم ، وإحسان ، وجودٍ ، إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق ، التي جبله الله عليها منذ نشأته ، وحرى به صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك ، فقد اختاره الله لحمل الأمانة العظمى التي هي أداءُ الرسالة ، وتبليغُها إلى الناس كافةً ، فكان لابدّ من إعداده لهذه المهمة ، ولذا فقد فطره الله على كلِّ خُلقٍ فاضل كريم ، وقد جمع الله خصال الخير كلها ، فلم يكن يُدْعَى إلا بالأمين.
ومن الأدلة التي يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي:
قول خديجة بنت خويلد: رضي الله عنها حينما أتاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم خائفاً بعد أن لقيه جبريل في غار حراء ، وقال لها: «إني قد خشيتُ على نفسي» فقالت له: كلا ، أبشرْ ، فواللهِ لا يخزيك اللهُ أبداً ، فواللهِ إنك لتصلُ الرحمَ ، وتصدقُ الحديثَ ، وتحمِلُ الكَلَّ ، وتُكْسِبُ المعدومَ ، وتقريَ الضيفَ ، وتعينُ على نوائب الحق.
ب ـ إجماع قريش على الإقرار بصدقه: حينما جمعها ليصدعَ بالدعوة جهراً ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ *} [الشعراء : 214] صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ، فجعل ينادي: يا بني فِهْرٍ ، يا بني عدي ـ لبطون قريش ـ حتى اجتمعوا ، فجعل الرجلُ إذا لم يستطعَ أن يخرجَ أرسلَ رسولاً لينظرَ ما هو ، فجاء أبو لهب وقريش ، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتُكم أنّ خيلاً بالوادي تريدُ أن تغيرَ عليكم أكنتم مصدّقِيَّ؟» قالوا: ما جربنا عليك إلا صِدْقاً ، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».
فالشاهد من الحديث قولهم: (ما جربنا عليك إلا صدقاً) فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه ، وانتفاء الكذب عنه ، لعلمه بما قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة.
على الرغم من تكذيب قريش للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة ، إلا أنّ أحداً منهم لم يجرؤ على وصفه بالكذب في سواها ، فقد قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّا لا نكذّبك ، ولكن نكذِّبُ الذي جئتَ به ، فأنزل الله تعالى: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ *} [الانعام : 33].
وكذلك عندما سأل الأخنسُ بن شُريقٍ أبا جهلٍ بعدما خلا به يومَ بدرٍ ، فقال: يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمّدٍ أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحدٌ من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا ، فقال أبو جهل: ويحك ، والله إنَّ محمداً لصادقٌ ، وما كذبَ محمّدٌ قط ، ولكن إذا ذهبَ بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش.
هذه بعضُ النماذج التي تدلُّ على صدقه صلى الله عليه وسلم ، وعصمته من الكذب قبل بعثته ، وكذا الحال بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ، فهذه أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله معتنًى بها ، مستوفاة تفاصيلها ، لم يرد في شيء منها تداركه صلى الله عليه وسلم لخبرٍ صدر منه رجوعاً عن كذبة كذبها ، ولو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا.
مسألة وقوع الخطأ منه:
أمّا ما يقعُ من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية ، فمن الأدلة على ذلك حديثُ رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: قدم نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ ، وهم يؤبّرون النخل (يلقحون النخل) فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً» فتركوه فنقصت. قال: فذكروا ذلك له ، فقال: «إنّما أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيٍ ، فإنّما أنا بشر».
وفي رواية أنس: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»، وفي رواية طلحة: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظناً فلا تواخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ، فإني لا أكذب على الله عز وجل».
وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام البشرية الجارية على يديه وقضاياهم ، ومعرفة المحق من المبطل ، وعلم المصلح من المفسد ، فهذه أمورٌ اجتهادية ، يجتهد فيها برأيه ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّكم تختصمون إليّ ، ولعلَّ بعضكم أنْ يكونَ ألحنَ بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعتُ له من حقّه أخيه شيئاً فلا يأخذْه ، فإنّما أقطعُ له به قطعة من النار».
فاقتضت حكمته تعالى أن لا يكونَ معصوماً في هذا الجانب ، وذلك حتى تقتدي به الأمة من بعده في النظر في القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس.
قال القاضي عياض: وتجري أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ، ويمين الحلف ، ومراعاة الأشبه ، ومعرفة العِفاص والوكاء ، مع مقتضى حكمة الله في ذلك.
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب :
الإيمان بالرسل والرسالات
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book94(1).pdf