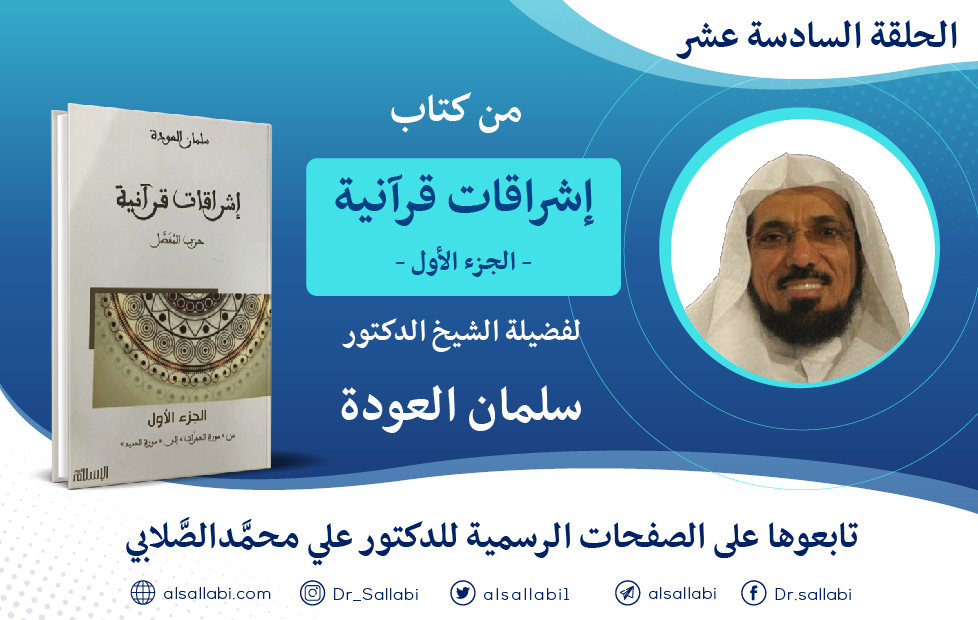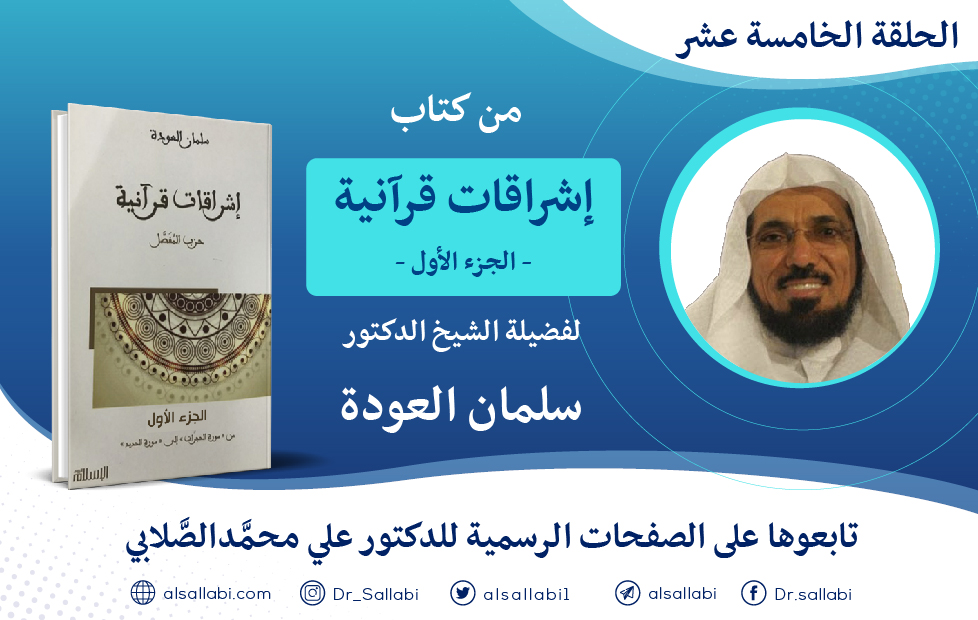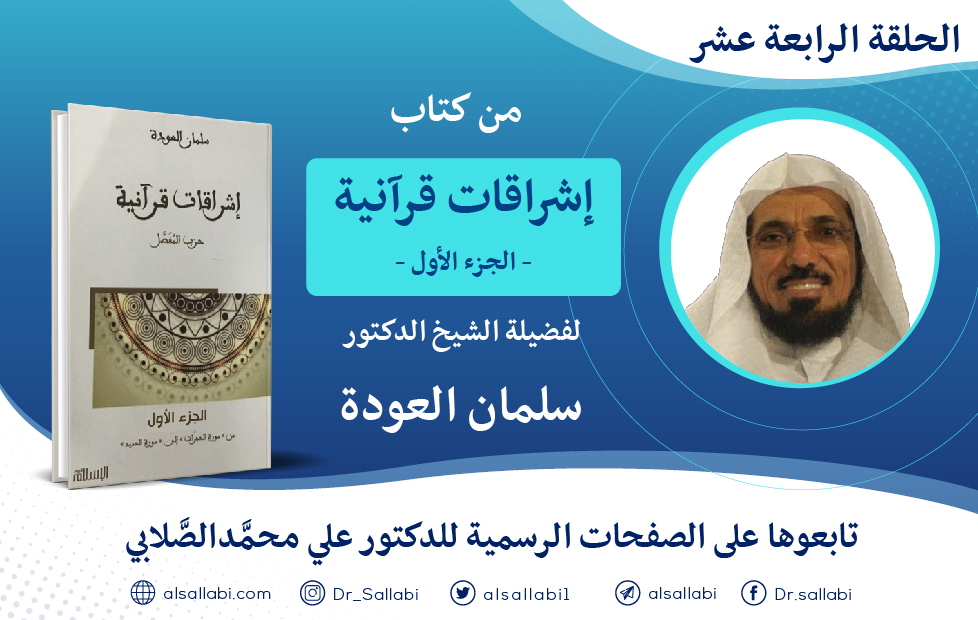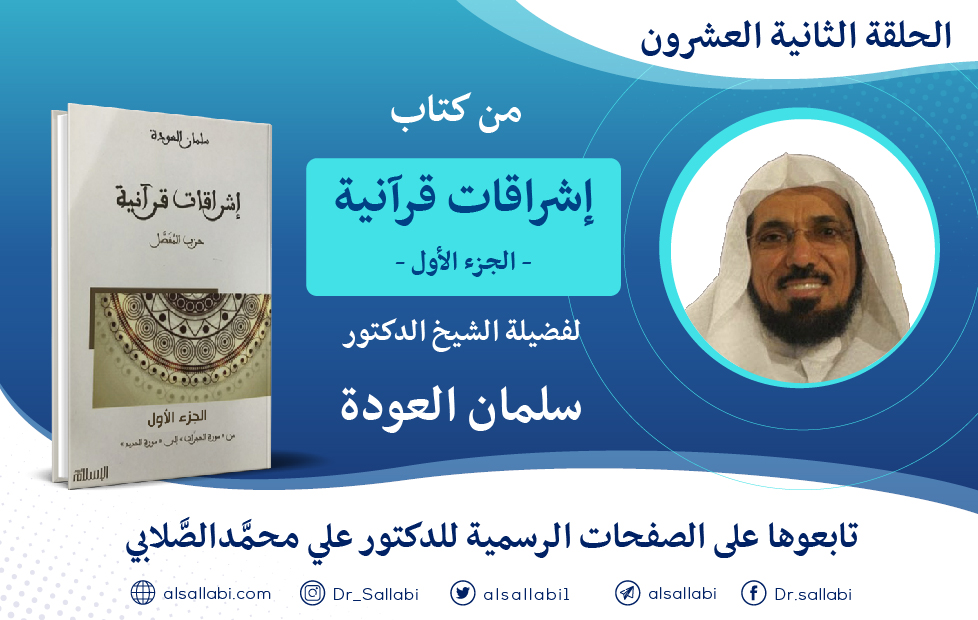من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الواقعة)
الحلقة السادسة عشر
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
ربيع الآخر 1442 هــ/ نوفمبر 2020
* تسمية السورة:
تُعرف بـ«سورة الواقعة»؛ نظرًا للكلمة ذاتها في الآية الأولى، باعتبار ورودها في الآية الأولى.
وهو في المصاحف، وكتب التفسير، والحديث، وورد في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسولَ الله، قد شِبْتَ؟ قال: «شَيَّبَتْني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، و ﴿عَمَّ يَتَسَاءلُون ﴾، و ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت ﴾». وهو حديث مضطرب، كما ذكر ابن الصلاح، وغيره.
وكذلك الحديث المروي أن عثمانَ زار عبدَ الله بنَ مسعود رضي الله عنهما في مرض موته، وقال له: أَلَا ندعو لك الطَّبيبَ؟ قال: الطَّبيبُ أمرضني. قال: هل تُوصي لأهلك وبناتك بشيء؟ قال: إني أوصيتُهم بما سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه «مَن قرأَ سورةَ الواقعة كلَّ ليلة لم تصبه فاقةٌ».
والحديث على تعدد طرقه، إلا أنه لا يثبت، والصحيح أن الفاقة إنما تُدفع بالأسباب التي خلقها الله تعالى، وأرشد عباده إليها لطلب الرزق، ومن ذلك الضرب في الأرض، كما قال تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، وتُدفع بالإحسان والإنفاق؛ فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: «يا ابنَ آدَمَ، أَنْفِقْ عنه: عليك». و﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَان ﴾ [الرحمن:60].
وأما قراءة القرآن فللعلم والعمل، ورجاء الآخرة، وإصلاح النفس والمجتمع، وليس تواكلًا ليأتي الرزق به دون سعي، فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا.
ومن أمثل ما ورد في الباب ما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور.
* عدد آياتها: تسع وتسعون آية، وهو الموجود في مصاحف المدينة النبوية.
وقيل: سبع وتسعون آية، أو ست وتسعون، على اختلاف علماء العدِّ.
* وهي مكية عند جمهور المفسرين، وهو الراجح، واستثنى بعضهم آيات منها، والراجح أن السورة كلها مكيَّة.
* ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة ﴾:
و ﴿إِذَا ﴾: ظرفٌ لما يُستقْبَل من الزمان، أنه شيء سوف يأتي، وفيه معنى الشرط فـ ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة ﴾ حدث عظيم فيه خفض ورفع، وجزاء وحساب.
و ﴿الْوَاقِعَة ﴾: اسم من أسماء يوم القيامة، مثل: ﴿الْحَاقَّة ﴾، و ﴿الصَّاخَّة ﴾، و ﴿الطَّامَّةُ ﴾، و ﴿الآزِفَة ﴾، و ﴿السَّاعَةُ ﴾.
* والآية إشارة إلى عظم هذا الأمر، فهو شيء له دَوِيٌّ وهزة عنيفة؛ ولهذا قال بعدها مباشرة: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَة ﴾ أي: أن وقوعها حقٌّ، لا ريب فيه ولا تكذيب.
وجاء التعبير بقوله: ﴿لِوَقْعَتِهَا ﴾، ولم يقل: «لوقوعها»؛ لأن كلمة «وقعتها» أسرع، كأنها وقعة واحدة سريعة مفاجأة.
ويحتمل أيضًا أن يكون قوله: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَة ﴾ أي: ليس فيها تراجع، وأنها إذا وقعت فإنها لا تُرفع؛ ولهذا قال: ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة * وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَة ﴾ [الحاقة: 15- 17]، فهي إذا وقعت لا تُرفع ولا تُدفع، وإنما تمضي في أحداثها المرسومة دون تعديل.
والعرب تُسمِّي المعركة الحربية: الوقعة، أو الواقعة، وقد تعلن الحرب أو تبدؤها على سبيل التهديد والزجر والوعيد، بينما يؤكِّد النص هنا أن تلك الواقعة
صادقة حاقة ماحقة ماضية، لا تُقال للتهديد فحسب، بل هي محقَّقة الوقوع، وحين وقوعها تراها العيون والقلوب فتصدِّق ولا تكذِّب.
* ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَة ﴾:
وهذا من أخص معانيها، قال بعضهم: إنها رفعت الصوت فأسمعت البعيد، وخفضت فأسمعت القريب.
ومن معانيها: أنها تخفض أقوامًا، وترفع آخرين.
وهذا جاء عن عمر وعليٍّ رضي الله عنهما، فإن الموازين يوم القيامة تتغيَّر؛ فيُؤتى بالرجل السَّمين العظيم، فلا يَزِنُ عند الله تعالى جناحَ بعوضة، ويُؤتى بالفقير الضعيف المغمور ذي الثياب البالية، لا يُؤْبَه له، فيكون ثقيل الميزان عند الله، وفي أعظم المنازل في الجنة.
ونلحظ أن الوصف جاء مطلقًا، فلم يقل: «إنها خافضة لشيء أو رافعة لشيء»؛ ليكون المعنى شاملًا لكل ما يحتمله الرفع والخفض؛ رفع الأشخاص وخفضهم، ورفع الأعمال وخفضها، ورفع الصوت وخفضه، ورفع الميزان وخفضه، ورفع الحق وخفض الباطل.
* أما متى حينها؟ فجوابه: ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا ﴾:
والرَّجُّ هو: الحركة الشديدة، وهو تعبير عن الزلزال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة:1]، ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم ﴾ [الحج: 1].
* ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴾:
والبَسُّ يحتمل معنيين:
التفتيت، فتصبح ﴿الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً ﴾ [المزمل: 14]، وتكون ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنفُوش ﴾ [القارعة: 5]، فليست كما هي الآن بمتانتها وقوتها وتماسكها وصلابتها.
والمعنى الثاني: ﴿وَبُسَّتِ ﴾ أي: ﴿سُيِّرَت ﴾ وسيقت: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت ﴾ [التكوير:3]، ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: 88]، بأمر الله تعالى.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: «فيأتي قومٌ يُبِسُّونَ، فيتحمَّلُونَ بأهليهم ومَن أطاعهم». أي: يخرجون بأموالهم وأهليهم وإبلهم من المدينة يسوقونها سَوْقًا.
والبَسُّ عند العرب يحتمل هذا وهذا، فتقول: بسَّ الشيء، إذا فتَّتَّه، وتقول: بسَّ عقاربه على فلان، إذا أرسلها، بمعنى الوقيعة والأذى.
* ﴿فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا ﴾:
والهباء هو: الشيء التافه الذي لا قيمة له، وهو الغبار.
وقال بعضهم: هو الغبار إذا تسلَّطت عليه أشعة الشمس، فأصبح يُرى في الجو متطايرًا.
والمُنْبَث: المنتشر، وهذا التغير للظواهر الكونية مقصود من أجل الإنسان الذي هو محل التكليف، فذكره وتكراره خَلِيق أن يوقظ النائم، ويصحِّي السكران، وينبِّه الغافل.
* ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَة ﴾:
والعادة أن الله تعالى يذكر زوجين ويسمِّيهم: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِين ﴾، و ﴿أَصْحَابُ الشِّمَال ﴾، وهو في معظم آيات القرآن الكريم، وفي هذه السورة قسَّم الناس إلى ثلاثة أزواج أو مجموعات أو طبقات، والخطاب للناس كلهم، للمؤمن والكافر، والبر والفاجر.
والسبب في ذلك أنه هنا قسَّم ﴿أَصْحَابُ الْيَمِين ﴾ إلى فئتين: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِين ﴾، و ﴿السَّابِقُون ﴾، وأما في «سورة فاطر» فقسَّمهم ثلاثة أقسام: ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾،
و ﴿مُّقْتَصِدٌ ﴾، و ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ [فاطر: 32].
وفي «سورة المطففين» ذكر ﴿الأَبْرَارِ ﴾، و ﴿الْمُقَرَّبُون ﴾، وفي «سورة الإنسان» ذكر قريبًا من ذلك، وهو من باب التنويع والتفصيل والتمييز.
* ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾:
سمَّاهم: «أصحاب الميمنة»، وسمَّاهم: «أصحاب اليمين»، وهم في معظم آيات القرآن الكريم.
سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون عن يمين الرحمن عز وجل، أو لأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، أو لأنهم يُذهب بهم ذات اليمين إلى منازلهم في الجنة، وسمُّوا كذلك تفاؤلًا؛ لأن العرب تقول: هذا فلان له يمنٌ وذاك له شؤم، فالذي له يمن أو يمين يكون خيرًا على نفسه وعلى أهله وعلى الناس الذين يلقاهم أو يعاملهم، ولذلك أصبح اليمين محمودًا في الشريعة؛ في الأكل والشرب والقيام والقعود والدخول والخروج واللُّبس وغيرها، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعجبُه التيمُّنُ في تنعُّله وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كلِّه.
والمقصود من السؤال في قوله: ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾ التفخيم والتعظيم، وكأنه مبتدأ وخبر، قال «أصحاب الميمنة»، وأخبر عنهم بمثل السؤال: ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾، فالأمر أعظم وأكبر من أن يُوصف، ويكفي أن يقال عنهم؛ ليدل على تناهي ما هم فيه في الفضل والمكانة والمنزلة والرِّضا والسرور والحُبور وقرَّة العين.
* ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة ﴾:
أي: في العذاب والنَّكال والرُّعب والخوف، والمقصود: ﴿أَصْحَابُ الشِّمَال ﴾، كما في السورة ذاتها، ومواضع أخرى من القرآن الكريم، وسمُّوا: ﴿أَصْحَابُ الشِّمَال ﴾؛ لما سبق، ولأنهم يأخذون كتبهم بشمالهم، ولأنهم كانوا عن شمال آدم عليه السلام لما رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه أَسْوِدَةٌ، وعن يسارِه أَسْوِدَةٌ، فإذا نظرَ قِبَلَ يمينه ضحكَ، وإذا نظرَ قِبَلَ شماله بَكَى؛ ولأنهم ﴿أَصْحَابُ الشِّمَال ﴾ الذين كتب الله عليهم الهلاك.
* ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُون * أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُون ﴾:
بدأ بـ ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾، ثم ﴿أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة ﴾، ومر عليهم دون أن يقف السياق عندهم إلا لمجرد التفخيم والتعظيم، ثم ذكر ﴿السَّابِقُون ﴾ في المرحلة الثالثة، وهذا- والله أعلم- من أجل أن يفرغ السياق للكلام عنهم، لأنه لما ذكرهم استوفى الكلام المراد بشأنهم، ثم رجع إلى ﴿أَصْحَابُ الْيَمِين ﴾ و ﴿أَصْحَابُ الشِّمَال ﴾، فقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُون ﴾، وهذا مبتدأ وخبر، معناه: السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الجنات، هم السابقون إلى العمل، السابقون إلى الفضل، وكأنه أخبر بهم عنهم، وهذا معروف عند العرب، كما يقول قائلهم:
أنا أبو النَّجْمِ، وشِعْرِي شِعْرِي
أي: فلان هو: فلان، ما يحتاج إلى المزيد من الكلام والتفصيل، فهنا إشارة إلى علو السابقين وفضلهم ومنزلتهم عند الله.
﴿أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُون ﴾ جمع: مقرَّب، أي: مقرَّبون عنده سبحانه، والمقرَّب أفضل من القَرِيب، ففلان مقرَّب عندي، أي: أنني قرَّبته واصطفيته، أما القريب فقد يكون قريب نسب؛ أو هو الذي يحاول أن يتقرَّب مني، فهؤلاء المقرَّبون هم ممن اختارهم واصطفاهم وفضَّلهم في الدنيا بلزوم الطاعة، وفي الآخرة بالفضل والمكانة.
وهذا لا ينافي ذكر أعمالهم الصالحة لأن الله تعالى لا يُقرِّب أحدًا لأنه يسكن في المدينة أو في مكة، أو لأنه من قريش أو من العرب، ولا لأنه أبيض أو جميل الهيئة، وإنما ﴿يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب ﴾ [الشورى: 13]، فهو يختارهم على علم، ويقرِّبهم؛ لصفاء قلوبهم، وصدق نواياهم، وسلامة سرائرهم، وكمال إشراقهم وعملهم الصالح، ويُقرِّبهم لتواضعهم، ولهذا قيل في معاني: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَة ﴾: أنها تخفض المرفوع وترفع المخفوض، تخفض المتكبِّر المتعجرف المتعالي، وترفع المتواضع المخبت لربه، فكلما كان الإنسان أكثر ضعفًا وانكسارًا وتواضعًا وأبعد عن رؤية الذات، كان أقرب إلى النجاة.
* ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيم ﴾:
يحتمل أن يكون هذا ظرف لتقريبهم، فهم مقرَّبون في الجنة.
ويحتمل أن يكون خبرًا ثانيًا أو ثالثًا عنهم بأن مقرَّهم ومصيرهم ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيم ﴾.
* ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِين * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِين ﴾:
الثُّلَّة: الجماعة من الناس، قلَّت أو كثرت.
و ﴿مِّنَ الأَوَّلِين ﴾ هذا يحتمل معنيين:
أنهم من أتباع الأنبياء السابقين، كنوح وموسى وعيسى وشعيب وصالح عليهم السلام، والرسل أنفسهم يدخلون دخولًا أوليًّا في ﴿أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُون ﴾، وعلى هذا يكون المقصود بـ ﴿الآخِرِين ﴾: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه يصبح ﴿السَّابِقُون ﴾ من الأمم السابقة أكثر منهم في هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة كثيرة، والأنبياء كثيرون، وثمة الأنبياء والرسل والشهداء والصِّدِّيقون والصالحون والحواريون، فكل هؤلاء من السابقين، وكلهم من المقرَّبين.
وقد ذهب إلى هذا أكثر المفسرين، ونُقل عن جمع من السلف.
والقول الثاني: أن هؤلاء جميعًا هم من هذه الأمة، فـ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِين ﴾ أي: من الذين صحبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِين ﴾ أي: من التابعين ومَن بعدهم إلى قيام الساعة.
وعليه، فالله تعالى لم يذكر الأمم السابقة، ليس لأنه لا سابقون فيها، ولكن لأن الخطاب موجَّه لهذه الأمة، فذكر تعالى من هذه الأمة من السابقين ثُلَّة من المتقدِّمين من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تَسُبُّوا أصحابي، لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدَكم أَنْفَقَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا، ما أدركَ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَهُ». وذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وسابقتهم، بل ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم مما يعزِّز هذا المعنى؛ قال: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ﴾ [التوبة: 100]، وقال: ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الحشر: 8]، فهذا يعزِّز المعنى، ولا ينفي أن يكون من السابقين، ومن المقرِّبين الرُّسل والأنبياء وأتباعهم، لكنه طُوي ولم يُذكر هاهنا؛ لأن السياق يخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا المعنى نُقل عن الحسن البصري وابن سِيرين وجماعة، ورجَّحه ابن كثير في تفسيره؛ لفضل هذه الأمة، ولاستبعاد أن يكون ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِين ﴾ من الأمم السابقة، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِين ﴾ من هذه الأمة، فهذا نوع من النقص في حق هذه الأمة، مع أن السياقات والنصوص لم يُعهد منها مثل هذا المعنى، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونُوا رُبُعَ أهل الجنة». فكبَّرْنا، فقال: «أرجو أن تكونوا ثُلُثَ أهل الجنة». فكبَّرْنا، فقال: «أرجو أن تكونُوا نصفَ أهل الجنة». فكبَّرنا، والنصوص تدل على فضلهم وسابقتهم.
وقد يقال بأن الأمم السابقة كثيرة ممتدة من عصر التكليف ونزول الرسل إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى مع ذلك فهذه الأمة ممتدة أيضًا، فهي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فالأمة كثيرة جدًّا، وجاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذ رُفِعَ لي سَوادٌ عظيمٌ، فظننتُ أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومُه، ولكن انظرْ إلى الأُفُق. فنظرتُ فإذا سَوادٌ عظيمٌ، فقيل لي: انظرْ إلى الأُفُق الآخر. فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيل لي: هذه أُمَّتُكَ، ومعهم سبعونَ ألفًا يدخلونَ الجنةَ بغير حساب ولا عذاب». فسُئل عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكَّلُونَ».
وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: «وعدني ربي سبحانه أن يُدْخِلَ الجنةَ من أمتي سبعينَ ألفًا لا حسابَ عليهم ولا عذابَ، مع كل ألف سبعونَ ألفًا...». وهذا عدد ضخم وكبير.
ومع أن الأمر محتمل، فالذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن القول بأن ﴿الأَوَّلِين ﴾ و ﴿الآخِرِين ﴾ هم من هذه الأمة أليق بالسياق وبالنصوص الأخرى، مع غير بخسٍ لمَن جاؤوا قبل هذه الأمة.
وفي كل دعوة خير، فمن الناس مَن يبادر ويقول: أنا لها، ويندفع برغبة وبصيرة، ومنهم مَن يكون عنده تردد وإحجام، يراعى المصالح والمفاسد، فإذا رأى الناس أقبلوا واندفعوا تنشَّط وصحبهم، وهذا فائدة الصحبة الطيبة، وإذا ثقل الناس فإنه يثقل معهم.
وفي هذه الآية الكريمة دعوة إلى المبادرة، وأن على المؤمن أن يسارع في عمل الخير، وإذا كان هؤلاء هم السابقون، فالله يأمرنا أن نجتهد أن نكون منهم فيقول: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ [الحديد: 21]، فـ ﴿السَّابِقُون ﴾ لديهم مسارعة وفتح لأبواب الخير وطرائقه وذرائعه، وتشجيع لغيرهم على سلوك الطريق؛ لأنهم جمعوا بين الإيمان الصادق بالله، وبين شدة الرغبة والحماس في الخير، وقلة المبالاة بالمعوِّقين والمثبِّطين وغيرهم تبعٌ لهم في ذلك.
وفيها دليل على فضل هذه الأمة وفضل السابقين منها؛ لأنه تعالى جعلهم بخير المنازل والمكانة، فهم الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصح أن نسمِّيهم جميعًا سابقين، كما سماهم ربهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ﴾ [التوبة: 100]؛ وحين جبن الناس وكذَّبوا وتأخَّروا وتراجعوا وتردَّدوا وخافوا أقدم هؤلاء وسبقوا غيرهم وتحمَّلوا التَّبعة وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ﴿وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ [الأعراف: 157]، فسماهم تعالى: ﴿السَّابِقُون ﴾، وهذا يشمل جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وقد يشمل قريبًا أو قليلًا ممن كانوا بعدهم من التابعين، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ﴾ [التوبة: 100].
ولا غرابة؛ فهم الذين ربَّاهم الرسولُ صلى الله عليه وسلم؛ بل اختارهم الله تعالى على عينه، وشهدوا التنزيل، وسمعوا القرآن رَطْبًا يُتلى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلَّوْا خلفه، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «سمعَ اللهُ لمَن حمدَه». فقالوا هم من ورائه: «ربنا ولك الحمدُ». وقال: «ولا الضالينَ». فقالوا من ورائه: «آمين». وأمرهم، فقالوا: سمعنا وأطعنا. ونهاهم، فقالوا: انتهينا انتهينا. وجاهدوا معه، وقُتلوا بين يديه، وفضَّلوا الموت على الحياة؛ فداءً له صلى الله عليه وسلم، كما قال عُبيدة بن الحارث وهو يُصرع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم: أما والله، لو أدرك أبو طالب هذا اليوم؛ لعلم أني أحق منه بما قال حين يقول:
كَذَبتُم وبَيتِ اللَه نُبزَى مُحَمَّدًا * ولَمّا نُطاعِن دونَهُ وَنُناضِلِ
ونُسلِمهُ حَتّى نُصَرَّعَ حَولَهُ * وَنذهلَ عَن أَبنائِنا والحَلائِلِ
وإذا كان هؤلاء يرتقي إليهم شك أو ريب، فمَن هو المربِّي أو القدوة أو السياسي أو القائد الذي سوف يصنع أتباعًا، ويقيم مجتمعًا، ويبني دولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
إن التشكيك في الجيل الأول هو تشكيك في جنس الإنسان، وإذا أصابنا شك في جدارة الأولين الذين ربَّاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن نثق بغيرهم، أو نتوقع نجاحًا من سواهم؟
وقد يحتج بعض الناس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ أمتي مَثَلُ المطر، لا يُدْرَى أوَّلُه خيرٌ أم آخرُهُ».
وهذا الحديث رواه أحمد، وغيره من طرق، وهو حسن بمجموع الطرق، وهو دليل أيضًا على فضل آخر هذه الأمة، وأن فيها من السابقين فضلًا عن أصحاب اليمين، وفيها خير كثير، ولكن لا يدل الحديث على تساوي الأولين والآخرين، وإنما تشبيه الصالحين المتأخِّرين بالسابقين الأولين.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: