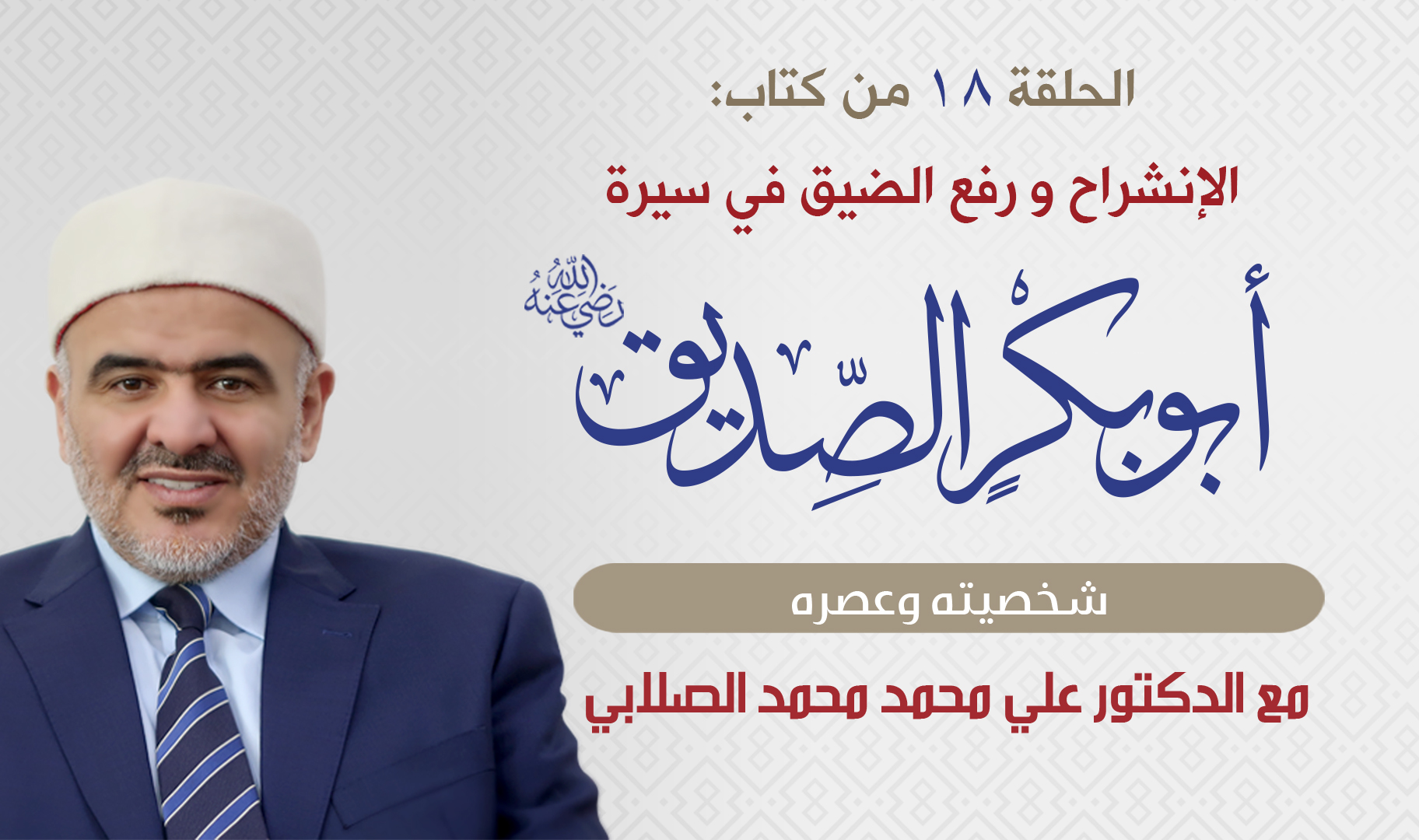من كتاب السِّيرة النَّبويّة للدكتور علي محمّد محمّد الصّلابيّ
الحلقة الثالثة والثلاثون
صور من البلاء العظيم الذي تعرَّض له صحابة النبيُّ صلى الله عليه وسلم (1)
تحمَّل الصَّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرَّواسي الشَّامخات، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يَسْلَمْ أشرافُ المسلمين من هذا الابتلاء.
- ما لاقاه أبو بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه:
لقد أُوذي أبو بكر رضي الله عنه، وحُثي على رأسه التُّراب، وضُرب في المسجد الحرام بالنِّعال حتَّى ما يُعرف وجهه من أنفه، وحُمِل إلى بيته في ثوبه، وهو ما بين الحياة والموت، فقد روت عائشة رضي الله عنها: أنَّه لـمَّا اجتمع أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً، ألحَّ أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهور، فقال: «يا أبا بكر! إنَّا قليل». فلم يزل أبو بكر يلحُّ حتَّى ظهر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وتفرَّق المسلمون في نواحي المسجد، كلُّ رجلٍ في عشيرته، وقام أبو بكر في النَّاس خطيباً ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فكان أوَّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وثار المشركون على أبي بكر، وعلى المسلمين، فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووُطِأىَ أبو بكر، وضُرب ضرباً شديداً، ودنا منه الفاسقُ عتبةُ بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين، ويُحرِّفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكرٍ رضي الله عنه، حتَّى ما يُعرف وجهه من أنفه، وجاءت بنو تَيْمٍ يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكرٍ، وحمَلتْ بنو تيم أبا بكرٍ في ثوب حتى أدخلوه منزله، ولا يشكُّون في موته، ثمَّ رجعت بنو تيمٍ، فدخلوا المسجد، وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تَيْم يكلِّمون أبا بكر حتَّى أجاب، فتكلَّم آخر النَّهار، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمسُّوا منه بألسنتهم، وعذلوه، وقالوا لأمِّه أمِّ الخير: انظري أن تطعميه شيئاً، أو تسقيه إيَّاه، فلـمَّا خلت به؛ ألحَّت عليه، وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أمِّ جميل بنت الخطاب، فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل؛ فقالت: إنَّ أبا بكرٍ يسألك عن محمَّد بن عبد الله، فقالت: ما أعرف أبا بكرٍ، ولا محمَّد بن عبد الله، وإن كنت تحبِّين أن أذهب معك إلى ابنك، قالت: نعم، فمضت معها؛ حتَّى وجدت أبا بكر صريعاً دَنِفاً، فدنت أمُّ جميل، وأعلنت بالصِّياح، وقالت: والله! إنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهلُ فِسْقٍ وكفرٍ، إنَّني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: هذه أمُّك تسمع، قال: فلا شيء عليك منها، قالت: سالمٌ، صالحٌ، قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم، قال: فإنَّ لله عليَّ ألاَّ أذوق طعاماً، ولا أشرب شراباً، أو اتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فأمهلتاه؛ حتَّى إذا هدأت الرِّجل وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما، حتَّى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: فأكبَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبَّله، وأكبَّ عليه المسلمون، ورقَّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّةً شديدة، فقال أبو بكر: بأبي، وأمي يا رسول الله! ليس بي بأسٌ إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمِّي بَرَّةٌ بولدها، وأنت مباركٌ فادعها إلى الله، وادعُ الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النَّار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاها إلى الله فأسلمت.
- دروسٌ، وعبرٌ، وفوائد:
- أ- حِرْصُ أبي بكرٍ رضي الله عنه على إعلان الإسلام، وإظهاره أمام الكفَّار، وهذا يدلُّ على قوَّة إيمانه، وشجاعته، وقد تحَمَّل الأذى العظيم، حتَّى إنَّ قومه كانوا لا يشكُّون في موته.
- مدى الحبِّ الَّذي كان يُكنُّه أبو بكرٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث إنَّه وهو في تلك الحال الحرجة، يسأل عنه، ويُلحُّ إلحاحاً عجيباً في السُّؤال، ثمَّ يحلف ألاَّ يأكل، ولا يشرب حتَّى يراه، كيف يتمُّ ذلك، وهو لا يستطيع المشي، بل النُّهوض؟ ولكنَّه الحبُّ الَّذي في الله، والعزائم التي تقهر الصِّعاب، وكلُّ مصابٍ في سبيل الله؛ ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم هيِّنٌ، ويسيرٌ.
- إنَّ العصبيَّة القبليَّة، كان لها في ذلك الحين دورٌ في توجيه الأحداث والتَّعامل مع الأفراد، حتَّى مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكرٍ تهدِّد بقتل عتبة؛ إن مات أبو بكر.
- الحسُّ الأمنيُّ لأمِّ جميلٍ رضي الله عنها، فقد برز في عدَّة تصرُّفاتٍ؛ لعلَّ من أهمها:
- إخفاء الشَّخصيَّة، والمعلومة عن طريق الإنكار:
عندما سألت أمُّ الخير أمَّ جميل، عن مكان الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، أنكرت أنَّها تعرف أبا بكر، ومحمَّد بن عبد الله، فهذا تصرُّفٌ حذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمُّ الخير ساعتئذٍ مسلمةً، وأمُّ جميل كانت تخفي إسلامها، ولا تودُّ أن تعلم به أمُّ الخير، وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ مخافةَ أن تكون عيناً لقريشٍ.
- استغلال الموقف لإيصال المعلومة:
فأمُّ جميلٍ أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكرٍ رضي الله عنه، وفي الوقت ذاته لم تظهر ذلك لأمِّ الخير؛ إمعاناً في السِّرِّيَّة، والكتمان، فاستغلَّت الموقف لصالحها قائلةً: «إن كنتِ تحبِّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت»، وقد عرضت عليها هذا الطَّلب بطريقةٍ تنم عن الذَّكاء وحسن التَّصرُّف، فقولها: «إن كنت تحبِّين - وهي أمُّه -» وقولها: «إلى ابنك»، ولم تقل لها: إلى أبي بكرٍ، كلُّ ذلك يحرِّك في أمِّ الخير عاطفة الأمومة، فغالباً ما ترضخ لهذا الطَّلب، هذا ما تم بالفعل؛ حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالتَّالي نجحت أمُّ جميل في إيصال المعلومة بنفسها.
- استغلال الموقف في كسب عطف أمِّ أبي بكر:
يبدو أنَّ أمَّ جميل حاولت أن تكسب عطف أمِّ الخير، فاستغلَّت وضع أبي بكرٍ رضي الله عنه، الَّذي يظهر فيه صريعاً دَنِفاً، فأعلنت بالصِّياح، وسَبَّتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقولها: «إنَّ قوماً نالوا هذا منكَ لأهلُ فسقٍ، وكفرٍ»؛ فلا شك أنَّ هذا الموقف من أمِّ جميلٍ يشفي بعض غليل أمِّ الخير من الَّذين فعلوا ذلك بابنها، فقد تُكِنُّ شيئاً من الحبِّ لأمِّ جميل، وبهذا تكون أمُّ جميل كسبت عطف أمِّ الخير، وثقتها، الأمر الذي يسهِّل مهمَّة أمِّ جميل في إيصال المعلومة إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه.
- الاحتياط والتأنِّي قبل النُّطق بالمعلومة:
لقد كانت أمُّ جميل في غاية الحيطة، والحذر، من أن تتسرَّب هذه المعلومة الخطيرة عن مكان قائد الدَّعوة، فهي لم تطمئن بعد إلى أمِّ الخير؛ لأنَّها ما زالت مشركةً آنذاك، وبالتَّالي لم تأمن جانبها، لذا تردَّدت عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له: هذه أمُّك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها، فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم سالمٌ صالحٌ، وزيادةً في الحيطة، والحذر، والتكتُّم لم تخبره بمكانه، إلا بعد أن سألها عنه قائلاً: أين هو؟ فأجابته: في دار الأرقم.
تخيُّر الوقت المناسب لتنفيذ المهمَّة:
حين طلب أبو بكرٍ رضي الله عنه الذَّهاب إلى دار الأرقم، لم تستجب له أمُّ جميل على الفور؛ بل تآخرت عن الاستجابة، حتى إذا هدأت الرِّجل وسكن النَّاس؛ خرجت به ومعها أمُّه يتكئ عليهما، فهذا هو أنسب وقت للتَّحرُّك، وتنفيذ هذه المهمَّة، حيث تنعدم الرَّقابة من قِبَلِ أعداء الدَّعوة، ممَّا يقلِّل من فرص كشفها، وقد نُفِّذت المهمَّةُ بالفعل دون أن يشعر بها الأعداء، حتَّى دخلت أمُّ جميل، وأمُّ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم، وهذا يؤكِّد: أنَّ الوقت المختار كان أنسب الأوقات.
- قانون المنحة بعد المحنة، حيث أسلمت أمُّ الخير أمُّ أبي بكر، بسبب رغبة الصِّدِّيق في إدخال أمِّه إلى حظيرة الإسلام، وطلبه من الرَّسول صلى الله عليه وسلم الدُّعاء لها؛ لِمَا رأى من برِّها به، وقد كان رضي الله عنه حريصاً على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟!.
- إنَّ من أكثر الصَّحابة الَّذين تعرَّضوا لمحنة الأذى، والفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصَّة له، والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرَّض فيها للأذى من قومه، فينبري الصِّدِّيق مدافعاً عنه، وفادياً إيَّاه بنفسه، فيصيبه من أذى القوم وسفههم، هذا مع أنَّ الصِّدِّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل، والإحسان.
- ما لاقاه بلالٌ رضيَ الله عنه:
تضاعف أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأصحابه؛ حتَّى وصل إلى ذروة العنف وخاصَّةً في معاملة المستضعفين من المسلمين، فنكَّلت بهم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم، وإسلامهم؛ ولتجعلهم عِبرةً لغيرهم، ولتنفِّس عن حقدها، وغضبها، بما تصبُّه عليهم من العذاب.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوَّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكرٍ، وعمَّارٌ، وأمُّه سميَّة، وصهيبٌ، وبلالٌ، والمقداد؛ فأمَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنعه الله بعمِّه أبي طالبٍ، وأمَّا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه، وأمَّا سائرهم؛ فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشَّمس، فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنَّه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدانَ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكَّة، وهو يقول: أحدٌ أحدٌ» [أحمد (1/404) وابن ماجه (150) واليبهقي في دلائل النبوة (2/281 - 282)]. لم يكن لبلال رضي الله عنه ظَهْرٌ يسنده، ولا عشيرةٌ تحميه، ولا سيوفٌ تذود عنه، ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليِّ المكيِّ يعادل رقماً من الأرقام، فليس له دورٌ في الحياة إلا أن يخدم، ويطيع، ويُباع، ويُشْترى كالسَّائمة، أمَّا أن يكون له رأيٌ، أو يكون صاحبَ فكرٍ، أو صاحب دعوةٍ، أو صاحب قضيَّةٍ، فهذه جريمةٌ شنعاءُ في المجتمع الجاهليِّ المكيِّ، تهزُّ أركانه، وتزلزل أقدامه، ولكنَّ الدَّعوة الجديدة؛ الَّتي سارع لها الفتيان؛ وهم يتحدَّون تقاليد، وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميِّ المنسيِّ، فأخرجته إنساناً جديداً على الوجود، فقد تفجَّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن امن بهذا الدِّين، وانضمَّ إلى محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وإخوانه في موكب الإيمان العظيم، وها هو الآن يتعرَّض للتَّعذيب من أجل عقيدته، ودينه، فقصد وزيرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصِّديقُ موقعَ التَّعذيب، وفاوض أميَّةَ بن خلف، وقال له: «ألا تتَّقي الله في هذا المسكين؟ حتَّى متَّى؟! قال: أنت الَّذي أفسدته، فأنقذه ممَّا ترى! فقال أبوبكر: أفعل، عندي غلامٌ أسود أجلد منه، وأقوى على دينك، أعطيكه به، قال: قد قبلت؛ فقال: هو لك، فأعطاه أبو بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذه، فأعتقه». وفي روايةٍ: اشتراه بسبع أواقٍ، أو بأربعين أوقيَّةٍ ذهباً.
ما أصبر بلالاً، وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام، طاهر القلب، ولذلك صَلُبَ ولم تَلِنْ قناتُه أمام التَّحدِّيات، وأمام صنوف من العذاب، وكان صبره، وثباته ممَّا يغيظهم، ويزيد حنقهم، خاصَّةً: أنَّه كان الرَّجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الَّذي ثبت على الإسلام، فلم يواتِ الكفار فيما يريدون، مردِّداً كلمة التَّوحيد بتحدٍّ صارخٍ، وهانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه.
وبعد كلِّ محنةٍ منحةٌ؛ فقد تخلَّص بلالٌ من العذاب والنَّكال، وتخلَّص من أسر العبودية، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيَّـة حياته ملازماً له، ومات راضياً عنه مبشِّراً إيَّاه بالجنَّة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لبلال: «... فإنِّي سمعت الليلةَ خَشْفَ نعليك بين يديَّ في الجنة» [البخاري (1149) ومسلم (2458)]. وأمَّا مقامه عند الصَّحابة، فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر سيدنا، وأعتق سيِّدنا» يعني: بلالاً.
وأصبح منهج الصِّدِّيق في فكِّ رقاب المستضعفين ضمن الخطَّة الَّتي تبنَّتها القيادة الإسلامية لمقاومة التَّعذيب الَّذي نزل بالمستضعفين، فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمِّين إلى هذا الدِّين الجديد من الرِّقِّ.
«ثمَّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستَّ رقابٍ؛ بلالٌ سابعهم: عامر بن فهيرة شهد بدراً، وأحداً، وقُتل يوم بئر معونة شهيداً، وأمُّ عُبيس، وزِنِّيرة، وأُصيب بصرُها حتى أعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات، والعزَّى. فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضرُّ اللات والعزَّى، وما تنفعان، فردَّ الله بصرها. وأعتق النَّهدية، وبنتها، وكانتا لامرأةٍ من بني عبد الدَّار، فمرَّ بهما، وقد بعثتهما سيِّدتهما بطَحينٍ لها، وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه: حِلٌّ يا أمَّ فلان! فقالت: حِلٌّ، أنت أفسدتهما، فأعتقهما، قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا، وكذا. قال: قد أخذتُهما، وهما حرَّتان، أَرْجعا إليها طَحينها. قالتا: أوَ نَفْرَغُ منه يا أبا بكر! ثمَّ نردُّه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شئتما».
وهنا وقفة تأمُّل ترينا كيف سوَّى الإسلام بين الصِّدِّيق والجاريتين حتَّى خاطبتاه، خطابَ الندِّ للندِّ، لا خطاب المسود للسَّيِّد، وتقبَّل الصِّدِّيق - على شرفه، وجلالته في الجاهليَّة، والإسلام - منهما ذلك، مع أنَّ له يداً عليهما بالعتق، وكيف صقل الإسلام الجاريتين حتَّى تخلَّقتا بهذا الخلق الكريم، وكان يمكنهما، وقد أُعتقتا، وتحرَّرتا من الظُّلم أن تدعا لها طحينها يذهب أدراجَ الرِّياح، أو يأكله الحيوان، والطَّير، ولكنَّهما أبتا - تفضُّلاً - إلا أن تفرغا منه، وتردَّاه إليها.
ومرَّ الصِّدِّيق بجارية بني مُؤَمَّل - حيٌّ من بني عديِّ بن كعب - وكانت مسلمةً، وعُمر بن الخطَّاب يُعذِّبها لتترك الإسلام، وهو يومئذٍ مشركٌ، وهو يضربها، حتَّى إذا ملَّ؛ قال: إني أعتذر إليك، إنِّي لم أتركك إلا عن ملالةٍ، فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكرٍ، فأعتقها.
هكذا كان واهب الحرِّيَّات، ومحرِّر العبيد، شيخ الإسلام الوقور؛ الَّذي عُرف بين قومه بأنَّه يكسب المعدوم، ويصل الرَّحم، ويحمل الكلَّ، ويُقري الضَّيف، ويعين على نوائب الحقِّ، لم ينغمس في إثمٍ في جاهليته، أليفٌ مألوفٌ، يسيل قلبه رقَّةً ورحمةً على الضُّعفاء، والأرقَّاء، أنفق جزءاً كبيراً من ماله في شراء العبيد، وأعتقهم لله، وفي الله قبل أن تنزل التَّشريعات الإسلاميَّة المحبَّبة في العتق، والواعدة عليه أجزل الثَّواب.
- ما لاقاه عمَّار بن ياسرٍ، وأبوه، وأمُّه رضي الله عنه:
كان والد عمَّار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن، قدم مكَّة، وأخواه: الحارثُ، ومالكٌ يطلبون أخاً لهم، فرجع الحارث، ومالكٌ إلى اليمن، وأقام ياسرٌ بمكَّة، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزوميَّ، فزوَّجه أبو حذيفةَ أَمَةً له، يقال لها: سُميَّة بنت خيَّاط، فولدت له عَمَّاراً، فأعتقه أبو حذيفة الَّذي لم يلبث أن مات، وجاء الإسلام، فأسلم ياسر، وسميَّة، وعمَّار، وأخوه عبد الله بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً، وصبُّوا عليهم العذاب صبّـاً، فكانوا يُخْرِجونهـم إذا حميـت الظَّهـيرة، فيعذِّبونهـم برمضـاء مكَّة، ويقلِّبونهم ظهراً لبطنٍ ، فيمرُّ عليهم الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يعذَّبون، فيقول: «صبراً آل ياسر! فإنَّ موعدكم الجنة» [الحاكم (3/383) والحلية (1/140) والمطالب العالية (4034)]. وجاء أبو جهل إلى سميَّة، فقال لها: ما امنت بمحمَّد إلا لأنكِ عشقتِه لجماله، فأغلظت له القول، فطعنها بالحربة في ملمس العِفَّة، فقتلها، فهي أوَّل شهيدة في الإسلام رضي الله عنها، وبذلك سطَّرت بهذا الموقف الشُّجاع أعلى، وأغلى ما تقدِّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ لتبقى كلُّ امرأةٍ مسلمةٍ حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها، ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها، فلا تبخل بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت سميَّة بنت خيَّاط بدمها في سبيل الله.
وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذاً بيده نتمشَّى بالبطحاء، حتَّى أتى على ال عمَّار بن ياسر، فقال أبو عمَّار: يا رسول الله! الدَّهر هكذا؟ فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : اصبر، ثمَّ قال: اللَّهمَّ اغفر لال ياسرٍ، وقد فعلتَ» [أحمد (1/62)].، ثمَّ لم يلبث ياسر أن مات تحت العذاب.
لم يكن في وسع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يقدمَ شيئاً لآل ياسر، رموز الفداء، والتضحية، فليسوا بأرقاء حتَّى يشتريهم، ويعتقهم، وليست لديه القوَّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب، فكلُّ ما يستطيعه صلى الله عليه وسلم أن يزفَّ لهم البشرى بالمغفرة، والجنَّة، ويحثَّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة المباركـة قدوةً للأجيال المتلاحقـة، ويشهد الموكب المستمـرُّ على مدار التَّاريخ هذه الظَّاهرة: «صبراً ال ياسر! فإنَّ موعدكم الجنَّة» .
أمَّا عمَّارٌ رضي الله عنه، فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً، فهو يُصنَّف في طائفة المستضعفين، الَّذين لا عشائر لهم بمكَّة تحميهم، وليست لهم منعةٌ، ولا قوَّةٌ، فكانت قريش تعذِّبهم في الرَّمضاء بمكَّة في منتصف النَّهار؛ ليرجعوا عن دينهم، وكان عمَّار يُعذَّب حتَّى لا يدري ما يقول. ولـمَّا أخذه المشركون ليعذبوه؛ لم يتركوه حتَّى سبَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وذكر الهتهم بخيرٍ، فلـمَّا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما وراءك؟» قال: شرٌّ، والله ما تركني المشركون حتى نلت منك! وذكرت الهتهم بخير، قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنّاً بالإيمان، قال: « فإن عادوا؛ فعد »[الحاكم (2/357) والزيلعي في نصب الرايـة (4/158)] . ونزل الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان عمَّار. قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106]، وقـد حضر المشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي حادثتي بلالٍ، وعمَّارٍ فقهٌ عظيمٌ يتراوح بين العزيمة، والرُّخصة، يحتاج الدُّعاة أن يستوعبوه، ويضعوه في إطاره الصَّحيح، وفي معاييره الدَّقيقة دون إفراطٍ، أو تفريطٍ.
- ما لاقاه سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه:
تعرَّض للفتنـة من قِبَـلِ والدته الكافرة، فقد امتنعت عن الطَّعام، والشَّراب حتَّى يعود إلى دينها. روى الطَّبرانيُّ: أن سعداً قال: أُنزلت فيَّ هذه الآية: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا﴾[العنكبوت: 8].
قال: كنت رجلاً بارّاً بأمِّي، فلـمَّا أسلمتُ، قالت: يا سعد! ما هذا الدِّين الَّذي أراك قد أحدثت؟! لتدعنَّ دينك هذا، أو لا اكل، ولا أشرب حتَّى أموت، فتُعيَّر بي، فيقال: يا قاتلَ أمه! فقلت: لا تفعلي يا أُمَّه؛ فإنِّي لا أدع ديني لشيء، فمكثتْ يوماً وليلةً لم تأكل، فأصبحتْ؛ وقد جهدت، فمكثتْ يوماً آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فمكثتْ يوماً آخر وليلةً أخرى لا تأكل، فأصبحتْ قد اشتدَّ جهدها، فلـمَّا رأيت ذلك؛ قلت: يا أُمَّه، تعلمين والله لو كانت لك مئة نفسٍ، فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشيءٍ، فإن شئت؛ فكلي، وإن شئت؛ لا تأكلي! فأكلتْ.
وروى مسلمٌ: أنَّ أمَّ سعدٍ حلفت ألاَّ تكلِّمه أبداً؛ حتَّى يكفر بدينه، ولا تأكل، ولا تشرب، قالت: زعمْتَ أنَّ الله وصَّاك بوالديك، وأنا أمُّك، وأنا امرك بهذا، قال: مكثتْ ثلاثاً حتَّى غُشي عليها من الجهد، فقال ابنٌ لها - يقال له عُمَارَةَ - فسقاها، فجعلت تدعو على سعدٍ، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ - في القرآن الكريم هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي﴾؛ وفيها: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصاً، ثمَّ أَوْجَرُوها [مسلم (1748) والترمذي (3189)]. فمحنة سعدٍ محنةٌ عظيمةٌ، وموقفه موقف فَذٌّ، يدلُّ على مدى تغلغل الإيمان في قلبه، وأنَّه لا يقبل فيه مساومةً مهما كانت النَّتيجة.
ومن خلال تتبُّع القرآن المكيِّ، نجد: أنَّه برغم قطع الولاء، سواءٌ في الحبِّ، أو النُّصرة بين المسلم وأقاربه الكفَّار، فإنَّ القرآن أمر بعدم قطع صلتهم، وببرِّهم، والإحسان إليهم، ومع ذلك فلا ولاء بينهم؛ لأنَّ الولاء للهِ ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لدينه، وللمؤمنين.