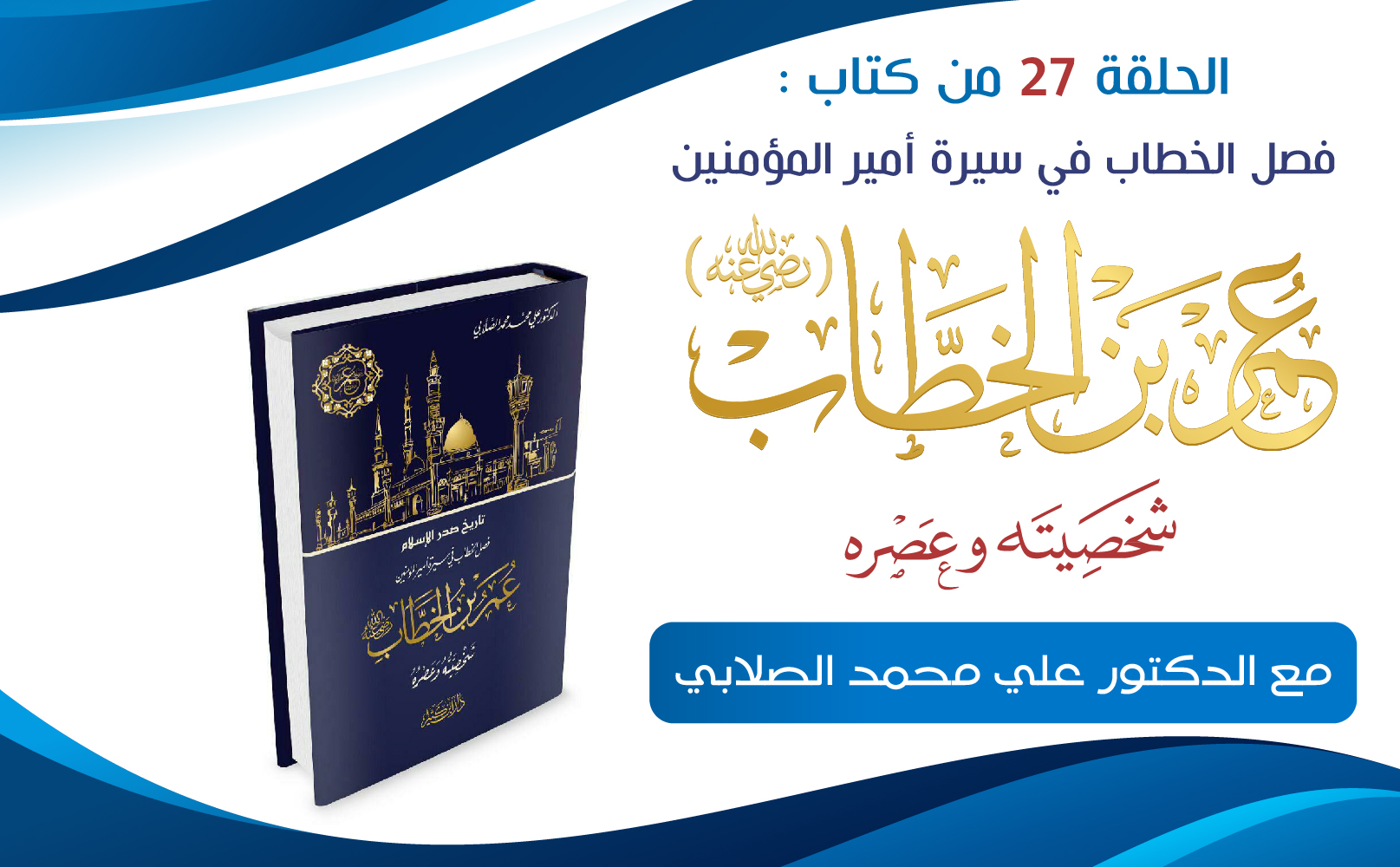الحلقة الرابعة عشر بعد المئة (114)
غزوة حنين، والطَّائف (8 هـ) أسبابها، وأحداث المعركة
لـمَّا فتح الله مكَّة على رسوله، والمؤمنين، وخضعت له قريشٌ، خافت هوازن، وثقيفٌ، وقالوا: قد فرغ محمَّد لقتالنا، فلنغزُه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على هذا، وولَّوْا عليهم مالكَ بن عوف النَّصْريَّ، فاجتمع إليه هوازن، وثقيف وبنو هلال، ولم يحضرها من هوازن كعبٌ، وكلابٌ، وكان معهم دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّة، وكان معروفاً بشدَّة البأس في الحرب، وأصالة الرَّأي، إلا أنَّه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي، والمشورة.
وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم النِّساء والذَّراري، والأموال حتى لا يفرُّوا، فلـمَّا علم بذلك دُرَيْدُ؛ سأله: لِمَ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كلِّ رجلٍ أهلَه، ومالَه؛ ليقاتل عنهم، فقال دُرَيْدُ: راعي ضأنٍ والله، وهل يردُّ المنهزمَ شيءٌ؟! إنَّها إن كانت لك؛ لم ينفعك إلا رجلٌ بسيفه، ورمحه، وإن كانت عليك؛ فُضِحْتَ في أهلك ومالك!! ولكنَّه لم يستمع لمشورته.
أوَّلاً: أهمُّ أحداث غزوة حنين:
تحرَّك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال، ووصلوا حنين في مساء العاشر من شوَّال، وقد استخلف الرَّسول (ص) عَتَّابَ بْنَ أَسِيْدٍ على مكَّة عند خروجه، وكان عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفاً من المسلمين، أمَّا عدد هوازن، وثقيف: فكانوا ضعف عدد المسلمين، أو أكثر، ولما رأى بعض الطُّلقاء جيش المسلمين؛ قالوا: لن نُغْلَبَ اليوم من قلَّة، ودخل الإعجابُ في النُّفوس.
أ - التعبئة الَّتي اتَّخذها مالكُ بن عوف زعيمُ هوازن، وثقيف:
اتَّخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئةً عاليةً، مرَّت بمراحل:
1 - رفع الرُّوح المعنويَّة لدى جنوده:
وقف مالك خطيباً في جيشه، وحثَّهم على الثَّبات، والاستبسال، وممَّا قال في هذا الجمع الحاشد: إنَّ محمداً لم يقاتل قطُّ قبل هذه المرَّة، وإنما كان يلقى قوماً أغماراً، لا علم لهم بالحرب فيُنصَرُ عليهم.
2 - حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش:
أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين، وأطفالهم، وأموالهم خلفهم، وقد قصد من وراء هذا التَّصرُّف دفع المقاتلين إلى الاستبسال، والثبات أمام أعدائهم؛ لأنَّ المقاتل - من وجهة نظره - إذا شعر أنَّ أعزَّ ما يملك وراءهُ في المعركة؛ صعُب عليه أن يلوذ بالفرار مخلِّفاً ما وراءه في ميدان المعركة؛ عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، قال: افتتحنا مكَّة، ثمَّ غزونا حنيناً، فجاء المشركون بأحسن صفوفٍ رأيتُ، قال: فصُفَّتِ الخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّت المقاتلة، ثمَّ صُفَّتِ النِّساءُ من وراء ذلك، ثُمَّ صُفَّتِ الغنم، ثم صُفَّتِ النَّعَمُ. [مسلم (1059/136)].
3 - تجريد السُّيوف، وكسر أجفانها:
جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال، وهذا التَّصرُّف يؤذن بإصرار المقاتل على الثَّبات أمام الخصم حتَّى النَّصر أو الموت، وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقاً لهذا، بدليل قولـه: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم، وشدُّوا شدَّة رجلٍ واحدٍ عليهم. [الحاكم (3/48 - 49)، ومجمع الزوائد (6/179 - 180)].
4 - وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم:
كان عند مالك بن عوف النَّصْرِيِّ معلوماتٌ وافيةٌ عن الأرض الَّتي ستدور عليها المعركة، ولهذا رأى أن يستغلَّ هذه الظُّروف الطَّبيعيَّة لصالح جيشه، فعمل بمشورة الفارس المحنَّك دُرَيْدُ بن الصِّمَّة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين، وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين لولا لطفُ الله - سبحانه وتعالى - وعنايتُه.
5 - الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين:
كان ضمنَ الخطَّة الَّتي رسمها القائد الهوازنيُّ الأخذُ بزمام المبادرة، ومهاجمة المسلمين؛ لأنَّ النَّصر في الغالب يكون للمهاجم، أمَّا المدافع فغالباً ما يكون في مركز الضَّعف، ولهذا اتت هذه الخطَّة ثمارها بعض الوقت، ثمَّ انقلبت موازين القوى - بفضل الله تعالى - ثمَّ بثبات رسول الله (ص) حيث كسب المسلمون الجولة، وانتصروا على أعدائهم.
6 - شن الحرب النَّفسيَّة ضدَّ المسلمين:
كان من ضمن بنود الخطَّة الحربيَّة الَّتي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازنيُّ، استعمال سلاحٍ معنويٍّ، له تأثيرٌ كبيرٌ في النُّفوس، فقد شنَّ الحرب النَّفسيَّة ضدَّ المسلمين من أجل إلقاء الخوف في نفوسهم، وذلك بأن عمد إلى عشرات الالاف من الجمال الَّتي صحبها معه في الميدان، فجعلها وراء جيشه ثمَّ أركب عليها النساء، فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب من يراه: أنَّ هذا الجيش مئة ألف مقاتلٍ، وهو ليس كذلك.
ب - خطوات الرَّسول (ص) لصدِّ هذه الحشود:
لـمَّا بلغ النبي (ص) عزم هوازن على حربه بعد أن تمَّ له فتح مكَّة - شرَّفها الله - قام بالآتي:
1 - أرسل عبدَ الله بن أبي حَدْرَد الأسْلميَّ حتَّى يوافيه بخبر هوازن:
فذهب رضي الله عنه، ومكث بينهم يوماً أو يومين، ثم عاد، وأخبر النَّبي (ص) بما رأى.
ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرَّسول (ص) وعاد على وجه السُّرعة بخبر هؤلاء الأعداء، إلا أنَّه قصَّر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملاً بحيث يسمع، ويرى ما يُدبَّر ضدَّ المسلمين هناك، وكان من أهمِّ ما يجب أن يُعنى به معرفة مواقع المشركين الَّتي احتلُّوها، وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن الَّتي نصبها الأعداء في منحنيات الوادي، حتَّى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في الجولة الأولى، فكان الجهل بهذه الكمائن أحدَ الأسباب الرَّئيسة وراء هزيمة المسلمين في أوَّل المعركة، وما حدث نتيجةً لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثَّابتة لرسول الله (ص) ؛ لأنَّ هذا الأمر ليس وحياً من الله - سبحانه وتعالى - وإنَّما هو من باب الاجتهاد في الأمور العسكريَّة، وقد بذل النَّبيُّ (ص) جهده في سبيل الحصول على أدقِّ المعلومات، وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها الخطَّة العسكريَّة المناسبة لمجابهة العدوِّ.
2 - عُدَّة الجيش، واستعارة الدُّروع، والرِّماح:
أعدَّ رسول الله (ص) جيشاً قوامه عشرة الاف، وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة، وألفان من مسلمة الفتح، فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفاً، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: لـمَّا كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن، وغطفان بذراريهم، ونَعَمِهم؛ ومع النَّبِيِّ (ص) يومئذٍ عشرة الاف، ومعه الطُّلقاء، وهم ألفان [مسلم (1059/135)]، وسعى (ص) لتأمين عُدَّة الجيش فطلب من ابن عمِّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة الاف رمح إعارةً، وطلب من صفوان بن أميَّة دروعاً، وتكفَّل (ص) بالضَّمان، وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم. عن صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه عن النَّبيِّ (ص) قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم - أو قال: فادفع إليهم - ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً، أو أقلَّ من ذلك» فقال له: العارية مؤدَّاة يا رسول الله؟! قال: فقال النَّبيُّ (ص) : «نعم» [أحمد (4/222)، وأبو داود (3566)، والنسائي في السنن الكبرى (5744)].
وفي روايةٍ: أنَّ رسول الله (ص) استعار منه يوم حنين دروعاً، فقال: أغصباً يا محمد؟! قال: «لا، بل عاريةٌ مضمونةٌ». قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله (ص) أن يضعها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم، ثمَّ أسلم. [أحمد (6/465)، وأبو داود (3562)، والحاكم (3/49)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/89)].
3 - ثباته (ص) وأثره في كسب المعركة:
سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين، واختاروا مواقعهم، وبثُّوا كتائبهم في شعابه، ومنعطفاته، وأشجاره، وكانت خطَّتهم تتمثَّل في مباغتة المسلمين بالسِّهام في أثناء تقدُّمهم في وادي حنين المنحدر.
لقد باغت المشركون المسلمين، وأمطروهم من جميع الجهات، فاضطربت صفوفهم، وماج بعضهم في بعضٍ، ونتيجةً لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش، ولاذوا بالفرار، كلٌّ يطلب النَّجاة لنفسه، وبقي الرَّسول (ص) ، ونفرٌ قليل في الميدان يتصدَّوْن لهجمات المشركين، ونترك العباس عمَّ الرسول (ص) يصف لنا ذلك المشهد المهيب، حيث يقول: شهدت مع رسول الله (ص) يوم حنين، فلزمتُ أنا، وأبو سفيان بن الحارث رسولَ الله (ص) ، فلم نفارقه ، ورسول الله (ص) على بغلةٍ لـه بيضاء، فلـمَّا التقى المسلمون والكفـار ؛ وَلَّى المسلمون مدبريـن، فطفق رسول الله (ص) يَرْكُضُ بغلته قِبَلَ الكفار، قال العباس: وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الله (ص) أَكُفُّها إرادة ألاَّ تسرع، فقال رسول الله (ص) : «أي عباس ! نادِ أصحاب السَّمُرَة».
فقال العباس - وكان رجلاً صَيِّتَاً - فقلت: بأعلى صوتي: أين أصحاب السَّمُرة؟ قال: فوالله! لكأن عَطْفَتَهم حين سمعوا صوتي عَطْفَةُ البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفَّارَ، والدَّعوةُ في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثمَّ قُصِرتِ الدَّعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله (ص) وهو على بغلته، كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله (ص) : «هذا حينَ حميَ الوطيسُ». [مسلم (1775)، وعبد الرزاق في المصنف (5/379 - 380)، وابن هشام (4/87)].
لقد أيّد الله نبيَّه (ص) يوم حنينٍ بأمورٍ، منها:
- نزول الملائكة من السَّماء.
- سلاح الرُّعب.
- تأثير قبضتي الحصى والتُّراب في أعين الأعداء.
من الأسلحة المادِّية الَّتي أيَّد الله بها رسولَه (ص) يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والتُّراب اللَّتين رمى بهما وجوه المشركين، حيث دخل في أعينهم كلِّهم من ذلك الحصى والتُّراب، فصار كلُّ واحد يجد لها في عينيه أثراً، فكان من أسباب هزيمتهم، قال العبَّاس رضي الله عنه: ثمَّ أخذ رسول الله (ص) حصياتٍ، فرمى بهنَّ وجوه الكفَّار. ثمَّ قال: «انهزَموا وربِّ محمَّد!» قال: فذهبت أنظر فإذا القتالُ على هيئته فيما أرى، قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدَّهم كليلاً، وأمرهم مُدْبراً. [سبق تخريجه].
ثانياً: مطاردة فلول الفارِّين إلى أوطاس، والطَّائف:
أ - قال أبو موسى الأشعريُّ رضي الله عنه:
لـمَّا فرغ النَّبيُّ (ص) من حنين؛ بعث أبا عامر على جيشٍ إلى أوطاس، فلقي دُريد بن الصِّمَّة، فَقُتِل دُرَيْدُ، وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرُمي أبو عامر في رُكبته، رماه جُشميٌّ بسهمٍ فأثبته في رُكبته، فانتهيت إليه، فقلت: يا عمُّ! مَنْ رماك ؟ فأشار إلى أبي موسى ، فقال : ذاك قاتلي الَّذي رماني ، فقصدت له، فلحقته، فلما راني وَلَّى، فاتَّبَعْتُهُ، وجعلت أقول له: ألا تستحي، ألا تثبت، فكفَّ. فاختلفنا ضربتين بالسَّيف فقتلتُه، ثمَّ قلت لأبي عامرٍ، قتل الله صاحبك. قال: فانْزِع هذا السَّهم، فنزعتُه، فنزل منه الماء.
قال: يابن أخي! أقرئ النَّبيَّ (ص) السَّلام، وقل له: استغفر لي، واسْتَخْلَفَني أبو عامرٍ على النَّاس، فمكث يسيراً ثمَّ مات. فرجعتُ، فدخلت على النَّبيِّ (ص) في بيته على سريرٍ مُرْمَلٍ، وعليه فراش قد أثَّر رمالُ السَّرير بظهره، وجنبيه، فأخبرته بخبرنا، وخبر أبي عامر، وقوله: قل له: استغفر لي، فدعا بماء، فتوضَّأ، ثمَّ رفع يديه فقال: «اللَّهُمَّ! اغفر لعُبيد أبي عامر». ورأيت بياضَ إبطيه. ثمَّ قال: «اللَّهُمَّ! اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ من خلقك من النَّاس» فقلت: ولي فاستغفر، فقال: «اللَّهُمَّ! اغفر لعبد الله بن قيس ذنبَه، وأدخله يوم القيامة مُدْخلاً كريماً».
قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى. [البخاري (2884)، ومسلم (2498)].
ب - محاصرة الفارّين إلى الطائف:
حاصر رسول الله (ص) أهل الطَّائف واستخدم أساليب متنوعةً في القتال، والحصار، ومارس الشُّورى، واختار المكان المناسب عند الحصار، واستخدم الحرب النَّفسيَّة، والدِّعاية في صفوف الأعداء، ومن هذه الأساليب:
1 - استخدم (ص) أسلوباً جديداً في القتال:
استعمل النَّبيُّ (ص) في حصاره للطَّائف أسلحةً جديدةً لم يسبق له أن استعملها من قبلُ، وهذه الأسلحة هي:
ـ المنجنيق:
فقد ثبت: أنَّ الرَّسول (ص) استعمل هذا السِّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطَّائف، فعن مكحولٍ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ (ص) نصب المنجنيق على أهل الطَّائف. [أبو داود في المراسيل (335)، والترمذي في نهاية الحديث (2762)].
والمنجنيق من أسلحة الحصار الثَّقيلة ذات التأثير الفعَّال على من وُجِّهَت إليه، فبحجارته تُهدَّم الحصون والأبراج، وبقنابله تُحَرَّق الدُّور والمعسكرات، وهذا النَّوع يحتاج إلى عدد من الجنود في إدارته، واستخدامه عند القتال.
ـ الدَّبابة:
ومن أسلحة الحصار الثَّقيلة الَّتي استعملها الرَّسول (ص) لأوَّل مرَّةٍ في حصار الطائف: الدَّبابة، والدَّبابة على شكل بيت صغير تُعمل من الخشب، وتُتَّخذ للوقاية من سهام الأعداء، عندما يُراد نقض جدار الحصن، بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لهم من الرَّمي.
ـ الحسَك الشَّائِك:
من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرَّسول (ص) في حصاره لأهل الطائف الحسَّك الشَّائك، وهو من وسائل الدِّفاع الثابتة، ويُعمل من خشبتين تُسمَّران على هيئة الصليب، حتَّى تتألَّف منها أربعةُ شعبٍ مدبَّبة، وإذا رُمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل، والمشاة، فتتعطَّل حركة السَّير السَّريعة المطلوبة في ميدان القتال.
وقد ذكر أصحاب المغازي، والسِّير: أنَّ الرَّسول (ص) استعمل هذا السِّلاح في حصاره لأهل الطَّائف، حيث أمر جنده بنشر الحسك الشَّائك حول حصن ثقيف وفي هذا إشارة لقادة الأمَّة خصوصاً، والمسلمين عموماً ألاَّ يعطِّلوا عقولهم، وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النَّافع، والجديد الَّذي يُحَقِّق للأمَّة مصلحة الدَّارين، ويدفع عنها شرور أعدائها.
2 - اختيار رسول الله (ص) مكاناً مناسباً عند القتال:
نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريبٍ من الحصن، وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى أمطرهم الأعداء بوابل من السِّهام؛ فأصيب من جرَّاء ذلك ناسٌ كثيرون، وحينئذٍ عرض الحُبَابُ بنُ المنذر على الرَّسول (ص) فكرة التَّحوُّل من هذا الموقع إلى مكانٍ آمن من سهام أهل الطَّائف، فقبل (ص) هذه المشورة، وكلَّف الحُبَاب؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيَّة الواسعة في هذا المجال بالبحث عن موقعٍ ملائم لنزول الجند، فذهب رضي الله عنه ثمَّ حدد المكان المناسب، وعاد فأخبر النَّبيَّ (ص) بذلك، فأمر النَّبيُّ (ص) جيشه بالتَّحوُّل إلى المكان الجديد.
وهذا شاهد عيان يحدِّثنا عَمَّا رأى، قال عمرو بن أميَّة الضَّمريُّ رضي الله عنه: لقد اطلع علينا مِنْ نبلهم ساعة نَزَلْنا شيءٌ الله به عليم، كأنَّه رَجْلُ جرادٍ، وترَّسنا لهم حتَّى أصيب ناسٌ من المسلمين بجراحةٍ، ودعا رسول الله (ص) الحُبَاب، فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن القوم» فخرج الحُبَاب حتَّى انتهى إلى موضع مسجد الطَّائف خارج القرية، فجاء إلى النَّبيِّ (ص) فأخبره، فأمر النَّبيُّ (ص) أن يتحوَّلوا.
3 - استخدام الحرب النَّفسيَّة والدِّعاية:
لما اشتدَّت مقاومة أهل الطائف، وقتلوا مجموعةً من المسلمين؛ أمر النَّبيُّ (ص) بتحريق بساتين العنب، والنَّخل في ضواحي الطَّائف للضغط على ثقيفٍ، ثمَّ أوقف هذا العمل بعد أَثَرِهِ في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة، وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وبالرَّحم أن يترك هذا العمل، ووجَّه النَّبيُّ (ص) نداءً لِعَبِيدِ الطَّائف أنَّ من ينزل من الحصن، ويخرج إلى المسلمين فهو حرٌّ، فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة الثَّقفي، فأسلموا، فأعتقهم، ولم يعدهم إلى ثقيفٍ بعد إسلامهم.
4 - الحكمة من رفع الحصار:
كانت حكمة رسول الله (ص) في رفع الحصار واضحةً، فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعةً لها، بل صارت ضمن سيادة الدَّولة الإسلاميَّة، ولم تعد تستمدُّ قوَّتها إلا من امتناع حصونها، فحصارها ورفعه سواء أمام القائد المحنَّك، وقد استشار رسول الله (ص) مَنْ حوله في عمليَّة الحصار، فقال نوفل بن معاوية الدَّيليُّ: ثعلب في حجرٍ؛ إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرَّك! فأمر رسول الله (ص) ابن الخطَّاب فأذَّن في النَّاس بالرَّحيل، فضج النَّاس من ذلك، وقالوا: نرحل، ولم يُفتح علينا الطَّائف؟! فقال رسول الله (ص) : «فاغدوا على القتال»، فغدوا فأُصيب المسلمون بجراحاتٍ، فقال رسول الله (ص) : «إنا قافلون غداً إن شاء الله»، فسُرُّوا بذلك، وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسولُ الله (ص) يضحك. [البخاري (4325)، ومسلم (1778)]. فلـمَّا ارتحلوا، واستقلُّوا، قال: «قولوا: ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» [أحمد (2/21)، والبخاري (1797)، ومسلم (1344)]، وقيل: يا رسول الله! ادعُ الله على ثقيفٍ، فقال: «اللَّهمَّ اهدِ ثقيفاً، وائتِ بهم». [أحمد (3/343)، والترمذي (2942)، وابن أبي شيبة في المصنف (12/201)، وانظره في مشكاة المصابيح (5986)].
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ


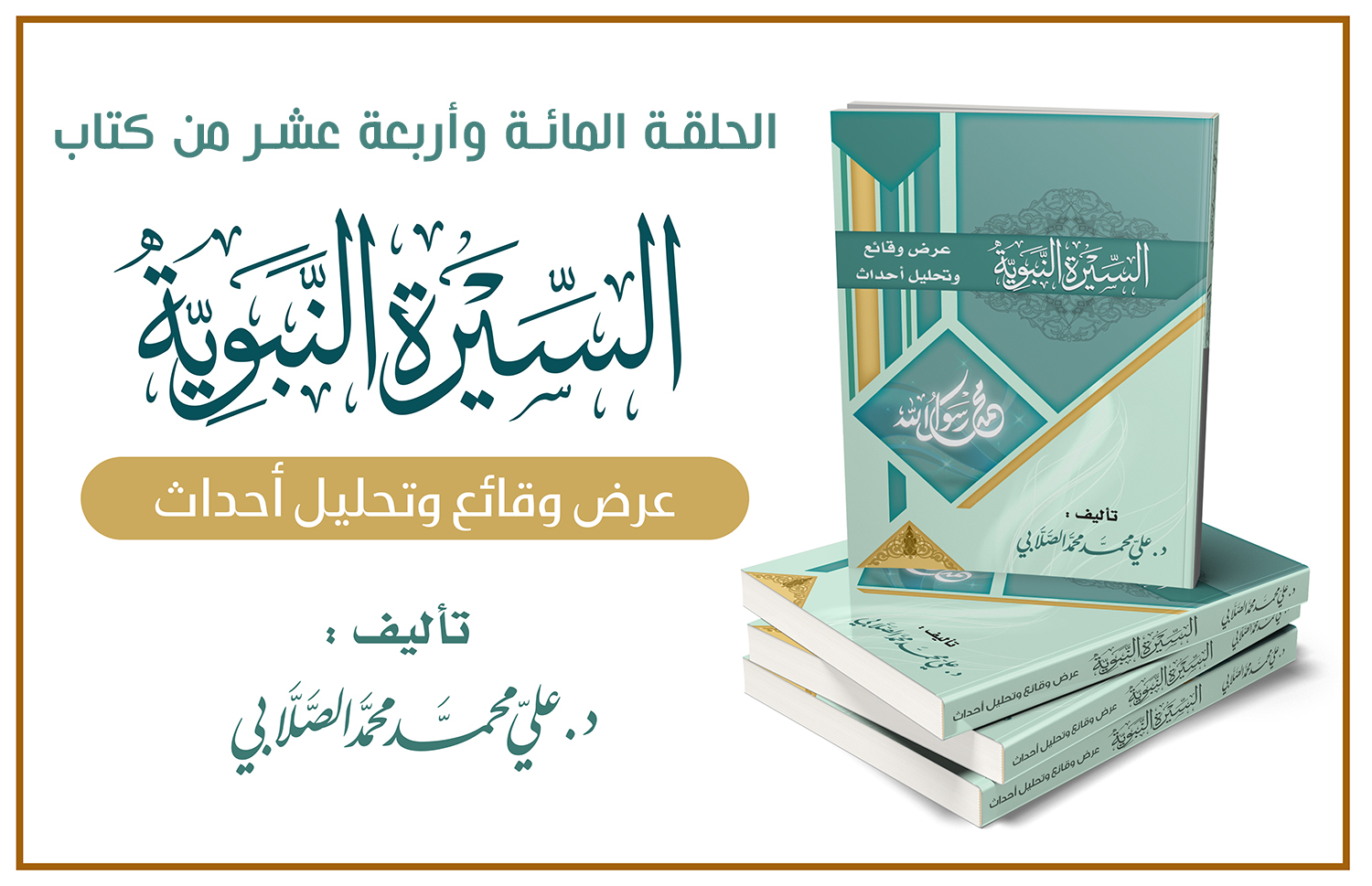
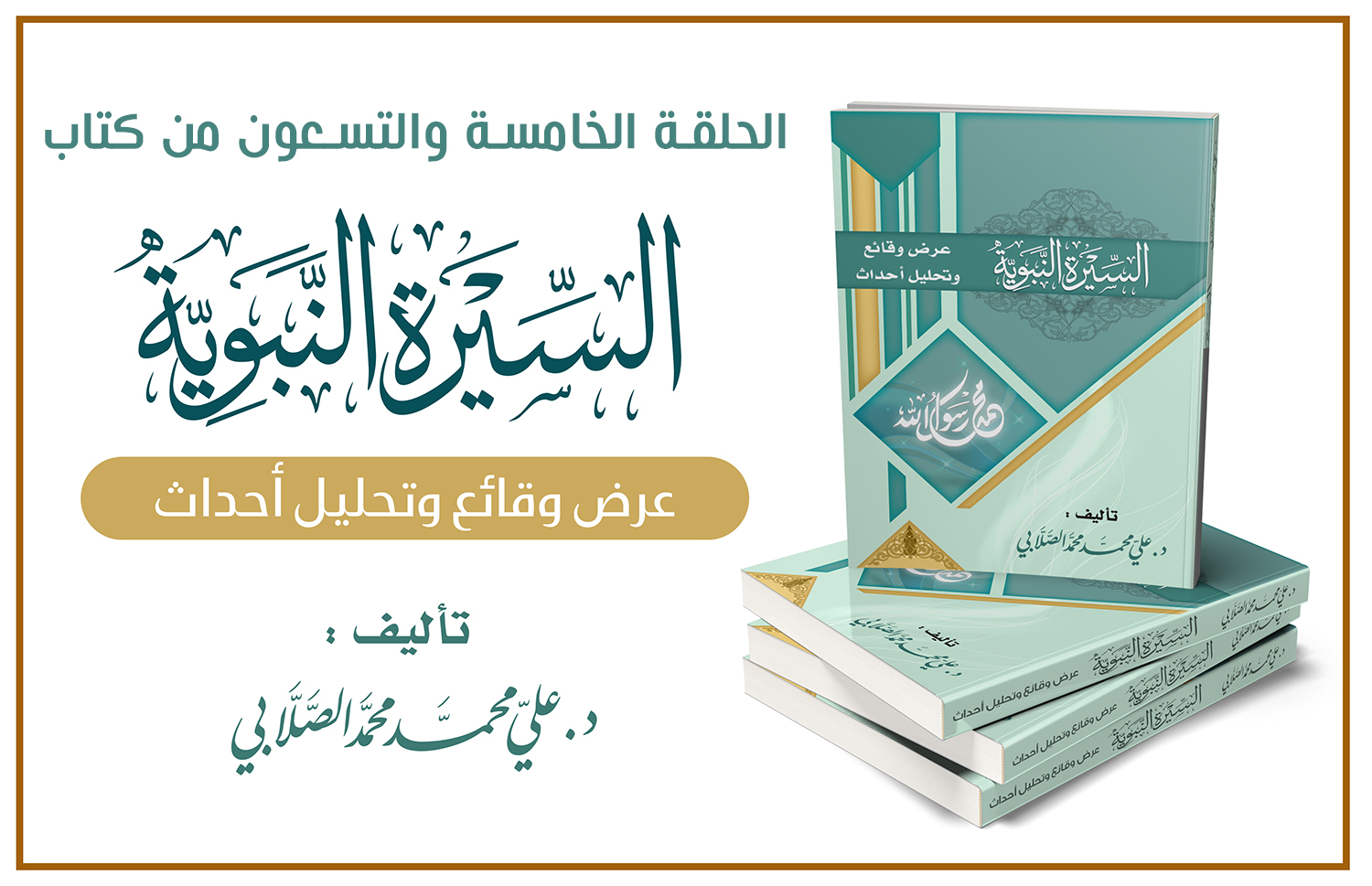
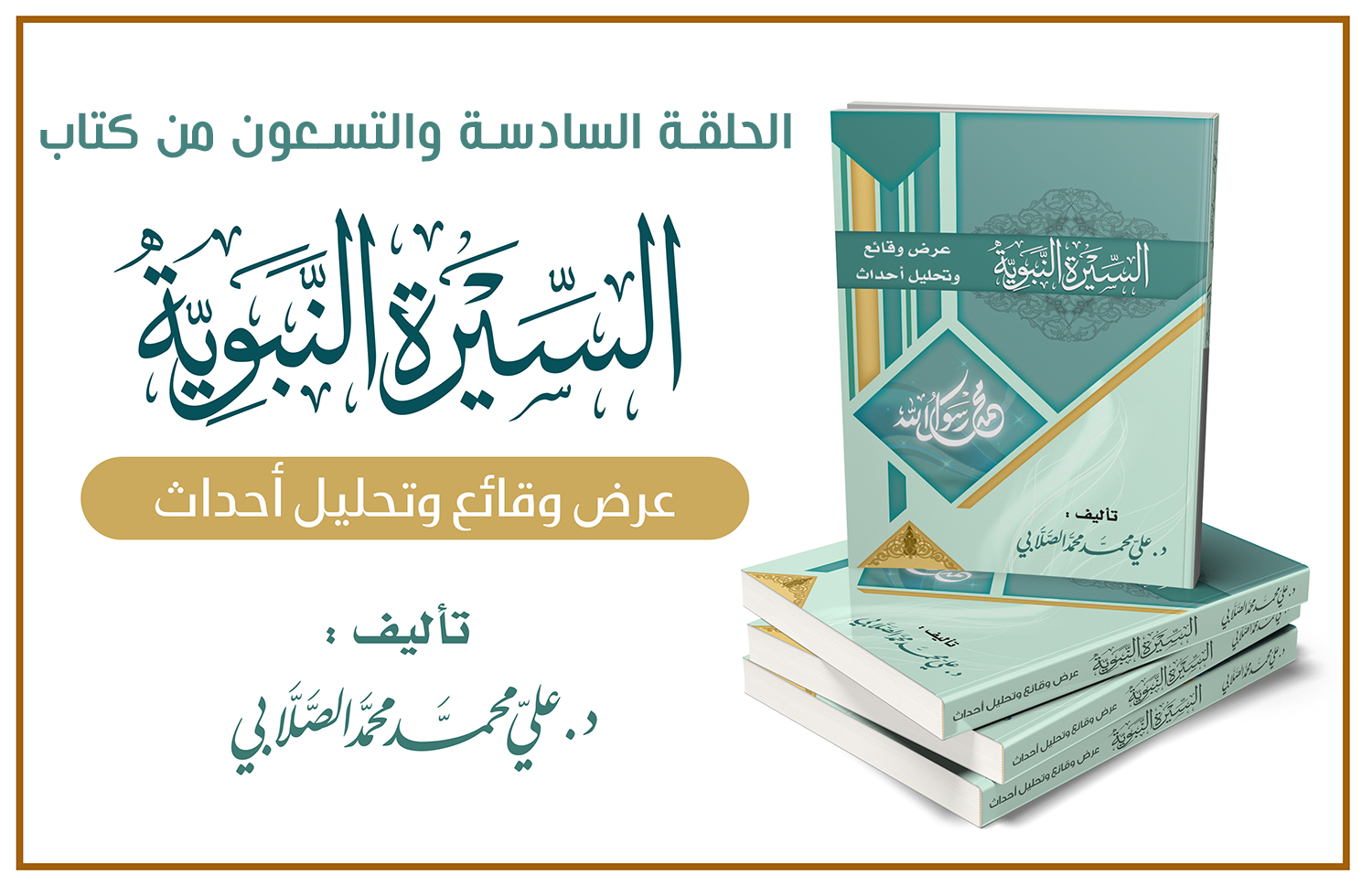
.jpg)