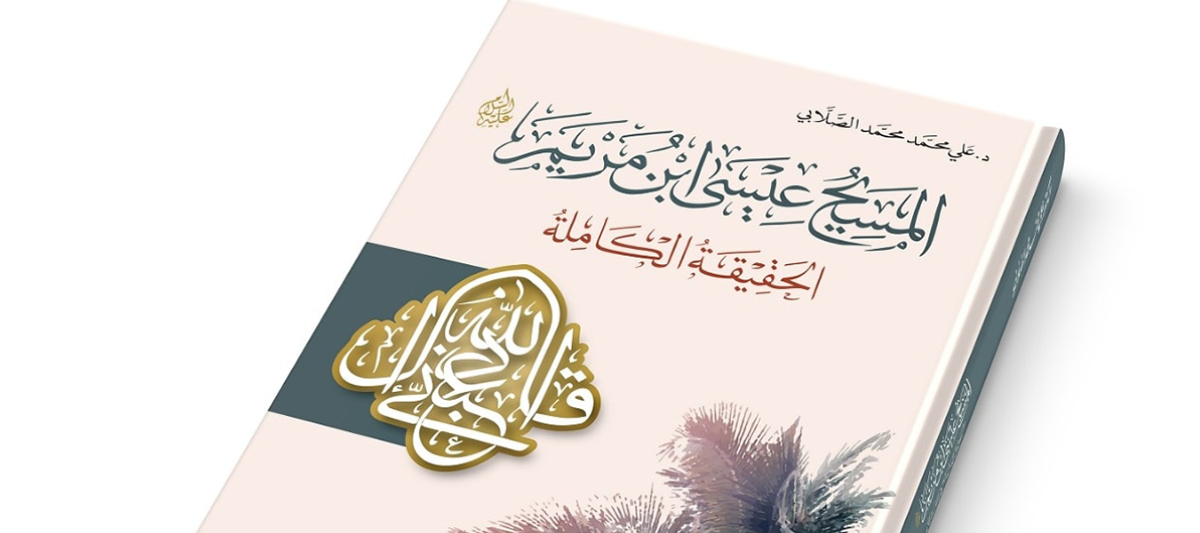العثمانيون في ليبيا ... فاتحون لا محتلون
د. علي محمد الصلابي
دخلت طرابلس والبلاد الليبية، بعد مرحلة الفتح الإسلامي في عام 643م في حكم دولة الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية تليها العباسية. وبشكل عام فقد تعاقبت على حكم ليبيا عدة دول إسلامية بعضها تأسس في إفريقيا واستقل عن حكم المشرق ومركز الخلافة، فأصبح المجال الليبي ساحة للصراع بين الأسر المحلية الحاكمة ومختلف العناصر القبلية التي تسعى للسيطرة على الأرض، وتبعت في غربها للفاطميين ثم لدولة صنهاجة ثم الدولة الموحدية ثم الحفصية، بينما بقيت برقة تحت السيادية الفاطمية ثم المصرية إلى مجيء العثمانيين (كورو،1984، 12).
وفي عام 1510م هاجم الأسطول الإسباني مدينة طرابلس واحتلها على الرغم من المقاومة الشديدة التي أبداها الأهالي، ورغم سقوطها إلا أن حركة المقاومة الشعبية استمرت، وقد ضرب المقاومون حصاراً حول طرابلس، التي سلمها الإسبان فيما بعد إلى فرسان القديس يوحنا الصليبيين (فرسان مالطا) عام 1530م. وقد استنجد الأهالي المقاومون بالسلطان العثماني سليم الأول لإنقاذ بلادهم وتحريرها (السيد،2000، 50-51)، ومن تلك اللحظة التاريخية الفاصلة دخلت ليبيا طوراً جديداً في تاريخها، حين بدأت العلاقة المباشرة بين الأتراك والليبيين، والتي سنتحدث عنها عبر مراحل تاريخية من بداية استنجاد الليبيين بالدولة العثمانية وحتى وقتنا الحاضر.
البدايات: فترة الجهاد العثماني ضد الصليبين في مياه المتوسط:
شكل القراصنة العثمانيون الموجة الأولى من طلائع المجاهدين، والذي بدأوا عملياتهم لتحرير سواحل إفريقيا الشمالية، وهم من هيأ الظروف لإخضاع البقاع الممتدة من الجزائر إلى طرابلس للسيطرة العثمانية. وبعد ذلك، شكل طلب النجدة الشعبية (استنجاد السكان المحليين في الجزائر وتونس وليبيا والمغرب) من السلطان العثماني نقطة تحول كبرى لعلاقة طويلة الأمد بين السواحل الإسلامية في أفريقيا والمجاهدين الأتراك الذين تميزوا بالجرأة والإقدام وخوض الصعاب للحفاظ على المسلمين في تلك المناطق، ومن الحوادث التي يمكن ذكرها أنه في عام 1512م ظهرت أولى السفن التركية التي أخذت تهدد الإسبان في طرابلس وتهاجمها بحراً مما سبب مضايقات للمحتلين الإسبان الذين لم يمض على احتلالهم لطرابلس سوى عامين، في وقت كان العرب الليبيين يحاصرونهم من جهة البر (سامح،1969، 186).
كما هدد بطل الجهاد البحري خير الدين بربروسا طرابلس عام 1515م، وذلك بعد توليه حكم الجزائر إثر استشهاد أخيه عروج، ووضع نفسه في طاعة السلطان العثماني سليم الأول، وحصل على مساعدات بحرية ومتطوعين من الشرق لجهاد الإسبان وغيرهم في مياه المتوسط.
وبشكل عام، فقد كان للنشاط الكبير الذي أبداه القراصنة الأتراك دوره في تعقيد الوضع بالنسبة للإسبان في شمال إفريقيا، حيث كانت طرابلس نفسها تعاني من أوضاع سيئة، ففي عام 1526م كان الشيخ الذي وثق فيه الإسبان قد انضم إلى الثوار في تاجوراء، بينما كان الخوف من هجوم للأسطول التركي مخيماً على الإسبان (سامح،1969، 188-189).
وهكذا ساهم الأتراك العثمانيون في تقويض النفوذ الصليبي بوقت مبكر في شمال أفريقيا (المنطقة الإسلامية)، فخاضوا عدة حروب ومعارك ألقوا الرعب من خلالها في قلوب الإسبان ودمروا أسطولهم في أكثر من موقعة كان أكثرها بقيادة المجاهد خير الدين باربروسا (السيد،2000، 53).
مرحلة التَماس المباشر: وفد تاجوراء طالباً النجدة السلطانية العثمانية:
ذكرت المصادر التاريخية أنه وبعد احتلال الإسبان لطرابلس، قام وفد من مدينة تاجوراء بالسفر إلى إستانبول عبر البحر طلباً لنجدة السلطان العثماني سليم الأول ومساعدته ضد الغزاة الصليبيين، وعندما وصل الوفد إلى عاصمة العثمانيين سألهم الأتراك عن المكان الذي قدموا منه، فأجابوهم بأنهم من طرابلس الغرب، وأنهم قدموا ليلتمسوا عون السلطان العثماني لهم في تحرير بلادهم، فاستقبلهم السلطان بحفاوة وأصغى إليهم، وقد قام بالترجمة بينه وبينهم المسيحي الأصل (أولوج) مراد آغا، والذي كان يتقن اللغة العربية، وفيما بعد أعاد السلطان سليمان القانوني الوفد بصحبة مراد آغا نفسه، واعترف به والياً على غريان (روسي،1974، 198-199).
وهذا ما يثبت أن قدوم العثمانيين إلى سواحل شمال إفريقيا سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا كان بناء على طلب ورغبة من السكان المحليين الذي وجدوا في السلطان العثماني نصيراً وعوناً لهم ضد المحتل الصليبي، ولذلك فإن الدخول العثماني ليبيا كان بطلب محلي واستناداً للشرعية التي أضفاها على حكمهم المسلمون في ليبيا وذلك بدعوتهم لهم أولاً ثم مساعدتهم في حربهم ضد الإسبان وفرسان مالطا الذين حلوا محل الإسبان عام 1530، ثم قبول حكمهم وسيادتهم على الأراضي الليبيا. فهو ليس احتلالاً كما ادعى البعض، فلم ينكر قدوم هذا الوفد التاجوري إلى إستنبول سوى بعض المستشرقين المعروفين بعدائهم للدولة العثمانية وللمسلمين عموماً، ومنهم نيكولاي بروشين في كتابه "تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين"، فقد دأب هذا المستشرق على إظهار الأتراك بمظهر المحتلين المستعمرين والمتسترين بالإسلام، فنفى وجود مثل هذا الوفد التاجوري تاريخياً وعلق على هذا الحدث واصفاً إياه بالأسطورة!، هذا بالرغم من ثبوت قدوم هذا الوفد من مسلمي طرابلس وتاجوراء إلى إستنبول في المصادر العربية والعثمانية والتركية المعاصرة على حد سواء، وممن ذكره من المؤرخين ابن غلبون الطرابلسي في كتابه "التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من أخبار"، وأحمد بن الحسين النائب الأنصاري في كتابه "نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان"، وقد اتهمهما بروشين بمحاولة التبرير لدخول الأتراك وتلميع تاريخهم، ولكن القارئ لتعليق بروشين على هذا الأمر يرى أنه لا يستند في نفيه وإنكاره إلى أي دليل أو مصدر تاريخي بل يتفرد بهذا الرأي ويخطّأ جميع من خالفوه! (بروشين،2001، 26-27).
لقد ذكر ابن غلبون الطرابلسي قصة الوفد في كتابه "التذكار"، حيث قال: "ولما انحاز المسلمون انتدب جماعة من أهل تاجوراء ركبوا شينياً وتوجهوا لصاحب القسطنطينية يطلبون منه إعانة، وكانوا لا خبرة لهم بلغة الترك، فلما حضروا إلى القسطنطينية استغرب أهلها زيهم وسألوهم من أي البلاد أنتم؟ فأخبروا أنهم من طرابلس الغرب قدموا لحضرة السلطان مستغيثين به، فأحضروا بين يديه. وكان مراد علجاً خصياً للسلطان، ربي بأرض المشرق وتعلم العربية فكان يعرب للسلطان عنهم، فأخبروه عن حال بلادهم وأخذ النصارى لها وتضييع ملوكهم دولهم، وأنهم يريدون منه إعانة على افتكاك بلادهم ووالياً يلي أمرهم" (الطرابلسي،1349ه، 93).
وقد ذكر عزيز سامح هذه الحادثة بطريقة أخرى أيضاً في كتابه "الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية": "ولما احتل الإسبانيون مدينة طرابلس لجأ الذين تمكنوا من الهروب إلى تاجوراء التي تبعد ستة عشر كيلو متراً، أما بقية الأنحاء وبرقة لم تقع في أيدي الأعداء، وعندما أدرك أهل طرابلس عجزهم عن التخلص من العدو بعثوا في عام 926ه – 1519م إلى إستنبول وسيطاً ليطلب المساعدة وهناك قابله مراد أحد خدام القصر الذي كان يتكلم بالعربية، وحدثه وأفهمه ما تعاني الدولة العثمانية من متاعب في ذلك الوقت، ومع ذلك فقد عرض أهل طرابلس على السلطان، الذي أمر بإسناد إمارة طرابلس إلى مراد آغا نظراً لمعرفته العربية وأرسل لها مزوداً بقليل من الجنود" (سامح،1969، 22-23).
حملة سنان باشا وتحرير طرابلس من أيدي فرسان مالطا (الصليبيين):
في عام 1550م، وصل مراد آغا إلى طرابلس مع الوفد الليبي عائداً من إستانبول، واختار تاجوراء فنزل بها، وأخذ يُعد العدة للحرب، ويتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة بالتنسيق مع قائد الأسطول العثماني سنان باشا لطرد فرسان مالطا (فرسان القديس يوحنا الصليبيين) من طرابلس وتحرير قلعتها (السيد،2000، 54). وقد ورد في الرسالة التي أرسلها المرشد الأكبر لمنظمة الفرسان في طرابلس إلى البابا في روما ما نصه:
"قد جاء إلى هنا التركي مراد آغا، وهو من أتباع بربروسا وقد أعلن نفسه ملكاً على تاجوراء، وهي أرض قريبة جداً من قلعة طرابلس، وقد استطاع بطرقه الخاصة أن يجمع حوله – إضافة إلى الأتراك الذين معه – عدداً آخر من العرب الذين ربطتهم به صلات ود وتحالف، ومن ذلك الوقت تعرضت القلعة إلى حرب متتابعة متواصلة عادت بالضرر على الطرفين. ورغم أن ملك تونس – بتأييد من منظمتنا – قد اهتم بطرد مراد آغا ولكنه لم يتمكن من ذلك، مما زاد في قوته كل يوم، سواء بتأييد من بربروسا أو من درغوث ريس، وهو قرصان كبير من الموالين له والمقربين إليه. وطبقاً للمعلومات المتوفرة لدينا فإنه بتأييد من بربروسا، وبتضامن واتفاق مع درغوث ريس والأهالي المجاورين، يعد العدة الآن لتنفيذ خطته للاستيلاء على القلعة. ويعتقد أنه سينفذ خطته تلك، ولو بالاقتصار على الأقل على احتلال مدينة طرابلس التي تحيط بالقلعة. فإذا قدر له أن يحتلها فسيصبح من المتعذر الاحتفاظ بها والدفاع عنها. وإنه إذا حدث هذا - لا قدر الله – فسوف تكون خسارة فادحة لا لمملكة صقلية وكالابريا ولكنها خسارة للمسيحية بصفة عامة. وستكون وكراً للقراصنة الذين ستمتلئ بهم هذه البحار" (روسي،1974، 202-203).
وكما توقع هذا المرشد في رسالته ففي آب/ أغسطس 1551م، وعقب الحصار البري والبحري الذي ضرب حولها، بدأ الهجوم على قلعة طرابلس، معقل فرسان مالطا، وقد قصفت القلعة لعدة أيام قصفاً شديداً ألحق بها أضراراً فادحة، فاضطر فرسان مالطا للاستسلام، وتمكن الأتراك العثمانيون من تحرير المدينة والقلعة ودخولهما في 14 أغسطس 1551م، وأقاموا احتفالاً كبيراً بانتصارهم. فعادت بذلك مدينة طرابلس إلى السيادة الإسلامية بفضل الله تعالى أولاً ثم بفضل المجاهدين العثمانيين، وأصبحت من أهم القواعد البحرية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط (التليسي،1997، 76).
وأقر السلطان سليمان القانوني مراد آغا على حكم البلاد فأصبح بذلك أول والي تركي عثماني للبلاد، وقد واجه في مستهل عهد عدة مشاكل كان أهمها العمل على إعادة إعمار المدينة وترميم قلعتها، وإعادة الحيوية للحياة العامة في البلاد. وقد نجح في مهمته فاستقرت الأحوال في عهده ونشطت الحركة التجارية ورمم الحصون والقلاع (التليسي،1997، 76-77).
أما برقة فقد كانت تتبع لدولة المماليك في مصر، وبعد سقوط المماليك ألحقت بالحكم العثماني، وبذلك أصبحت أرض ليبيا كلها تحت الحكم العثماني كولاية مستقلة، وبهذا بدأ عصر الولاة العثمانيين في ليبيا، وبلغ عددهم حتى بداية عهد القرامانليين أربعة وأربعون والياً (السيد،2000، 55).
أوضاع ليبيا في فترة ولاة الدولة العثمانية:
بعد تحرير طرابلس أصبحت رسمياً ولاية تابعة عثمانية تحت اسم إيالة طرابلس الغرب لتمييزها عن إيالة طرابلس الشام. وفي عام 1864م وبعد الإصلاحات الإدارية استبدلت الإيالة بولاية طرابلس الغرب.
إن من محاسن دخول العثمانيين إلى ليبيا هو دورهم في تشكيل نواة الدولة الحديثة المركزية في ليبيا، فقد كانت ليبيا تحكم بشكل صوري من قبل الأسر الحاكمة المجاورة كالموحدين والحفصيين والمماليك وغيرهم، بينما يكون الحكم الفعلي للقبائل والعشائر المحلية المنتشرة في البلاد، وبعد الدخول العثماني أصبحت إدارة هذه الإيالة الواحدة إدارة مركزية فعلية عن طريق وال يعينه السلطان العثماني مباشرة، ويحظى بدعم الانكشاريين، وكان أولهم مراد آغا، وقد استمر الحكم على هذا النظام إلى عام 1711م مع استلام أحمد باشا القره مانلي للحكم مؤسساً لسلالة حاكمة من نسله تحكم الإيالة باسم العثمانيين (عميرة،2018).
المراجع:
1- كورو، فرانشكو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، طرابلس، ط2، 1984.
2- السيد، محمود، تاريخ دول المغرب العربي، الإسكندرية، 2000.
3- سامح، عزيز، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، ترجمة: عبدالسلام أدهم، ط1، 1969.
4- روسي، إتوري، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911م، ط1، 1974.
5- بروشين، نيكولاي إيليتش، تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين، بيروت، ط2، 2001.
6- الطرابلسي، أبو عبد الله محمد بن غلبون، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من أخبار، تعليق: الطاهر أحمد الزاوي، القاهرة، 1349 ه.
7- التليسي، خليفة محمد، حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب، ط3، 1997.
8- عميرة، عائد، كيف حكم العثمانيون ليبيا لأكثر من 3 قرون؟، 16/3/2018، موقع نون بوست، انظر: https://www.noonpost.com/index.php/content/22498.