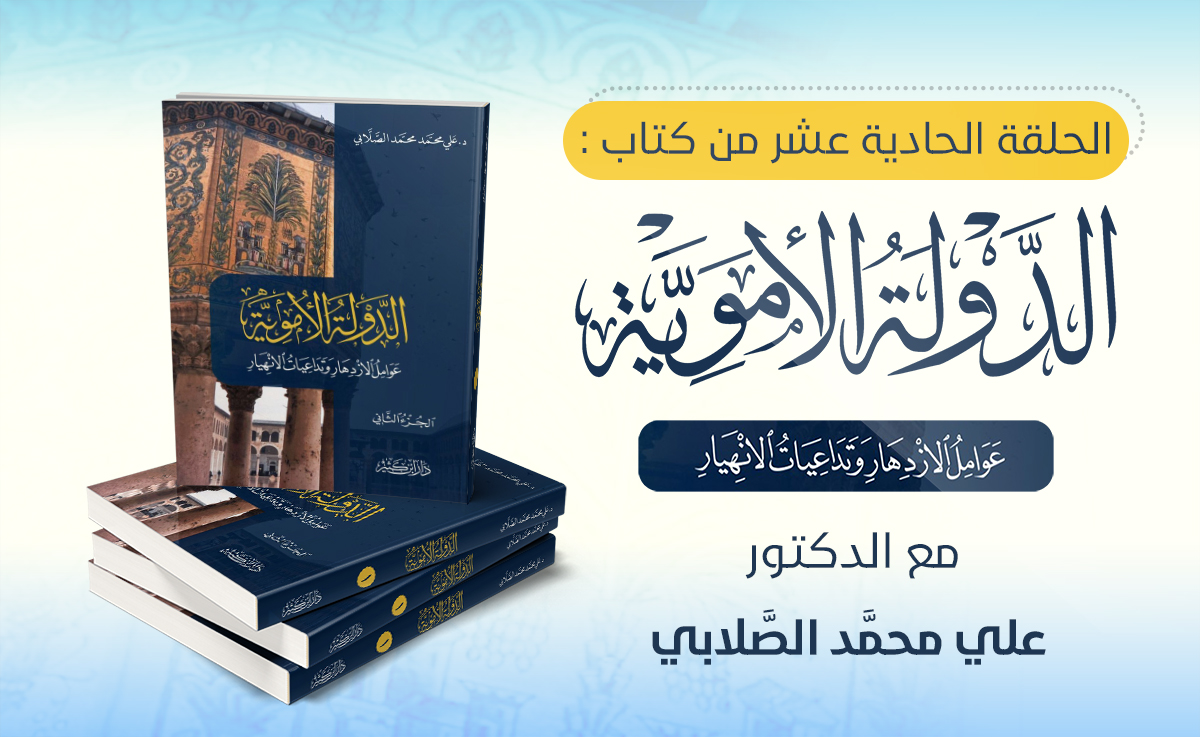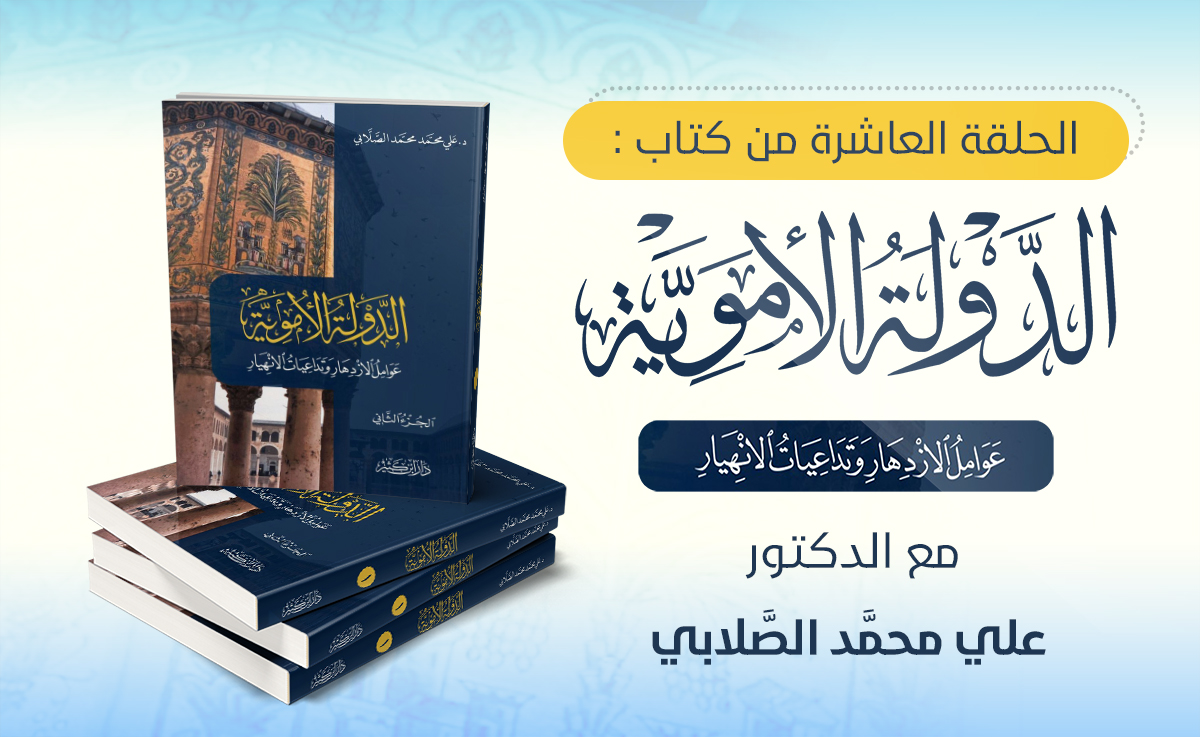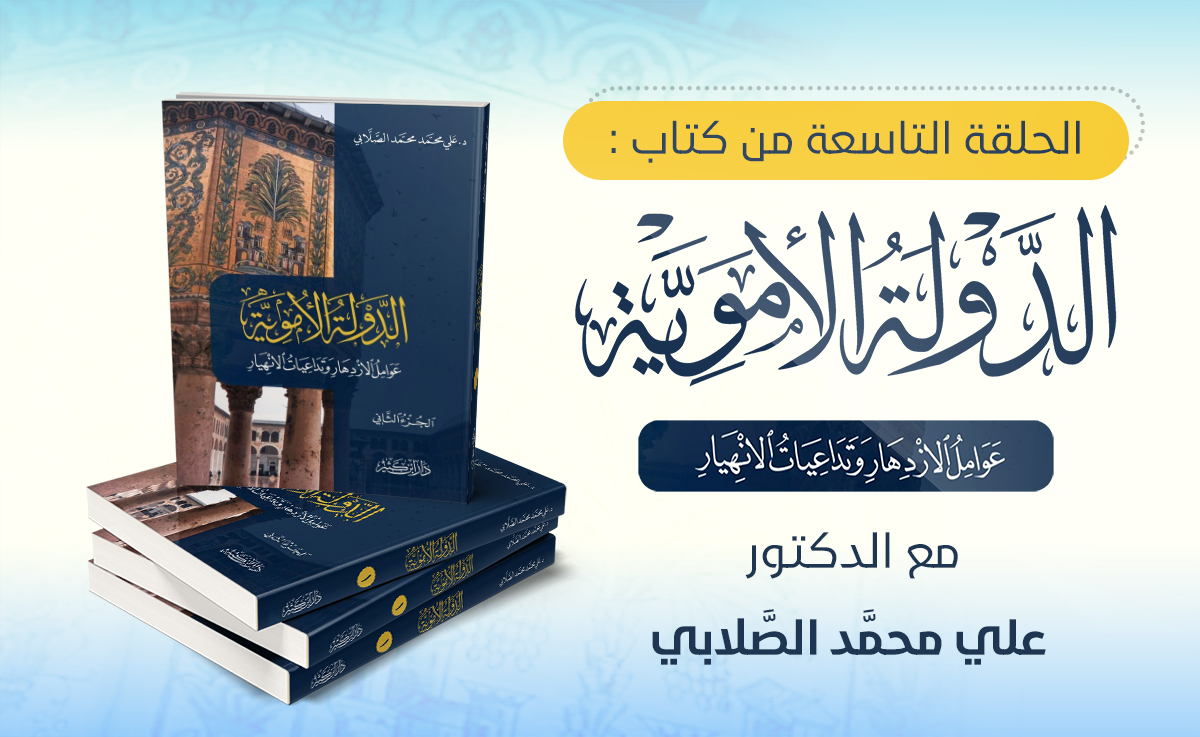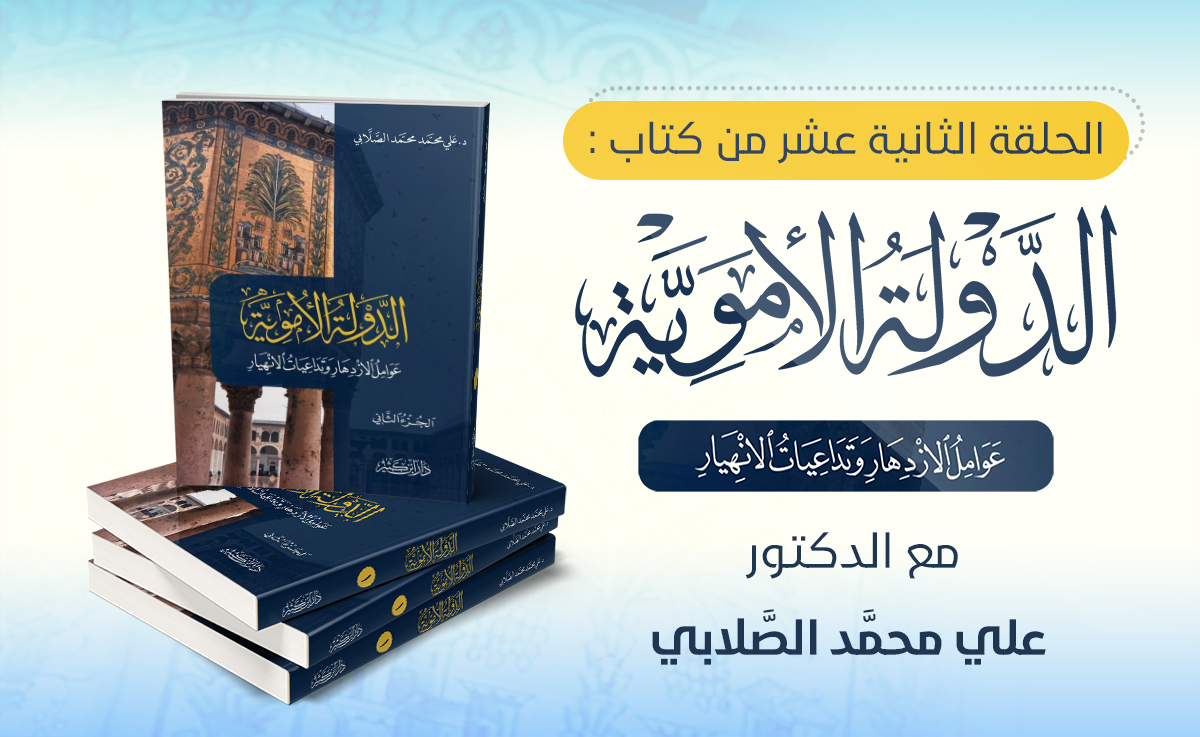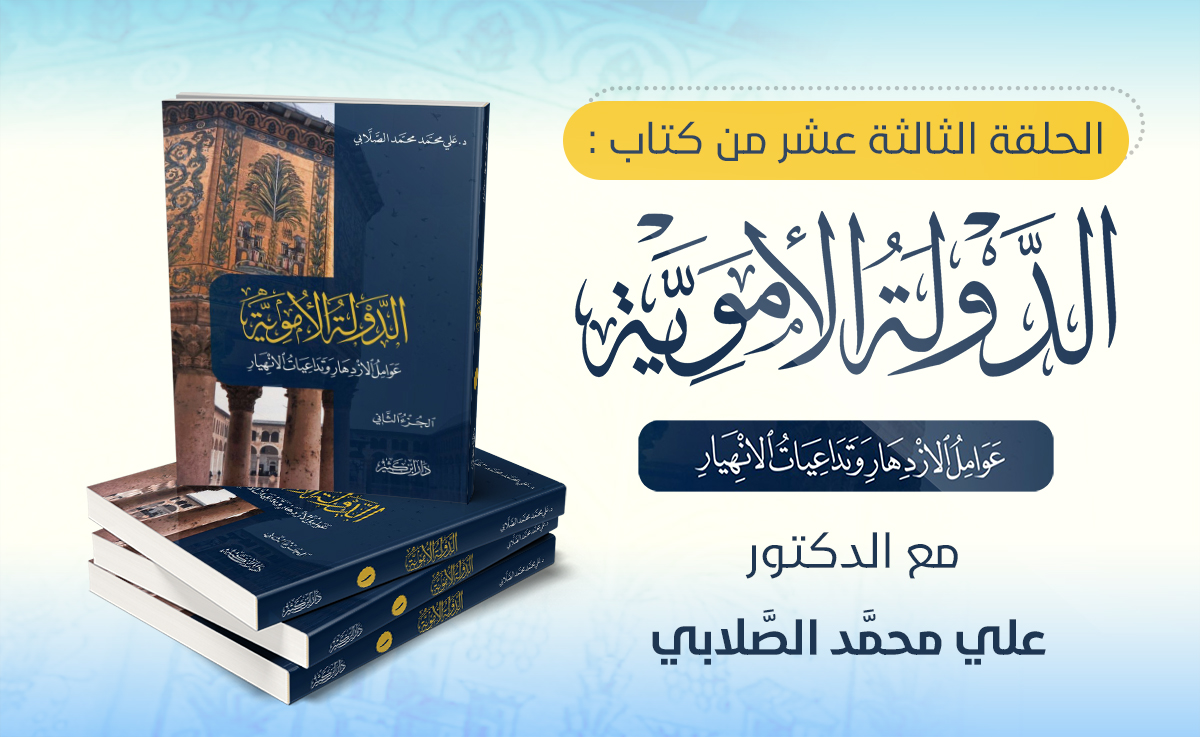من أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه
الحلقة: الحادية عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
محرم 1442 ه/ سبتمبر 2020
قال الزهري: ولي عثمان اثنتي عشرة سنة أميراً للمؤمنين، أول ستّ سنين منها لم ينقم الناس عليه شيئاً، وإنّه لأحبُّ إلى قريش من عمر بن الخطاب، لأنّ عمر كان شديداً عليهم، أمّا عثمان، فقد لان لهم، وَوَصَلَهم، ثمّ حدثت الفتنة بعد ذلك، وقد سمّى المؤرِّخون المسلمون الأحداث في النِّصف الثاني من ولاية عثمان 30 ـ 35هـ (الفتنة)، التي أدَّت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر، وعمر، وصدر من خلافة عثمان، متَّفقين، لا تنازع بينهم، ثم حدثت في أواخر خلافة عثمان أمور، أوجبت نوعاً من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان ، وكان المجتمع الإسلامي في خلافة الصديق، والفاروق، والنِّصف الأوَّل من خلافة عثمان يتَّصف بالسِّمات الآتية:
أ ـ أنه ـ في عمومه ـ مجتمع مسلم بكل معنى الإسلام، عميق الإيمان بالله واليوم الآخر، مطبق الإسلام بجدية واضحة، والتزام ظاهر، وبأقلّ قدر من المعاصي وقع في أي مجتمع في التَّاريخ.
ب ـ أنه المجتمع الذي تحقَّق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقيِّ للأمَّة بمعناها الرَّباني، فهي الأمة التي تربط بينها رابطة العقيدة، بصرف النظر عن اللغة، والجنس، واللَّون، ومصالح الأرض القريبة، وهذه لم تتحقَّق في التاريخ كما تحقّقت في الأمة الإسلامية.
جـ أنه مجتمع أخلاقيٌّ يقوم على قاعدة أخلاقية واضحة مستمدة من أوامر الدين، وتوجيهاته.
د ـ أنه مجتمع جادٌّ، مشغول بمعالي الأمور لا بسفاسفها، وليس الجدُّ بالضرورة عبوساً، وصرامة، ولكنه روح تبعث الهمّة في الناس، وتحثُّ على النشاط، والعمل، والحركة.
هـ أنه مجتمع مجنَّد للعمل، في كلِّ اتجاه، تلمس فيه روح الجنديَّة واضحة لا في القتال في سبيل الله فحسب، ولكن في جميع الاتجاهات، فهو معبَّأ من تلقاء نفسه بدافع العقيدة وبتأثير شحنتها الدّافعة لبذل النشاط في كلِّ اتجاه.
و ـ أنه مجتمع متعبِّدٌ نلمس فيه روح العبادة واضحة في تصرفاته ليس فقط في أداء الفرائض، والتطوّع بالنَّوافل ابتغاء مرضات الله، ولكن في أداء الأعمال جميعاً، والعمل في حسِّه عبادةٌ، يؤديه بروح العبادة.
هذه من أهم صفات عهد الخلفاء الراشدين ـ بصفة عامة ـ إلا أن تلك السِّمات كانت أقوى كلَّما اقتربنا من عهد النبوة، وتضعف كلَّما ابتعدنا عن عصر النُّبوة، وقد بدأ التغير على عهد الخلافة الراشدة مع ظهور فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان لظهور هذه المحنة العظيمة التي مرت بها الأمة أسباب؛ منها:
أ ـ الرخاء وأثره في المجتمع:
وغنيٌّ عن الإشارة: أنَّ النِّعم، والخيرات، وتلك الواردات من الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع، إذ تجلب الرَّخاء وما يترتَّب عليه من انشغال النَّاس بالدُّنيا، والافتتان بها، كما أنَّها مادة للتنافس، والبغضاء خاصة بين أولئك الذين لم يصقل الإيمان نفوسهم، ولم تهذبهم التَّقوى من أعراب البادية، وجفاتها، ومن مسلمة الفتوحات، وأبناء الأمم المترفة، وقد أدرك عثمان رضي الله عنه هذه الظاهرة وأنذر بما سيؤول إليه أمر الأمّة من التَّبذُّل والتغيُّر في كتابه الموجه إلى الرّعية: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاثةٍ فيكم: تكامل النِّعم، وبلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن.
وحدث ما توقعه عثمان رضي الله عنه، وبدأ أثر التغير يظهر أولاً على أطراف الدّولة الإسلامية، ثم أخذ يزحف إلى عاصمة الخلافة، ممّا دفع عثمان رضي الله عنه، إلى تذكير المسلمين في خُطَبهِ بضرورة الحذر من التهالك على الدنيا، وحطامها، فكان مما قاله في إحدى خطبه: إنَّ الله إنَّما أعطاكم الدُّنيا، لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها، لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى، وإن الآخرة تبقى، ولا تبطرنَّكم الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، ... واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم، لا تصيروا أحزاباً، ثم قرأ: {وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤} [آل عمران: 103-104]
وفي مثل هذه الظروف، والخيرات، فاضت الدُّنيا على المسلمين وتفرّغ الناس بعد أن فتحوا الأقاليم واطمأنُّوا، فأخذوا ينقمون على خليفتهم. ومن هنا يُعلم أثر الرخاء في تحريك الفتنة، ومن هنا أيضاً يمكن فهم مقالة عثمان رضي الله عنه لعبد الرَّحمن بن ربيعة ـ له صحبة ـ وهو على الباب: إن الرَّعية قد أبطر كثيراً منهم البطنة، فقصِّر بهم، ولا تقتحم بالمسلمين، فإنِّي خاشٍ أن يبتلوا.
ب ـ طبيعة التحول الاجتماعيِّ في عهد عثمان رضي الله عنه:
حدثت تغيراتٌ اجتماعية عميقة، ظلَّت تعمل في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس، حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجِّر بدءاً من النِّصف الثاني من خلافة عثمان، بلغت قمّة فورانها في التمرُّد الذي أدَّى إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه.
ولما توسَّعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح، حصل تغيُّر في تركيبة المجتمع، والاختلالات في نسيجه، لأنَّ هذه الدَّولة بتوسُّعها المكانيِّ، والبشريِّ، ورثت ما على هذه الرقعة الواسعة من أجناس، وألوان ولغات، وثقافات، وعادات، ونظم، وأفكار، ومعتقدات، وفنون أدبية، وعمرانية، ومظاهر، وظهرت على سطح هذا النسيج ألوان مضطربة، وخروقات غير منتظمة، كما صيَّرت المجتمع غير متجانس في نسيجه التَّركيبيِّ، وبالذات في الأمصار الكبرى المؤثِّرة: البصرة، الكوفة، والشّام، ومصر، والمدينة ومكة، فقد كانت الأمصار الكبيرة ـ بمواقعها وأهميتها ـ تدفع بجيوش الفتوح، وتستقبلها وهي عائدة، وقد نقص عددها بالموت والقتل، وتستقبل بدلاً عنهم أو أكثر منهم أعداداً وفيرة من أبناء المناطق المفتوحة: فرس، وترك، وروم، وقبط، وكرد، وبربر، وكان أكثرهم من الفرس، أو النَّصارى العرب، أو غيرهم، أو من اليهود، وأكثر سكان هذه الأمصار الكبيرة هم ممَّن شاركوا في حركة الفتح الإسلامي ثم استقروا في هذه الأمصار، وكان أغلب هؤلاء من القبائل العربيَّة من جنوبها، وشمالها، وشرقها، والذين لم يكونوا ـ عادة ـ من الصَّحابة، وبمعنى أدق: ليسوا ممَّن تلقَّوا التَّربية الكافية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أيدي الجيل الأوَّل من الصحابة، إمَّا لانشغالهم بالفتوح، أو لقلة الصحابة.
وقد حصلت تغيراتٌ في نسيج المجتمع البشريِّ المكوَّن من الجيل السَّابقين، وسكّان البلاد المفتوحة، والأعراب، ومن سبقت لهم ردَّة، واليهود، والنَّصارى، وفي تكوين نسيج المجتمع الثَّقافي، وفي بسطة عيش المجتمع، وفي ظهور لون جديد من الانحرافات، وفي قبول الشائعات.
ج ـ ظهور جيل جديد:
فقد حدث في المجتمع تغيُّر أكبر، ذلك: أن جيلاً جديداً من الناس ظهر، وأخذ يحتل مكانه في المجتمع، وهو غير جيل الصحابة، جيل يعيش في العصر غير الذي كانوا يعيشون فيه، ويتَّصف بما لا يتَّصفون به، فهو جيل يعتبر في مجموعه أقلَّ من الجيل الأوَّل الذي حمل على كتفه عبء بناء الدّولة، وإقامتها، فقد تميَّز الجيل الأوَّل من المسلمين بقوَّة الإيمان، والفهم السَّليم لجوهر العقيدة الإسلاميَّة، والاستعداد التّام، لإخضاع النَّفس لنظام الإسلام المتمثِّل في القرآن والسُّنَّة، وكانت هذه الميِّزات أقل ظهوراً في الجيل الجديد الذي وُجد نتيجة للفتوحات الواسعة، وظهرت فيه المطامع الفرديَّة، وبُعثت فيه العصبية للأجناس، والأقوام، وبعضهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهليَّة التي كانوا عليها ولم ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة الصحيحة السَّليمة مثل ما نال الرَّعيل الأوَّل من الصَّحابة رضي الله عنهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرتهم، وانشغال الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة، فالصَّحابة كانوا أقلَّ فتناً من سائر من بعدهم، فإنَّه كلما تأخَّر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ووجد دعاة الفتنة في المنحرفين من الجيل الجديد بغيتهم.
د ـ استعداد المجتمع لقبول الشائعات:
ندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس في نسيج المجتمع: أنه صار مهيَّأً للهزَّات، مستعدَّاً للاضطراب، قابلاً لتلقِّي الإذاعات، والأقاويل والشائعات، ولهذا لما كان الناس في خلافة أبي بكر وعمر ـ اللذين أُمر المسلمون بالاقتداء بهما، كما قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر» ـ أقرب عهداً بالرِّسالة، وأعظم إيماناً، وصلاحاً، وأئمتهم أقوم بالواجب، وأثبت في الطمأنينة؛ لم تقع فتنة، إذ كانوا في حكم القسط، أي: النفوس المطمئنة.
ولما كان في آخر خلافة عثمان، وخلافة عليّ، كثر أهل النفس اللَّوَّامة التي تخلط عملاً صالحاً، وآخر سيئاً، فصار فيهم شهوة، وشبهة مع الإيمان، والدِّين، وصار ذلك في بعض الولاة، وبعض الرَّعايا، ثمَّ كثر هذا القسم، الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدَّم من عدم تمحيص التَّقوى، والطَّاعة في الطَّرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى، والمعصية في الطَّرفين، وكل منهم متأوِّلٌ أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وأنَّه مع الحقِّ، والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه من الظنِّ، وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحقِّ من الأخرى، ويوضِّح هذا الواقع بدقة أكثر ذلك الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وأحد أتباعه، قال الرَّجل: ما بال المسلمين اختلفوا عليك، ولم يختلفوا على أبي بكر، وعمر؟ قال علي: لأنَّ أبا بكر، وعمر كانا واليين على مثلي، وأنا اليوم والٍ على مثلك.
وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان مدركاً لما يدور في وسط المجتمع؛ حيث قال في رسالته إلى الأمراء: أمّا بعد، فإن الرَّعيَّة قد طعنت في الانتشار، ونزعت إلى الشَّره، وأَعْداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء مسرعة، وضغائن محمولة، يوشك أن تنفر، فَتُغيَّر.
هـ مجيء عثمان بعد عمر، رضي الله عنهما:
كان مجيء عثمان رضي الله عنه مباشرة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختلاف الطبع بينهما مؤدِّياً إلى تغيُّر أسلوبهما في معاملة الرَّعية، فبينما كان عمر قوي الشكيمة، شديد المحاسبة لنفسه، ولمن تحت يديه، كان عثمان ألين طبعاً وأرقَّ في المعاملة، ولم يكن يأخذ نفسه، أو يأخذ النّاس بما يأخذ به عمر حتّى يقول عثمان لنفسه: يرحم الله عمر، ومن يطيق ما كان عمر يطيق ؟! لكن النَّاس، وإن رغبوا في الشَّوط الأوَّل من خلافته، لأنَّه لان معهم، وكان عمر رضي الله عنه شديداً عليهم حتَّى أصبحت محبَّته مضرب المثل، فقد أنكروا عليه بعد ذلك، ويرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفه، ولين عريكته، ورقة طبعه، ودماثة خلقه، ممّا كان له بعض الأثر في مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده، وعهد سلفه عمر بن الخطَّاب، وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم: أتدرون ما جرّأكم عليَّ؟ ما جرَّأكم عليَّ إلا حلمي.
وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجَّة في ردّه على المآخذ التي أخذوها عليه أمام الملأ من الصَّحابة والنّاس، أبى المسلمون إلا قتلهم، وأبى عثمان إلا تركهم، لحلمه، ووداعته قائلاً: بل نعفو، ونقبل، ولنبصرهم بجهدها، ولا نحادّ أحداً حتى يركب حدّاً، أو يبدي كفراً.
و ـ خروج كبار الصَّحابة من المدينة:
كان عمر رضي الله عنه قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن، وأجلٍ، فشكوه، فبلغه، فقام، فقال: ألا إنِّي قد سننت الإسلام سَنَّ البعير، يبدأ فيكون جذعاً، ثم ثَنِيّاً، ثمّ رباعيّاً، ثم سدسيّاً، ثمّ بازلاً، فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان، ألا فإنَّ الإسلام قد بَزَل، ألا وإنَّ قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معوناتٍ دون عباده، ألا فأما وابن الخطاب حيٌّ فلا، إني قائم دون شِعب الحرَّة، آخذ بحلاقيم قريش، وَحُجَزِها أن يتهافتوا في النَّار.
لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصَّحابة من انتشارهم في البلاد المفتوحة، وتوسُّعهم في القطاع والضِّياع؛ فكان يأتيه الرَّجل من المهاجرين، وهو ممَّن حبس في المدينة، فيستأذنه في الخروج، فيجيبه عمر: لقد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدُّنيا، ولا تراك، وأمَّا عثمان فقد سمح لهم بالخروج، ولان معهم.
ز ـ العصبية الجاهلية:
يقول ابن خلدون: لما استكمل الفتح، واستكمل للملَّة الملك، ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة، والكوفة، والشّام، ومصر، وكان المختصُّون بصحبة الرَّسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه، وآدابه: المهاجرين والأنصار، وقريش، وأهل الحجاز، ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم، وأمَّا سائر العرب من بني بكر بن وائل، وعبد القيس، وسائر ربيعة، والأزد، وكندة، وتميم، وقضاعة، وغيرهم فلم يكونوا في تلك الصحبة بمكان إلا قليل منهم. وكانت لهم في الفتوحات قدم ، فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السَّابقة، ومعرفة حقِّهم، وما كانوا فيه من الذهول، والدَّهش لأمر النُّبوّة، وتردُّد الوحي، وتنزل الملائكة، فلمَّا انحصر ذلك العباب، وتنوسي الحال بعض الشَّيء، وذل العدوُّ، واستفحل الملك، كانت عروق الجاهليَّة تنبض، ووجدوا الرِّياسة عليهم من المهاجرين، والأنصار، وقريش، وسواهم، فأنِفَتْ نفوسهم منه، ووافق ذلك في أيَّام عثمان، فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصار، والمؤاخذة لهم باللَّحظات، والخطوات، والاستبطاء عليهم بالطاعات، والتَّجنِّي بسؤال الاستبداد منهم، والعزل ويفيضون في النّكير على عثمان، وفشت المقالة في ذلك في أتباعهم، وتناولوا بالظُّلم في جهاتهم، وانتهت الأخبار بذلك إلى الصَّحابة بالمدينة، فارتابوا، وأفاضوا في عزل عثمان، وحمله على عزل أمرائه، وبعث إلى الأمصار من يأتيه بالخبر.. فرجعوا إليه فقالوا: ما أنكرنا شيئاً، ولا أنكره أعيان المسلمين ولا عوامُّهم.
ح ـ توقُّف الفتوحات بسبب حواجز طبيعية أو بشرية:
حين توقَّفت الفتوح في أواخر عهد عثمان أمام حواجز طبيعية أو بشرية لم تتجاوزها، سواء في جهات فارس، وشمالي بلاد الشَّام، أو في جهة إفريقية، توقفت الغنائم على أثرها، فتساءل الأعراب: أين ذهبت الغنائم القديمة؟ أين ذهبت الأراضي المفتوحة التي يعدونها حقاً من حقوقهم، وانتشرت الشائعات الباطلة التي اتهمت عثمان رضي الله عنه بأنه تصرف في الأراضي الموقوفة على المسلمين وفق هواه، وأنه أقطع منها لمن شاء من النَّاس، وقد كان لها أثر، ووقع على الأعراب، وخاصة وأنَّ معظمهم بقي بدون عمل يقضون شطراً من وقتهم في الطعام والنَّوم، والشطر الاخر بالخوض في سياسة الدّولة، والحديث عن تصرُّفات عثمان التي كانت تهوِّلها السبئيَّة، وقد أدرك أحد عمّال عثمان هذا الأمر، وهو عبد الله بن عامر، فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله ـ وهم وزراؤه، ونصحاؤه ـ أن يجتهدوا في آرائهم، ويشيروا عليه، فأشار عليه أن يأمر النَّاس بالجهاد ويجمهرهم في المغازي حتَّى لا يتعدَّى همُّ أحدهم قمل فروة رأسه، ودبرة دابته.
وفي ذلك الجو من الحديث، والفكر عند أفراد تعوَّدوا الغزو، ولم يفقهوا من الدِّين شيئاً كثيراً؛ يمكن أن يتوقع كلُّ سوء، ويكفي أن يحرّك هؤلاء الأعراب، وأن يُوجَّهوا توجيهاً، فإذا هم يثورون، ويحدثون القلاقل والفتن، وهذا ما حدث بالفعل، فإنَّ الأعراب ـ بسبب توقف الفتوحات ـ ساهموا في بوادر الفتنة الأولى، وكان سبباً من أسباب اندلاعها.
ط ـ المفهوم الخاطئ للورع بتحريم الحلال:
الورع في الشريعة طيِّبٌ، وهو أن يُترك ما لا بأس به، مخافة ممَّا فيه بأس، وهو في الأصل ترفع عن المباحات في الله، ولله، والورع شيء شخصي يصحُّ للإنسان أن يطالب به نفسه، ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين ، ومن أخطر أنواع الورع: الورع الجاهل الذي يجعل المباح حراماً، أو مفروضاً، وهذا الذي وقع فيه أصحاب الفتنة، فقد استغلَّ أعداء الإسلام يومها مشاعرهم هذه، ونفخوا فيها، فرأوا فيما فعله عثمان من المباحات، أو المصالح خروجاً على الإسلام، وتغييراً لسنَّة من سبقه، وعظمت هذه المسائل في أعين الجهلة، فاستباحوا ـ أو أعانوا من استباح ـ دم الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وفتحوا على المسلمين باب الفتنة إلى اليوم.
ي ـ ظهور جيل جديد من الطامحين:
وجد في الجيل الثاني من أبناء الصحابة رضي الله عنهم من يعتبر نفسه جديراً بالحكم والإدارة، ووجد أمثال هؤلاء أنَّ الطريق أمامهم مغلق، وفي العادة أنه متى وجد الطَّامحون الذين لا يجدون لطموحهم متنفساً، فإنَّهم يدخلون في كل عملية تغيير، ومعالجة أمر هؤلاء في غاية الأهمية.
ك ـ وجود طائفة موتورة من الحاقدين:
لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقد والذكاء والدَّهاء، ما استطاعوا به أن يدركوا نقاط الضَّعف التي يستطيعون من خلالها أن يوجدوا الفتنة، ووجدوا من يستمع إليهم بآذان صاغية، فكان من آثار ذلك ما كان، فقد عرفنا سابقاً وجود يهود، ونصارى، وفرس، وهؤلاء جميعاً معروف باعث غيظهم، وحقدهم على الإسلام، والدولة الإسلاميّة.
ولكنَّنا هنا نضيف من وقع عليه حدٌّ أو تعزير لأمر ارتكبه في وسط الدولة، وعاقبه الخليفة، أو ولاته في بعض الأمصار وبالذّات البصرة، والكوفة، ومصر، والمدينة، فاستغلَّ أولئك الحاقدون من يهود، ونصارى، وفرس، وأصحاب الجرائم مجموعات من الناس كان معظمهم من الأعراب، ممّن لا يفقهون هذا الدِّين على حقيقته، فتكوَّنت لهؤلاء جميعاً طائفة، وصفت من جميع من قابلهم بأنَّهم أصحاب شرٍّ، فقد وُصفُوا: بالغوغاء من أهل الأمصار، ونزَّاع القبائل، وأهل المياه، وعبيد المدينة، وبأنهم ذؤبان العرب، وأنَّهم حثالة النَّاس ومتَّفقون على الشَّرِّ، وسفهاء عديمو الفقه، وأرذال من أوباش القبائل، فهم أهل جفاء، وهمج، ورعاع من غوغاء القبائل، وسفلة الأطراف الأراذل، وأنَّهم آلة الشيطان، وقد تردَّد في المصادر اسم عبد الله بن سبأ الصَّنعاني اليهوديِّ ضمن هؤلاء الموتورين الحاقدين، وأنه كان من اليهود، ثمّ أسلم، ولم يُنقِّب أحد عن نواياه، فتنقَّل بين البلدان الإسلاميَّة باعتباره أحد أفراد المسلمين، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله.
ل ـ التّدبير المحكم لإثارة المآخذ ضدّ عثمان رضي الله عنه:
كان المجتمع مهيَّأً لقبول الأقاويل والشائعات نتيجة عوامل وأسباب متداخلة، وكانت الأرض مهيَّأةً، ونسيج المجتمع قابلاً لتلقي الخروقات، وأصحاب الفتنة أجمعوا على الطّعن في الأمراء بحجَّة الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، حتى استمالوا النَّاس إلى صفوفهم، ووصل الطَّعن إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه نفسه باعتباره قائد الدَّولة، وإذا ما حصرنا الدّعاوى التي رُوِّجت ضد الخليفة، وطعنوه بها، فيمكننا تصنيفها إلى مجموعات خمس:
1 ـ مواقف شخصيَّة له قبل توليه الخلافة (تغيبه عن بعض الغزوات ، والمواقع).
2 ـ سياسته المالية: الأعطيات ، الحِمَى.
3 ـ سياسته الإدارية النَّافذة: توليته أقرباءه، طريقته في التَّولية.
4 ـ اجتهادات خاصة به ، أو بمصلحة الأمَّة (إتمام الصَّلاة بمنى، جمع القرآن، الزِّيادة في المسجد).
5 ـ معاملته لبعض الصَّحابة: عمَّار، أبي ذرّ، ابن مسعود.
وقد بينت موقف عثمان رضي الله عنه في كلِّ ما وجه إليه في كتابي تيسير الكريم المنان في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شخصيته وعصره. وقد حدث تزيُّد في إبراز المطاعن على عثمان رضي الله عنه سواء في عهده، وما واجهوه بها، وردُّه عليها في حينه، أو ما تُقوِّل عليه فيما بعد عند الرُّواة، والكتَّاب، فإنَّها لم تصح، ولم تصل إلى حدِّ أن تكون سبباً في قتله.
إن المآخذ السَّابق ذكرها والمدوَّنة في تاريخ الطَّبري، وغيره من كتب التاريخ والمرويّة عن طريق المجاهيل، والإخباريين الضُّعفاء ـ خاصَّة الشيعة ـ كانت وما تزال بليَّة عظمى على الحقائق في سير الخلفاء والأئمَّة، خاصة في مراحل الاضطرابات والفتن، وقد كان مع الأسف لسيرة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك الحظُّ الوافر، فرواية الحوادث ووضع الأباطيل على النَّهج الملتوي بعض ما نال تلك السيرة النيرة، من تحريف المنحرفين، وتشويه الغالين، بغية التأليب عليه، أو التشهير به، وقد أدرك عثمان رضي الله عنه بنفسه ذلك عندما كتب إلى أمرائه: أمّا بعد، فإن الرَّعية طعنت في الانتشار ونزعت إلى الشرِّ، أعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء متسرّعة، وضغائن محمولة، وقال ابن العربي على تلك المآخذ: قالوا متعدِّين متعلِّقين برواية كذَّابين: جاء عثمان في ولايته بمظالم، ومناكير ، ... هذا كله باطل سنداً ومتناً.
م ـ استخدام الأساليب والوسائل المهيِّجة للنَّاس:
وأهم هذه الأساليب: إشاعة الأراجيف، حيث تردّدت كلمة الإشاعة والإذاعة كثيراً، والتَّحريص، والمناظرة، والمجادلة للخليفة أمام النَّاس، والطَّعن على الولاة، واستخدام تزوير الكتب، واختلاقها على لسان الصَّحابة رضي الله عنهم، كعائشة، وعليٍّ، وطلحة، والزبير، والإشاعة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأحق بالخلافة، وأنَّه الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظيم فرق في كل من البصرة، والكوفة، ومصر، أربع فرق من كلِّ مصر ممّا يدل على التَّدبير المسبق، وأوهموا أهل المدينة: أنهم ما جاؤوا إلا بدعوة الصَّحابة، وصعَّدوا الأحداث، حتى وصل الأمر إلى القتل.
وإلى جوار هذه الوسائل استخدموا مجموعة من الشعارات منها: التّكبير، ومنها: أنَّ جهادهم هذا ضدَّ المظالم، ومنها: أنَّهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، ومنها: المطالبة باستبدال الولاة، وعزلهم، ثمَّ تطورت المطالبة إلى خلع عثمان، إلى أن تمادوا في جرأتهم وطالبوا، بل سارعوا إلى قتل الخليفة، وخاصَّة حينما وصلهم الخبر بأنَّ أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة، فزادهم حماسهم المحموم لتضييق الخناق على الخليفة، والتَّشوُّق إلى قتله بأيِّةِ وسيلة.
ن ـ دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة:
في السَّنوات الأخيرة من خلافة عثمان رضي الله عنه بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلاميِّ نتيجة عوامل التَّغيير التي ذكرناها، وأخذ بعض اليهود يتحيَّنون فرصة الظهور مستغلِّين عوامل الفتنة، ومتظاهرين بالإسلام، واستعمال التَّقيَّة، ومن هؤلاء: عبد الله بن سبأ الملقَّب بابن السَّوداء، وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التَّهويل من شأنه كما فعل بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة، فإنه كذلك لا يجوز التَّشكيك فيه، أو الاستهانة بالدَّور الذي لعبه في أحداث الفتنة، كعامل من عواملها، على أنَّه أبرزها، وأخطرها، إذ إنَّ هناك أجواء للفتنة مهَّدت له، وعوامل أخرى ساعدته، وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء، ومعتقدات ادّعاها، واخترعها من قبل نفسه، وافتعلها من يهوديَّته الحاقدة، وجعل يروِّجها لغاية ينشدها، وغرض يستهدفه، وهو الدس في المجتمع الإسلامي بغية النَّيل من وحدته، وإذكاء نار الفتنة، وغرس بذور الشِّقاق بين أفراده، فكان ذلك من جملة العوامل التي أدَّت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وتفرُّق الأمة شيعاً وأحزاباً.
وخلاصة ما جاء به أن أتى بمقدِّمات صادقة، وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السُّذَّج، والغلاة، وأصحاب الأهواء من النَّاس، وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبَّس فيها على من حوله، حتى اجتمعوا عليه، فطرق باب القران بتأولّه على زعمه الفاسد، حيث قال: لَعَجبٌ ممَّن يزعم أنَّ عيسى يرجع، ويكذِب بأن محمَّداً يرجع، وقد قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٖۚ} [القصص: 85]. فمحمد أحق بالرجوع من عيسى رضي الله عنه بقوله: إنَّه كان ألف نبيٍّ، ولكل نبيٍّ وصيٌّ، وكان عليٌّ وصيَّ محمد، ثمّ قال: محمد خاتم الأنبياء. وعلي خاتم الأوصياء.
وحينما استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل إلى هدفه المرسوم، وهو خروج النَّاس على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم، حيث قال لهم: من أظلم ممَّن لم يُجِزْ وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمّة، ثمَّ قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حقٍّ، وهذا وصيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوا في هذا الأمر، فحرِّكوه، وابدؤوا بالطَّعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، تستميلوا النَّاس، وادعوهم إلى هذا الأمر. وبثَّ دعاته، وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السِّر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كلِّ مصر منهم إلى مصر آخر بما يضعون، فيقرؤهأولئك في أمصارهم، وهؤلاء في أمصارهم حتَّى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرُّون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر: إنّا لفي عافية ممَّا ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة فإنَّهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا: إنَّا لفي عافية ممّا فيه النَّاس.
ويظهر من هذا النَّصِّ الأسلوب الذي تبعه ابن سبأ، فهو أراد أن يوقع في أعين الناس بين اثنين من الصَّحابة؛ حيث جعل أحدهما مهضوم الحقِّ وهو عليٌّ، وجعل الثاني مغتصِباً وهو عثمان، ثمّ حاول بعد ذلك أن يحرِّك النَّاس ـ خاصَّة في الكوفة ـ على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهم، علماً بأنَّه ركَّز في جملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم مادّة ملائمة لتنفيذ خطّته، فالقرَّاء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وأصحاب المطامع منهم هيّج أنفسهم، بالإشاعات المغرضة المفتراة على عثمان، مثل: تحيزه لأقاربه، وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين عليهم، وأنّه حمى الحمى لنفسه، إلى غير ذلك من التُّهم، والمطاعن التي حرك بها نفوس الغوغاء ضدّ عثمان رضي الله عنه، ثمّ إنه أخذ يحض أتباعه على إرسالالكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصار، وهكذا يتخيل النّاس في جميع الأمصار: أنّ الحال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه، والمستفيد من هذه الحال هم السبئية، لأن تصديق ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي.
هذا وقد شعر عثمان رضي الله عنه بأن شيئاً ما يحاك في الأمصار، وأنّ الأمّة تمخض بشرٍّ، فقال: والله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات، ولم يحرّكها.
على أن المكان الذي رتع فيه ابن سبأ هو مصر، وهناك أخذ ينظّم حملته ضدّ عثمان رضي الله عنه، ويحثُّ على التوجّه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى: أنّ عثمان أخذ الخلافة بغير حقٍّ، ووثب على وصيِّ رسول الله، يقصد عليَّاً، وقد غشهم بكتب ادّعى أنها وردت من كبار الصحابة حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة المنوَّرة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعاً، تبرّؤوا ممّا نسب إليهم من رسائل تؤلّب النَّاس على عثمان، ووجدوا عثمان مقدّراً للحقوق، بل وناظرهم فيما نسبوا إليه، وردّ عليهم افتراءهم وفسر لهم صدق أعماله، حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك بن الأشتر النّخعي: لعله مُكر به وبكم. ويعتبر الذهبي: أنّ عبد الله بن سبأ المهيِّج للفتنة بمصر، وباذر بذور الشِّقاق والنِّقمة على الولاة ثمَّ الإمام ـ عثمان ـ فيها، ولم يكن ابن سبأ وحده وإنَّما كان عمله ضمن شبكة من المتآمرين، وأخطبوطاً من أساليب الخداع، والاحتيال، والمكر، وتجنيد الأعراب، والقرّاء وغيرهم، ويروي ابن كثير: أنَّ من أسباب تألُّب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأ، وذهابه إلى مصر، وإذاعته بين النَّاس كلاماً اخترعه من عند نفسه، فافتتن به بشر كثير من أهل مصر.
إنَّ المشاهير من المؤرِّخين والعلماء من سلف الأمَّة وخلفها يتَّفقون على أنَّ ابن سبأ ظهر بين المسلمين بعقائد، وأفكار ، وخطط سبئيَّة، ليلفت المسلمين عن دينهم، وطاعة إمامهم، ويوقع بينهم الفرقة، والخلاف، فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكوَّنت به الطائفة السَّبئيَّة المعروفة التي كانت عاملاً من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي الله عنه والذي يظهر من خطط السَّبئيَّة أنّها كانت أكثر تنظيماً، إذ كانت بارعة في توجيه دعايتها، ونشر أفكارها، لامتلاكها ناصية الدِّعاية، والتَّأثير بين الغوغاء والرُّعاع من النَّاس، كما كانت نشيطة في تكوين فروع لها سواء في البصرة، أم الكوفة، أم مصر، مستغلة العصبية القبليَّة ومتمكِّنة من إثارة مكامن التَّذمُّر عند الأعراب، والعبيد، والموالي، عارفة بالمواضع الحسَّاسة في حياتهم، وبما يريدون.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf