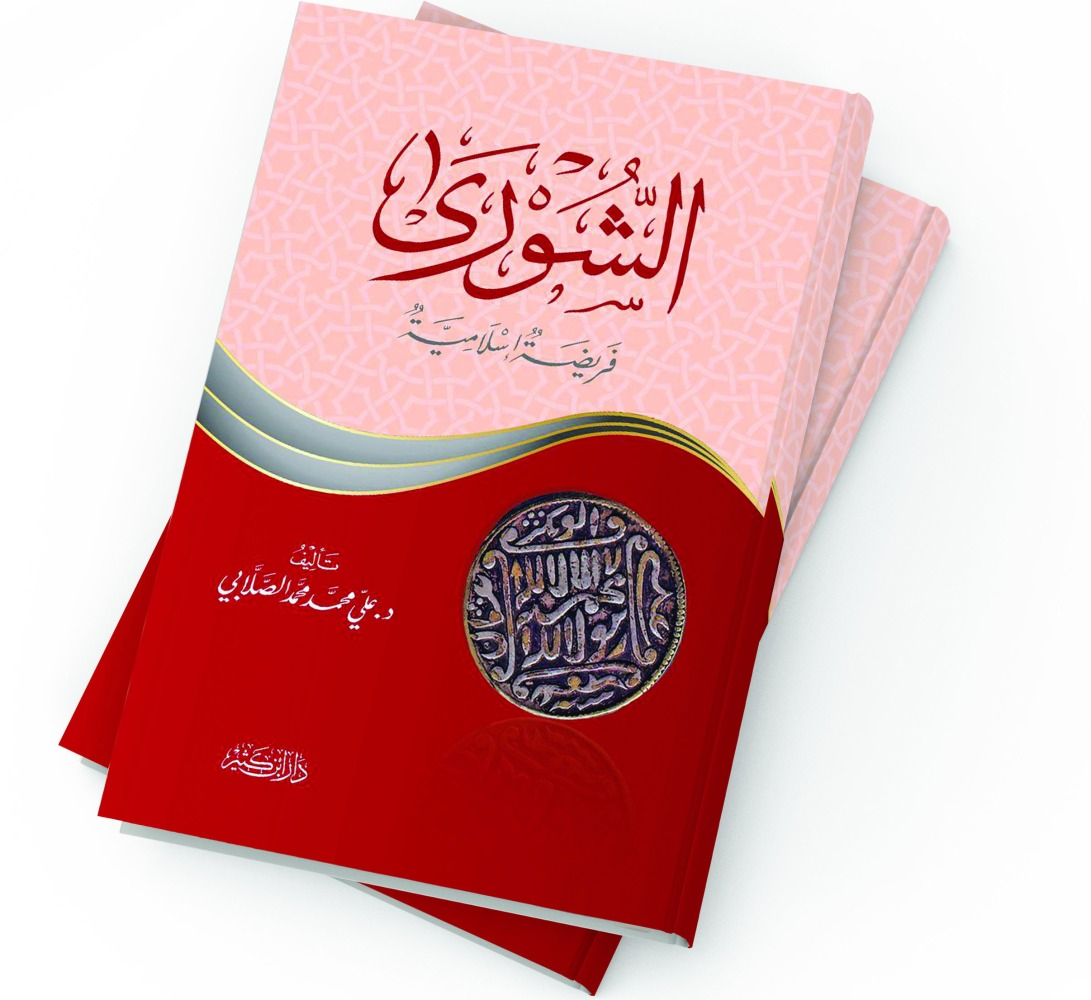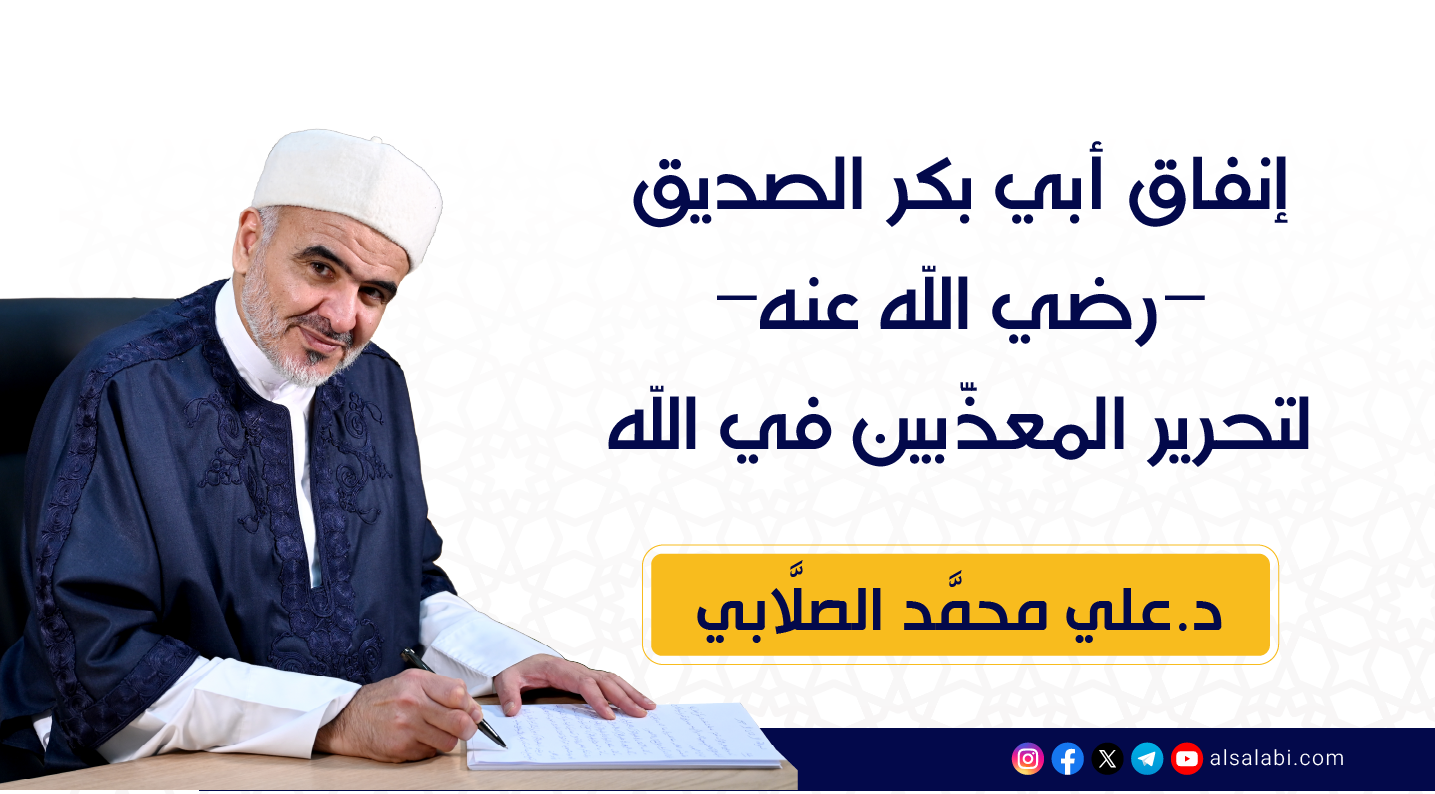"فإنِّي أردُّ إليك جوارك، وأرضى بجوار الله عزَّ وجل!"
بقلم: د. علي محمد الصَّلابي
كان لأبي بكر الصديق موقفٌ مع ابن الضغنة عندما عزم أن يهاجر أول مرة إلى الحبشة، وهو ما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: لم أعقل أبويَّ قطُّ إلا وهما يدينان الدِّين، ولم يمرَّ علينا يوم إلاَّ يأتينا فيه رسول الله (ﷺ) طرفي النَّهار: بكرةً، وعشيَّةً، فلمّا ابتلي المسلمون؛ خرج أبو بكرٍ مهاجراً نحو أرض الحبشة حتّى برك الغماد، لقيه ابن الضغنة ـ وهو سيِّد القارةـ فقال: أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربِّي، قال ابن الضغنة: فإنَّ مثلك يا أبا بكر! لا يَخْرُج، ولا يُخْرَج، إنَّك تكسب المعدوم، وتصل الرَّحم، وتحمل الكَلّ، وتَقْري الضيف، وتُعين على نوائب الحق. فأنا لك جارٌ، ارجع، واعبد ربك ببلدك. فرجع، وارتحل معه ابن الضغنة، فطاف ابن الضغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إنَّ أبا بكرٍ لا يَخرج مثله، ولا يُخرج، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم، ويصل الرَّحم، ويحمل الكلّ، ويقري الضيف، ويُعين على نوائب الحق؟ فلم تكذِّب قريش بجوار ابن الضغنة، وقالوا لابن الضغنة: مر أبا بكرٍ فليعبد ربه في داره، فليصلِّ فيها، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنّا نخشى أن يفتن نساءنا، وأبناءنا. فقال ذلك ابن الضغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثمَّ بدا لأبي بكرٍ، فابتنى مسجداً بفناء داره، وكان يصلِّي فيه، ويقرأ القران، فتقذف عليه نساء المشركين، وأبناؤهم، وهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكرٍ رجلاً بكّاءً لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الضغنة، فقدم عليهم فقالوا: إنّا كنا أجرنا أبا بكرٍ بجوارك على أن يعبد ربَّه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره، فأعلن بالصَّلاة، والقراءة فيه، وإنّا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانْهَهُ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربَّه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك؛ فسله أن يردَّ إليك ذمَّته، فإنّا قد كرهنا أن نُخْفِركَ، ولسنا بمقرِّين لأبي بكرٍ الاستعلاء .
قالت عائشة: فأتى ابن الضغنة إلى أبي بكرٍ، فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإمّا أن تقتصر على ذلك، وإمّا أن تُرجع إليَّ ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أنِّي أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكرٍ: فإنِّي أردُّ إليك جوارك، وأرضى بجوار الله عزَّ وجل (فتح الباري: 7/274).
وحين خرج من جوار ابن الضغنة، يعني أبا بكر، لقيه سفيهٌ من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا على رأسه تراباً، فمرَّ بأبي بكر الوليد بن المغيرة ـ أو العاص بن وائل ـ فقال له أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: ألا ترى ما يصنع هذا السَّفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك، وهو يقول: أَي ربِّي ما أحلمك! أي ربِّي ما أحلمك! أي ربِّي ما أحلمك (ابن كثير، 1988، ص 3/95)! وفي هذه القصَّة دروسٌ وعبرٌ كثيرةٌ منها:
1ـ كان أبو بكرٍ في عزٍّ من قومه قبل بعثة محمَّدٍ (ﷺ)، فهاوه ابن الضغنة يقول له: مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج مثله، إنَّك تكسب المعدوم، وتصل الرَّحم، وتحمل الكلّ، وتقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق، فأبو بكرٍ لم يدخل في دين الله طلباً لجاهٍ، أو سلطانٍ، وما دفعه إلى ذلك إلاَّ حبُّ اللهِ، ورسولِه (ﷺ)، مِمَّا يترتَّب على ذلك من ابتلاءات؛ أي: أنَّه لم يكن له تطلُّعات سوى مرضاة الله تعالى، إنَّه يريد أن يفارق الأهل، والوطن، والعشيرة؛ ليعبد ربَّه، لأنَّه حيل بينه وبين ذلكَ في وطنه (مسعود، 1986، ص 134).
2ـ إنَّ زاد الصِّدِّيق في دعوته القرآن الكريم، ولذلك اهتمَّ بحفظه، وفهمه، وفقهه، والعمل به، وأكسبه الاهتمام بالقران الكريم براعةً في تبليغ الدَّعوة، وروعةً في الأسلوب، وعمقاً في الأفكار، وتسلسلاً عقليّاً في عرض الموضوع الذي يدعو إليه، ومراعاةً لأحوال السَّامعين، وقوةً في البرهان، والدَّليل (هاني، ص 88).
وكان الصِّدِّيق يتأثَّر بالقرآن الكريم، ويبكي عند تلاوته، وهذا يدلُّ على رسوخ يقينه، وقوَّة حضور قلبه مع الله عزَّ وجلَّ، ومع معاني الآيات التي يتلوها. والبكاء مبعثه قوَّة التأثير إمّا بحزنٍ شديدٍ، أو فرحٍ غامرٍ، والمؤمن الحقُّ يظلُّ بين الفرح بهداية الله تعالى إلى الصِّراط المستقيم، والإشفاق من الانحراف قليلاً عن هذا الصراط، وإذا كان صاحب إحساسٍ حيٍّ، وفكرٍ يقظٍ كأبي بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ فإنَّ هذا القران يذكِّرُ بالحياة الآخرة وما فيها من حسابٍ، وعقابٍ، أو ثوابٍ، فيظهر أثر ذلك في خشوع الجسم، وانسكاب العبرات، وهذا المظهر يؤثر كثيراً على مَنْ شاهده، ولذلك فزع المشركون من مظهر أبي بكرٍ المؤثر، وخَشوا على نسائهم، وأبنائهم أن يتأثَّروا به، فيدخلوا في الإسلام (الحميدي، 1998، ص 19/209).
لقد تربّى الصِّدِّيق على يدي رسول الله (ﷺ)، وحفظ كتاب الله تعالى، وعمل به في حياته، وتأمَّل فيه كثيراً، وكان لا يتحدَّث بغير علمٍ، فعندما سئل عن ايةٍ لا يعرفها أجاب بقوله: أيُّ أرضٍ تسعني، أو أيُّ سماءٍ تُظِلُّني إذا قلت في كتاب الله ما لم يُرد الله (السيوطي، 1997، ص 117). ومن أقواله التي تدلُّ على تدبُّره، وتفكُّره في القران الكريم قوله: إنَّ الله ذكر أهل الجنَّة، فذكرهم بأحسن أعمالهم، وغفر لهم سيئتها، فيقول الرَّجل: أين أنا مِنْ هؤلاء؟! يعني: حسنها، فيقول قائلٌ: لست من هؤلاء؛ يعني: وهو منهم (ابن تيمية، 1997، ص 6/212).
وكان يسأل رسول الله (ﷺ) فيما استشكل عليه بأدبٍ، وتقديرٍ، واحترامٍ، فلمّا نزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا *﴾ [النساء: 123] قال أبو بكر: يراسل الله! قد جاءت قاصمة الظَّهر، وأيُّنا لم
يعمل سوءاً؟ فقال: «يا أبا بكر! ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الألواء؟ فذلك ممّا تجزون به » (مسند أحمد، رقم: 68).
وقد فسَّر الصِّدِّيق بعض الآيات مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ *﴾ [فصلت: 30] قال فيها: فلم يلتفتوا عنه يمنةً ولا يسرةً، فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه، لا بالحبِّ، ولا بالخوف، ولا بالرَّجاء، ولا بالسؤال، ولا بالتوكُّل عليه، بل لا يحبُّون إلا الله، ولا يحبون معه أنداداً، ولا يحبُّون إلا إياه، لا لطلب منفعة، ولا لدفع مضرَّة، ولا يخافون غيره كائناً مَنْ كان، ولا يسألون غيره، ولا يتشرَّفون بقلوبهم إلى غيره (ابن تيمية، 1997، ص 28/22)، وغير ذلك من الآيات .
إنَّ الدُّعاة إلى الله عليهم أن يكونوا في صحبةٍ مستمرةٍ للقران الكريم، يقرؤونه ويتدبَّرونه، ويستخرجون كنوزه، ومعارفه للناس، وأن يظهروا للناس ما في القران من إعجازٍ بيانيٍّ، وعلميٍّ، وتشريعيٍّ، وما فيه من سبل إنقاذ الإنسانيَّة المعذَّبة من ماسيها، وحروبها، بأسلوبٍ يناسب العصر، ويكافئ ما وصل إليه الناس من تقدُّمٍ في وسائل الدَّعوة، والدِّعاية، ولقد أدرك أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ كيف تكون قراءة القران الكريم في المسجد على ملأٍ من قريش وسيلةً مؤثِّرةً من وسائل الدعوة إلى الله (المصري، 1987، ص 95).
المصادر والمراجع:
(1) ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدِّمشقي، (1988)، البداية والنِّهاية، دار الرَّيَّان، القاهرة، الطَّبعة الأولى 1408هـ 1988م.
(2) مسعود، د. جمال عبد الهادي محمَّد، (1986)، أخطاء يجب أن تُصحح في التَّاريخ، استخلاف أبي بكر الصِّدِّيق، دار الوفاء، المنصورة، الطَّبعة الأولى 1406هـ 1986م.
(3) هاني، يسرى محمد، تاريخ الدَّعوة إِلى الإِسلام في عهد الخلفاء الرَّاشدين، الطَّبعة الأولى 1418هـ جامعة أمِّ القرى، معهد البحوث العلميَّة، وإِحياء التراث.
(4) الحميدي، عبدالعزيز عبدالله، التَّاريخ الإِسلاميُّ مواقف وعبر، دار الدَّعوة، الإِسكندريَّة، دار الأندلس الخضراء، جدَّة، الطَّبعة الأولى 1418هـ 1998م.
(5) السيوطي، جلال الدين، (1997)، تاريخ الخلفاء، عُني بتحقيقه إِبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، الطَّبعة الأولى 1417هـ 1997م.
(6) ابن تيمية، (1997)، مجموعة الفتاوى، تقي الدِّين أحمد بن تيميَّة الحَرَّاني، دار الوفاء، مكتبة العبيكان، الطَّبعة الأولى 1418هـ 1997م.
(7) المصري، جميل عبدالله، (1987)، تاريخ الدَّعوة الإِسلاميَّة في زمن الرَّسول (ﷺ) والخلفاء الرَّاشدين، مكتبة الدَّار بالمدينة المنوَّرة، الطَّبعة الأولى 1407هـ 1987م.