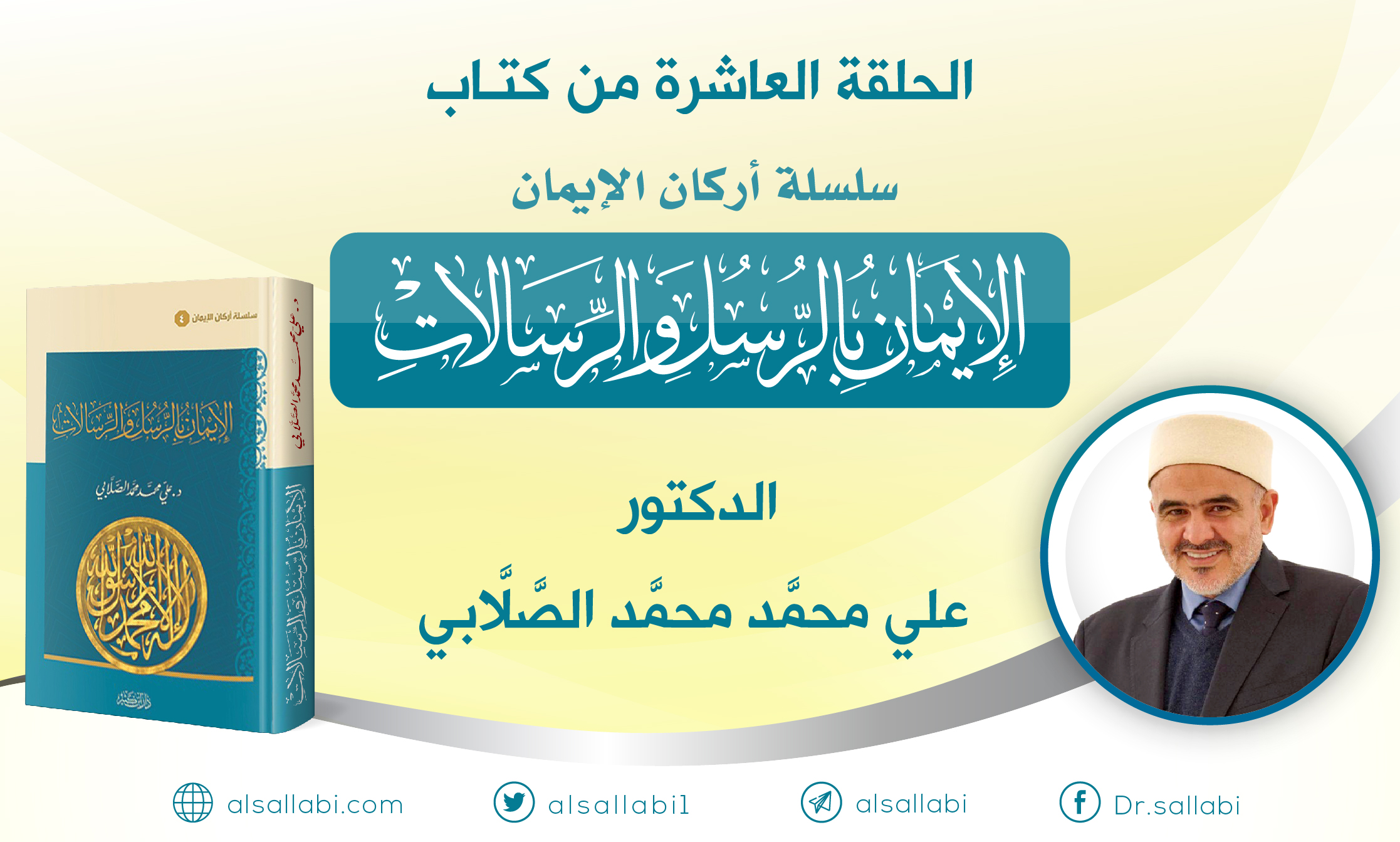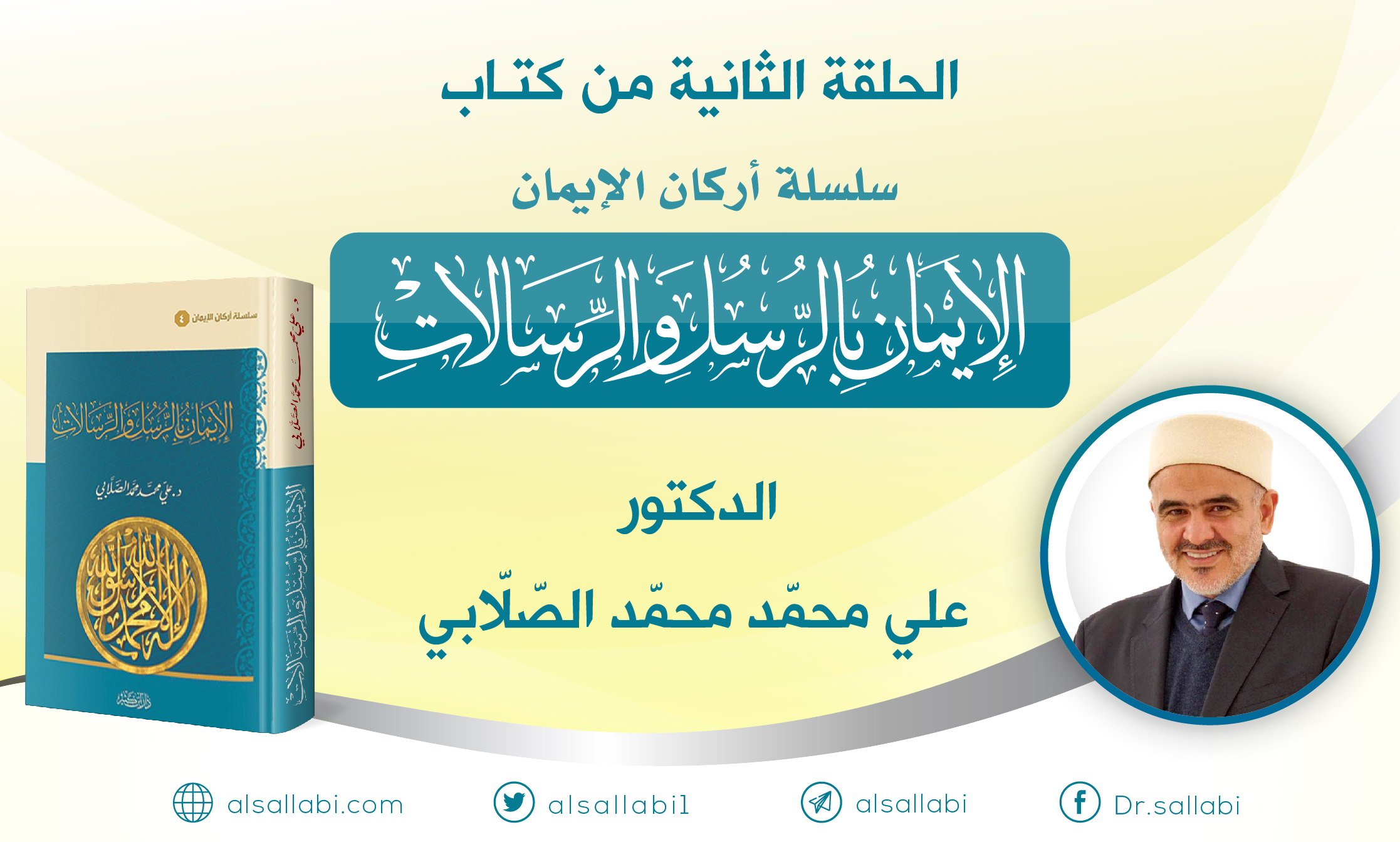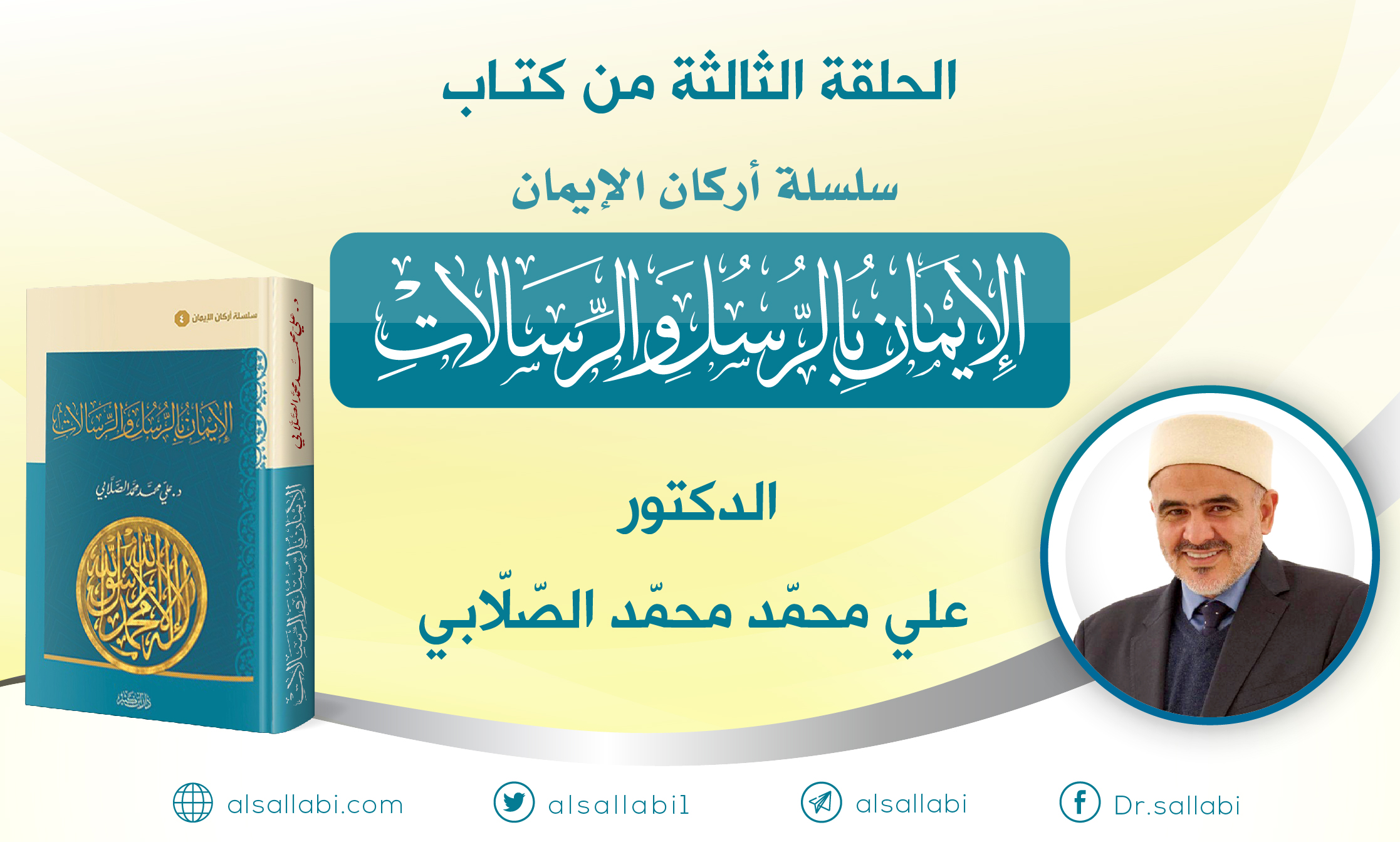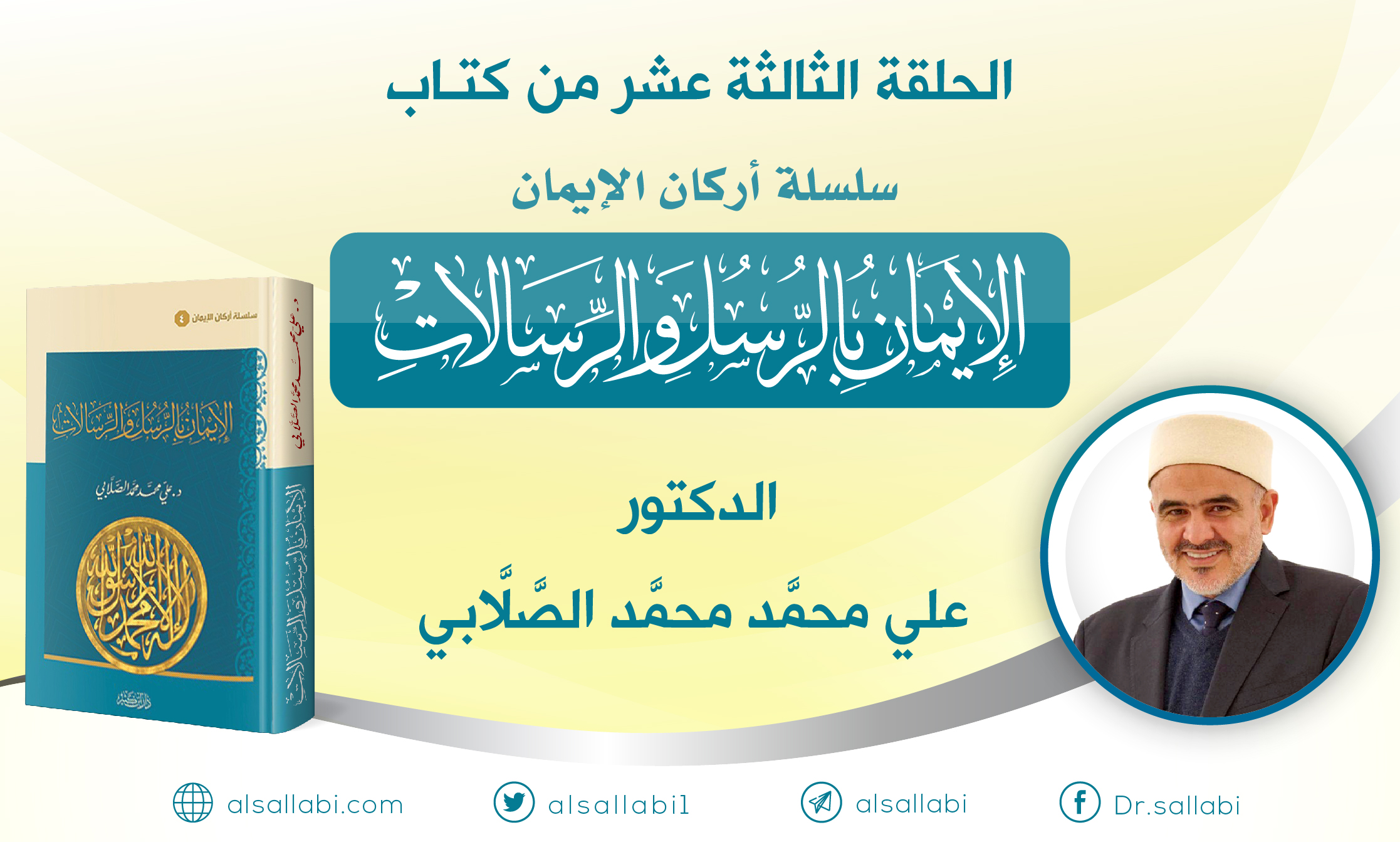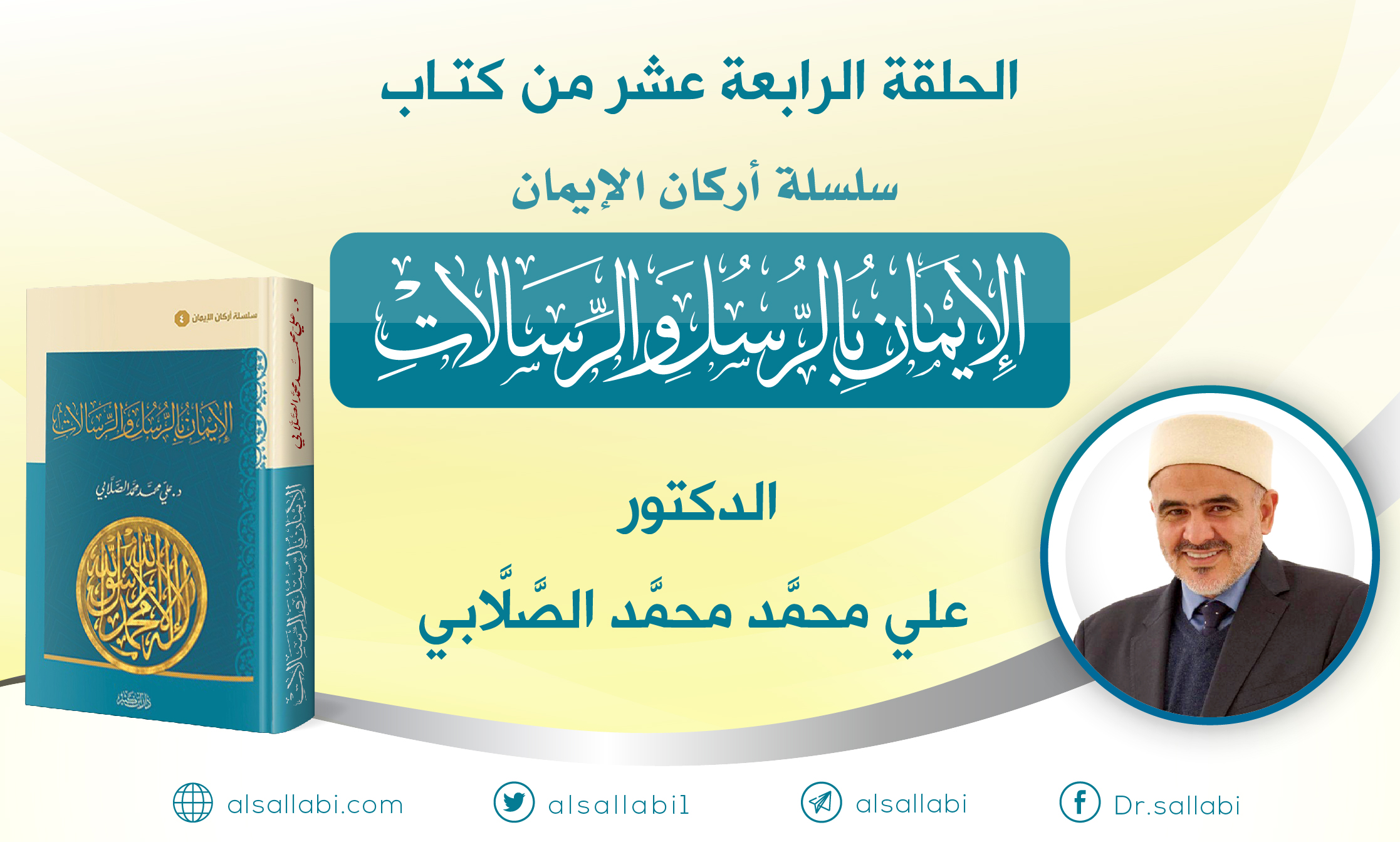من أهمّ صفات الأنبياء والمرسلين (2)
الحلقة: العاشرة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شوال 1441 ه/ يونيو 2020
1 ـ التبليغ:
إنّ مهمة الرسل الأولى التي كلّفهم الله تعالى بها إلى الأمم ، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور:هي التبليغُ الذي أوجبه الله تعالى عليهم بمقتضى اصطفائهم للرسالة التي حمّلهم إيّاها ، فيجبُ عليهم التبليغُ ، ويستحيل عليهم الكتمانُ ، ويجب على المسلمين اعتقادُ ذلك فيهم ، تصديقاً لشهادة الله تعالى لهم بذلك ، قال تعالى: {فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ *} [النحل: 35].
وقد قام رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بواجب ذلك البلاغ أكمل قيام ، حيث بلّغوا كل صغيرةٍ وكبيرةٍ ليلاً ونهاراً ، لا يفترون عن ذلك ، ولا يملّون ، حتى قامت الحجةُ على أقوامهم ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقّت عليه الضلالة ، وقد كانوا ينالون من جرّاء ذلك الشدة الشديدة والإيذاء البليغ ، وذلك لما هم عليه من الرحمة بأممهم ، والشفقة بهم ، لعلمهم بما سيحيق بهم من العذاب إن أعرضوا عن قبولِ ما بلّغوه عن الله تعالى جل جلاله.
فكان كلُّ واحد يبذل جهده ، ويتفانى في إقناع قومه بقبول ما أُمِرَ بتبليغه إليهم ، ويتلطّف لهم بالخطاب ، ليقبلوا ما جاءوا به من عند الله تعالى ، كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام: {قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ *} [الاعراف : 61 ـ 62]. وكما قال هود عليه السلام لقومه أهل عاد: {قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ *} [الاعراف: 67 ـ 68]. إلى غير ذلك من الايات الدالّة على التلطّف بالبلاغ ، وكمال الرحمة بالمبلَّغين.
فكانوا غير مقتصرين على مجرد البلاغ الواجب عليه قط ، بل إنّهم كانوا يتفانون في النصيحةِ لأقوامهم لقبوله ، فيجادلونهم ويحاورونهم بالتي هي أحسن ، حتى يقبلوا أو ييأسوا من ذلك ، فعندئذٍ لا يَسَعُهم إلاّ أن يقولوا: {وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ *} [يس: 17] كما قال هود عليه السلام لما يئس من قوم عاد من قبول رسالة الله: {قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ *} [الاحقاف: 23]. وقال أيضاً: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ *} [هود: 57] وكما قال صالح عليه السلام: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ *} [الاعراف: 79]. وكما قال شعيب عليه السلام: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَال ياقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ *} [الاعراف: 93].
وهكذا نجد الرسل جميعاً يعلنون بكل صراحةٍ ووضوحٍ أنهم قد بلّغوا رسالة الله ، ونصحوا للأمة ، حتى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربُّه بتبليغ الرسالة ، فيقول مخاطباً له: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ *} [المائدة: 67].
فكلُّ رسول مكلَّفٌ بتبليغ الدعوة والرسالة ، ولا يمكِنُ لأحدٍ من الرسل أن يزيدَ حرفاً أو ينقِصَ حرفاً ممّا نزل عليه ، لأنه يكونُ قد خالف أمر الله ، وخانَ الأمانة التي عُهدتْ إليه ، ولهذا نجدُ بعضَ السور أو الايات الكريمة تبدأ بقوله تعالى وهو أمرٌ موجَّهٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ليبلغه {قُلْ} ، فيبلغها الرسول كما نزلت عليه ، دون زيادة أو نقصان ، اقرأ مثلاً قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]. وقوله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *} [الكافرون: 1 ـ 2]. وقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} [الفلق: 1]. وقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} [الناس: 1].
وقد كان يكفي الرسول أن يبلّغَ الأوامرَ الإلهية دون تلك الكلمة التي خوطب بها ، ولكنّه أمينٌ على الوحي ، يبلِّغ رسالة ربه بالحرف الواحد دون تغيير أو تبديل ، أو زيادةٍ أو نقصان ، فلم يقل ولم يقل أو وإنّما ذكر الأمرَ الذي توجّه إليه من العلي القدير ، بنفس الصيغة ، ونفس الحروف ، وذلك دليلٌ الأمانةِ القصوى في تبليغ الدعوة والرسالة.
والغرض من (التبليغ) أن يقطعَ اللهُ الحجةَ على الناس ، ولئلا يبقى لأحدٍ عذرٌ يومَ القيامة ، فإنّ الله تبارك وتعالى أكرمُ من أن يعذّب إنساناً قبل أن تبلغه الرسالةُ ، وأرحمَ من أن يعذّبَه دونَ ذنبٍ ، كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً *} [الاسراء: 15].
كان التبليغُ لدى سيد المرسلين فطرةً وسجيةً ، وكانت نفسُه تضيقُ عندما لا يجدُ قلباً طاهراً يقبلُ دعوته ، مثلما نضيق نحن إن حُرمنا من الطعام والشراب ، أو عندما نحرَمُ من تنفس الهواء ، والحقيقة أنّه صلى الله عليه وسلم ما كان يهتمّ بالطعام والشراب ، فقد كان يصومُ أحياناً صوماً متواصلاً ، وكان يأكل أحياناً ما يكفي لسدِّ رمقه فقط ، وإبقائه حياً ، فإنّ قلبَه المفعمَ بالام دعوته لم يدعْ لديه شهيةً للأكل ، فكما تعيشُ الملائكة بالتسبيح ، كان رسولُنا صلى الله عليه وسلم يعيشُ بالدعوة ، وعندما يجدُ أمامه صدراً رحباً طاهراً يفرحُ وينشَطُ ، والقران الكريم يصفُ وضعَه هذا فيقول: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ *} [الشعراء: 3] وفي اية أخرى يقول: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا *} [الكهف : 6].
2 ـ الفطنة والحكمة وقوة الحجة:
وهذه الصفات واضحة في القران الكريم في سير الأنبياء والمرسلين ، فقد قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ *} [الانعام: 83].
وقال تعالى داود عليه السلام: {وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ} [البقرة : 251] وقال أيضاً: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ *} [البقرة: 20].
وعن يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ *} [يوسف: 55].
ويمكن ملاحظة هذه الصفات من خلال هذه الأمثلة القرانية والنبوية.
أ ـ إبراهيم عليه السلام:
قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ *} [الانبياء: 51] فسيدنا إبراهيم عليه السلام في غاية الذكاء والنباهة ، والحكمة وقوة الحجة ، وانظر إليه في موقف المحاجة لقومه المشركين نجدْ فيه ايات النبوغ والحكمة والذكاء ، قال تعالى: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ *قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ *قَالُوا سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ *قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ *قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ياإِبْرَاهِيمُ *قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ *فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ *ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ *قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ *أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ *} [الانبياء : 58 ـ 67].
وحقاً إنّه لمنتهى الذكاء والنبوغ ، يتجلّى في عمل إبراهيم عليه السلام ، فلقد حطم بيده الأصنام ، ثم علق القدوم في عنق أكبر الأصنام ، ليقيمَ الحجةَ على قومه ، فحين قدّموه للمحاكمة سألوه هذا السؤال: مَن الذي حطّم الهتنا ، وأقدم على تكسير الأصنام؟ هل أنتَ فعلتَ ذلك يا إبراهيم؟.
فأجابهم إبراهيم عليه السلام: إنني لم أحطّمها ، ولكنّ الصنمَ الكبير والإلهَ العظيم هو الذي حطمها ، لأنه لم يرضَ أن تعبد معه ، والدليل على ذلك أنّه وضع القدوم في عنقه ، وإذا لم تصدّقوا كلامي ، فاسألوهم عن ذلك الأمر ، وسلوه ، وهنا كان قد بلغ إبراهيم إلى هدفه ، فأقام عليهم الحُجّة بعد أن سفّه عقولهم ، وجعلهم يضحكون من أنفسهم ، وهكذا يكون منطق الأنبياء.
وانظر إليه في موقف اخر ، وهو يجادلُ الطاغيةَ (النمرود) الذي نازعَ اللهَ في ملكه ، وزعم أنّه إله يُعْبَدُ من دون الله ، وأنّه الربُّ المعبود ، كيف كان نبوغ إبراهيم وذكاءه؟ وكيف دحض خصمه العنيد ، قال تعالى:
{إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *} [البقرة : 258].
فانظر في الايات السابقة لمّا أراد الطاغية أن يَرُوْغَ في قضية الإماتة والإحياء ، كيف ترك إبراهيمُ هذه المسألة ، وفاجأ الطاغيةَ بسؤالٍ لم يتوقعه فأرداه باهتاً ، وتصوّر لو أنّا افترضنا أنّ إبراهيم بقيَ يجادله في المسألة الأولى ماذا تكون النتيجة؟ ثم لاحظ أنَّ سؤال إبراهيم الثاني لا يدعُ المجال حتى للمكابر ، فتخيّل لو أنّ إبراهيمَ قال له: مَنْ خلقَ الشمس؟ فإنّ المكابر قد يقول: أنا ، ولكنّ إبراهيم طالبه بفعلِ جديدٍ في الشمس ، فماذا يقول المكابر؟.
فقد أقام إبراهيم عليه السلام الحجةَ الدامغةَ بفطنته النيرة ، بحيث لم يستطع مواصلةَ اللجاج والعناد ، وبذلك عرّف خبره لأتباعه ، وأنه أحقر من أن يخلقَ بعوضةً أو يدبِّرَ أمراً ، وتبيّن لهم بذلك أنَّ دعواه الألوهية محض افتراء ، ولكنهم مع ذلك لم يهتدوا ، إذ الناسُ غالباً على أديان ملوكهم ، وأتباع كلِّ ناعق.
ومن فطنةِ إبراهيم عليه السلام وحكمتهِ وقوةِ حجته مناظرته لقومه في شأنِ معبوداتهم من الكواكب ، حيث استطاعَ إقامة الحجة الدامغة عليهم في بطلانِ ألوهيتها ، بما لم يدع شكاً للمنصف العاقل ، فقد استدرجهم في تفنيد اعتقادِهم شيئاً فشيئاً ، حتى أتى على معتقدهم الزائفِ من أساسه ، وأقام الحجة الدامغة على اجتثاثه ، كما قصّه الله تعالى علينا ذلك بقوله: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ *فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِينَ *فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ *فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ *إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} [الأنعام: 75 ـ 79].
بيّن إبراهيمُ عليه السلام أولاً عدمَ صلاحية الكواكب للألوهية ، ثم ترقّى منها إلى القمر ، الذي هو أضوأ منها وأبهى ، ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشدّ الأجرامِ المشاهدةِ ضياءً وسناءً وبهاءً ، فبيّن أنها مسخرةٌ مسيّرةٌ مقدّرةٌ مربوبةٌ ، فلا تصلحُ أن تكون رباً.
وأنَّ الربَّ من شأنه أن يكون مدبِّراً مسخِّراً ضارّاً نافعاً ، وأنَّ هذه الكواكب لا تملكُ شيئاً من هذه الأمور ، فهي إذاً لا تستحقُّ أن تعبدَ ، فأعلنَ براءته منها وإخلاصَ عبوديته لله تعالى قائلاً: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} [الانعام: 79].
وبذلك زعزع إيمانَهم في معتقداتهم الضالّة بهذه الكواكب السيّارة ، التي لا تملك ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وذلك بفضل الله تعالى ، ثم بفضل هذا الأسلوب الجدلي الحكيم القائم على استدراج المخاطَبِ بالتسليم بدعاويه ، ثم الكرَّ عليها بالبطلان ، لقوة الحجة والبرهان ، وما كان له بذلك من قوة لولا الفِطنةُ الكبرى التي رزقه الله تعالى إيّاها ، لتساير تكليفه بالرسالة.
ب ـ نوح عليه السلام:
استطاع نوحٌ عليه السلام بفطنته وحكمته وقوّة حجته أن يُفحمَ مناوئيه من قومه حتى أقروا له بالعجز عن مجادلته ، واستعجلوا ما يتوعدهم به من العذاب ، وقالوا: {قَالُوا يانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ *} [هود: 32].
ذلك لأنه ما فتأى يناظرهم ويجادلهم ويحاججهم ، كلما أتوه بشبهة فندّها ، وكلما جادلوه أسكتهم ، فلا يملكون جواباً ولا رداً ولا حجة ، {فَقَالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ *} [هود: 27]. أجابهم نوح عليه السلام بقوله:
{وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَاقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ *وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ *} [هود: 28 ـ 31].
فقومه لمّا جادلوه بما يُنمي عن قصور عقولهم ، حيث احتجّوا عليه بفقده وسائلَ السؤدد عليهم في نظرهم من المال والجاه ، فرأوا أنّه غيرُ أهلٍ لشرفِ الرسالة ، وأنّه من جنسهم البشري ، وظنّوا أنّ شرفَ الرسالة ينبغي أن يكونَ لغير هذا الجنس ، مع أنّه الجنسُ الذي كرّمه الله وشرّفه على كثيرٍ من الأجناس ، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الاسراء: 70].
فلمّا قصر نظرهم عن إدراك أسباب الكمال ، حيث نظروا إليه وإلى أتباعه ، فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس ، بل إنّ أتباعه من ضعفاء قومهم ، ورأوا أنّ ذلك علامةُ كذبه ، وضلالُ أتباعه ، لمَّا كان أمرهم كذلك سلك نوح عليه السلام في مجادلتهم مسلك الإجمالِ لإبطالِ شبههم ، ثم مسلك التفصيل لردّ أقوالهم.
أمّا مسلك الإجمال فسلك فيه مسلك القلب ، بأنّهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمِلُ على التصديق برسالته ، فكذلك هو لا يستطيعُ أن يحملهم على رؤيةِ المعاني الدالّة على صدقه ، وأنّه لا يستطيع منعَ الذين امنوا به من متابعته والاهتداء بالهدى الذي جاء به ، وأنّه لم يدّعِ فضلاً غيرَ الوحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه ورسله عليهم السلام في قوله: {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [ابراهيم: 11].
ثم فصّل إجابته السابقة ، فأجابهم عمّا توهموه ، من أنّ من لوازم النبوة أن يكونَ أغنى منهم أو أن يعلمَ الأمورَ الغائبة بقوله: {وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ} [هود : 31].
والمعنى لا أدّعي ما ليسَ لي ، فتنكروا قولي ، وتستبعدوا ما اتاني الله من فضل النبوة.
وعن دعواهم بأنّه بشر لا يستحقُّ أن يتميّزَ عنهم بالرسالة أجابهم بقوله: {ولا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ} بل أنا بشرٌ مثلكم تعرفوني، ولكن اتاني الله فضلَ الرسالةِ إليكم.
وعن دعواهم باسترذالِ أتباعه لكونهم من ضعفائهم وفقرائهم أبطله بطريقة التغليط ، لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً لانتفاء فضلهم ، فأبطله بأنَّ ضعفهم ليس بحائلٍ بينهم وبين الخير من الله تعالى إذ لا ارتباطَ بين الضعفِ في الأمور الدنيوية من فقرٍ وقلةٍ ، وبين الحرمان من نوالِ الكمالاتِ النفسانية والدينية ، فقال: {وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ} وهكذا فنّد ادعاءاتهم
واحدةً واحدةً بما لم يتركْ لهم مجالاً للمكابرة ، حيث قرّر لهم بذلك الحقائق الثابتة في شأنه ، والتي لا يجهلونها ، وجعلهم في واقع الأمر مسلّمين بأنّه لا يحملهم على مجادلته إلا محضُ الكِبْرِ ومجرّدِ اللجاج والعنادِ ، فما كان لهم بعد ذلك من طاقة في الصبر على مجادلته المفحمة ، فعدلوا إلى استعجال العذاب الذي يتوعّدهم به ، لما سئموا من تزييف معارضتهم وارائهم ، شأنهم بذلك شأنُ المبطِلِ إذا دمغته الحجة فقالوا: [هود: 32]
ج ـ يوسف عليه السلام:
قال تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ *قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ *وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ *يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ *} [يوسف: 36 ـ 41].
ومن فطنةِ يوسفَ عليه السلام وحكمتِه وقوّةِ حجته توظيفُه حاجةَ صاحبيه إلى علمِه، فشرعَ في بثِّ عقيدته الصحيحة بين السجناءِ ، وتوضيح التوحيد ، وخطورة الشرك ، ويبدو في طريقةِ تناول يوسف للحديثِ لطفُ مدخله إلى النفوس ، وكياستُه ، وتنقّلُه في الحديث في رفقٍ لطيفٍ، ولمّا أكملَ مهمته في تبليغ الدعوة شرعَ في تفسير الرؤيا للسجينين.
د ـ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ *مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ *} [القلم: 1 ـ 2]. حيث أقسم المولى جلّ وعلا قَسَماً مؤكَّداً على نفي الجنون عنه الذي كان يرميه به بعضُ المشاغبين من أهل الكفر والعِناد ، كما قال سبحانه: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ *} [القلم: 51]. وذلك ردّاً عليهم ، وتكذيباً لقولهم ، كما قال في اية أخرى: {وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ *} [التكوير: 22].
وقال تعالى: {فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ *} [الطور: 29]. وفي ذلك النفي إثباتٌ لكمال عقله ، وأنّه من إنعامِ اللهِ عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيلُ للنبوة بمنزلةٍ عظمى لا يُرْقَى إليها. وقد برهن الله تعالى على كمال عقله ـ إضافة إلى قسمه المؤكّد ـ بعظمة أخلاقه ، حيث قال بعد ذلك: {وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ *وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *} [القلم: 3 ـ 4].
إذ إنّ صاحبَ الخلق العظيم ، لا يكونُ إلا في منتهى الكمال العقلي ، والصفاء الذهني ، لأنّ العقلَ أصلُ فروع الفضائل الخُلقية ، وعنصر ينابيعها ، ونقطة دائرتها حيث يتفرّع منه: ثقوبُ الرأي ، وجودةُ الفطنة والإصابة ، وصدقُ الظنِّ ، والنظرُ للعواقب ، ومصالحُ النفسِ ، ومجاهدةُ الشهوةِ ، وحسنُ السياسةِ والتدبير ، واقتناءُ الفضائل ، وتجنُّب الرذائل ، وقد كان صلى الله عليه وسلم من هذه كلها في الغايةِ القصوى التي لم يبلغْها بشرٌ سواه.
وقال القاضي عياض بعد أن قرّر أنّه لا مريةَ في أنّه صلى الله عليه وسلم أعقلُ الناس وأذكاهم ، قال: ومن تأمّل تدبيرَه أمرَ بواطن الخلق وظواهرهم ، وسياسةِ العامة والخاصّة ،
مع عجيب شمائله ، وبديعِ سيرته ، فضلاً عَمّا أفاضه من العلم ، وقرّره من الشرع ، دونَ تعلّم سابقٍ ، ولا ممارسةٍ تقدّمت ، ولا مطالعةٍ للكتب فيه ، لم يمترِ في رجحانِ عقله ، وثقوبِ فهمه لأوّلِ بديهةٍ.
ومن الأمثلة على فطنته وذكائه:
* سرعةُ إقامةِ الحجّة على المعارضين ، وقطع شغبهم وجدالهم بالباطل ، فلا يستطيعونَ مجاراته أو مكابرته ، بل لا يَسَعُهم إلاّ الإذعانُ والتسليمُ ، أو النكوصُ على أعقابهم خاسئين.
ومن ذلك ما أجابَ به أبا سفيان يوم أحد حينما افتخر أبو سفيان ـ وهو على شركه يومئذٍ ـ بأوثانه إثر المعركة التي انجلت عن نصرٍ له ولقومه أهل الشرك والوثنية ، فقال متبجّحاً: أعُل هُبَل.
فقال صلى الله عليه وسلم: «أجيبوه».
فقالوا: ما نقول؟.
قال: «قولوا: الله أعلى وأجلّ».
قال أبو سفيان: لنا العُزّى، ولا عُزّى لكم.
فقال صلى الله عليه وسلم: «أجيبوه».
فقالوا: ما نقول؟.
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم».
فقال أبو سفيان: يومٌ بيومٍ والحربُ سجالٌ ، وتجدون مُثْلَةً لم امرْ بها ، ولم تَسُؤني.
فقال صلى الله عليه وسلم: «أجيبوه».
فقالوا: ما نقول؟.
قال: «قولوا: لا سواء ، قتلانا في الجنّةِ ، وقتلاكم في النار».
ومن مظاهر كمال فطنته صلى الله عليه وسلم سرعةُ حَلِّه للمشاكل المستعصية ، التي تحارُ في حلِّها العقولُ الكبيرةُ الشهيرة.
فقد حاول المنافقون ذات مرة أن يفككوا عُرى الوحدةِ بين المهاجرين والأنصار ، فكانت حكمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفطنتُه لهم بالمرصاد ، فأحبطتْ تلك المحاولةَ الخبيثةَ ، وأجهضتها في حينها ، وذلك أنّ رجلاً من غِلمان المهاجرينَ كسع رجلاً من غلمان الأنصار، إثر اختلافٍ بينهما على الماء، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بالُ دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسعَ رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها مُنتنةٌ».
فسمع بذلك عبد الله بن أُبيّ رأسُ المنافقين فقال: فعلوها؟ أمّا واللهِ لئنْ رجعنا إلى المدينةِ ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل ، فبلغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقام عمرُ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ، دعني أضرِبُ عنقَ هذا المنافق ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «دعه ، لا يتحدَّثُ الناسُ أنَّ محمّداً يقتلُ أصحابه».
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومَهم أجمع ، حتى أمسى ، وليلتَهم حتى أصبح ، وصدرَ يومهم حتى اذتهم الشمسُ ، ثم نزل بالناس ، فلم يلبثوا أنْ وجدوا مسّ الأرض ، فوقعوا نياماً. وإنّما فعل ذلك ليشغلَ الناسَ عن الحديثِ الذي كان بالأمسِ، حيث خاضَ الناسُ في حديثِ عبد الله بن أبيّ ، وفي النزعةِ الجاهليةِ التي كادتْ تقضي على وحدةِ المجتمعِ المسلم لولا حكمةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسته الماهرة ، وفطنته العظيمة ، في إطفاءِ لهبها بسيره الميمون ، ذلك الذي أشغلهم به عن الخوض في تلك الفتنة العمياء ، التي أرادَ رأسُ النفاق أن يُشْعِلها ، ليحقِّقَ غرضه في زعزعةِ المجتمع المسلم ، وإطفاء نور الله ، ولكنَّ اللهَ ردَّ كيده في نحره بفضل ما اتى نبيَّه من الحكمة والفطنةِ والحِلْمِ فصلواتِ ربي وسلامه عليه.
وكم كانت فطنته وحكمته تحلُّ من مشاكل عديدَة في أسرعِ وقتٍ وأقصره ، فيتحقّقُ بذلك له ولأمته ما يَصْبون إليه من نَصْرٍ وسعادَةٍ وعزٍّ وسيادةٍ ، ينوءُ عنها الحصر في مثل هذا المقام المقتضي للإيجاز ، والإتيان من كل بحرٍ بقطرة كنموذج لغيره ، والدليلُ على ما سواه.
ومن ذلك براهينه الساطعة القاطعة التي كان يقيمها على مجادليه ومناظريه من مشركين وءِأهل كتاب ، التي كانت تقطعُ دابِرَهم ، وتزهقُ باطِلَهم ، وتجعلهم يوقنون أنّهم في ضلالهم يعمهون ، ويعميهم عن اتباع الحقِّ بعد سماع تلك القوارع البينة: الكِبْرُ والعنادُ ، والرسوخُ في الإلحاد.
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب :
الإيمان بالرسل والرسالات
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book94(1).pdf