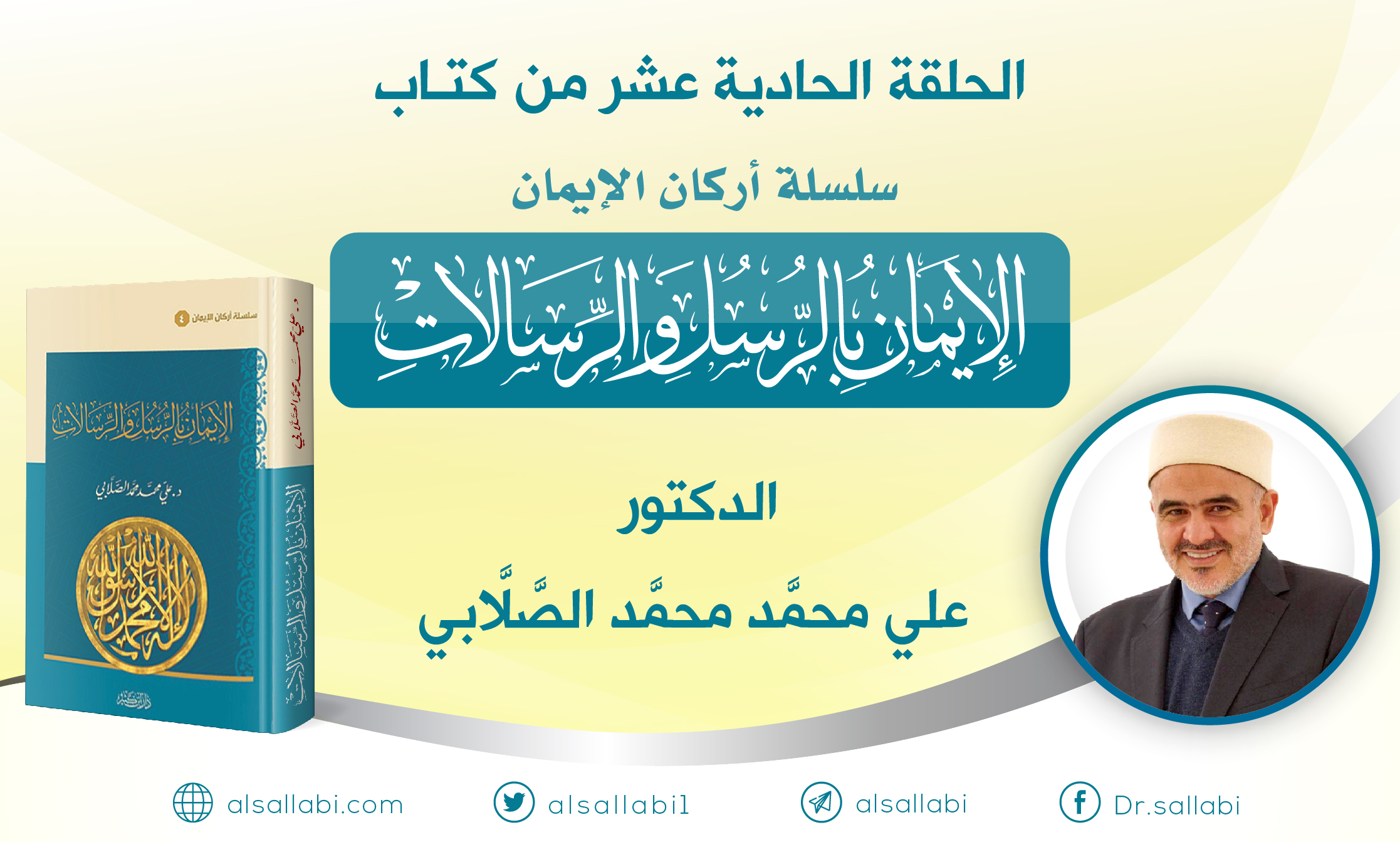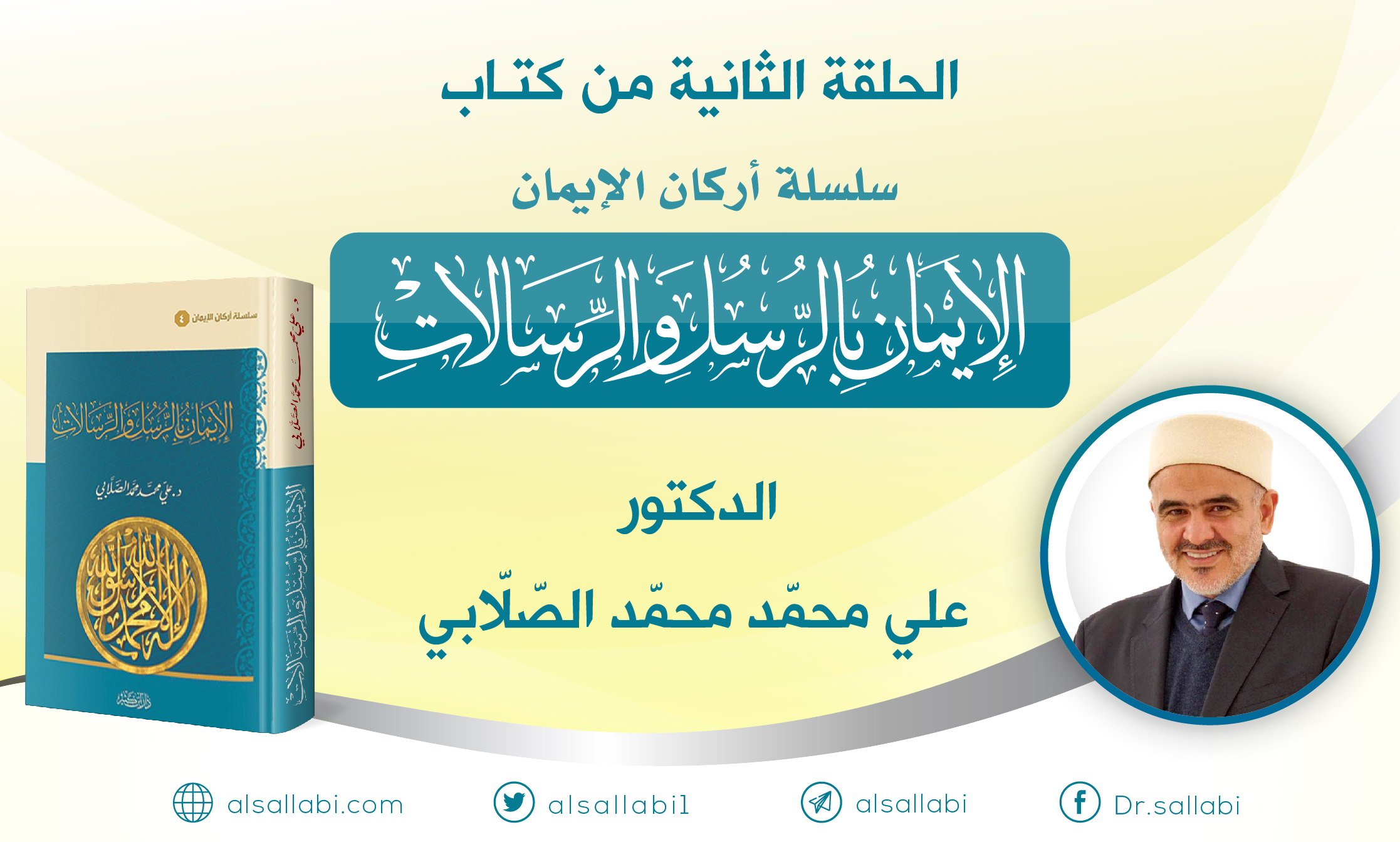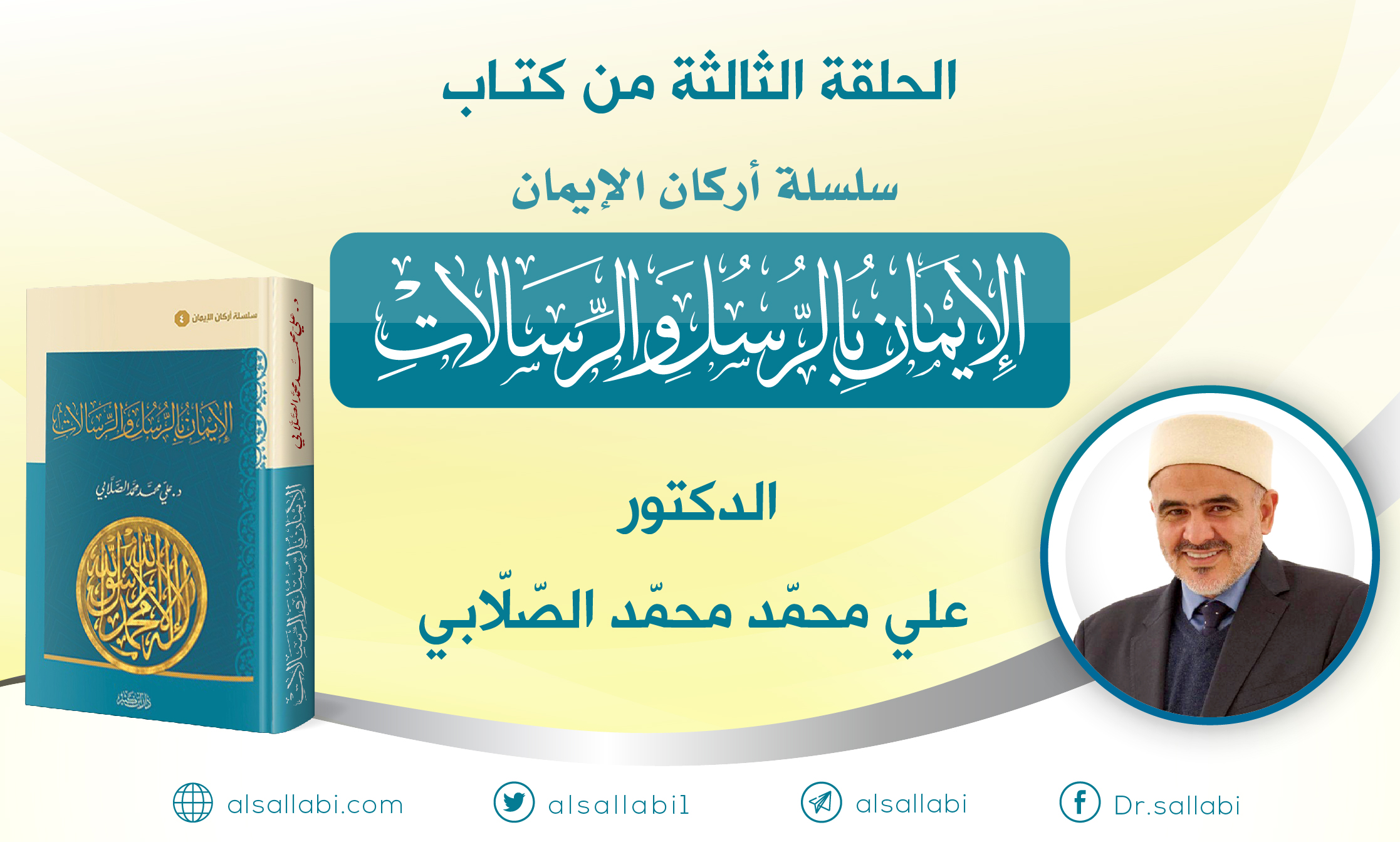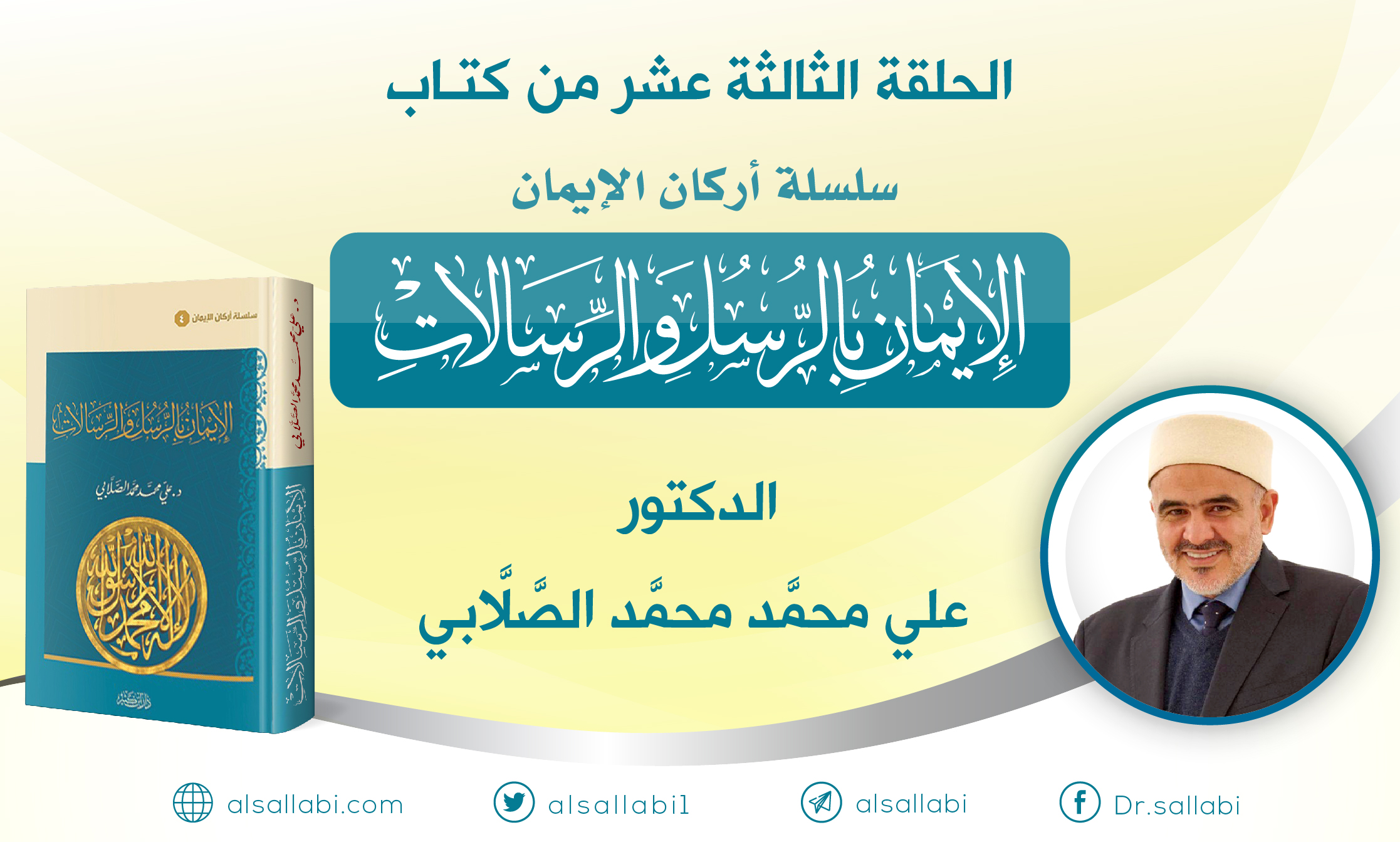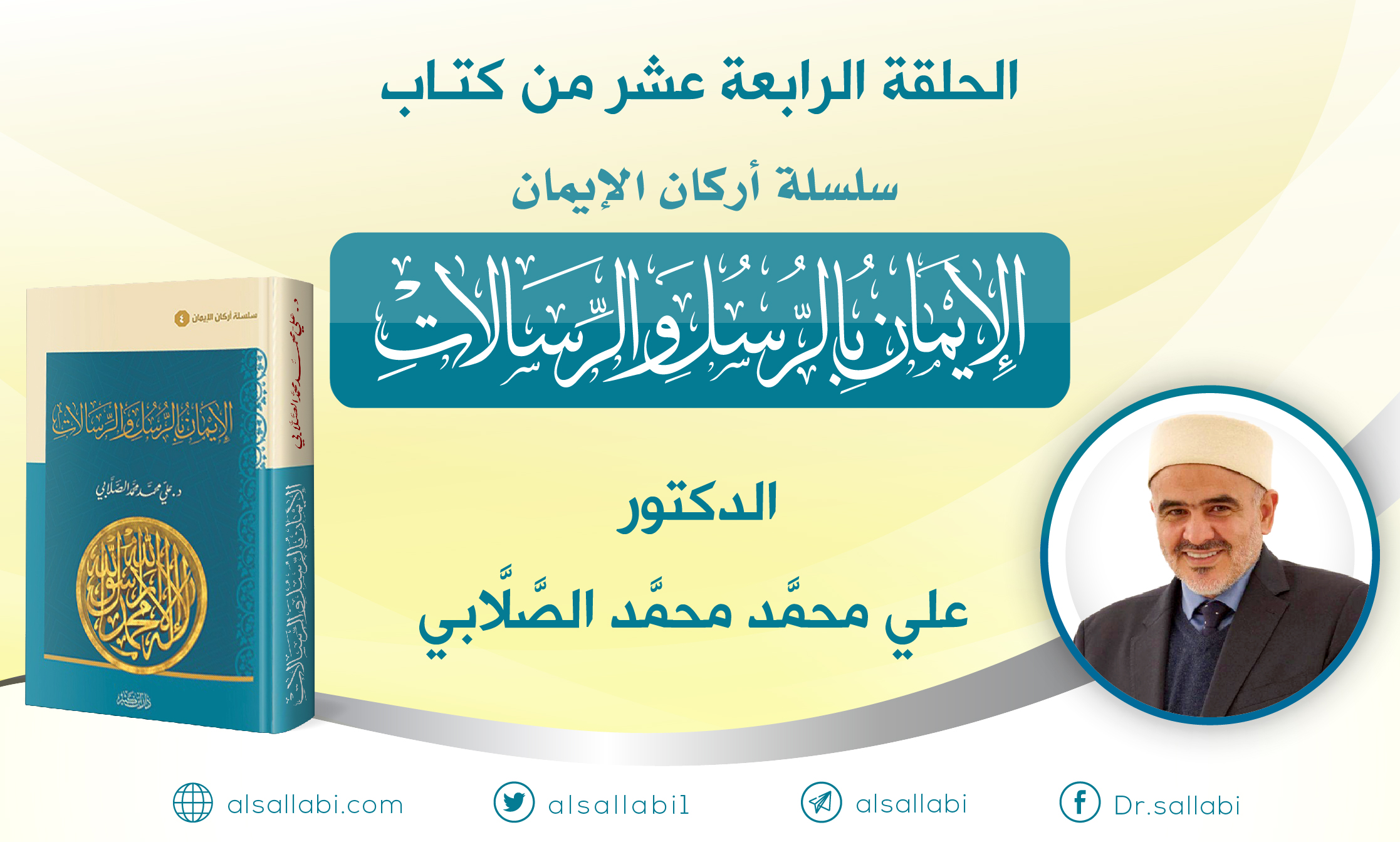من أهمّ صفات الأنبياء والمرسلين (3)
الحلقة: الحادية عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شوال 1441 ه/ يونيو 2020
1 ـ الأمانة:
وهي أن يكونَ النبيُّ أميناً على الوحي، يبلّغ أوامرَ الله ونواهيه إلى عباده، دونَ زيادةٍ أو نقصانٍ ، ودون تحريفٍ أو تبديلٍ ، امتثالاً لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا *} [الاحزاب: 39].
فالأنبياء جميعاً مُؤتَمَنونَ على الوحي ، يبلّغون أوامر الله كما نزلت عليهم ، لا يمكن لهم أن يخونوا أو يُخْفُوا ما أمرَهم الله تعالى به ، لأنّ الخيانة تتنافى مع الأمانة ، وهل يليقُ بالنبيِّ أن يخونَ أمانته ، فلا ينصحُ الأمة ، ولا يبلّغ رسالة الله؟!
ولذلك كان وصفُ الأمانة واجباً ، ويجب على الأمةِ اعتقاده فيهم ، وقد أثنى الله تعالى به عليهم في اياتٍ كثيرةٍ كما قال هود عليه السلام: {وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ *} [الاعراف: 68] ، وكما قال عن يوسف عليه السلام: {إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ *} [يوسف : 54] ، وقصَّ عن نوحٍ وهودٍ وصالحٍ ولوطٍ وشعيبٍ وموسى عليهم السلام مقالةَ كلٍّ منهم لقومه وهو يدعوهم للإيمان: {إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ *} [الشعراء: 107 ، 125 ، 143 ، 162 ، 168 ، والدخان: 18] ، وقصَّ مقالةَ ابنةِ شعيبٍ عليه السلام في وصفها لموسى عليه السلام: {يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ *} [القصص: 26] إلى غير ذلك من الايات الواصفة لهم بهذا الخلق ، دونَ سائر أوصافهم الحميدة ، فدل اختيارُ وصفِ الأمانةِ لأنبياءِ الله عليهم السلام في هذه الايات مع كثرة صفاتهم وأخلاقهم الكريمة على عظمة هذا الخُلق ، وبالغُ منزلته.
ولو لم تكن في الأنبياء الأمانةُ لتغيّرت مظاهِرُ الرسالة ، وتبدّلت ، ولما اطمأنّ الإنسانُ على الوحي المنزَل ، ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان محمّدٌ كاتماً شيئاً ممّا نزل عليه لكتم هذه الاية الكريمة: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}[الاحزاب : 37].
وقد نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة لا يعرف لهما بديلاً منذ نشأته وترعرعه ، وهو لا يكادُ يُعْرَفُ في أوساط قومه إلا بالأمين ، فيقولون: جاء الأمينُ ، وذهبَ الأمين، حتى حلّ محلّ الرضا في قلوبهم وعقولهم ، كما دلّ على ذلك احتكامُهم إليه في قصّةِ رفع الحجر الأسودِ عند بنائهم الكعبةَ المشرّفة ، بعد تنازعهم في استحقاق شرف رفعه ، ووضعه في محله ، حتى كادوا يقتتلون لولا اتفاقهم على تحكيم أولِ داخلٍ يدخلُ المسجدَ الحرام ، فكان ذلك الداخلُ هو محمّدٌ صلى الله عليه وسلم المرضيُّ لديهم أجمعين «فلما رأوه قالوا: هذا الأمينُ رضينا ، هذا محمد ، فلما انتهى إليهم ، وأخبروه الخبر ، قال صلى الله عليه وسلم: «هلمَّ إليَّ ثوباً» فأُتيَ به ، فأخذَ الركنَ ، فوضعه فيه بيده الطاهرة ، ثم قال: «لتأخذْ كلُّ قبيلةٍ بناحيةٍ من الثوبِ ، ثم ارفعوه جميعاً» ففعلوا ، حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه هو بيده ، ثمَ بنى عليه» قال ابن هشام: وكانت قريشٌ تسمِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أن ينزلَ عليه الوحيُ الأمين.
وهكذا كان خلق الأمانة سبباً لترشيح هذا الشاب اليتيم لحلِّ فتنةٍ كادت تشتعلُ بين بطون قريش ، فتُودي بحياة كثير منهم ، لولا أنَّ الحكمة العظيمة مِنْ صاحب الأمانةِ العظيمةِ أطفأتها ، وما كان لهذه الحكمة أن تبرزَ لو لم يكنْ خلقُ الأمانـةِ قد مهّد الطريقَ أمامها ، ممّا جعلهم يرضون بحكمه دون أن يتسرّبَ إليهم شكٌّ في محاباةٍ أو مداهنةِ فئة على أخرى ، لعلمهم بعظيم أمانته ، وثقتهم بـه.
بل لقد جعلتهم ثقتهم الكبيرة بأمانته صلى الله عليه وسلم ينقلون إلى بيته أموالهم ، ونفائسَ مدّخراتهم ، لتكونَ وديعةً عنده ، فلم يكن أحدٌ بمكةَ عنده شيءٌ يخشى عليه إلا وضعه عنده صلى الله عليه وسلم، لما يعلمُ من صدقه وأمانته ، ولم يزل ذلك دأبهم حتى بعد معاداته بسبب دعوته لهم إلى الإيمان بالله تعالى ، وترك عبادة الأوثان ، لا يختلجهم شك في أمانته ، وهم له معادون.
كما دل على ذلك تركه صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة بعد هجرته ، ليردَّ ودائعَ الناس التي كانت عنده للناس ، حتى إذا فرغَ منها ، لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
* الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة:
ولقد شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانةِ الأعداءُ والأصدقاءُ على حدٍّ سواء ، وذلك دليلٌ على شيوع هذا الخلق فيه ، وتسليمُ الكلِّ له به.
فأبو سفيان زعيمُ مكة لمّا كان قبلَ إسلامه أمامَ هرقل ملك الروم ، لم يستطعْ أن يخفي هذا الخلقَ العظيمَ ، وهو الحريصُ على أن يغمطه حقه ، أو يطعنَ فيه بدافع العداء له حينذاك ، ولكن لما سأله عمّ ماذا يأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم أجابه أبو سفيان: بأنه يأمرُ بالصلاة ، والصدقِ ، والعفافِ ، والوفاءِ بالعهد ، وأداءِ الأمانة.
وأما الأصدقاء ، فمنه ما قالته خديجةُ رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم عند ابتداء تنزُّل الوحي: ... فواللهِ إنكَ لتؤدّي الأمانةَ ، وتصلُ الرّحمَ ، وتَصْدُقُ الحديثَ.
وما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في قصته مع النجاشيِّ ملك الحبشة وذلك حين سأله عن الدين الذي اعتنقوه ، فكان من إجابته له قوله: «حتى بعثَ الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبَه وصِدْقَه وأمانتَه وعفافَه..».
ولا غَرْوَ في أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتلك المكانة من الأمانة ، لأن الله تعالى قد أراد منه أن يكونَ خاتم أنبيائه ورسله إلى الخلق كافة ، ولا يقومُ بذلك إلا أمينٌ كاملُ الأمانةِ ، ينالُ ثقةَ الناس ، فيستجيبون له ، ويؤمنون به ، ولقد تمثّل خلقُ الأمانة فيه صلى الله عليه وسلم بكل معانيه بعد بعثته ، كتمثله فيه قبل ذلك ، بل بأوضح من ذلك وأجلّ ، فلقد ائتمنه الله تعالى على تبليغ شرعه ، وسياسة خلقه ، فقام بذلك حقَّ قيام ، حتى رضي الله عنه وعن بلاغه المبين ، وشهد له بأنّه أدى الأمانة ، وبلَّغَ الرسالة كما وصلت إليه حتى تمَّ الدِّين ، وذلك حين قال سبحانه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}[المائدة: 3].
2 ـ السلامة من العيوب المنفرة أو ما يخل بأداء رسالتهم:
وهذه الصفة من خصائص الأنبياء والرسل الكرام ، فإنه لما كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستدعي مخالطةَ الناس ، والاجتماعَ بهم لدعوتهم وإرشادهم وقيادتهم وسياستهم ، فلا يمكنُ أن تكونَ فيهم عيوب خَلْقية أو خُلقية ، تنفّرُ الناسَ من الاجتماع بهم ، أو اتباعهم ، والسماع لدعوتهم ، كما أنّ الأمراضَ المنفِّرة كالبرص والجُذام والتشويه الجسدي لا يكونُ في أحدِ الأنبياء ، فهم وإن كانوا من البشر ، تصيبُهم العوارضُ التي تصيبُ البشر ، إلاّ أنّ الله عزّ وجلّ قد صانهم من العيوب المنفّرة ، وسلّمهم من الأمراض الشائنة ، التي تجعل النفوسَ تنفر منهم.
وما يحكى عن أيوب عليه السلام من أنّه مرضَ ، واشتدّ به المرض ، حتى تعفّنَ جسدُه ، وأصبح الدودُ يخرج من بدنه ، حتى كرهته زوجتُه ، فإنَّ هذا من الأباطيل والأكاذيب التي نُقلت عن الإسرائيليات ، ولا يجوزُ تصديقها أو الاعتقاد بها ، لأنها تتنافى مع صفاتِ الأنبياء ، ولم يذكر لنا القرانُ الكريمُ شيئاً من هذا ، وإنّما الذي ذكره أنه قد أصابه الضرُّ في بدنه ، فدعا ربَّه فكشف عنه ما أصابه من كرب وبلاء ، قال تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *} [الأنبياء: 83 ـ 84 ].
وظاهر من الاية الكريمة أنّ الضر الذي أصابه كان في جسمه وأهله ، وهذا النوع من الضرّ يلحَقُ البشر ، ويلحق الأنبياء ، فإنَّ المرض يعتري الأنبياء ، كما يعتريهم الموت ، وليس في ذلك شيءٌ ينقص من قدرهم ، أو يزري بمقامهم ، وكما يستحيل على الأنبياء الإصابة بالأمراض المنفّرة ، كما يستحيل عليهم الجنون والإغماء الطويل ، لأنّ ذلك يخلّ بقيامهم بأعمال الرسالة.
3 ـ العصمة:
* العصمة من الخطأ في التبليغ والتنفيذ:
الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله ، فهم لا يخطئون في التبليغ عن الله ، ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم ، عصمهم الله من الخطأ في هذه وتلك ، وذلك من خصوصياتهم:
أ ـ لأنّ الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن الله ، إذ ليس لذلك إلا إحدى نتيجتين ـ كلتاهما خارجة عن التصور ـ:
* إما أن يسكتَ الوحيُ عن تصحيح الخطأ ، ومعنى ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمراً معيناً ، ثم رضي جل جلاله أن يبلّغَ عنه غير ذلك الأمرَ ، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى.
* وإمّا أن يتنزلَ الوحي بالتصحيح، فيعودُ الرسولُ فيقول للناس: إنّ الله أمرني أن أبلّغكم كذا وكذا ، ولكني أخطأتُ في التبليغ ، وإليكم الان تصحيح البلاغ ، وينتجُ عن ذلك لا محالة أن يفقدَ الناسُ الثقةَ فيما يبلغهم إياه الرسول عن ربه ، لأنّ احتمالَ الخطأ في التبليغ قائمٌ في أذهانهم.
وكلا هذين الأمرين خارجٌ عن التصور، لأنّه يتنافى مع الحق الذي يتنزل به الوحي مع التوقير والتعظيم اللازمين لكلام الله سبحانه وتعالى ، مع وجوب الطاعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
ب ـ ولا يستقيمُ الأمرُ كذلك إذا أخطأ الرسولُ في تنفيذ ما أوحى الله به إليه ، لأنّ القدوةَ تنتفي يومئذٍ ، ويضطرِبُ الأمرُ في نفوس الأتباع ، الذين اتبعوا الرسلَ ، فلا يعرفون أيَّ طريق يسلكون ، وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم ، فالمفروض في الشخص المؤمن أن يجتهد في اتباع ما أنزل الله قدر جهده ، ليكون أقرب إلى الصواب ، فإذا كان القدوة أمامه ـ وهو الرسول ـ يخطأى في التنفيذ ، فسوف يحسُّ هو أنه في حِلّ من أن يخطأى ، وليس عليه أن يتحرّى الصوابَ ، فهو ليس أفضل من الرسول المؤيد بالوحي ، وعندئذٍ ينفرط عقد الأمر ، ولا يعود للدين ما أراده الله من تعظيم في نفوس المؤمنين.
إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد اصطفاهم الله واختارهم ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ *} [ال عمران: 33].
* العصمة من المعاصي:
ونزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [ال عمران: 161].
وحلاّهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والتفاني في الحق ، فاجتباهم ، وعلمهم: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *} [يوسف : 6].
فالأنبياء يتّسمون بالطهر والنزاهة والقداسة ، وهم النموذج الحي ، والصورة المثلى للكمال الإنساني ، ومن ثَمّ فهم معصومون عن الاثام ، ومنزّهون عن الوقوع في المعاصي ، فلا يرتكبون محرّماً ، ولا يقصّرون في أداء واجب ، ولا يتّصفون إلاّ بالأخلاق العظيمة ، التي يكونون بموجبها القدوةَ الحسنةَ والمثلَ الأعلى ، وقد زكّاهم الله سبحانه وتعالى ، وأدبهم وهذّبهم وعلّمهم ، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الانعام : 90]. وقال تعالى: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ *} [الانبياء : 90].
فيتَّضحُ من هذه الايات مدى الكمال الإنساني الذي أفاضه الله على أنبيائه ورسله ، ولو لم يكونوا كذلك ، لسقطت هيبتُهم في القلوب ، ولصغرَ شأنُهم في أعين الناس ، وبذلك تضيعُ الثقة فيهم ، فلا ينقادُ لهم أحدٌ ، ولذهبت الحكمةُ من إرسالهم ليكونوا قادةَ الخلقِ إلى الحقِّ.
* حقيقـة العصمـة:
العصمة في اللغة: المنعُ ، وورد في (لسان العرب): العصمةُ المنعُ ، وقال الزجّاج في
قوله تعالى: {قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ} [هود : 43]. أي يمنعني من الماء ، والمعنى: من تغريق الماء. واعتصم فلانٌ بالله إذا امتنع به ، واعتصمتُ بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية ، ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: {وَلَقَدْ رَاوَدْتَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ} [يوسف : 32].
أمّا في الاصطلاح: فهي لطفٌ من الله تعالى يحمِلُ النبيَّ على فعل الخير ، ويزجره عن الشر ، مع بقاءِ الاختيار ، تحقيقاً للابتلاء.
وقيل: هي حفظُ اللهِ أنبياءَه ورسلَه من النقائص ، وتحقيقهم بالكمالات النفسية ، والنصرة والثبات في الأمور ، وإنزال السكينة.
وقيل: هي ملكةٌ إلهية تمنعُ الإنسانَ من فعل المعصيةِ والميلِ إليها مع القدرةِ عليها.
وقد ذهبَ بعضُهم إلى أنها خاصيةٌ في نفس الشخص أو في بدنه ، يمتنعُ بسببها صدورُ الذنب عنه ، وممّا يضعّف هذا الرأي ويَدْحَضُه ، كما يقول الإيجي: إنه لو كان ذلك كذلك ، لما استحقَّ المدحَ بذلك ، وأيضاً فالإجماعُ على أنّهم مكلفون بترك الذنوب ، مثابون به ، ولو كان الذنبُ ممتنعاً عنهم ، لما كان كذلك ، وأيضاً قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [فصلت : 6]. يدل على مماثلتهم لسائر الناس فيما يرجِعُ إلى البشريةِ والامتيازِ بالوحي لا غير.
* العصمة ثابتة قبل البعثة وبعدها:
وقد اختلف العلماءُ في عصمة الأنبياء ، هل هي قبل البعثة أم بعدها؟ وهل تكونُ العصمةُ عن الكبائر فقط ، أم عن الكبائر والصغائر من الذنوب؟ فذهب بعضُهم إلى أنّ العصمة ثابتةٌ لهم قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر ، وذلك لأنّ السلوك الشخصيَّ ـ ولو قبل النبوة ـ يؤثّر على مستقبل الدعوة للنبي ، فلابدَّ إذاً أن يكونَ من ذوي السيرة العطرة ، والصفاء النفسي ، حتى لا يكونَ ثمة مطعنٌ في رسالته ودعوته ، واستدلّوا على ذلك بأنّ الله تبارك وتعالى قد اختار أنبياءه من صفوة البشر ، ورعاهم منذ الصغر كما قال تعالى لموسى عليه السلام: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي *} [طه : 39]. وجعلهم من المصطفين ، كما قال سبحانه: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ *} [ص : 47]. فلابدّ إذاً أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها ، لكن وقع الخلاف في وجوب العصمة لهم من الصغائر.
والبحث في هذه المسألة داخلٌ في الأمور الاجتهادية التي لم تنهضْ لها أدلةٌ قاطعة تقطعُ دابرَ الخلاف فيها ، وإن كان جمهورُ أهل السنة والجماعة يميلون إلى القول بامتناع الصغائر في حقّ الأنبياء خصوصاً بعد البعثة.
وأما الفريق الاخر فقد ذهب إلى أنَّ عصمة الأنبياء والرسل إنما تكون بعد النبوة ، وتكون في الصغائر والكبائر معاً ، لأنَّ المعاصي تكونُ بعد ورود الشرع والتكليف به ، ولأنَّ البشرَ ليسوا مأمورين باتباعهم قبل البعثة ، فالاتباع والاقتداء إنّما يكون بعد نزول الوحي عليهم ، وبعد تشريفهم بحمل الرسالة والأمانة ، وأمّا قبلها فإنّما هم كسائر البشر ، ومع ذلك فإنَّ سيرتهم تأبى عليهم الوقوعَ في المعاصي والاثام ، أو الانحراف في طريق الفاحشة والرذيلة ، فإنّهم ولو كانوا قبل البعثة غيرَ معصومين ، لكنّهم محفوظون بالعناية والفطرة.
والصحيحُ الذي عليه المعوَّلُ من أقوال العلماء: هو أنّ الأنبياءَ صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن المعاصي (الصغائر والكبائر) بعد النبوة باتفاق ، وأما قبل النبوة فيحتمل أن تقع منهم بعضُ المخالفات اليسيرة التي لا تخلُّ بالمروءة ، ولا تقدحُ بالكرامة والشرف.
استعظام بعض الباحثين نسبة صغائر الذنوب إلى الأنبياء: مدّعين بأنّ وقوع مثل هذه الذنوب فيه طعنٌ بالرسل والرسالات ، واحتجّوا لذلك بأمرين:
الأمر الأول: أنّ الله أمرَ باتباع الرسل ، والتأسي بهم ، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا *} [الاحزاب : 21]. وهذا يستلزِمُ أنّ اعتقادات الرسول وأفعاله وأقواله جميعاً طاعاتٌ لا محالة ،لأنّه لو جاز أن يقعَ من الرسول معصيةٌ لحصل تناقض ، ولاجتمعَ في هذه المعصية التي وقعت منه الأمر باتباعها وفعلها من حيثُ الأمر بالتأسي به ، والنهي عن اقترافها من حيث كونها معصية منهي عنها ، وهذا تناقض ، فلا يمكن أن يأمرَ الله عبداً بشيءٍ في حالٍ ينهاه عنه.
وقد تصدقُ هذه الدعوى لو بقيت معصيةُ الرسول خافيةً غير ظاهرةٍ ، بحيث تختلط علينا الطاعةُ بالمعصيةِ ، ولكن ممّا يقرره أهل السنة القائلون بوقوع الصغائر منهم: أنّ الرسل لا يُقرُّوْنَ على معصيةٍ أيّاً كانت ، ومن ثَمَّ فإنَّ الوحي ينبّههم إلى ما وقعَ منهم من صغائر الذنوب ، ويدفعهم إلى التوبة منها.
الأمر الثاني: من قال بعصمة الأنبياء من مثل هذه الذنوب ، توهم أنَّ الذنوبَ تنافي الكمال ، وأنَّها تكون نقصاً ، وإن تاب المذنبُ منها ، وهو غير صحيح ، فإنَّ التوبة تجبُّ ما قبلها ، والتائِبُ من الذنبِ كَمَنْ لا ذنبَ له ، ومِنْ ثَمَّ فإن صغائر الذنوب لا تنافي الكمال ، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم ، بل إنّ العبد في كثيرٍ من الأحيان يكون بعد توبته من معصيةٍ خيراً منه قبل وقوع المعصية ، وذلك لما يشعرُ به من الندم والخوف والخشية ، ولما يقبل عليه من الاستغفار والدعاء ، والعمل الصالح رجاء أن تمحو الحسناتُ السيئاتِ ، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *} [البقرة : 222]. وقال تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا *} [الفرقان : 70].
وأخيراً: فإنّ مثل هذه الصغائر لا تَنْتَقصُ من مكانة الرسل ، ولا تَقْدَحُ في عصمة الأنبياء ، بل هي أقربُ لتوكيد بشريتهم ، فهم بشرٌ عرضةٌ للخطأ في التصرّفات ، والاجتهاداتِ الشخصية ، ولكنّهم معصومون فيما يتعلّق بالوحي تلقيناً وتبليغاً ، وهذا يجعلهم أهلاً للقدوة والأسوة ، فلو أصبحوا نوعاً اخر من البشر لا تجري عليهم الهنات والهفوات البشرية ، لصعبتِ القدوةُ بهم ، وقال الناس: هؤلاءِ الرسلُ ليسوا مثلنا في أي شيءٍ فكيف نقتدي بهم؟.
ومعلوم أنّه لم يقعْ ذنبٌ من نبي ، إلا وسارع إلى التوبة والاستغفار ، يدلُّنا على هذا أنّ القران لم يذكر ذنوبَ الأنبياء إلا مقرونةً بالتوبة والاستغفار.
فادمُ وزوجُه عصيا فبادرا بالتوبة قائلين: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ *} [الاعراف : 23].
وما كادت ضربةُ موسى عليه السلام تُسْقِطُ القبطيَّ قتيلاً حتى سارع طالباً الغفران والرحمة: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص : 16].
وداود ما كاد يشعرُ بخطيئته حتى خرَّ راكعاً وأناب: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ *} [ص : 24]، وذلك حين حكمَ لأحدِ الخصمين قبل أن يستمعَ لقول الخصمِ الاخر ، قال تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ *إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ *إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ *قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ *} [ص : 21 ـ 24].
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب :
الإيمان بالرسل والرسالات
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book94(1).pdf