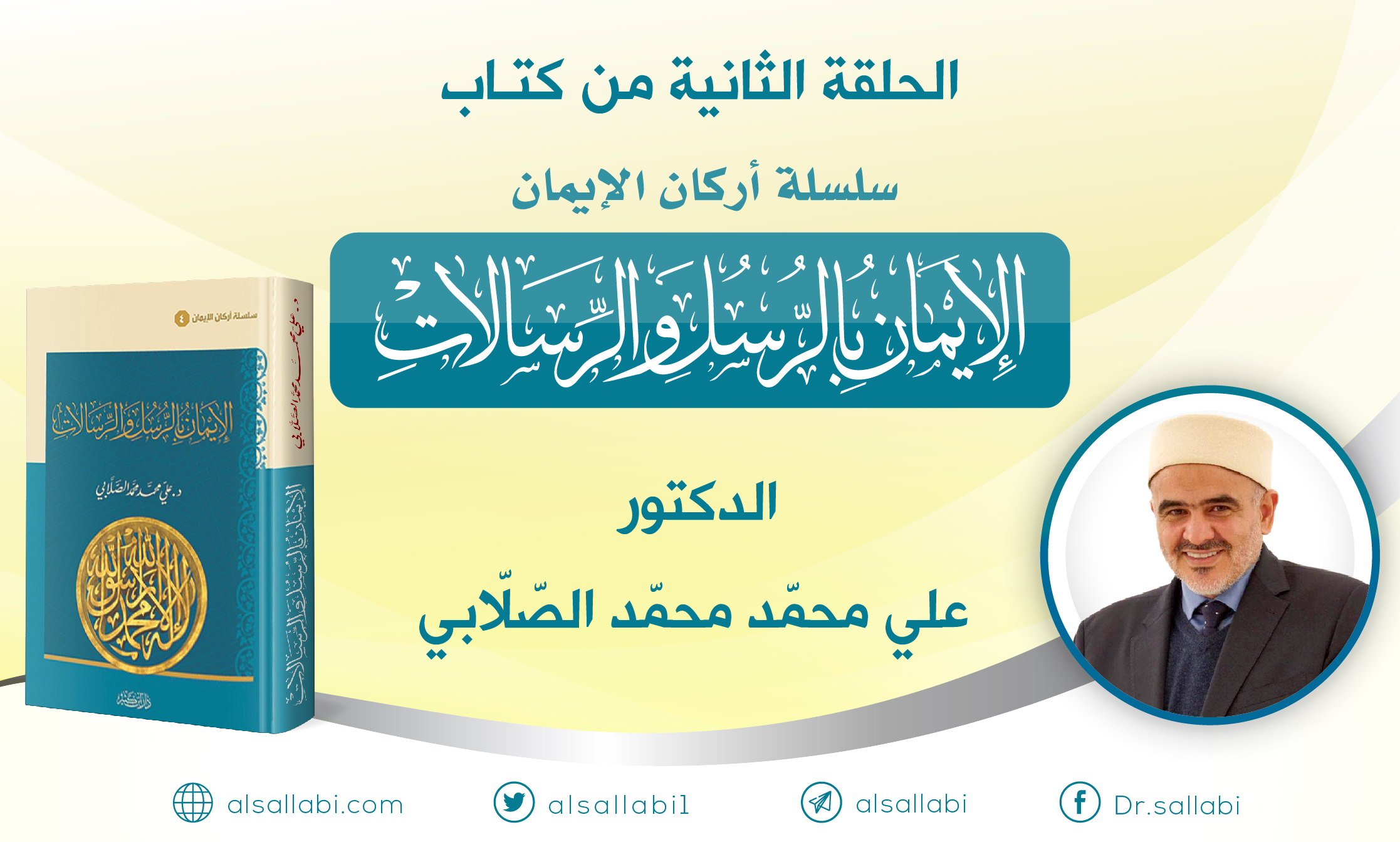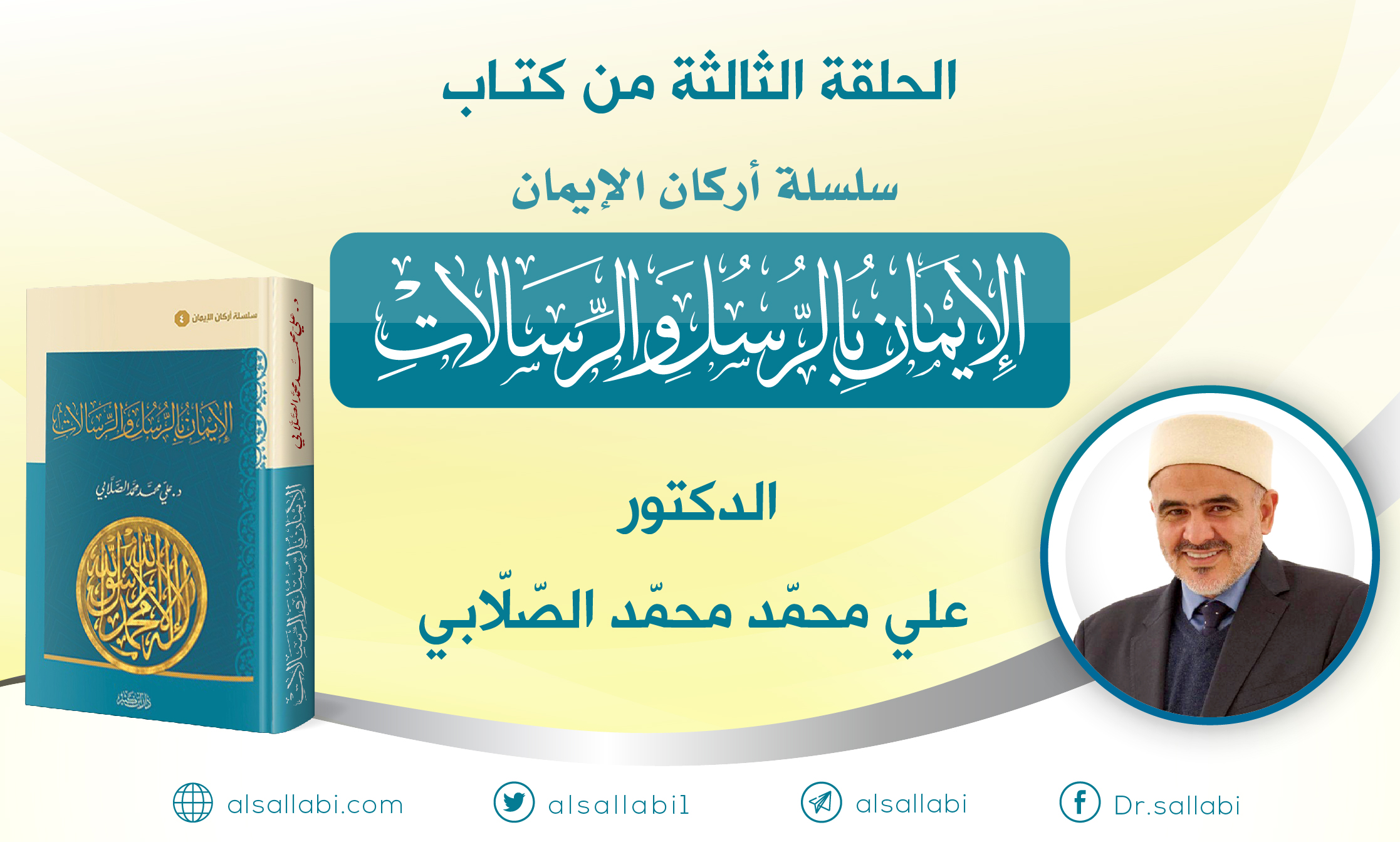مفهوم النبوة والرسالة والفرق بينهما
الحلقة: الأولى
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شوال 1441 ه/ يونيو 2020
أولاً ـ تعريف النبوة لغة وشرعاً:
أ ـ تعريف النبوة لغةً:
للنبوّةِ عند أهل اللغة ثلاثةُ استعمالات:
1 ـ حينما تكون مشتقةً من النبأ ، فتكون بمعنى الإخبار ، لأنّ النبأ معناه الخبر ، ومنه قوله تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ *عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ *} [النبأ: 1 ـ 2].
2 ـ حينما تُشْتَقُّ من النباوة ، أي الطريقُ الواضحة ، فتكونُ بمعنى الطريق الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل، وكل هذه المعاني موافقةٌ للمعنى الشرعي للنبوة.
ب ـ تعريف النبوة شرعاً:
هي أخبارُ رجُلٍ عن اللهِ عز وجل بما أُوْحِيَ إليه من ربّه ، وهي أيضاً رفعةٌ لصاحبها ، لما فيها من التكريم والتشريف ، فإن مقامَ النبوّة مقامٌ رفيعٌ ، لا يكون إلاّ لمن يقع عليه الاختيار من الله عز وجل بحمل أعباء الرسالة ، وإبلاغها للناس ، يقول الله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الانعام: 124] ، وقال تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص: 68].
كما أنها الطريق الواضحة الجلية ، الذي لا يمكن الوصول إلى مراضي الله ، واجتناب مساخطه؛ والفوز بجنته؛ والنجاة من ناره؛ إلا عن طريقه.
إلاّ أنّ أخصَّ تلك المعاني بالدلالة هو الاستعمال الأول ، لأنّ وظيفةَ النبي الرئيسة هي الإخبارُ عن اللهِ ، وإبلاغُ الأمةِ بما أُوحِيَ إليه من ربِّه.
ثانياً ـ تعريف الرسول لغة:
الرسول مأخوذٌ من الإرسال. أي البعثُ والتوجيه ، والرسول بمعنى الرسالة وهو الذي يتابِعُ أخبارَ الذي بعثه، ومنه قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ *} [النمل: 35].
وعلى ذلك فالرسل إنّما سُمّوا بذلك ، لأنّ الله أرسلهم وبعثهم بالرسالات إلى أممهم ، وكلّفهم بحملها وتبليغها ، قال عز وجل: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} [المؤمنون: 44].
ثالثاً ـ الفرق بين النبي والرسول:
ذهب بعضُ العلماء إلى التفريق بين النبيِّ والرسول ، وعرّفوا النبيَّ بأنَّه إنسانٌ أوحيَ إليه بشرعٍ سواءٌ أمر بتبليغه أم لم يؤمر ، والرسول هو إنسانٌ أوحي إليه بشرعٍ ، وأُمر بتبليغه للناس ، فالنبيُّ أعم من الرسول ، فمن نبأى وأُمر بتبليغ ما نبِّأى به إلى الناس فهو نبيٌّ ورسولٌ ، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبيٌّ غيرُ رسولٍ ، وعليه فكلُّ رسولٍ نبيٌّ ، وليس كلُّ نبيٍّ رسولٌ.
ويشهد لهذا التفريق ما ورد من الوصف بالمصطلحين وفيه إشعار بتغاير المفهومين في الاصطلاح الشرعي ، ومن ذلك قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا *} [مريم: 51].
ومثال النبيِّ غير الرسول (يوشع) صاحب موسى وفتاه ، فقد نبّأه الله ، وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل ، وهو الذي غزا بيتَ المقدس وفتحها.
ومثال النبيِّ الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ هو نبي الله ورسوله إلى الناس أجمعين ، وكذلك سائِرُ الأنبياء المرسلين إلى أقوامهم المذكورين في القران الكريم.
وذهبَ اخرون إلى أنَّ الكلمتين مترادفتان ، ولهما مدلولٌ واحد ، فالنبيُّ يسمّى رسولاً ، والرسول يسمى نبياً ، فيسمى رسولاً بالنظر إلى ما بينه وبين الناس الذين أرسله الله تعالى إليهم ، ويسمى نبيّاً بالنظر إلى ما بينه وبين الله ، حيث إنه نبي أوحي إليه ، وكلاهما متلازمان ، وقد ذهب إلى هذا الرأي القاضي عياض والسعد التفتازاني.
وذهب اخرون إلى رأي غير هذين الرأيين ، مفاده أن النبيَّ هو مَنْ أوحى الله إليه ، وهو يبلغ ما أوحي إليه ، لكنّه لم يرسل إلى قوم كافرين ، ليخرجهم من الكفر إلى الإيمان ، أمّا الرسول فهو مَنْ أرسل إلى قومٍ كفّارٍ يدعوهم للتوحيد ، فإن الله تعالى قال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِّيٍ} [الحج: 52]. فذكر أنَّ الإرسال يعمُّ الرسول والنبي ، وخصَّ أحدَهما بأنه رسول ، وهذا هو الرسول المطلق ، الذي أمر بتبليغ رسالة الله إلى قوم خالفوا أمر الله ، ووقعوا في الشرك ، كما كان شأنُ نوحٍ عليه السلام ، وقد ثبت في (الصحيح) أنّه أوّل رسولٍ بُعِثَ إلى الأرض ، وقد كان قبله أنبياء كادم وإدريس عليهم السلام.
وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِّيٍ} [الحج: 2] دليلٌ على أنَّ النبيَّ مرسلٌ ، ولا يسمّى رسولاً عند الإطلاق ، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنّه الحق ، كالعالم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العلماءُ ورثةُ الأنبياء». وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة ، فإنّ يوسفَ كان رسولاً ، وكان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولين ، وكانا على شريعة التوراة.
والتعريف المختار أنّ الرسول مَنْ أُوحي إليه بشرعٍ جديدٍ ، والنبيُّ هو المبعوثُ لتقرير شرعِ مَنْ قبلَه. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلّما مات نبي قام نبي ، كما ثبت في الحديث، وأنبياءُ بني إسرائيل مبعوثون بشريعة موسى (التوراة) ، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحيَ الله إليهم ، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإَِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا} [البقرة: 246].
فالنبيُّ كما يظهر من الاية يوحى إليه شيءٌ يوجِبُ على قومه أمراً ، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ ، واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى ، فهؤلاء جميعاً أنبياء ، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل ، والحكم بينهم ، وإبلاغهم الحق ، والله أعلم بالصواب.
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب "الإيمان بالرسل والرسالات" من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book94(1).pdf