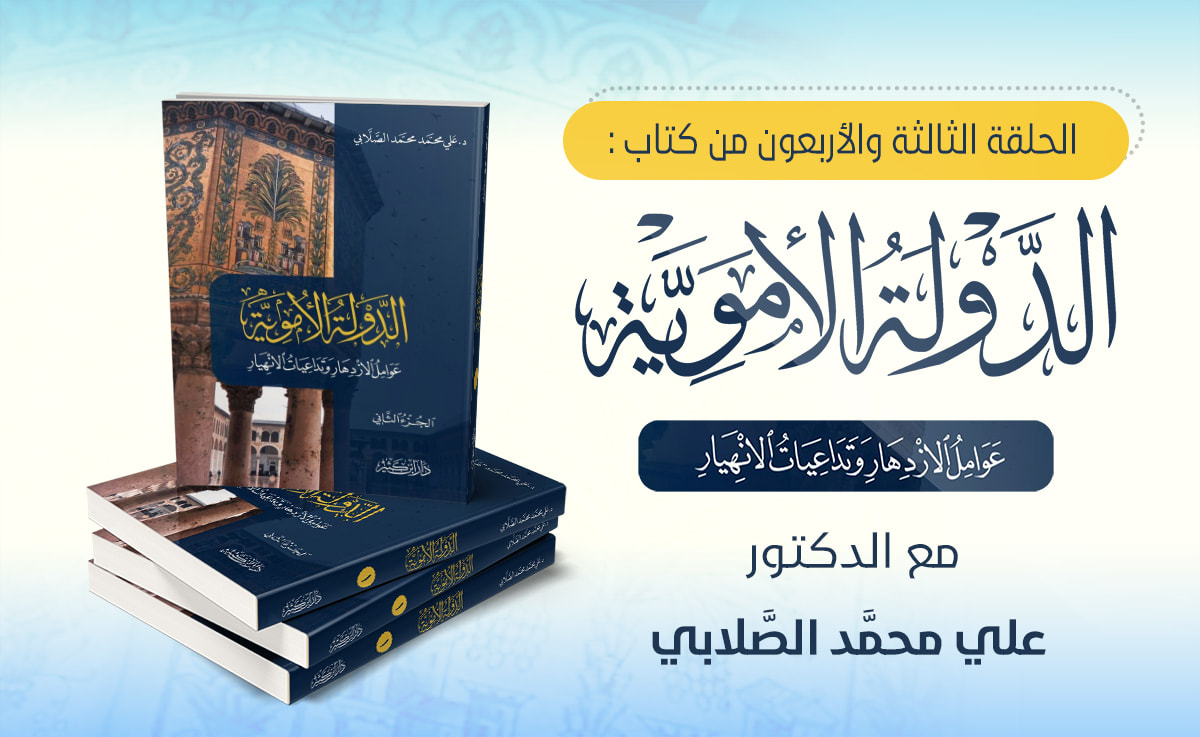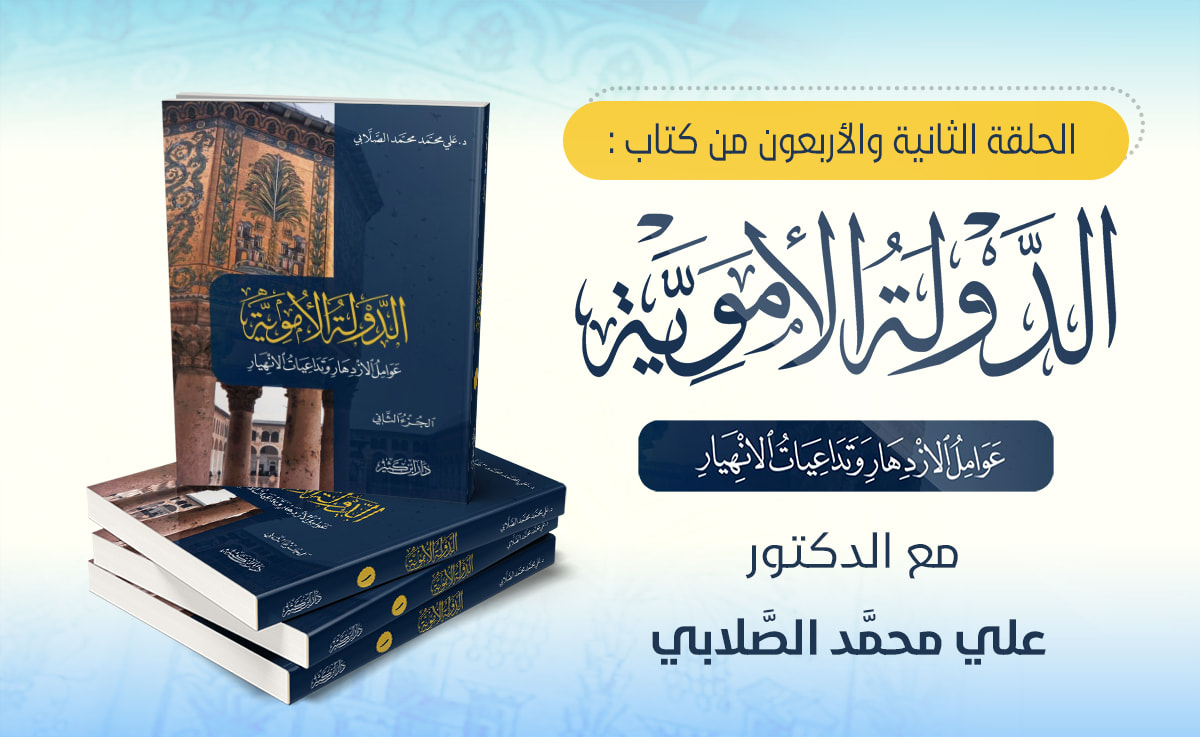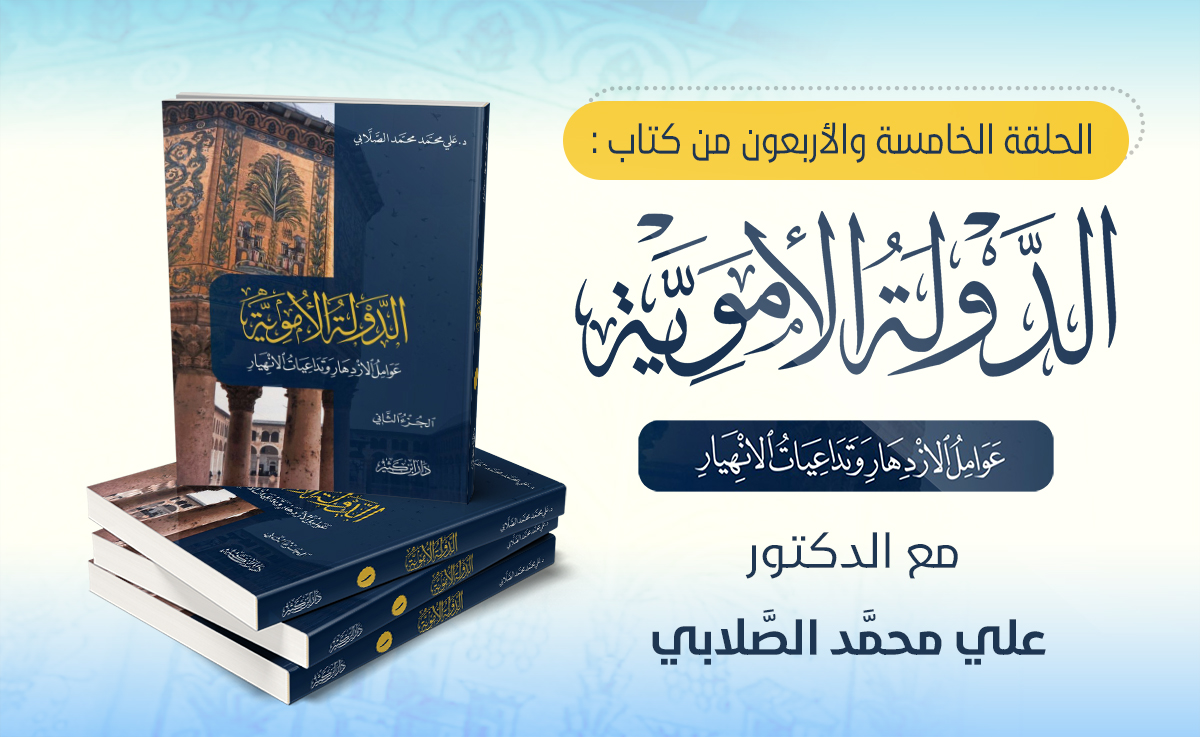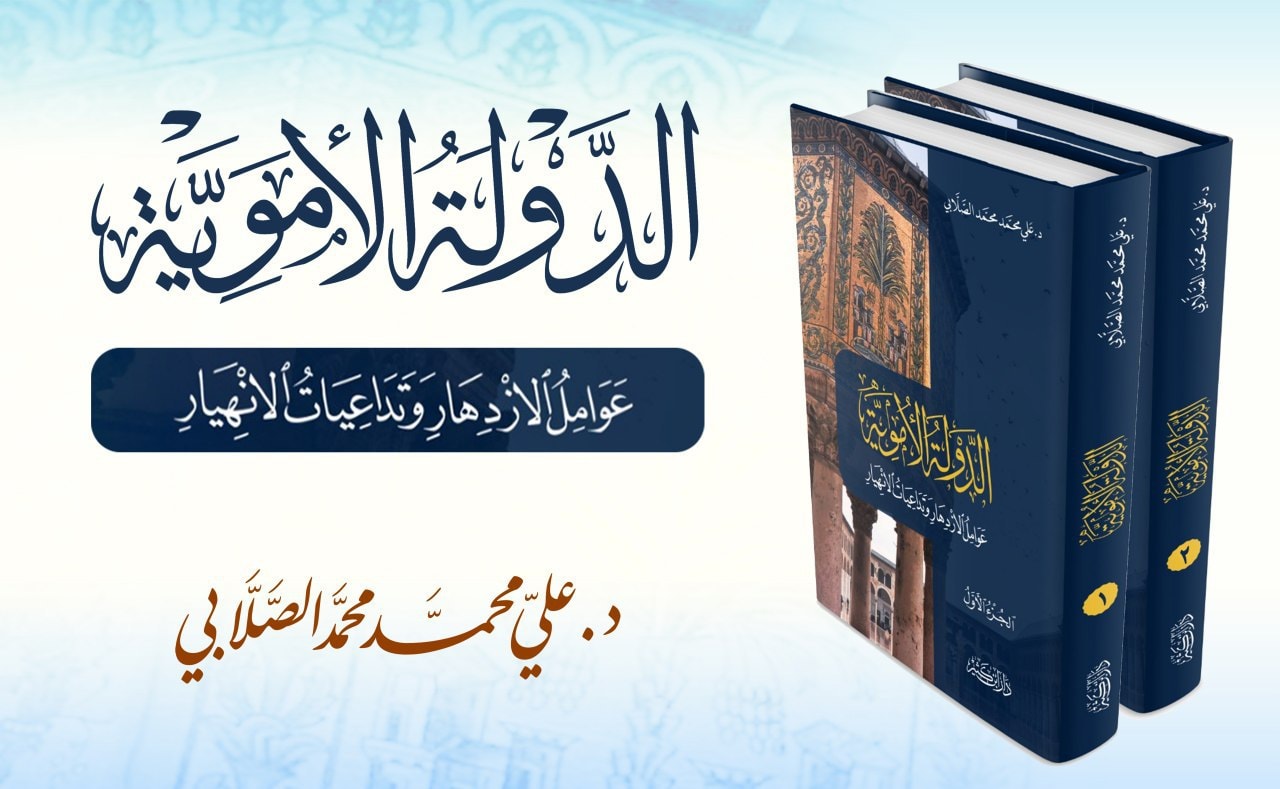من كتاب
الدولة الأموية: خلافة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)
الشرطة في عهد معاوية رضي الله عنه
الحلقة: الرابعة والأربعون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
شهد عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تطوراً كبيراً في نظام الشرطة من جهة نموها وترسخها كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة وبصورة لم تُعرف من قبل ، لقد أصبحت مؤسسة الشرطة مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع الأمصار الإسلامية ، لقد أصبحت أهم قوة أمن يعتمد عليها معاوية وولاته لتحقيق الأمن الشخصي من جهة ، وحفظ الأمن والنظام في الداخل من جهة أخرى ، يضاف إلى هذا كله أن أصبحت الشرطة المدافع الأول عن نظام الأمن الأموي وحمايته من اعتداءات الفرق الأخرى المعارضة له كالخوارج والشيعة وغيرهما؛ التي كانت تعمل على إسقاطه بشتى السبل ، وقد استعمل معاوية رضي الله عنه الشرطة كحرس خاص لحمايته شخصياً ، ودونما شك أن المحاولة الفاشلة التي قام بها الخوارج لاغتيال معاوية كان لها دور كبير في دفع معاوية لاتخاذ قراره بالاعتماد على الشرطة كحرس خاص لضمان عدم تكرار المحاولة ، وخصوصاً أن علياً وعمرو بن العاص قد تعرضا للمحاولة نفسها ، قُتل على أثرها أمير المؤمنين عليّ ، وكان ذلك عام 40هـ ، ومنذ ذلك الحين ومعاوية لا يخرج بدون حماية خاصة ، وحتى أوقات الصلوات كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه حماية له من الاعتداءات المحتملة من مناوئيه.
أولاً: الشرطة في العراق:
يعتبر المغيرة أول والٍ يعينه معاوية في الكوفة ، وقد استعان برجال الشرطة لغرض بسط الأمن ، وعين صاحب شرطة عُرف بشراسته وقسوته وكان يُدعى قبيصة بن دمّون ، ومن الحوادث التي تبين مدى فعالية شرطة في حفظ الأمن والنظام ما أورده الطبري حول صراع المغيرة مع الخوارج ، وذلك حين أخبره صاحب الشرطة باجتماعهم في الكوفة لإثارة القلاقل والاضطرابات ، فأصدر المغيرة أوامره إلى صاحب الشرطة لمحاصرة مكان الاجتماع ، وبعد أن ألقى القبض عليهم أودعهم السجن.
وفي البصرة ، عين معاوية عبد الله بن عامر والياً عليها ، ثم عزله في عام 54هـ وعين زياد بن أبيه والياً على البصرة. وقد تبين لزياد عند وصوله البصرة مدى التدهور الحاصل في الأمن ، فذكره وشدّد عليه في خطبه التي افتتح بها ولايته ، جرياً على العادة في ذلك الوقت ، فألقى خطبة طويلة سيأتي الحديث عنها بإذن الله ، بين فيها أسلوبه الذي سوف يتبعه في معالجة التدهور الأمني ، ومن قراءة تلك الخطبة تبين أن زياد كان مصمماً على إقامة الأمن والنظام بغض النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك الهدف ، ولو كانت بالعسف ، وخصوصاً حين يقول: وإني أقسم بالله لآخذنّ الولي بالولي ، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصحيح منكم بالسقيم ، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج يا سعد فقد هلك سعيد ، أو تستقيم لي قناتكم.
ويروي البلاذري كيف استتب الأمن في البصرة في عهد زياد ، وذلك في حادثة مفادها أن زياداً سمع جلباً وأصواتاً بين العامة ، فسأل عن السبب؛ فقيل له: إنّ فلاناً قد استأجر من يحمي له بيته ، وذلك نظراً لعدم وجود الشرطة ، وانتشار السُّراق، وفي اليوم التالي أمر زياد صاحب الشرطة بأن يقوم الشرطة بحراسة الطرقات بعد صلاة العشاء.
ويضيف البلاذري: أنّ الشرطة قد قتلت ما يقارب الخمسمئة نفر من لص ومنتهب للبيوت ، ويعتبر زياد أول من منع التجول، وذلك بمنع العامة من الخروج من منزلهم ليلاً، وكان يأمر صاحب شرطته بالخروج ، فيخرج ولا يرى إنساناً إلا قتله. فأخذ ليلة أعرابياً ، فأتى به زياداً فقال: هل سمعت النداء؟ ـ يقصد نداء منع التجاول ليلاً ـ قال: لا والله ، قدمت بحلوب لي وغشيني الليل فاضطررتها إلى موضع ، فأقمت لأصبح ، ولا علم لي بما كان من الأمير. قال: أظنك والله صادقاً ، ولكن في قتلك صلاح هذه الأمة ، ثم أمر به فضربت عنقه. ومثل هذا الفعل الظالم لا تقرّه الشريعة مهما كانت التبريرات.
وعلى ما يبدو أن قتل البدو لم يكن لمجرد الرغبة في القتل ذاته ، بل تمّ لإقناع أهل البصرة بجدية الوالي في تنفيذ أوامره ، وأن لا أحد ينجو من العقوبة إذا خرق القانون ، حتى لو كان بريئاً لا ذنب له ، كما سبق وهدّد في خطبته البتراء.
لقد كان الهدف النهائي عند زياد ، إقرار هيبة الدولة والحصول على طاعة العامة ، ولو عن طريق الإرهاب ، وبذلك تستقيم الأمور في البصرة حيث ترى العامة أن الأمر لا هزل فيه ولا هوان في تطبيق العقاب.
ولم يكن خافياً على زياد بن أبيه ضرورة إعادة تنظيم جهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق سيطرة فعالة على الأوضاع الأمنية ، لذلك عمل زياد على اتخاذ بعض الإجراءات التي تسمح له بفرض هيمنته ، منها: زيادة عدد الأفراد العاملين في الشرطة ، فصعّد عددهم حتى وصل أربعة الاف فرد ، وعين اثنين في منصب صاحب الشرطة بدلاً من واحد.
إن ارتفاع عدد رجال الشرطة إلى أربعة آلاف يدل على أمرين:
أولهما: شدة الاضطراب الداخلي.
الثاني: أن الشرطة كانت ترفد الجيش في كثير من الأحيان.
وبلغ من دقته في عهده أنه قال: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه ، وترتب على ذلك ما قاله الطبري: ... وكان زياد أول من شد أمر السلطان ، وأكد الملك لمعاوية ، وألزم الناس الطاعة ، وتقدم في العقوبة، وجرد السيف ، وأخذ بالظنَّة ، وعاقب على الشبهة وخافه الناس في سلطانه ، خوفاً شديداً ، حتى أمن الناس بعضهم بعضاً ، حتى كان الشيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه ، وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها ، وساس الناس سياسة لم ير مثلها ، وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله ، وأدرّ العطاء، وبنى مدينة الرزق ، وعندها ضمّ معاوية الكوفة إلى ولاية زياد ، واستطاع أن يفرض النظام الأمني حيث حقق للأمويين رغبتهم في استقرار النظام والأمن في كل من البصرة والكوفة ، وحيث أصبحت الشرطة أهم قوة داخلية وأكثرها فاعلية.
ثانياً: الشرطة في الأقاليم الأخرى:
عند مقارنة مثلاً مصر بغيرها من الأمصار الإسلامية كالبصرة مثلاً ، نجد أن الشرطة لم تلعب الدور نفسه؛ وذلك لبعد مصر عن الاضطرابات التي يحدثها عادة الخوارج ، وكذلك تذكر المصادر في العادة حرص الولاة عند اختيار صاحب الشرطة ، وقد عين مروان بن الحكم والي المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في منصبي صاحب الشرطة والقضاء في آن واحد ـ كما مرّ معنا ـ وكان ذلك في عهد معاوية. ويروي ابن سعد أن مصعباً كان شديداً على المذنبين والخارجين على القانون ، وقد طلب مصعب من الوالي مروان بن الحكم أن يزوده بعدد كبير من أفراد الشرطة ، إذا كان يريد الحفاظ على الأمن في المدينة ، حيث لم يكن عدد الشرطة المتوفر كافياً لهذه المهمة ، وأجابه مروان إلى طلبه وأرسل إليه مئتي شرطي ، وظل مصعب في منصب صاحب الشرطة حتى وفاة معاوية.
ثالثاً: واجبات الشرطة:
كان للشرطة في الدولة الأموية مكانة مميزة بسبب الواجبات المهمة التي كانت تقوم بها هذه المؤسسة تجاه السلطة والمجتمع؛ ومن هذه الواجبات:
1 ـ حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم في الداخل:
أول من استخدم الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتيال الخليفة معاوية مؤسس الدولة الأموية ، الذي خاض صراعاً (سياسياً ـ عسكرياً) عنيفاً مع معارضيه من الخوارج وغيرهم ، وكان الشرطة يحرسون معاوية بشكل دائم في حله وترحاله ، بل حتى وقت الصلاة كان هناك حارس يقف عند رأسه وهو يصلي في المحراب ، وعلى ما يبدو أن الخليفة كان يسير بين يديه صاحب الشرطة متقلداً كامل سلاحه ، وكذلك تقوم الشرطة بتوفير الحماية للولاة في الأمصار المختلفة ، بالطريقة السابقة نفسها ، وكما ذُكر سابقاً أن زياد بن أبيه كان يستخدم الشرطة لأمنه الشخصي ، وكان صاحب الشرطة هو المسؤول الأول عن سلامة الوالي.
إن ظهور صاحب الشرطة في مقدمة موكب الخليفة أو الوالي في الأماكن العامة ليس دليلاً فقط على الحماية ، بل لإشعار العامة أيضاً بالهيمنة والسلطة ، إلى جانب ذلك كانت الشرطة أداة بيد الخليفة والولاة لفرض سلطة الدولة على الذين يحاولون التمرد عليها أو معارضتها ، وكانت تعين الخليفة على جمع المعلومات ، فقد كان معاوية رضي الله عنه قد بلغ من اهتمامه في الحصول على أخبار عماله ورعيته أن بثَّ عيونه في كل قطر وكل ناحية ، فكانت تصله الأخبار أولاً بأول ، فانتظم له أمره ، وطالت في الملك مدته ، وحذا زياد بن أبيه حذو معاوية ، ومما يحكى عنه: أن رجلاً كلمه في حاجة له ، فتعرف عليه وهو يظنّ أنّه لا يعرفه فقال: أصلح الله الأمير أنا فلان بن فلان. فتبسم زياد وقال: أتتعرّف إليّ وأنا أعرف منك بنفسك ، والله إني لأعرفك وأعرف أباك وأمك وجدك وجدتك ، وأعرف هذا البُرد الذي عليك وهو لفلان.. فبُهت الرجل وأرعد حتى كاد يغشى عليه.
2 ـ معاقبة المذنبين والخارجين على القانون:
الشرطة بحكم كونها القوة الرئيسة المسؤولة عن حفظ الأمن ، والنظام داخل المدن ، إضافة إلى واجبها في فرض القانون ، ولكن الأحوال الاجتماعية في المدن الكبرى كانت تدفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه العامة ، وقد بين زياد بن أبيه في خطبته البتراء خطورة التجاوزات التي حدثت من الناس؛ فقال: ... من بُيّت منكم فأنا ضامن لما ذهب له ، إياي ودلج الليل ، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه ، ... وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن ، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ، فمن غرّق قوماً ، غرقناه ، ومن حرّق على قوم حرقناه ، ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه، ومن نبش قبراً دفنته فيه حياً...
من هذه الخطبة يتبين مدى التدهور الحاصل في البصرة ، من خلال طبيعة الجرائم التي كان يرتكبها بعض المنحرفين من أهلها قبل قدوم زياد ، وحين انتهى من خطبته أمر صاحب الشرطة بحراسة الطرقات وقتل كل من يوجد خارج منزله ليلاً. ويروي البلاذري أن زياداً لم يتردد في تنفيذ ما توعّد به حرفياً.
3 ـ تنفيذ العقوبات الشرعية:
من الواجبات التي كانت الشرطة تقوم بها: تنفيذ الحدود الشرعية ، التي يأمر بها القضاة ، ضد كل من يظهر منه فساد في المجتمع الإسلامي ، والحدود الشرعية ـ كما هو معروف ـ مذكورة في القرآن الكريم، والسنة النبوية بينت ذلك، وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم لديهم غيرة وحرص على أوامر الدين وتنفيذها ، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك: أنّ عبداً سرق وديّاً فوجدوه ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه ، فسأله عن ذلك ، فأخبره: أنّه سمع رسول الله يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» ، فقال الرجل: فإنَّ مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي وهو يريد قطع يده ، وأنا أحبّ أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم ، فقال: أخذت غلاماً لهذا ؟ فقال: نعم ، فقال: ما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده ، فقال له رافع: سمعت رسول الله يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» ، فأمر مروان بالعبد فأرسل.
ويستفاد من هذه اللمحة كذلك احترام الولاة والعمال للصحابة الكرام ، وعدم التعرّض لتصرّفاتهم ما دامت منبثقة من الحرص على تنفيذ أمر الله ورسوله ، حتى وإن كانت داخلة ضمن مهام الوالي، ومن مظاهر الغيرة على أوامر الدين وتغليب أمر الله على ما سواه: امتناع والي شرطة المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما من هدم دور بني هاشم ، ومن كان في حيّزهم ، ودور بني أسد بن عبد العزّى ، والشدّة عليهم ، وذلك لموالاتهم الحسين بن علي وابن الزبير ، وامتناعهم عن بيعة يزيد ، إذ قال مصعب لأمير المدينة عمرو بن سعيد: أيها الأمير إنّه لا ذنب لهؤلاء ولست أفعل ، فقال له الأمير: انتفخ سحرك يا بن أم حريث ، إليّ سيفنا ، فرمى إليه بالسيف وخرج عنه. وهذا الفعل يدل على قوة إيمان مصعب ، وأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومن واجبات الشرطة: مساعدة الجيش ضد أعداء الدولة، وتنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب للمناوئين السياسيين وكل ما يتصل بالسجناء عند صاحب السجن ، وإن كانت الواجبات الأخيرة تتضح ملامحها في عهد الخلفاء الذين بعد معاوية أكثر.
رابعاً: قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة:
تعتبر الشرطة العمود الفقري للجهاز الأمني في الدولة الأموية ، وكانت المهمة الرئيسة لهم: حفظ الأمن الداخلي بالدرجة الأولى ، ومع ذلك عرف العصر الأموي مؤسسات أخرى لعبت دوراً مشابهاً ومكملاً للشرطة؛ وهذه المؤسسات هي:
1 ـ الحرس:
استخدمت كلمة حرس في بدايات العصر الأموي لوصف كل من يقوم بمهمة الحراسة بغض النظر عن المكان أو الشخص الذي يحرسه ، وفي العصر الأموي كان الحرس يمثلون تلك الفئة التي تقوم بمهمة حماية الخلفاء والولاة ، وعلى ما يظهر أن معاوية كان أول خلفاء بني أمية يتخذ الحرس لحمايته الشخصية من احتمال الاعتداء عليه من قبل الخوارج وغيرهم ، وفي خلافة معاوية استخدم الولاة الحرس ، كقوة أمنية داخلية إلى جانب الشرطة ، وقد استخدم زياد بن أبيه خمسمئة رجل في قوات الحرس الخاصة به ، وعين عليهم رجلاً من بني سعد أطلق عليه صاحب الحرس ، ومنذ ذلك الحين وخلفاء بني أمية يعينون من يثقون به.
وخلاصة القول: إن مفهوم الشرطة يتسع إلى الدرجة التي يضم فيها نشاط الحرس تحت سلطته ، في حين أن الحرس لا يدخلون ضمن الشرطة ، ويورد الجاحظ شطر بيت من الشعر: كأنه شرطي بات في حرس؛ للدلالة على التفرقة بين المؤسستين.
2 ـ الحرس من غير العرب:
عرف العرب ، قبل قيام الدولة الأموية ، بعض الألفاظ الأجنبية التي تطلق على الحرس الذين كانوا يحرسون بيت المال في البصرة. وهذه الألفاظ هي: الأساورة والسيابجة والزطّ ، ويشرح البلاذري هذه الألفاظ فيقول: إنّ الأساورة من الفرس ، أما السيابجة والزطّ فينحدرون على ما يظهر من الهند.
ويتضح من تاريخ الخلافة الأموية أن الولاة كانوا يستخدمونهم لضرب الثورات التي تقوم بها المعارضة ، بين حين وآخر ، وكان يُطلق على هذه العناصر لفظ: البخارية، تبعاً لرواية البلاذري أيضاً: أن والي خراسان عبيد الله بن زياد ، أسر في إحدى المعارك عدداً كبيراً من أهل بخارى ، وجعل من البصرة مستقراً لهم ، وأجرى لهم من الأعطيات ما كان يدفعه نفسه للقبائل العربية ، وذلك حين أصبح والياً على العراق. وقد استخدم عبيد الله هذه القوة الجديدة لمساندة قوة الشرطة للقضاء على ثورة الخوارج في العراق.
وأما ابن سعد ، فيذكر: أن البخارية قد استعملوا أول الأمر كقوة أمنية ، على يد والد عبيد الله حين كان والياً على العراق ، ويضيف ابن سعد: أن زياداً استخدم البخارية لمساعدة الشرطة في محاولتهم للقبض على حجر بن عدي رضي الله عنه.
ويشيد البلاذري بمهارة البخارية في الرمي بالقوس ، ويظهر من مراجعة المصادر التاريخية أن استعمال هذه الفرقة كقوة بشرية لم يكن مقتصراً على الولاة ، بل وجد أنهم كانوا يقومون بخدمة الأشراف ، ففي مدينة البصرة مثلاً ، كان أبناء عبد الله بن عامر والي العراق في السابق ، يستخدمون البخارية كحرس خاص لحمايتهم الشخصية.
3 ـ العرفاء:
ونظراً لما يتمتع به العرفاء من مكانة لدى الولاة؛ فإن بعضهم يستطيع من الأمور ما لا يقدر عليه غيره ، ونظراً لكون العريف مسؤولاً عن مراقبة العامة وتبليغ السلطات عن الحركات المشبوهة، أو عن الأفراد الذين يُشك في ولائهم للسلطة... ولذلك لم يكن لهذا المنصب شعبية ، إلاّ أن ذلك لم يمنع كبار القوم من توليه ، إذ يورد ابن سعد في طبقاته أسماء كثيرة تولت مهام هذا المنصب.
4 ـ صاحب الاستخراج أو العذاب:
شهد العهد الأموي قيام جهة خاصة مهمتها استخراج الأموال من الذين يختلسونها بحكم مناصبهم الرسمية ، وكان يطلق على الشخص المكلف بمهمة تعذيب المختلسين لكي يقروا بمكان وجودها ، لقب (صاحب الاستخراج) ، ويروي ابن قتيبة أن هذه المهنة ظهرت في عهد زياد بن أبيه ، الذي كان دائم التحذير لمن يعينهم لمساعدته في الإدارة ، وكان لا يتردد في إعفائهم من مناصبهم إذا ظهرت منهم خيانة ، ويكون العزل بعد إيقاع العقوبة بهم، ويورد كثير من المؤرخين حوادث تتصل بالولاة الذين استخدموا صاحب الاستخراج لاسترداد الأموال المختلسة من المختلسين ، أو ممن ظهرت عليهم أمارات الخيانة أو ما شابه ذلك من أمور؛ من ذلك أن والي العراق عبيد الله بن زياد عزل من مساعديه رجلاً يدعى عبد الرحمن ، واستخلص منه مئتي ألف درهم ، كما استخلص مبلغ مئة ألف درهم اختلسها أحد العاملين في إدارته.
5 ـ جهاز الحسبة:
والمقصود هنا بالحسبة: المعنى الضيق ، أي: عملية الإشراف على تنظيم الأسواق والعمليات التجارية فيها ، وقد كان من مهام المحتسب في الدولة الأموية جباية ضرائب المبيعات وتحصيل أجرة الدكاكين التابعة للدولة ، إضافة إلى مسؤوليات السوق والتي من أبرزها:
أ ـ التأكد من دقة الأوزان ، والمكاييل ، والمقاييس المستعملة في عمليات السوق ، منعاً لحدوث غبن في التعامل.
ب ـ التفقد المفاجئ لعيار الحبات ، والمثاقيل؛ لضمان عدم الإخلال بها.
جـ منع الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية.
د ـ منع حالات الاحتكار إن وجدت ، وإجبار المحتكر على بيع ما احتكره.
ووفق هذا المفهوم نجد أن الحياة الاقتصادية في بداية الدولة الأموية كانت بسيطة ، وعليه فقد سار ولاة الأقاليم على نهج الخلافة الراشدة؛ فكان الولاة ـ كل في إقليمه ـ يباشر الحسبة بنفسه.
لكن هذا لم يمنع من ظهور وظيفة العامل على السوق في مدينة البصرة في عهد ولاية زياد بن أبيه (45 ـ 53 هـ).
ويمكن القول ـ من خلال التتبع ـ بأن نظام الحسبة كان موجوداً منذ بداية العصر الأموي ، وإن لم يكن يحمل لفظ الحسبة ، إنما دور المحتسب في تنظيم السوق كان متواجداً طوال العصر الأموي ، وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع التجارة ، والأسواق ، فيلاحظ أنه في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه أعمال الحسبة ، ثم تطور الأمر لأن يكون هناك شخص معين وظيفته الأشراف على السوق ، ثم تطور الأمر ليكون لهذا المعين أعوان يعينونه في عمله.
6 ـ نظام المراقبة:
ظهر هذا النظام في دمشق في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، في عدة صور:
أ ـ إلزام بعض مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة في الجماعة في مساجد معينة. ويشبه هذا الإجراء ما هو معمول به في بعض الدول المعاصرة من إلزام المشبوهين بالتردد على مراكز الشرطة في أوقات محددة.
ب ـ إسكان بعض مناوئيه في مساكن خاصة أعدّها لهم في دمشق وغيرها؛ لتسهل عليه مراقبتهم.
جـ إحكام المراقبة الشخصية على الأجانب الذين يدخلون دار الإسلام.
7 ـ مؤسسة الدرك:
والدرك في الاصطلاح: مؤسسة تضم قوى الدولة العاملة في سبيل الأمن خارج حدود المدن الكبيرة، وفي الطبري نص يفيد اهتمام زياد عام 45 هـ أي أيام معاوية ـ بالسُّبل ـ أي الطرق ـ جاء فيه: قيل لزياد: إن السبل مخوفة. فقال: لا أعاني شيئاً سوى المصر ، حتى أغلب على المصر وأصلحه ، فإن غلبني المصر ، فغيره أشد غلبة ، فلما ضبط المصر تكفل ما سوى ذلك ، فأحكمه. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه. وهذا لا يكون إلا إذا كان رجاله متمكنين من الطرق والسبل. وقد طرح زياد نظرية أمنية مفادها التمكن أولاً من داخل الأمصار ، ثم التوسع لما حولها من طرق وسبل. هذه بعض الملامح والمعالم الكبيرة عن نظام الشرطة في عهد معاوية رضي الله عنه.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf