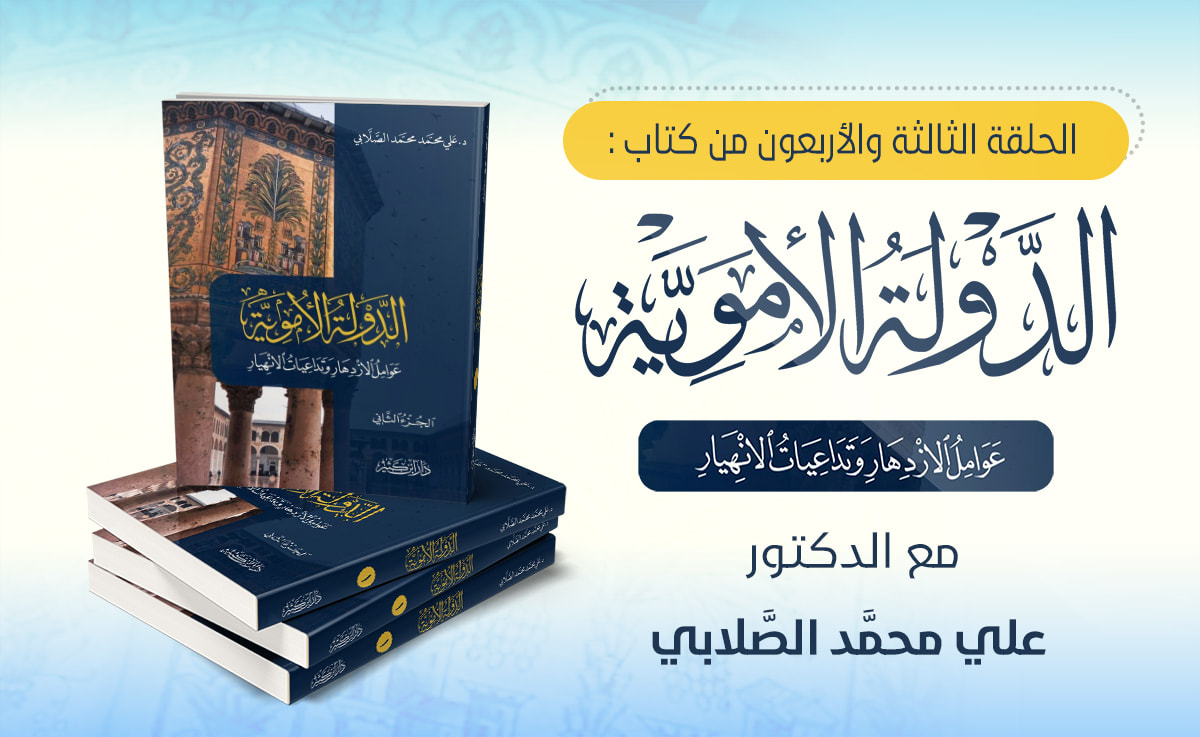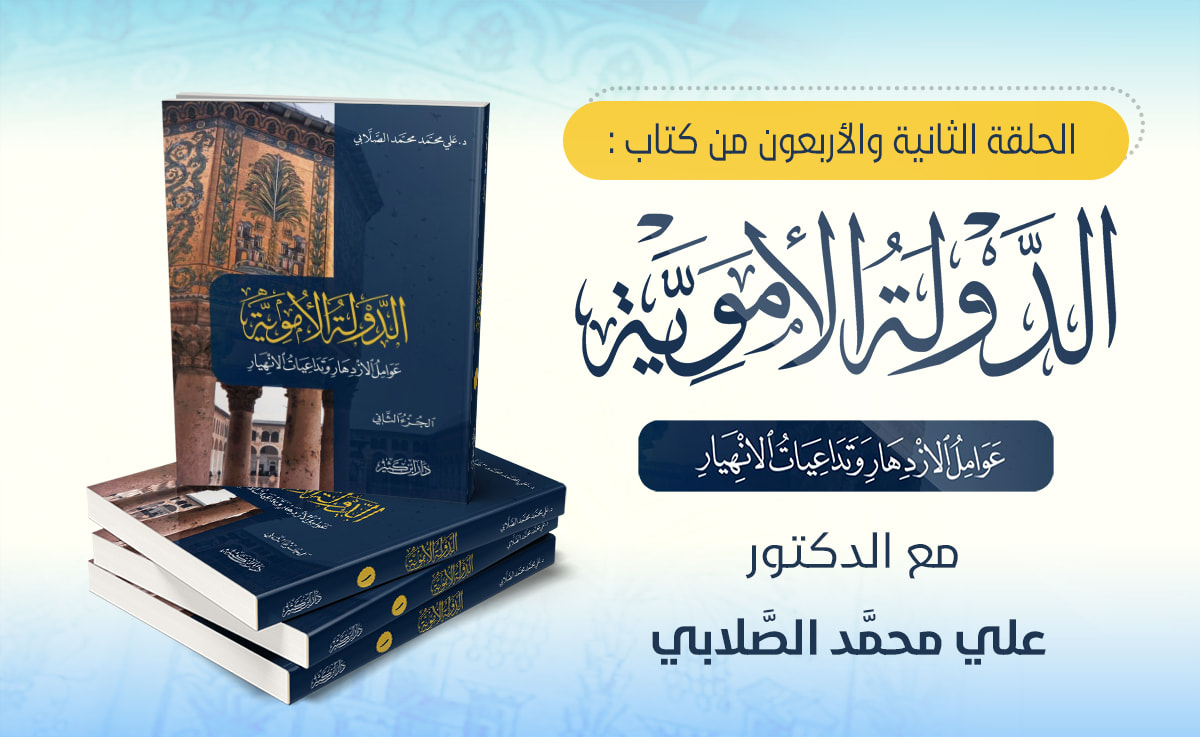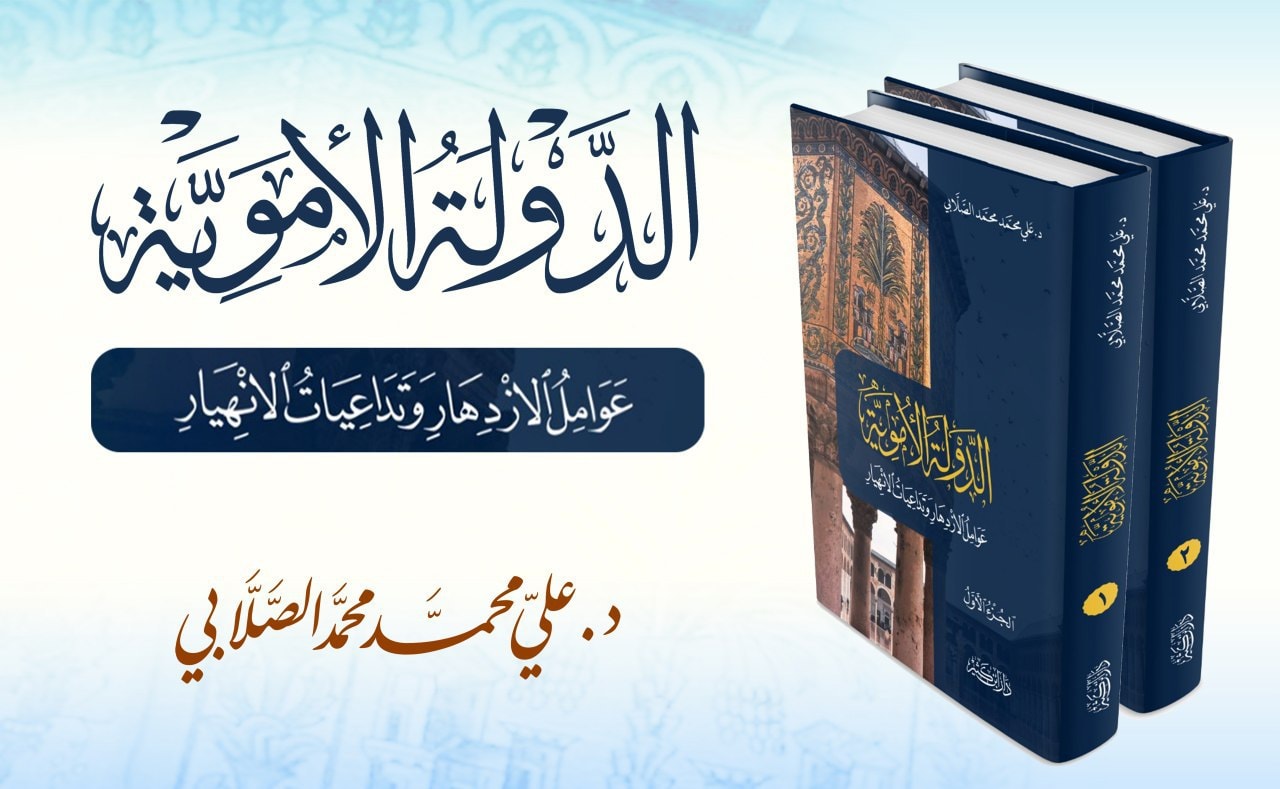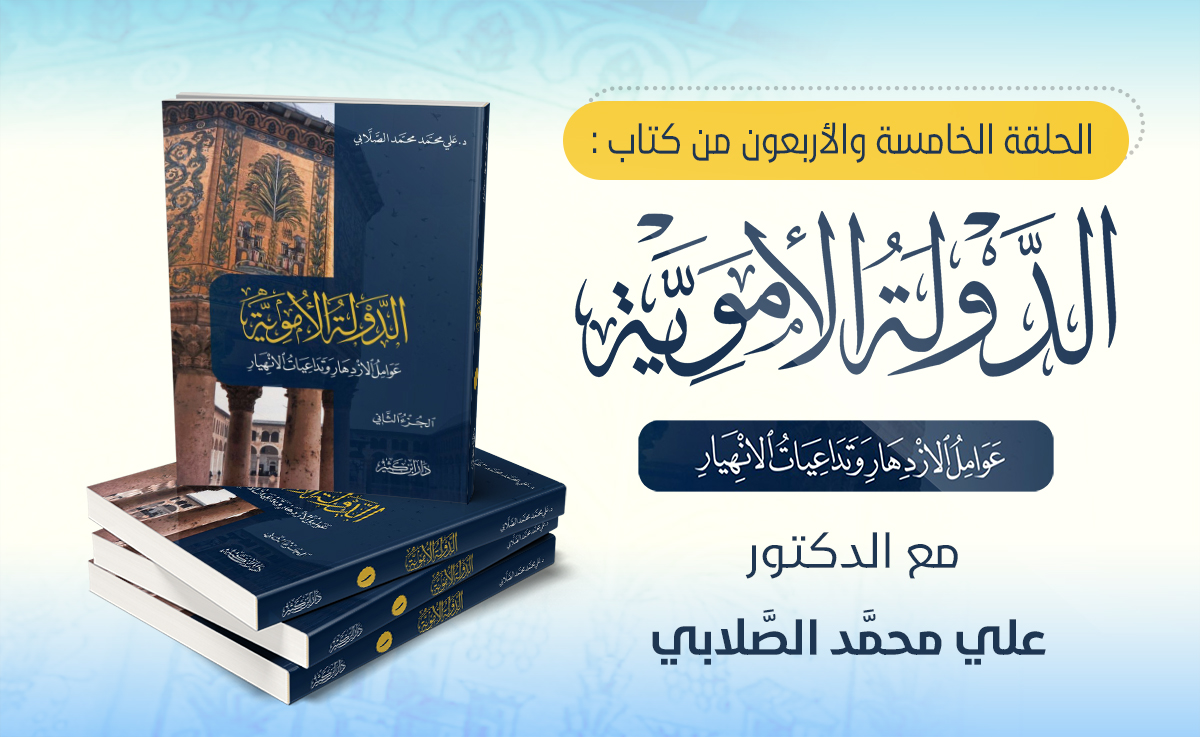من كتاب الدولة الأموية: خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
القضاء في عهد معاوية رضي الله عنه والدولة الأموية
الحلقة: الثالثة والأربعون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
يعتبر القضاء في العهد الأموي من الدرجة الثالثة بعد القضاء في العهد النبوي والقضاء في العهد الراشدي ، لأن العصر الأموي كان زاهياً وفيه كثير من اثار العهد الراشدي ، وكانت كثير من الأعمال امتداداً للعهد الراشدي ، وخاصة في جانب الفتوحات الإسلامية ، وانتشار الدعوة في المشارق والمغارب ودخول الناس في دين الله أفواجاً ، وازدهار الحضارة الإسلامية.
أولاً: صلة العهد الأموي بالعهد الراشدي:
كان العهد الأموي وخصوصاً عهد معاوية امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب ، فبقي كثير من الصحابة إلى العهد الأموي ، وشاركهم في العلم والفقه والقضاء وغيرها كبار التابعين ، ثم صغار التابعين ، كما بقي بعض قضاة العهد الراشدي يمارسون القضاء في العهد الأموي ، وبعدهم طال قضاؤهم كشريح بن الحارث رحمه الله ، وبقيت في العهد الأموي اثار التربية الدينية وسمو العقيدة ، واثار الإيمان ، والالتزام بأهداب الدين ، والتقيد بالأحكام الشرعية ، وظهر في العهد الأموي عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة والمذاهب الفقهية ، وكان العلماء والمجتهدون في العهد الأموي أساتذة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي، وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأموي، وظهر التوسع بالاجتهاد ، كما بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية ، والانفتاح على الحضارات الأخرى ، وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم المجاورة.
ثانياً: تخلي الخلفاء عن ممارسة القضاء، وفصل السلطات:
كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم ، ويفصلون في القضايا والدعاوى والمنازعات ، وصدرت عنهم أقضية كثيرة ، وكان الولاة في الأمصار يتمتعون بنفس السلطات والصلاحيات الممنوحة للخليفة لأنهم نواب عنه ، إلا إذا قيدت سلطتهم ومنعوا من القضاء ، وعُين معهم القضاة للفصل بين الناس ، ومن هؤلاء الولاة معاوية بن أبي سفيان الذي بقي والياً على الشام عشرين سنة ، وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه ، ولما تولى معاوية الخلافة تخلى عن ممارسة القضاء ، وعين القضاة في حاضرة الدولة الإسلامية بدمشق وفوَّض إليهم السلطة القضائية، وخوَّلهم الصلاحيات الكاملة في الدعاوى ، وسار ولاته في الأمصار على هذا النهج ، وابتعد الولاة عن أعمال القضاء، وسار خلفاء بني أمية على هذه الخطة طوال العهد الأموي ، سواء في عاصمة الدولة الأموية، أم في سائر الأمصار والمدن والولايات وانقطعت صلة خلفاء بني أمية عن القضاء الإسلامي إلا في ثلاثة أمور:
1 ـ تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق.
2 ـ الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم ، ومتابعة شؤونهم الخاصة في التعيين والعزل ، والرزق ، وحسن السيرة ، ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم ، للتأكد من مطابقتها للحق والعدل ، والشرع والدين ، والالتزام بالسلوك القضائي القويم.
3 ـ ممارسة قضاء المظالم ، وقضاء الحسبة. وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة ورعاية كاملة لقضاء المظالم حتى وقف على قدميه ، وأصبح له جهاز كامل مستقل. ومن ذلك نرى أن القضاء في العهد الأموي كان مستقلاً عن أية سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة أو الوالي الذي كانت سلطته تنتهي عند تولية القاضي أو عزله ، دون أن يكون لهم تدخل في أعمال القاضي واجتهاده وحكمه ، وما على الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة.
قال النُّباهي: ولما أفضى الأمر إلى معاوية جرى بجهده على سنن من تقدّمه من ملاحظة القضاة ، وبقي الرسم على حذو ترتُّبه زماناً. فقد كان معاوية رضي الله عنه أول خليفة امتنع من القضاء تماماً ، ودفعه إلى غيره ، فكان له قضاة في قاعدة ملكه ، فضلاً عن قضاته في الأمصار.
ثالثاً: رزق القضاة:
من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي فصل القضاء عن الولاية ، وهو أول من رتب أرزاق القضاة ، وأمَّا أمير المؤمنين علي وهو المعروف بالزهد والقناعة فقد قال لعامله على مصر في شأن القضاة: ... وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس ، واستمر الحال على ذلك في العهد الأموي ، فكانت تُجرى على القضاة أرزاقهم من بيت المال ، مع التوسيع عليهم ، واختلاف المقدار بحسب البلدان والظروف ، وروى الشعبي عن شريح: أنه كان يأخذ على القضاء خمسمئة درهم كل شهر ، ويقول: أستوفي لهم ، وأوفيهم ، ويقول أيضاً: أجلس لهم على القضاء ، وأحبس نفسي ولا أرزق؟! ولما قدم عبد الملك بن مروان النخيلة سنة 72 هـ ، وسأل عن شريح ، فعلم أنه امتنع عن القضاء في عهد ابن الزبير ، فاستدعاه وقال له: وفقك الله ، عُدْ إلى قضائك، فقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم ، وثلاثمئة جريب ، فأخذهما وقضى إلى سنة ثمان وسبعين ، وكان بعض القضاة لا يأخذون على القضاء أجراً ، ويحتسبون أجرهم عند الله تعالى في إقامة شرعه ، منهم مسروق بن الأجدع القاضي والمفتي (ت 63 هـ) ، وكان أعلم بالفتيا من شريح ، وشريح أبصر منه في القضاء ، وقالت امرأة مسروق: كان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقاً ، وقال القاسم: كان مسروق يقول: لأن أقضي يوماً فأقول فيه الحق أحب إليَّ من أن أرابط سنة في سبيل الله.
رابعاً: تسجيل الأحكام والإشهاد عليها:
ظهر في العهد الأموي لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في سجله وديوان المحكمة؛ ليرجع إليه القاضي عند الحاجة ، وأول من سجل الأحكام سُليم بن عنز التجيبي قاضي مصر في عهد معاوية ، لما تخاصم إليه أشخاص في توزيع ميراث ، فحكم بينهم ، فغابوا مدة ، واختلفوا وتناكروا وتجاحدوا الحكم ، وعادوا يطلبون فصل الخلاف ثانية ، فتذكر القاضي قصتهم ، وكاشفهم بها ، فاعترفوا ، فأعاد الحكم بينهم ، وطلب من كاتبه أن يُسجل الأحكام القضائية وكتب لهم كتاباً بقضائه ، وأشهد عليه.
وقال الكندي: فكان سليم أول القضاة بمصر سجل سجلاً بقضائه ، وكان سُليم ـ فيما وصل إلينا ـ أول من أشهد على الأحكام القضائية لتوثيقها ، ومنع جحودها أو إنكارها ، ثم توسع الأمر في العهد العباسي.
خامساً: أعوان القضاة:
يحتاج القضاة عادة إلى أعوان يساعدونهم في حسن التقاضي وسير القضاء ، منهم كاتب القاضي أو كاتب المحكمة، أو كاتب الضبط ، وأول ما ظهر في العهد الراشدي ثم شاع استعماله فيما بعد ، وظهر أعوان جدد في العهد الأموي بحسب الحاجة ، وتطور الحياة ، واتساع أعمال القاضي ، وكثرة الدعاوى ، ونذكر أهمهم:
1 ـ المنادي:
وهو الذي يجلس عند القاضي ، لبيان مكانة القاضي ، ومعرفته ، والمناداة على الخصوم ، وكان يطلق عليه: (الذي على رأس القاضي) ، أو (صاحب المجلس) ، وأول ما ظهر ذلك في عهد شريح ، قال وكيع: عن عمرو بن قيس الماضي ، قال: رأيت رجلاً كان يقوم على رأس شريح ، وكان إذا تقدم إليه خصمان ، فيقول: أيكما المدعي فليتكلم ، وروى وكيع أيضاً: «كان شريح إذا جلس للقضاء لم يقم حتى يُنادي: هل من خصم أو مستثبت أو مستفت؟».
2 ـ الحاجب:
وهو الذي يقف على باب القاضي ، ليحجب عنه الناس أثناء النظر في الدعاوى ، ويرتب دخول المتداعين عليه عند تزاحمهم وتعددهم ، وقد يكون الحاجب هو المنادي الذي يقف على رأس القاضي ، ويقوم بالعملين معاً ، وقد يكون هو نفسه الجلواز «التابع للشرطي ، أو أحد الشرطة القضائية» ، وقد يكلفه القاضي القيام ببعض الأعمال في المحكمة ، أو أداء بعض المهمات خارجها، وذكر وكيع أن إبراهيم النخعي كان جلوازاً للقاضي شريح ، وكان على رأس شريح شرطي بيده سوط.
3 ـ الترجمان أو المترجم:
اتخذ القضاة الترجمان لكثرة الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام ، وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضها ، تحقيقاً لقوله تعالى: {وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ} [الحجرات: 13]؛ فإذا حصل نزاع أو اختلاف، أو دعوى ، استعان القاضي بالترجمان الثقة المقبول لينقل أقوال الخصوم له.
سادساً: المراقبة والمتابعة:
إن تخلي الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاء ، والاقتصار على التعيين والعزل لم يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحكامهم ومتابعة الدعاوى والأقضية التي تصدر عنهم ، لأن الخليفة هو المسؤول عن القضاء ، وجميع ما يخص الأمة والأفراد في سياسة الدين والدنيا ، وتفويض القضاء للقضاة لا ينجي الخليفة من المسؤولية في الدنيا والآخرة ، لذلك كان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة ، ويتابعون ما يصدر عنهم ، فإن وجدوا فيه خللاً أو انحرافاً ، أو تقصيراً ، تصدوا للتقويم والتصحيح، وهذا ما نقلناه سابقاً عن النباهي قال: «ولما أفضى الأمر إلى معاوية جرى بجهده على سنن من تقدَّمه من ملاحظة القضاة ، وبقي الرسم حذو ترتبه زماناً».
سابعاً: مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي:
اعتمد القضاة على المصادر نفسها التي جرى عليها القضاة في العهد الراشدي ، وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارة ، وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس ، وهو ما تلتزم به الخلافة ، وتتم عليه البيعة ، وتطور الأمر في السوابق القضائية على الإشادة بقول الصحابة رضوان الله عليهم والتقيد غالباً بما صدر عنهم ، لأنهم أقرب عهداً وصلة بمدرسة النبوة ، ونزول الوحي ، وخصوصاً أقضية الخلفاء الراشدين ، كما بدأ يظهر في هذا العهد أثر العرف والعادة على أقضية الحكام ، نظراً لاختلاف الأعراف والعادات في أصقاع الخلافة الأموية المترامية الأطراف ، فكان القضاة ينظرون في الأقوال والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراف التي تظلهم وتحدد المراد من الألفاظ والمصطلحات.
وكان الفقهاء والقضاة والخلفاء يحرصون على التثبت في نقل النصوص ، وصحة الأحاديث للاعتماد عليها ، وحذر معاوية رضي الله عنه من الاعتماد على الأحاديث المكذوبة ، فخطب في وفد من قريش ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أما بعد ، فإنه قد بلغني أن رجالاً فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ، ولا تُؤْثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئكم جهالكم. وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاة ، وتطلق يد القضاة ، ولا يتقيدون برأي اجتهادي معين في أحكامهم ، إلا ما ورد في النصوص والإجماع ، وإلى حد ما إلى السوابق القضائية وقول الصحابة ، ولم تكن المذاهب الفقهية قد ظهرت ، ولم تدوَّن الأحكام ، فكان الأمر راجعاً إلى القضاة أنفسهم ، وبما يصلون إليه مع استشارة الفقهاء والعلماء والمجتهدين في كل مصر على حدة.
ثامناً: اختصاص القضاة ، وتخصيص القضاء:
كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ، وكثرة الناس ، وانشغال الخلفاء بالفتوحات ، وإدارة الدولة ، وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاء ، وفوضوا جميع اختصاصاته إلى القضاة ، وتنازلوا عن النظر في الجنايات والحدود ، وكلفوا القضاة النظر فيها ، وكان معاوية بن أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقصاص إلى القضاة ، فكتب إلى القاضي سُلَيم بن عِتر (قاضيه على مصر) يأمره بالنظر في الجراح ، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان ، وكان سُليم أول قاضٍ نظر في الجراح ، وحكم بها ، فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضي ، وأحضر بينته على الذي جرحه ، فيكتب القاضي بذلك الجُرح قصاصه على عاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان ، فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح ، وينجَّم «يقسَّط» ذلك في ثلاث سنين ، فكان الأمر على ذلك.
وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال ، وأحكام الأسرة ، والمواريث والقصاص والحدود، ويظهر ذلك جلياً من سيرة القضاة وأقضيتهم التي ذكرها وكيع في كتابه (أخبار القضاة) ، والكندي في كتابه (الولاة والقضاة). وفي العهد الأموي ضُم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبه قضائية ، وبعضها إدارية ، فمن أهم هذه الأعمال في ذلك العصر: النظر في أموال الأيتام ، الإشراف على الأوقاف ، الإفتاء.
تاسعاً: القضاة والأعمال المختلفة:
نظراً لما يتمتع به القضاة من الثقة ، وما يتصفون به من العدل والنزاهة ، والورع والتقوى ، فقد أسند لهم الخلفاء في العهد الأموي عدة أعمال؛ هي:
1 ـ الشرطة:
تولى القضاة رئاسة الشرطة بالإضافة إلى أعمالهم القضائية ، فجمعوا بين ولاية القضاء وولاية الشرطة وذلك في عدة مدنٍ إسلامية ، فقد روى وكيع أن معاوية عزل سعيد بن العاص عن المدينة سنة ثلاثٍ وخمسين ، ويقال: سنة أربع وخمسين في شهر ربيع ، وأعاده مروان بن الحكم ، فعزل مروان أبا سلمة ، واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، وضم إليه الشُّرَط مع القضاء ، وكان شديداً صلباً في ولايته ، ولما ولي الشُّرَط أخذ الناس بالشدة ، قال الكندي عن مسلمة بن مخلَّد أنه: قدم مسلمة الفُسطاط ، فعزل السائب بن هشام بن كنانة العامري عن شُرطه ، وولّى عليها عابس بن سعيد ، وعزل سُليمان بن عنز عن القضاء وجعله إلى عابس ، فجمع له القضاء والشّرط ، وهو أول من جمع له سنة ستين ، ولما توفي مسلمة سنة 62 هـ ، بعد أن مكث والياً على مصر أكثر من 15 سنة وليها سعيد بن يزيد الأزدي في رمضان سنة 62 هـ ، فأقر عابس بن سعيد على القضاء والشُّرط جميعاً ، ولما جاء عبد الرحمن بن عتبة بن جَحْدم الفهري أميراً على مصر أقر عابساً على الشُّرط والقضاء ، وذكر الكندي: أن مسلمة بن مخلِّد والي مصر عين عابس بن سعيد على شُرطته ، ثم جمع له الشُّرط والقضاء ، وذلك في أول سنة إحدى وستين.
2 ـ الإمارة:
استعمل بعض القضاة ولاة في بعض الأحيان ، كما كان الخليفة أحياناً ينيب القاضي مكانه في الإمارة إذا خرج عن دمشق ، وكان كثير من الولاة يستخلفون القاضي على إدارة الأمور ، وتصريف شؤون المصر أثناء غيابهم ، أو خروجهم لمهمة ، قال أبو زرعة: لما خرج معاوية إلى صفين استخلف القاضي فضالة بن عُبيد على دمشق.
عاشراً: أسماء القضاة في عهد معاوية:
1 ـ أشهر قضاة دمشق:
أ ـ فضالة بن عُبيد: الذي ولاه معاوية القضاء في الشام بترشيح أبي الدرداء رضي الله عنه ، وبقي فضالة على القضاء حتى مات في خلافة معاوية سنة 53 هـ ، وحضر معاوية جنازته وحمل بجانب السرير ، وكان معاوية يستخلفه على دمشق عندما يخرج منها ، وقضى فضالة بدرء الحد عندما أتاه رجل بسارق يحمل سرقته ، فقال له فضالة: لعلك وجدتها ، لعلك التقطتها ، فقال له الرجل: إنّا لله وإنا إليه راجعون ، إنه ليلقنه ، قال: إي والله ، أصلحك الله ، وجدتها ، فخلَّى سبيله ، وأجاز الفقهاء تلقين المتهم في الحدود ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز.
ب ـ النعمان بن بشير بن سعد: أبو إدريس الأنصاري الخزرجي ، الصحابي الذي ولي القضاء بالشام بعد فضالة، وتوفي سنة 46هـ قتلاً بقرب حمص.
2 ـ قضاة المدينة:
أ ـ أبو هريرة الصحابي المشهور رضي الله عنه: قضى بالمدينة ، لما رواه وكيع عن نعيم قال: شهدت أبا هريرة يقضي.. وأمر بالتسوية بين الخصوم ، ورفض حبس مدين معسر ، وحكم على قاذف بثمانين جلدة ، وكان أبو هريرة يسكن المدينة حتى توفي فيها سنة 59 هـ ، ولعله استقضي قبل عبد الله بن الحارث.
ب ـ عبد الله بن الحارث بن نوفل : وهو أول قاض في المدينة لواليها مروان بن الحكم في خلافة معاوية ، وكان أول ما قضى حقاً على آل مروان ، فزاده ذلك عند مروان بن الحكم خيراً ، وكان يقضي باليمين مع الشاهد ، وتوفي سنة 84 هـ ، وكان من صلحاء المسلمين وفقهائهم.
جـ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ت 94 هـ): وهو من كبار التابعين ، وكان يزعم عن نفسه أنه أفقه الناس ، واستعمله سعيد بن العاص والي معاوية على قضاء المدينة ، وكان يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد.
د ـ مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (ت 64 هـ): استقضاه مروان بن الحكم سنة 53 هـ أو 54 هـ وضمَّ إليه الشُّرط مع القضاء ، وكان شديداً صلباً في ولايته ، ولما ولي الشُّرط أخذ الناس بالشدة في جرائم القتل التي انتشرت في المدينة ، ولما مات معاوية واستخلف يزيد استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان، فاستقضى طلحة بن عبد الله بن عوف ، وهو أحد الأجواد ، ويقال له: طلحة الجواد.
3 ـ قضاة البصرة:
تولى القضاء في البصرة كثيرون ، نذكر منهم: عُميرة بن يثربي الضبِّي الذي استقضاه عبد الله بن عامر بن كريز عامل معاوية على البصرة، وكان عميرة يحكم بضمان العارية، وبقي في القضاء حتى سنة 45هـ ، فعزله زياد الذي ولى إمارة البصرة، وولى القضاء عمران بن حصين فاستعفاه بطلبه، وولى عبد الله بن فضالة ثم أخاه عاصم بن فضالة، ثم زرارة بن أوفى.
4- قضاة الكوفة:
كانت الكوفة من أنشط المدن العلمية ، وكانت مركز النشاط والحركة والعلم منذ أسست في عهد عمر رضي الله عنه، واتخذها علي رضي الله عنه عاصمة ، وكان من أشهر قضاة الكوفة شريح القاضي، فقد كان من عهد عمر واستمر في القضاء طوال العهد الراشدي ، ومدة طويلة في العهد الأموي تزيد عن خمس وثلاثين سنة، وتوقف في عهد (ابن الزبير) ثم عاد إلى القضاء حتى استعفى من الحجاج فأعفاه سنة 78هـ ومن قضاة الكوفة في عهد معاوية رضي الله عنه: مسروق بن الأجدع الهمداني، ولي لمعاوية في إمرة زياد القضاء، وكان من الفضلاء.
5- قضاة مصر:
ومن أشهر قضاة مصر في عهد معاوية سليم بن عنز التجيبي وهو أول من ولي القضاء بمصر في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة أربعين للهجرة، وعابس بن سعيد المرادي الذي عينه مسلمة بن مخلد على الشرطة ، ثم عزل سليم بن عنز عن القضاء، وجعله إلى عابس فجمع له القضاء والشرط. هؤلاء هم أشهر القضاة في عهد معاوية رضي الله عنه.
حادي عشر: ميزات القضاء في عهد معاوية والعهد الأموي عموماً:
من أهم ميزات وخصائص القضاء في العهد الأموي الآتي:
1- بقي القضاء في العهد الأموي كما كان في العهد النبوي والعهد الراشدي، في معالمه الأساسية، وتنظيمه الجوهري، ووسائله وأهدافه، وكان استمرارا لما سبق في إقامة الحق والعدل ، والنزاهة والموضوعية ، مع مراعاة التطور والتوسع في الخلافة الأموية.
2 ـ استعمل القضاة في العهد الأموي وسائل الإثبات الشرعية نفسها المعمول بها في العهد الراشدي ، مع التوسع في الفراسة ، واستعمال الحيل على المتهم ، لكشف الحق ، والوصول إلى الصواب والعدل.
3 ـ ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية؛ وهي: العرف ، وقول الصحابي ، وإجماع أهل المدينة أحياناً ، بالإضافة إلى المصادر الأصلية في العهد النبوي وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة ، والمصادر الاجتهادية في العهد الراشدي وهي: الإجماع ، والقياس ، والسوابق القضائية ، والرأي.
4 ـ كان الخلفاء يعينون القضاة في الشام ، وقد يرشحون بعض القضاة للأقاليم ، وكان الولاة في الأمصار يعينون القضاة ، ويعزلونهم.
5 ـ حرص الخلفاء والولاة على اختبار أحسن الناس لولاية القضاء ، من العلماء والفقهاء والشرفاء وخيرة القوم، الذين تتوفر فيهم صفات القاضي الشرعية ، ويخشون الله تعالى ، ويلتزمون بالحق والشرع ، ويقيمون العدل بين الناس.
6 ـ طرأت تغييرات بارزة على القضاء في العهد الأموي ، وأضيفت لأول مرة ، وهي:
أ ـ تسجيل الأحكام خوفاً من النسيان ، ومنعاً للتجاحد ، ووضعها في ديوان خاص.
ب ـ الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها.
جـ النظر في أموال اليتامى ومراقبة الأوصياء.
د ـ ترتيب الدعاوى ، واستعمال الرقعة لإدخال الخصوم والمناداة على الناس بالترتيب.
هـ وجود المساعدين للقضاة ، وهم: الأعوان والحاجب ، والشرطي في مجلس القضاة.
و ـ الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية ، وإجراءات الخصومة.
7 ـ كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية ، ولهم الحرية المطلقة في استنباط الأحكام من القران والسنة ومقاصد الشريعة ، وبقية المصادر ، ولم يتقيدوا برأي الخلفاء ، ولم يلتزموا بمذهب فقهي ، ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة العلماء والفقهاء ، ومشاركتهم في المجالس القضائية.
8 ـ لم يتأثر القضاة بسياسة الحكام والخلفاء ، وكان القضاة مستقلين في عملهم ، ولم تؤثِّر عليهم الميول السياسية ، والحركات الثورية ، والخلافات الفكرية ، والفتن الداخلية. هذه هي أهم ميزات القضاء في العهد الأموي.
ثاني عشر: خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية في القضاء:
كتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: «أما بعد؛ فإنني كتبت في القضاء كتاباً لم الك ونفسي فيه خيراً. ..» ثم إن عمر قال:
1 ـ «الزم خمس خصال يسلم لك دينك ، وتأخذ فيه بأفضل حظك: إذا تقدم إليك الخصمان ، فعليك بالبينة العادلة ، واليمين القاطعة؛ فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب؛ فمن تمسك به سلم له دينه ، ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة». فمعنى اليمين القاطعة: أي: القاطعة للخصومة والمنازعة.
2 ـ «وأدنِ الضعيف حتى يشتد قلبه ، وينبسط لسانه». ولم يرد بهذا الأمر تقديم الضعيف على القوي ، وإنما أراد الأمر بالمساواة ، لأن القوي يدنو بنفسه لقوته ، والضعيف لا يتجاسر على ذلك ، والقوي يتكلم بحجته، وربما يعجز الضعيف عن ذلك. فعلى القاضي أن يدني الضعيف ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه ، وينبسط لسانه، فيتكلم بحجته.
3 ـ «وتعاهد الغريب ، فإنك إن لم تتعاهده ترك حقه ، ورجع إلى أهله ، فربما ضيع حقه من لم يرفع به رأسه». قيل: هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاء ، فإن الغريب قلبه مع أهله ، فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومة ، ليرجع إلى أهله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الغرباء. وقيل: مراده أن الغريب منكسر القلب ، فإذا لم يخصه القاضي بالتعاهد عجز عن إظهار حجته ، فيترك حقه ، ويرجع إلى أهله ، والقاضي هو السبب ، لتضييع حقه ، حين لم يرفع به رأسه ، ثم قال:
4 ـ «وعليك بالصلح بين الناس ، ما لم يستبن لك فصل القضاء». وفيه دليل أن القاضي مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح ، خصوصاً في موضع اشتباه الأمر.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf