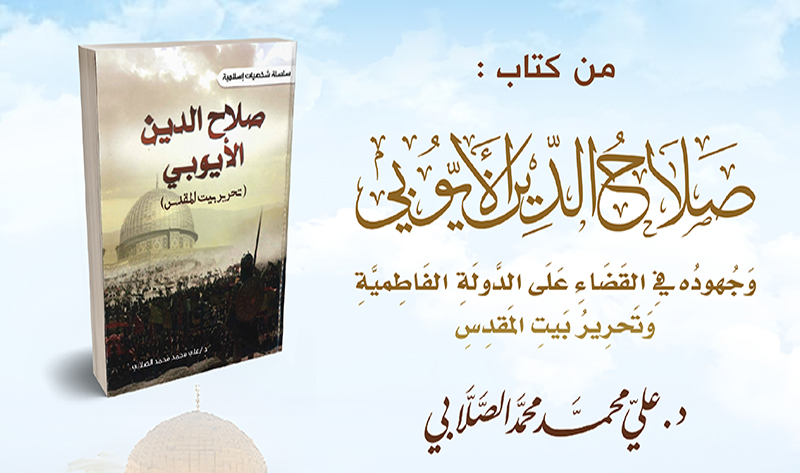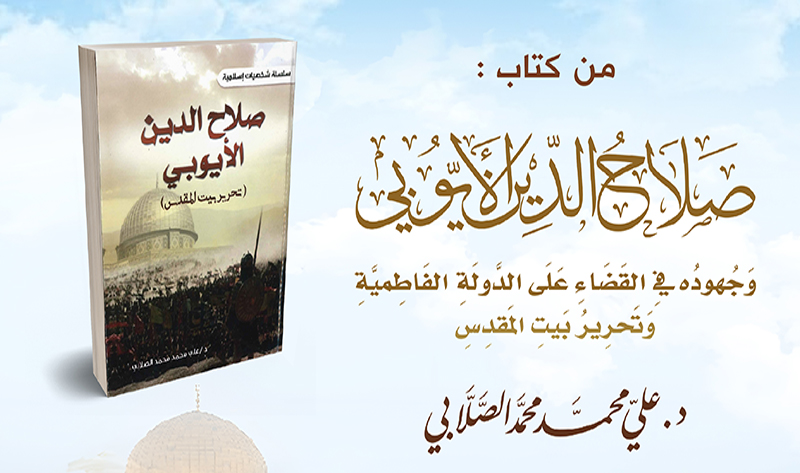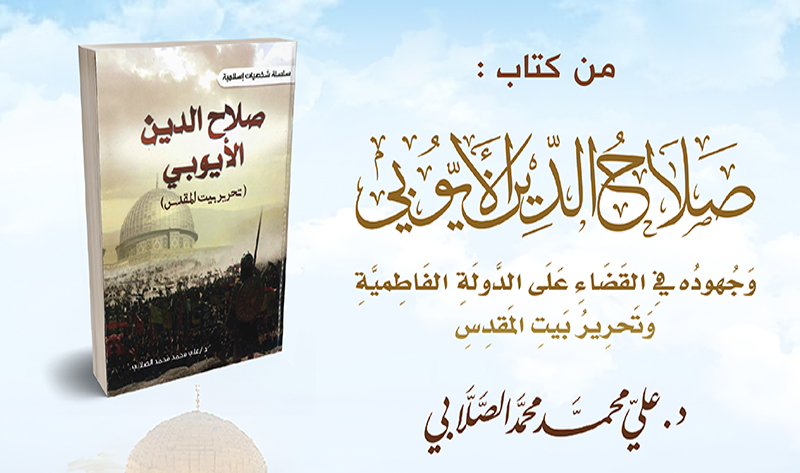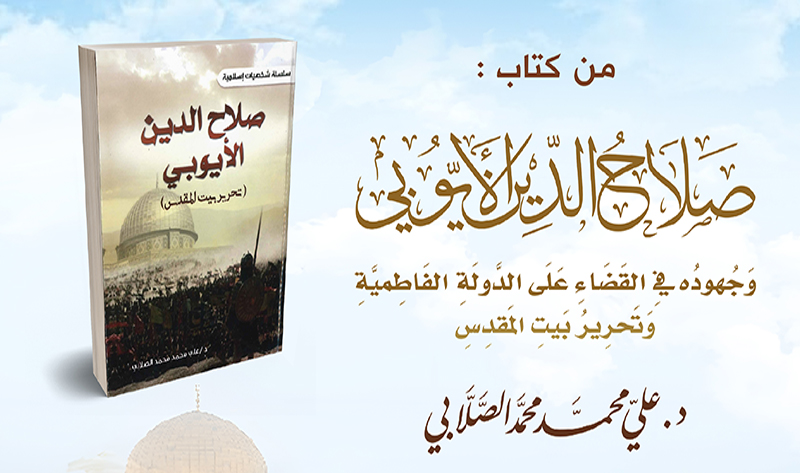في سيرة صلاح الدين الأيوبي:
المتطوعون في الجيش الأيوبي:
الحلقة: الستون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يوليو 2020
إضافة إلى المقاتلين من الفرسان ، والمشاة النظاميين المسجلين في ديوان الجيش الأيوبي ، وإلى جند الإقطاع التابعين إلى الأمراء الأيوبيين ، والأمراء الاخرين؛ الذين دخلوا في تبعية صلاح الدين تباعاً ، والذين كانوا يزوِّدون الجيش الأيوبي بالمحاربين وقت الحاجة ، وإضافة إلى المماليك السُّلطانية كان ثمةَّ مَنْ تطوَّعوا ، ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجيشن حبَّاً بالجهاد في سبيل الله ، ورغبةً منهم في تحرير الأرض الإسلامية من الاحتلال الصليبي ، والواقع: أنَّ عهد الإفاقة الإسلامية بدأ بوضوح بظهور المجاهد عماد الدين زنكي مؤسِّس الدولة الزنكية ، وفي عهد أبنه نور الدين محمود الشهيد ، بلغ هذا العهد ذروته أيام صلاح الدين ، لقد أعاد عهد صلاح الدِّين إلى الأذهان أيام التطوع ، والجهاد الأولى في صدر الإسلام ، فلا غرابة إذا وجدنا جيش صلاح الدين يضمُّ الكثير من المتطوعين في معركة ، لاسيما في حطِّين ، وفتح بيت المقدس؛ والمعارك اللاَّحقة ممَّا استرعى انتباه المؤرِّخين ، فذكر ابن كثير: أن السلطان حين عزم على فتح بيت المقدس ، قصده العلماء ، والصالحون تطوُّعاً.
وكان المتطوِّعون ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية من المسلمين من أبناء القبائل ، والقروِّيين ، وأهل المدن ، من الفقراء ، والأغنياء لاسيما من الفقهاء ، والصوفية . يقول: إنَّ نور الدين محمود أمر بالنداء في الغزاة ، والمجاهدين ، والأحداث المتطوِّعة من فتيان البلدان ، والغرباء بالتأهب ، والاستعداد لمجابهة الفرنج أولي الشرك ، والإلحاد. وكان لفظ الأحداث يستخدم للدَّلالة على المتطوِّعين ، ثم اختفى اللفظ لتحلَّ محلَّه كَلمة المتطوعين ، والكلمتان تدلاَّن على أنَّ أفراد تلك الجماعتين لم يكونوا قوَّة نظامية ، بل كانوا من المتطوِّعين.وفي المساجد كان الخطباء يحثُّون الناس على التطوع في الجيش الإسلامي ، فإذا ما نزل الخطباء من على منابرهم ردَّد المصلون الهتافات ، والدَّعوات مقبلين زرافاتٍ ووحدانا من جميع الجهات إلى معسكر الجيش، وكان صلاح الدين يوكل إلى المتطوعين أحياناً أمر قتل الأسرى بأيديهم لاسيما من المرتدِّين، أو الرُّماة الصَّليبيين، كما حصل في بيت الأحزان 575هـ/1179م.
وفي إثر انتصار حطين طلب صلاح لدين من المتطوِّعين المتودعة ، والمتصوفة ، أن يقتل كل واحد منهم أحد الأسرى المنتمين إلى الفرقتين الصليبيتين: الداوية ، والاسبتارية ، بل إن المتطوعة قاموا بعمل مجيد يوم حطين ، وأسهموا في أحراز النصر بسرعةٍ على الصليبيين ، حين اندفعوا ليضرموا النار في الحشيش اليابس المحيط بالصليبيين، فتأجَّج عليهم استعارها ، وتوهَّج نار الضِّرام. وكانت الرِّيح على الفرنج فحملت حرَّ النار ، والدُّخان إليهم فاجتمع عليهم العطش، وحرُّ الزمان ، وحرُّ النار ، والدُّخان ، وحرُّ القتال على حدِّ تعبير ابن الأثير ؟.
الفرق الملحقة بالجيش:
أ ـ الفرقة الهندسية: كانت تصحب الجيش عادةً فرقةٌ هندسيةٌ ، وأخرى طبيَّةٌ ، وكانت الأولى تقوم بمهمات تتطلَّب معرفة خاصة بشؤون الهندسة العسكرية التي يلزمها القتال ، لاسيما قتال الأسوار ، والخنادق ، مثل نصب المعدَّات الحربية الثقيلة ، كالمنجنيق ، والدبابات ، والأقواس الثقيلة مثل ، قوس الزيار ، والجرخ ، والقوس المتعدَّدة الاتجاه ، وقاذفات النفط ، ثم بناء المعسكرات ، والأسوار لاسيما في الأماكن ذات الميزة العسكرية الحسَّاسة ، وتشييد الجسور، ونسفها ، وردم الخنادق ، وحفر الابار ، وتعيين مواقع ضرب الحصار حول أسوار المدينة المنوي فتحها ، وتهشيم هذه الأسوار ، وتغيير مجاري الأنهار ، وغيرها من الأعمال الهندسية؛ التي هي ضمن واجبات هذه الفرقة.
فلدى حصار بيت المقدس ظلَّ صلاح الدين ، وجيشه يطوفون حوله طيلة خمسة أيام ، وأخيراً استطاع الملمُّون بشؤون هندسة الأسوار العثور على المكان المناسب في الجهة الشمالية من السُّور، نحو باب العامود، وكنيسة صهيون، فأمر صلاح الدين بنصب معدات الحصار عند هذا الموضع . وفي عام 581هـ/1185م ولدى حصار الموصل؛ التي عجز جيش صلاح الدين من إحراز نصر عسكري مباشر عليها ـ رغم تكرار محاولاته ـ بسبب متانة أسوارها ، أشار عليه بعض رجاله إلى تعطيش المدينة بتحويل مجرى نهر دجلة، وعرض الفكرة على رأي الفقيه العالم فخر الدين بن الدهان البغدادي وكان مهندس زمانه.. قال: هذا ممكنٌ، ولا يتعذَّر، ويتيسر، ولا يتعسر.
وجاء في كتاب بعث به صلاح الدين إلى الخليفة العباسي ، والذي كتبه مستشاره المعروف القاضي الفاضل: وذكر المهندسون أهل الخبرة: أنَّه يسهل تحويل دجلة الموصل عنه ، بحيث يبعد مستقى الماء منها ، وحينئذٍ يضطر أهلها إلى تسليمها بغير قتال ، ولا حصول ضرر في تضييق ، ولا نزال؛ إلا أنَّ صلاح الدين لم ينفذ المشروع ، ولعلَّ ذلك لصعوبته ، وارتفاع تكاليفه ، وضيق الوقت ، واهتمامه بمشاريع أكثر أهميةً.
ب ـ الفرقة الطبية: ومصاحبة الفرقة الطيبة للجيش إلى ميدان القتال لمعالجة الجرحى ، والمرضى كان أمراً ضرورياً ، وكان الأطباء ، ومساعدوهم يشكِّلون ما يشبه مستوصفاً متنقلاً ، فيه ما يحتاجونه من أدوية ، وأدوات ، ونقالات لحمل الجريح ، أو المريض ، وكانت هذه المعدَّات تحمل على ظهر الحيوان ، ثم ينصب المستوصف داخل خيام يبيت فيه المحتاج إلى العلاج. والظاهر أن عهد صلاح الدين كان فترة انتعاشٍ للشؤون المتعلِّقة بالطبِّ ، وذلك لكثرة الحاجة إليها ، وإغداق صلاح الدين ، والأمراء المال عليهم بسخاء ، والواقع: أنَّ صلاح الدين بدأ يهتمُّ بشؤون الطبِّ ، ويشجع القائمين منذ وقتٍ مبكرٍ من حكمه ، وقد أولى الأطباء الذين خدموا البلاط الفاطمي بمصر ، أو البلاط النوري الأتابكي في الشام اهتماماً كبيراً. ومن الأطباء الذين شاركوا في الحملات العسكرية؛ التي يقوم بها الجيش الصلاحي: أبو زكريا أمين الدولة يحيى بن إسماعيل الأندلسي أحد تلامذة الحكيم مهذب الدين، فقد كان يصاحب جيش صلاح الدين في القتال ، ثم استقرَّ في دمشق ، كأكثر أطباء عصره ، ويبدو لنا: أنَّ سبب هذا الاستقرار في هذه المدينة يعود إلى وجود المستشفى النوري الكبير فيها ، وقد اختيرت دمشق لقربها من ميدان القتال ، فكان جرحى ، ومرضى الحرب يرسلون إليها بيسر. هذا؛ وقد عجز أبو زكريا عن العمل في أواخر حياته ، فانطلق له السُّلطان جامكية استمرَّت حتى وفاته ، كما فعل صلاح الدين مع أطباء اخرين أمثال ابن الدَّهان البغدادي ، والكحَّال أبي الفضل سليمان المصري .
ومن أشهر أطباء صلاح الدين موفق الدين أبو نصر أسعد المعروف بابن المطران الدمشقي؛ الذي عرف عنه مشاركته في غزوات السُّلطان، وكان يعمل في البيمارستان النوري بدمشق، وله مجموعة من المصنفات الطبية، منها: المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية، وغيرها كثير، يقول العماد الكاتب عن هذا الطبيب: إنه كان بارعاً ظريفاً، ويشيد بإخلاصه كثيراً، وأنه قد حظي بتقدير صلاح الدين كثيراً، فكان له شأن كبير لديه، وكانت له درايةٌ، وذكاءٌ، وفراسةٌ.
هذا وكان للسلطان طبيبه الخاص يصحبه في حملاته؛ لأنَّه كان يعاني في بعض الأوقات من الام ، والتياث مزاج ، وتظهر دمامل في ظهره؛ حتى لامه أصحابه على قلَّة اعتنائه بصحَّته ، وعدم أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة ، فكان يردُّ عليهم بقوله: إذا ركبت للجهاد ، زال عني الألم حتى أنزل. وكان الطبيب الخاص لا ينفرد بعلاج السلطان، بل يعالج كبار قادته ، وأمراء جيشه أيضاً ، فحين مرض صاحب أربيل زين الدين يوسف نيالتكين بالحمَّى؛ التي أودت بحياته في سنة 586هـ/1190م أثناء حصار عكَّا ، ذهب طبيب صلاح الدين لمعالجته. وكان السُّلطان يشرف بنفسه أحياناً على معالجة الجرحى ، كما حصل بعد هزيمة المسلمين في موقعة أرسوق في شعبان 587هـ/أيلول 1191م حين جلس ، وطلب بإحضار الجرحى ، فقام بمداواتهم.
ج ـ فرقة الموسيقى العسكرية: بعد أن ينادي الجاويش بالعسكر أن يستعدُّوا؛ تشدُّ الرايات ، وتبدأ الكوسات بالضرب ، وكان هذا بمثابة الموسيقى العسكرية ، أو المارشات في الوقت الحاضر كجزء من عملية إثارة حماس المقاتلين. وتثبت وقائع التاريخ الأيوبي: أنَّ الموسيقى العسكرية كان لها شأن كبير في الجيش ، حتى خصص لها مكان خاصٌّ يسمى: «الطبلخاناه» أي: «مكان الطبل». ويذكر المقريزي بهذا الصدد: أنَّه بعد استقرار صلاح الدين في مصر ، وانتهاء الدولة الفاطمية «رتَّب نوبة الطبلخاناه» ونظم شؤونها. ويشرح القلقشندي معنى هذا المصطلح ، ويقول: «ومعناه: بيت الطبل ، ويشتمل على الطبول ، والأبواق ، وتوابعها من الآلات» وقد كانت هذه الآلات تضرب في أوقات القتال ، وفي بقيَّة الأيام «ثلاث مرات في كلِّ يوم» وكان الذي ينقر على الطبل يسمَّى: «دبندار» والنافخ في البوق يسمى: «منفر» أما الذي يضرب بالصنوج النحاس بعضها على بعض ، فكان يسمَّى: «كوسي» ، وكانت العادة أن يضرب على الكوسات أيضاً لدى قدوم شخصية عسكرية هامة ، وتنشر معها الأعلام ، والبيارق ، وتنعق البوقات ، كما كان لكل مناسبة إيقاعها الخاص ، تمرن على عزفها العازفون، وعلى سماعه المقاتلون، فثمة ضرباتٍ خاصَّةٍ حين تدعو الحالة إلى عدم التوقف عن القتال؛ رغم الهزيمة التي ألحقت بهم، فكان «الكوسي» يدق ، ولا يفتر. وكذلك ضربات خاصة لبشائر النصر، فحين وصل الخبر في شوال 587هـ/1191م بأنَّ الأسطول الإسلامي قد استولى على مراكب الفرنج؛ التي كانت تحمل أكثر من خمسمئة صليبي؛ سرَّ المسلمون بذلك ، وضربت بشائر النصر ، ونعق بوق الظَّفر.
د ـ حملة أعلام الجيش: كان ضمن الجيش جماعةٌ مهمَّتهم حملُ الراية السلطانية ، والحفاظ عليها ، والراية ، أو العلم بمثابة البشارة؛ التي تميز جماعةً عن جماعةٍ أخرى، ودولةً عن أخرى، فكان لكلِّ دولة إسلامية، وغير إسلامية علمها الخاصُّ؛ الذي يتَّخذ من لونٍ، أو رنك. وكان لون العلم الصلاحي أصفر، وفي وسطه صورة طير النِّسر علامة القوة، والثِّقة في النصر. وكان بين الرَّايات رايةٌ عظيمةٌ من حيريرٍ أصفر مطرَّزةٌ بالذَّهب ، عليها ألقاب السُّلطان ، وأسمه، وتسمَّى العصابة، وراية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر تسمى الجاليش، ورايات صفر صغار تسمى السناجق. وكانت الراية الكبيرة تحمل عادة في ركب السلطان.
وعن الراية اصلاحية يتحدَّث العماد لدى فتح الجيش الأيوبي لصيدا سنة 583هـ/1187م يقول: جاء رسل صاحبها بمفاتيحها ، وأذهبنا ظلماتها من العزائم العز بمصابيحها ، وطلعت الراية الصَّفراء باليد البيضاء على سورها.
هذا؛ وقد ورد ذكر الراية الصلاحية في مجموعةٍ من قصائد شعراء ذلك العصر في المناسبات؛ التي أحرز فيها الجيش الأيوبي نصراً على الصليبيين ، ورفع فيها العلم الأيوبي ، فلدى انتصار المسلمين عليهم ، وتخريب بيت الأحزان سنة 575هـ/1179م هنَّأه جماعةٌ من الشعراء بالفتح ، منهم بهاء الدين أبو الحسن علي السَّاعاتي الخراساني؛ الذي قال في قصيدةٍ له:
وما رفعت أعلامُك الصُّفْر ساعة
إلى أن غدت أكبادُها السُّود ترجفُ
كَبَا مِنْ أعاليه صليبٌ وبيعةٌ
وساد به دِيْنٌ حنيفٌ ومصحفُ
أتسكن أوطانَ النبيين عصبةٌ
تمين لدى أيمانها حين تَحْلِفُ
نصحتكمُ والنصح في الدِّين واجب
ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسفُ
وقال «العلم الشاتاني» الذي مدحه بقصيدته الرَّائية التي مطلعها:
أرى النَّصر مقروناً برايتك الصَّفرا
فسر واملك الدنيا فأنت بها أحرى
وكانت الراية رمز السيادة ، فكانت ترفع في الأماكن ، كالحصون ، والسفن ، والمؤسَّسات الحربية الرئيسية ، وحين يهزم أحد الطرفين ، فإن أوَّل ما كان يفعله المنتصر هو نزع راية المنهزم ، وإنزالها ، ورفع رايته مكانها ، كما فعل المسلمون في الحصون التي فتحوها ، والتي كانت بيد الصليبيين.
وأما الراية الصليبية فيصفها ابن شداد الذي راها محمَّلةً على عربةٍ ، ويقول: وعلم العدو مرتفعٌ على عجلةٍ هو مغروس فيها ، وهي تسحب بالبغال ، وهم يذبُّون عن العلم ، وهو عالٍ جداً كالمنارة خرقته بياض ، ملمعٌ بحمرةٍ على شكل الصُّلبان. أي: إن العلم الصليبي كان يشبه علم منظمة الصليب الأحمر الدَّولية الآن.
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي: