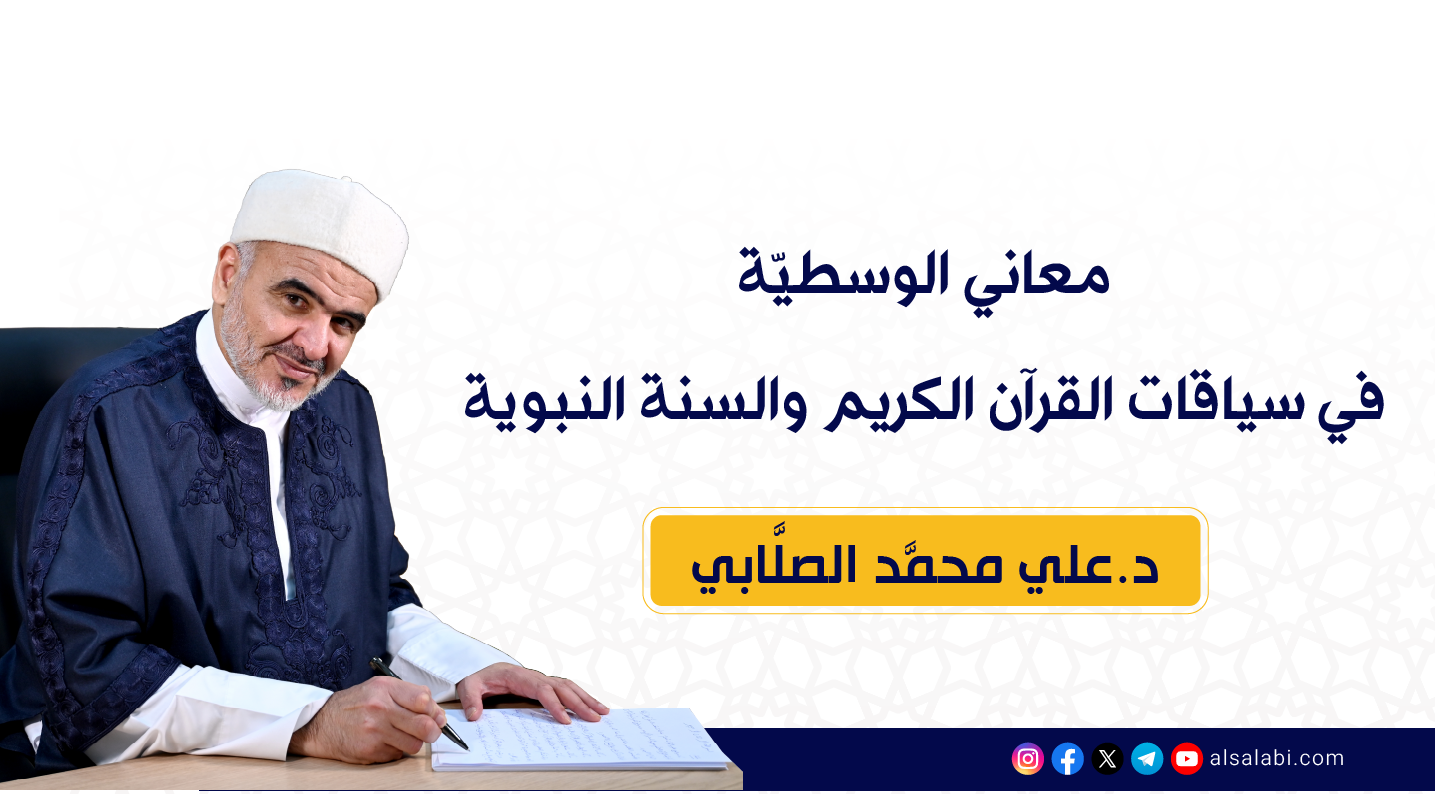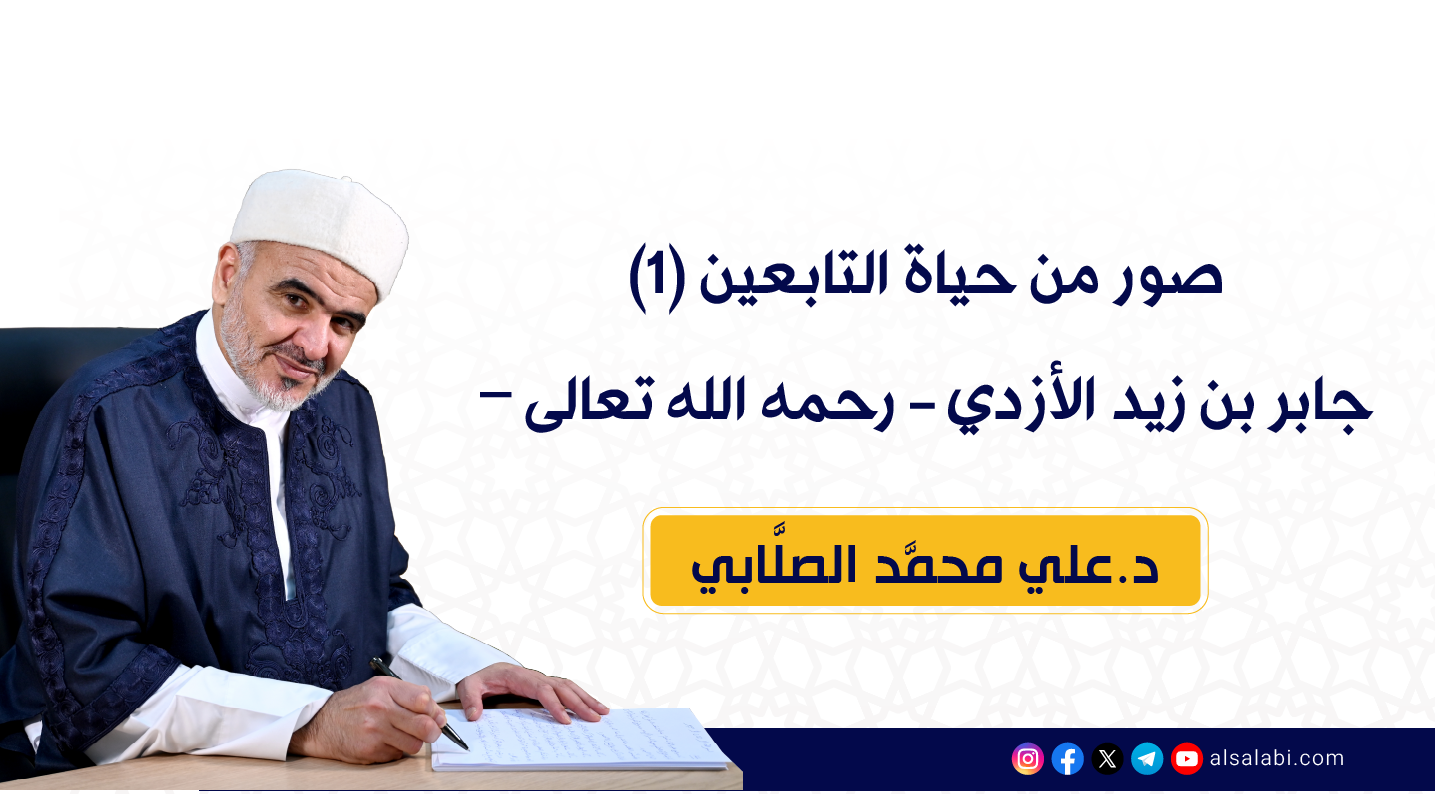الفصل بين السلطات في الإسلام
بقلم: د. علي محمد الصلابي
لا يخفى على الباحثين في الفكر الإسلامي أن الرسول (ﷺ) كان يجمع بين الوظائف الثلاث، فقد كان مشرعاً بتبليغه عن الله عز وجل آياته وأحكامه وبتفصيل مجمله، ومشرعاً ابتداء فيما لا نص فيه من الكتاب، وكان يتولى تنفيذ الأحكام بنفسه، ويقضي بين الناس بما أراه الله، إلا أن تصرفاته كانت منفصلة وظيفياً وإن كانت مجتمعة في شخصه (ﷺ)، وقد بين هذا الفصل الوظيفي فقهاء الإسلام، وميزوه عن بعضه، يقول أحمد بن إدريس القرافي، وهو يبين الفصل الوظيفي لأعماله وتصرفاته (ﷺ): اعلم أن رسول الله (ﷺ) هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو (ﷺ) إمام الأئمة، وقاضي القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصباً منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أنه غالب تصرفاته (ﷺ) بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب عليه، ثم تقع تصرفاته (ﷺ) منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعداً، فمنهم من يقلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى... إلخ.
ثم ذكر ما ينتج عن التفريق بين تصرفاته من اثار في الشريعة، فوصف القرافي للنبي (ﷺ) بأنه الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم بيان وتمييز للوظائف الثلاثة التي تحملها النبي (ﷺ) الإمام الأعظم: وصف له بأنه على رأس السلطة التنفيذية.
وكونه (ﷺ) القاضي الأحكم: وصف له بأنه كان على رأس السلطة القضائية، والتي لا تنفصل كثيراً عن السلطة التنفيذية.
وكونه (ﷺ) المفتي الأعلم، وصف له بأنه كان على رأس السلطة التشريعية[(1)].
ويوضح ذلك محمد علي بن حسين المكي المالكي في حاشيته على الفروق في مسائل أربعة فذكر المسألة الأولى، وهي: ما تصرف فيه عليه الصلاة والسلام بوصف الإمامة الذي هو التنفيذ لأعلى وجه ـ فصل القضاء والإبرام والإمضاء ـ كبعث الجيوش لقتال الكفار، ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه الصلاة والسلام.
وكل ما تصرف فيه عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء الذي هو تنفيذ على وجه القضاء والإبرام والإمضاء، كفصله (ﷺ) بين اثنين من دعاوى الأموال، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به (ﷺ)، وكل ما قاله (ﷺ)، أو فعله (ﷺ) على سبيل التبليغ والفتوى الذي هو التعريف، كتصرفه (ﷺ) في العبادات؛ يكون حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة[(2)].
وبهذا اتضح لنا أن مبدأ فصل السلطات وظيفياً كان معروفاً لدى فقهاء الإسلام، وأما فصلها عضوياً بحيث لا يتولى السلطة التنفيذية من يتولى السلطة القضائية، فلم يكن مطبقاً في عهد الرسول (ﷺ) لعدم الحاجة إليه[(3)].
وإذا كانت النظم السياسية الحديثة بأمس الحاجة إلى مبدأ الفصل بين السلطات؛ باعتباره إحدى ضمانات الدولة القانونية الحديثة؛ بما يؤدي إليه من حماية للحريات عن طريق توزع السلطة بقصد الحد منها، ذلك أن العلة التي من أجلها نادى مونتسكيو وغيره بمبدأ الفصل بين السلطات، هي أن كل فرد بيده سلطة، ينزع بطبيعته إلى إساءة استعمالها، ورتبوا على ذلك أنه لابد من توزيع السلطة بقصد الحد منها[(4)].
ولا مانع من الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات إذا حقق الأهداف المرجوة من ذلك، كضمان الحرية ومحاربة الاستبداد، وتقسيم الأعمال للإتقان، فهذه الأمور من مقاصد الإسلام والنظام.
ومسألة النزوع إلى إساءة استعمال السلطة هي مسألة سلوكية بمعنى أنه اعوجاج في سلوك الإنسان، وأن الأصوب معالجة هذا الاعوجاج لا تركه، والإسلام عالج ذلك بتقرير جملة من القواعد والمبادئ، وهي مزيج من النظام القانوني، والخلقي، والروحي.
الأولى: إن من بيده السلطة في النظام الإسلامي لا تكون إرادته هي القانون، فيعسف أو يستبد، وإنما هو (منفذ) فقط لشريعة قائمة لا يملك التقدم عليها أو التأخر عنها.
والثانية: إن الإسلام لا يولي السلطة إلا الكفء، الأمين، وأساس الكفاءة القدرة على ما يتولاه، ومعنى الأمانة عدم التفريط بشؤون ما ولي عليه، ومراقبة الله تعالى، وخشيته فيه، وقد أشار القران الكريم إلى المبدأ الواجب مراعاته في تولية الأمور، فقال تعالى: ِ {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [5] .
والثالثة: إن إساءة استعمال السلطة عليها جزاءان:
الأول ـ أخروي يتمثل في عقاب الله تعالى.
والثاني ـ دنيوي يتمثل في حق الأمة في خلعه ومحاسبته على أخطائه وعداوته.
إن منع الاستبداد في الإسلام فرض كفاية على الأمة، وسيادة الشريعة الإسلامية؛ أصل من أصول الدين، والحكام في الإسلام لا يملكون سلطة التشريع، بمفهومه الوضعي أو الاصطلاحي الفقهي القديم ـ وإنما مهمتهم هي تنفيذ أحكام التشريع بمعنى الشريعة، والالتزام بها، وإلزام غيرهم بها، حيث يكون التشريع بمعنى الشريعة الإسلامية صاحبة السيادة العليا في المجتمع، وباب الاجتهاد فيه مفتوح لأهل الاجتهاد مما يحقق المصالح، ويدفع المفاسد مع مراعاة تغير الأزمان والأحوال؛ إلا أن تقنين القوانين ضروري طالما كانت الشريعة الإسلامية هي مصدره، وإلا تعسر على القضاة أداء وظيفتهم، واختل ميزان العدالة، وهو ما يسمى قضية (تقنين الشريعة) التي أصبحت مطلباً شعبياً عاماً؛ كما هي مطالب رجال القانون والفقه والقضاء في مصر وغيرها من الدول الإسلامية[(6)].
المصادر والمراجع:
ـ[1]السلطة التنفيذية، محمد الدهلوي (1 / 296).
ـ[2]تهذيب الفروق (1 / 206) محمد حسين المكي المالكي.
ـ[3]السلطة التنفيذية للدهلوي (2 / 297).
ـ[4]النظام السياسي الإسلامي، منير البياتي ص 163.
ـ[5]المصدر السابق ص 164.
ـ[6]الحسبة في الإسلام، فريد عبد الخالق ص 234.
ـ[7]البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة، علي محمد الصلابي، دار المعرفة بيروت، ص 27-33.