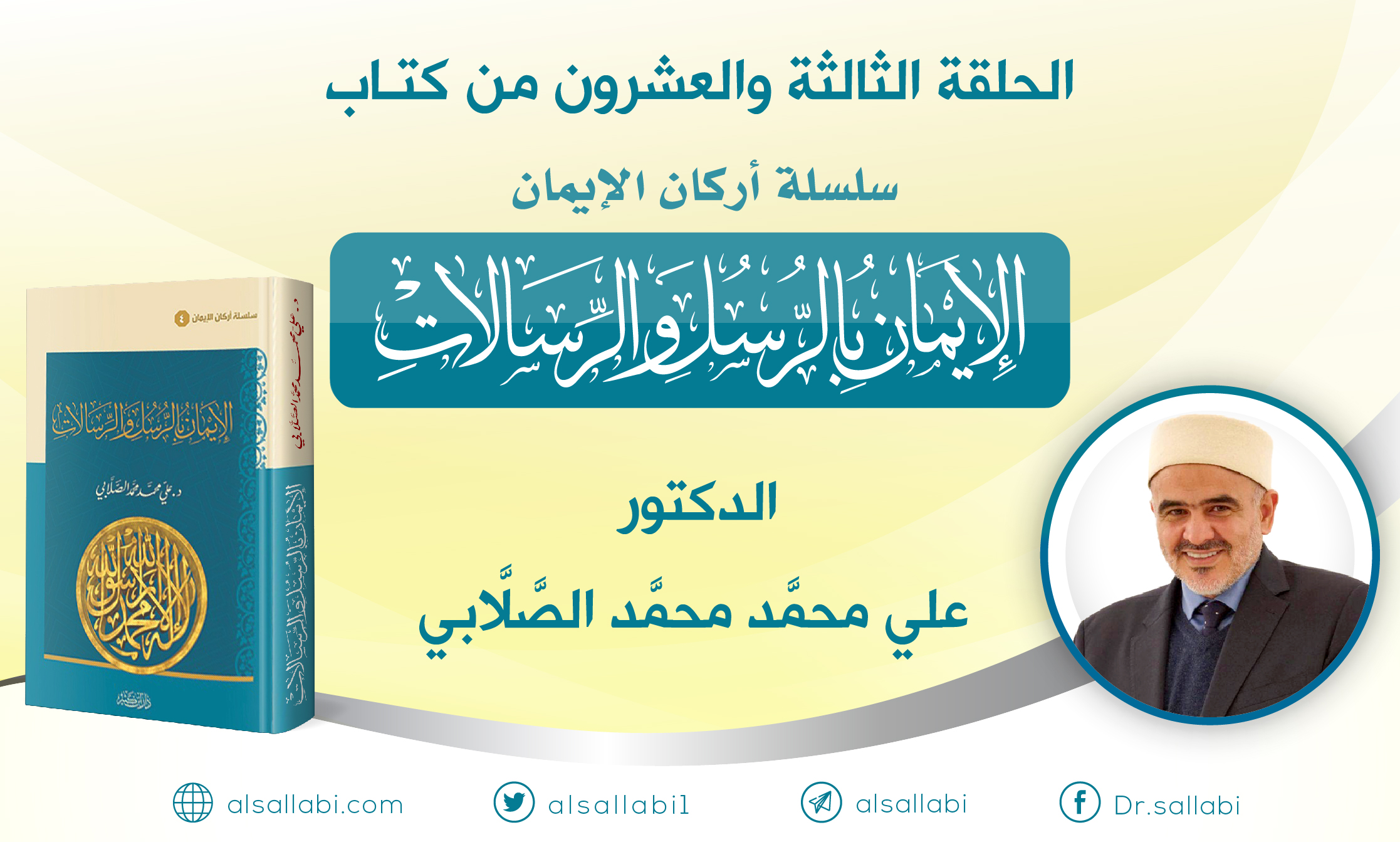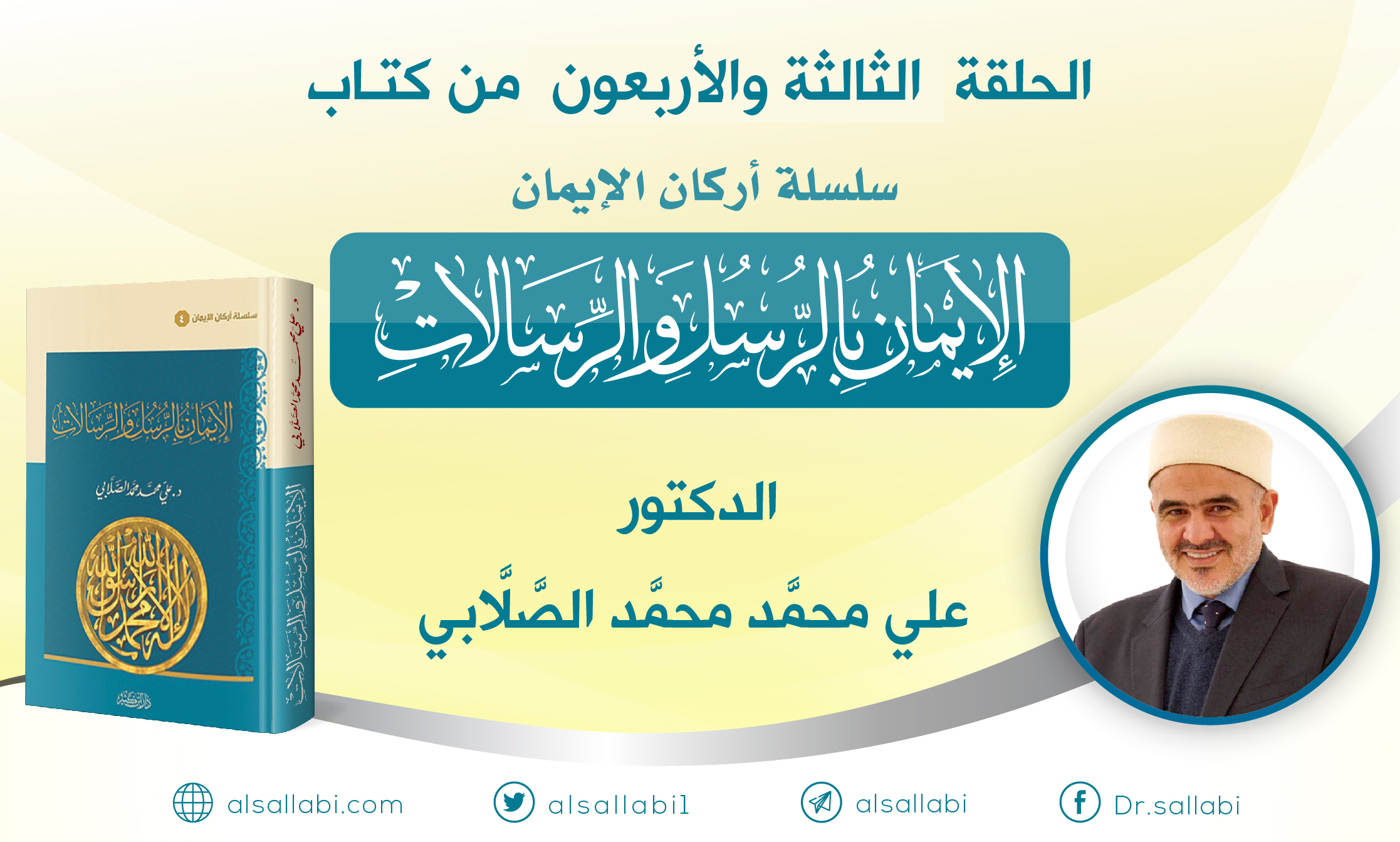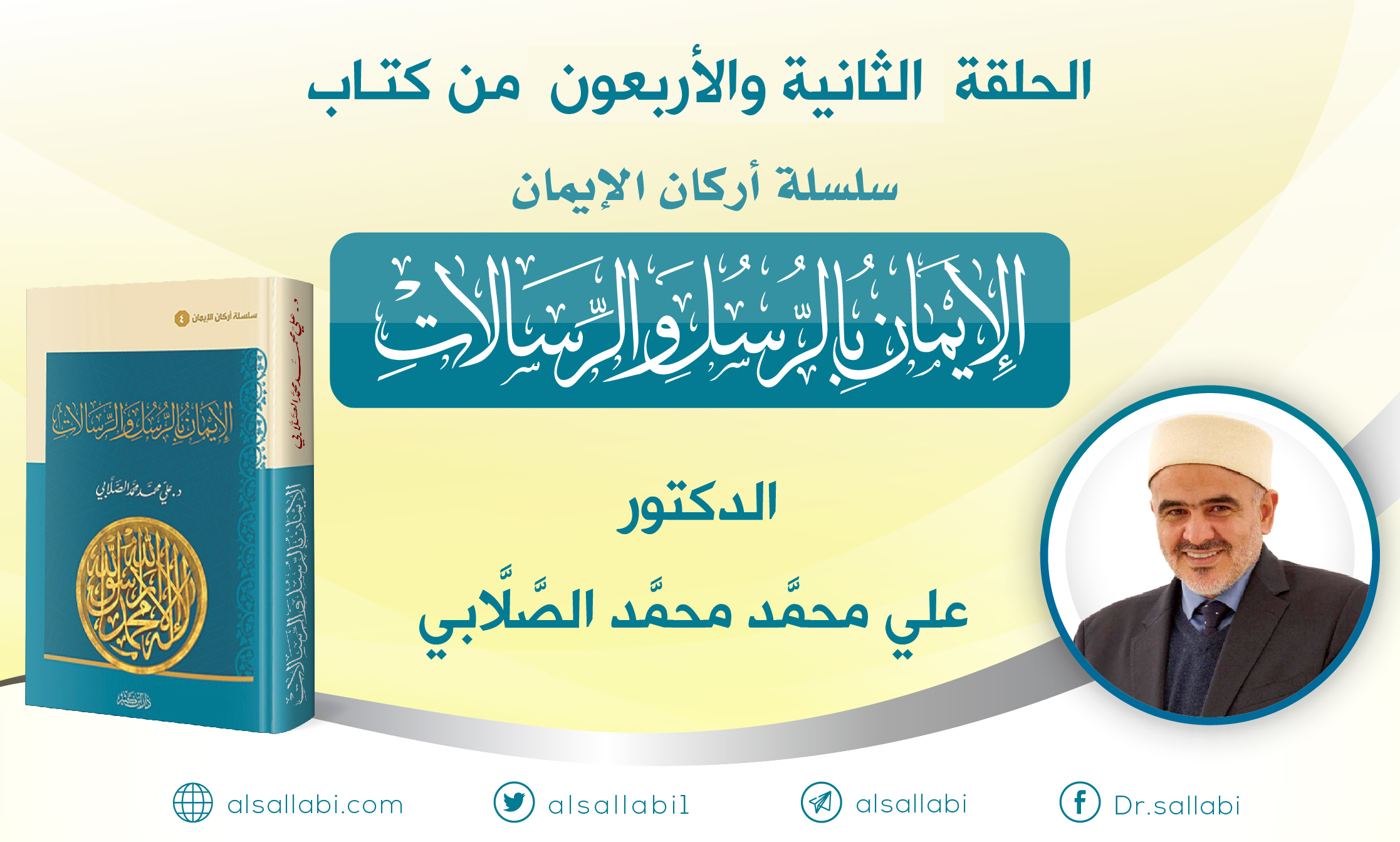شدة تعظيم الأنبياء لله عزّ وجل وخوفهم منه
الحلقة: الخامسة والعشرون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يوليو 2020
مما يلفت الانتباه في حياة الأنبياء شدةُ تعظيمهم لله عز وجل، وخوفهم منه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
أ ـ مناجاة نوح عليه السلام لربّه بشأن ابنه:
قال تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَال يانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ *قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ *}[هود: 45 ـ 47].
ويظهر من هذه الايات علمُ نوح عليه السلام بربه عزّ وجلّ ، والذي أثمر عنده هذا الأدبَ العظيم مع ربِّه ، والخوف منه سبحانه ، فتراه وهو يدعو ربّه بشأن ابنه الهالك مع الكافرين يختمُ دعاءَه بقوله: {وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ *} ، ولم يقل: وأنت أرحم الراحمين ، وهذا من كمال علمه عليه السلام بأسماء الله عزّ وجلّ وصفاته واثارها ، لأنّ المقام مقام تفويض واستسلام لحكمة الله البالغة ، التي اقتضت أن يكون ابنُ نوح مع الهالكين ، ولم يكن مع الناجين ، ولذلك ختم نوح عليه السلام دعاءه بقوله: . {وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ *}
كما يظهر في هذه المناجاة خوف نوح عليه السلام من ربه ، واتهامه لنفسه بالظلم ، وطلبه المغفرة من ربه سبحانه ، وذلك في قوله: الله أكبرُ! هذا نوحٌ عليه السلام الذي أمضى تسعمئة وخمسين عاماً في دعوة {وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ *} ، وصبر وصابر ، وناله من الأذى والاستهزاء الشيءَ العظيم ، ومع ذلك يختم دعوته بطلب المغفرة والرحمة من ربّه سبحانه: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا *} [نوح : 28].
ب ـ محاجّة شعيب عليه السلام لقومه ، وردّه عليهم عندما خيّروه بين الخروج من قريتهم ، أو العودة في ملتهم:
قال الله عز وجل: {قَالَ الْمَلأَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ} {آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ *}[الأعراف: 88 ـ 89].
أي: يمتنعُ عن مثلنا أن نعودَ فيها ، فإن هذا من المحال ، فايسهم عليه السلام من أن يوافقهم من وجوهٍ متعددة:
من جهة أنّه هو ومن معه كارهون لملّتهم ، مبغضون ما هم عليه من الشرك.ومن جهة ثانية جعل ما هم عليه كذباً ، وأشهدهم أنّه إن اتبعهم وهو من معه فإنّهم كاذبون ومنها اعترافهم بمنّةِ الله عليهم ، إذ أنقذهم الله منها.
ومنها أنّ عودتهم في ملّتهم بعد أن هداهم الله ـ من المحالات ، بالنظر إلى حالتهم الراهنة ، وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى ، والاعتراف له بالعبودية ، وأنّـه الإله وحده ، الذي لا تنبغي العبادةُ إلاّ له وحده ، لا شريك له ، وأنَّ الهةَ المشركين أبطلُ الباطل ، وأمحلُ المحال ، لأنّ الله منَّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال.
وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله ، وإرادته النافذة في خلقه ، التي لا خروجَ لأحدٍ عليها ، ولو تواترت الأسباب ، وتوافقت القوى ، فإنّهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه ، ولهذا استثنى {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا} ، أي: فلا يمكننا ولا غيرُنا الخروج على مشيئته التابعة لحكمه وحكمته ، قال تعالى: {وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} ، فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه.
ونلاحظ في الايات الكريمة: أنَّ شعيباً بقدر ما يرفعُ رأسَه ، وبقدر ما يرفع صوتَه في مواجهةِ طواغيت البشر من الملأ الذين استكبروا من قومه ، بقدر ما يخفِضُ هامته ، ويسلّم وجهه في مواجهة ربه الجليل ، الذي وسع كل شيء علماً ، فهو في مواجهة ربه ، لا يتألّى عليه ، ولا يجزمُ بشيءٍ أمامَ قدره ، ويدع له قيادة زمامه ، ويعلن خضوعه واستسلامه: {إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} ، إنّه يفوّض الأمرَ لله ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه ، إنّه يملك رفضَ ما يَفْرِضُه عليه الطواغيتُ من العودةِ في ملّتهم ، ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ، ويعلن الاستنكارَ المطلقَ للمبدأ ذاته ، ولكنّه لا يجزمُ بشيءٍ عن مشيئة الله به وبهم ، فالأمرُ موكولٌ إلى هذه المشيئة ، وهو والذين امنوا معه لا يعلمون ، وربّهم وسعَ كل شيء علماً ، فإلى علمه ومشيئته تفويضُه واستسلامُه.
إنّه أدبُ وليِّ الله مع الله، الأدب الذي يلتزم به أمره ، ثم لا يتألّى بعد ذلك على مشيئته وقدره ، ولا يتأبّى على شيء يريدُه به ، ويقدّره عليه.
وهنا يدع شعيبُ طواغيتَ قومه وتهديدَهم ووعيدهم، ويتّجه إلى وليه بالتوكل الواثق يدعوه أن يفصلَ بينه وبين قومه بالحق
ج ـ تعظيم موسى عليه السلام لربه وخوفه منه:
قال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143].
وفي قوله تعالى: { وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ } إذا تجلّى الله له {فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل} الأصمّ الغليظ {جعله دكاً} أي: انهال مثل الرمل ، انزعاجاً من رؤية الله ، وعدم ثبوته لها {وَخَرَّ مُوسَى} حيث رأى ما أرى {صعقاً} أي: مغشياً عليه {فلما أفاق} تبيّن له حينئذٍ أنّه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله ، فموسى أولى أن لا يثبتَ لذلك ، فاستغفرَ ربَّه لما صدرَ منه من السؤال الذي لم يوافق موضعاً ، لذلك {قَالَ سُبْحَانَكَ} أي: تنزيهاً لك، وتعظيماً عما لا يليق بجلالك {تُبْتُ إِلَيْكَ} من جميع الذنوب، وسوءِ الأدبِ معك {وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين} أي جدد عليه السلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك.
د ـ تعظيم عيسى عليه السلام لربه سبحانه، وأدبه مع ربه عز وجل:
وذلك عن سؤال الله عز وجل له يوم القيامة وهو أعلم {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [المائدة : 116].
قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ *إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *}[المائدة: 116 ـ 120].
وفي هذه الايات الكريمة من المعاني الشريفة اللطيفة ما يحتاجُ إلى تأمل وتدبر ، ففي ردّ عيسى عليه السلام من التعظيم والتنزيه والأدب لربّه عزّ وجلّ ما يدلُّ على معرفته لخالقه الكريم.
وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله ، وخطابهم وسؤالهم ، كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟.
قال المسيح عليه السلام: ولم يقل: لم {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} ، وفَرْقٌ بين الجوابين في حقيقة الأدب ، ثم أحال الأمرَ على علمه سبحانه بالحال وسره ، فقال: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} ، ثم برّأ نفسَه عن علمه بغيب ربه ، وما يختصّ به سبحانه ، فقال: ثم أثنى على {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي} ، ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها ، فقال: ثم نفى أن يكونَ قال لهم غير {وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} أمره ربُّه به ـ وهو محض التوحيد ـ فقال: {إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ *} ، ثم أخبرَ عن شهادته عليهم مدّةَ مقامه فيهم ، وأنّه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم ، وأنّ الله عزّ وجلّ وحدَه هو المتفرّدُ بعد الوفاة بالاطلاع عليهم ، فقال: ثم وصفه بأنّ شهادته سبحانه فوق كل شهادة {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} ، فقال: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} ، ثم قال: وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} ، أي شأن السيد رحمةُ عبيده ، والإحسان إليهم ، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك ، فإذا عذّبتهم ـ مع كونهم عبيدك ـ فهذا عدلك ، فلولا أنهم عبيدُ سوءٍ من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم ، لأنّ قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته ، فلماذا يعذّب أرحمُ الراحمين؛ وأجودُ الأجودين؛ وأعظمُ المحسنين: عبيدَه لولا فرط عتوّهم وإبائهم عن طاعته ، وكمال استحقاقهم العذاب ، ثم قال: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ} ، ولم يقل:
الغفور الرحيم ، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى ، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم ، والأمر بهم إلى النار ، فليس المقام مقام استعطافٍ ولا شفاعةٍ ، بل مقامِ براءة منهم. فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعرَ باستعطافه ربَّه على أعدائه الذين قد اشتدّ غضبه عليهم ، فالمقامُ مقامُ موافقةٍ للربِّ في غضبه على مَنْ غضب الربُّ عليهم ، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يُسألُ بهما عطفه ورحمته ومغفرته ، إلى ذكر العزّةِ والحكمة المتضمنتين لكمالِ القدرةِ وكمالِ العلم.
والمعنى: إن غفرتَ لهم فمغفرتُك تكونُ عَنْ كمالِ القدرة والعلم ، وليست عن عجزٍ عن الانتقام منهم ، ولا عن خفاءٍ عليك بمقدار جرائمهم ، وهذا لأن العبد قد يغفِرُ لغيره لعجزٍ عن الانتقام منه ، ولجهله بمقدار إساءته إليه ، والكمالُ: هو مغفرةُ القادر العالم ، وهو العزيزُ الحكيم ، وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عينُ الأدبِ في الخطاب.
هـ تعظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وخوفه منه:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فوالله إنِّي لأعلمُهم بالله ، وأشدُّهم له خشية».
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً».
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفتِ الريحُ قال: «اللهم إنِّي أسألُكَ خَيْرَها ، وخَيرَ ما فيها ، وخيرَ ما أرسلتْ به ، وأعوذُ بكَ من شرِّها ، وشرِّ ما فيها ، وشرِّ ما أُرسلتْ به».
قالت: وإذا تخيّلت السماءُ تغيّرَ لونه ، وخرجَ ، ودخلَ وأقبل وأدبرَ ، فإذا أمطرت سُرِّي عنه ، فعرفت ذلك عائشة ، فسألته فقال: «لعلّه يا عائشة» فسألته فقال؛ «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}[الأحقاف: 24]».
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب:
الإيمان بالرسل والرسالات
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/upload/file/doc/Book94(1).pdf