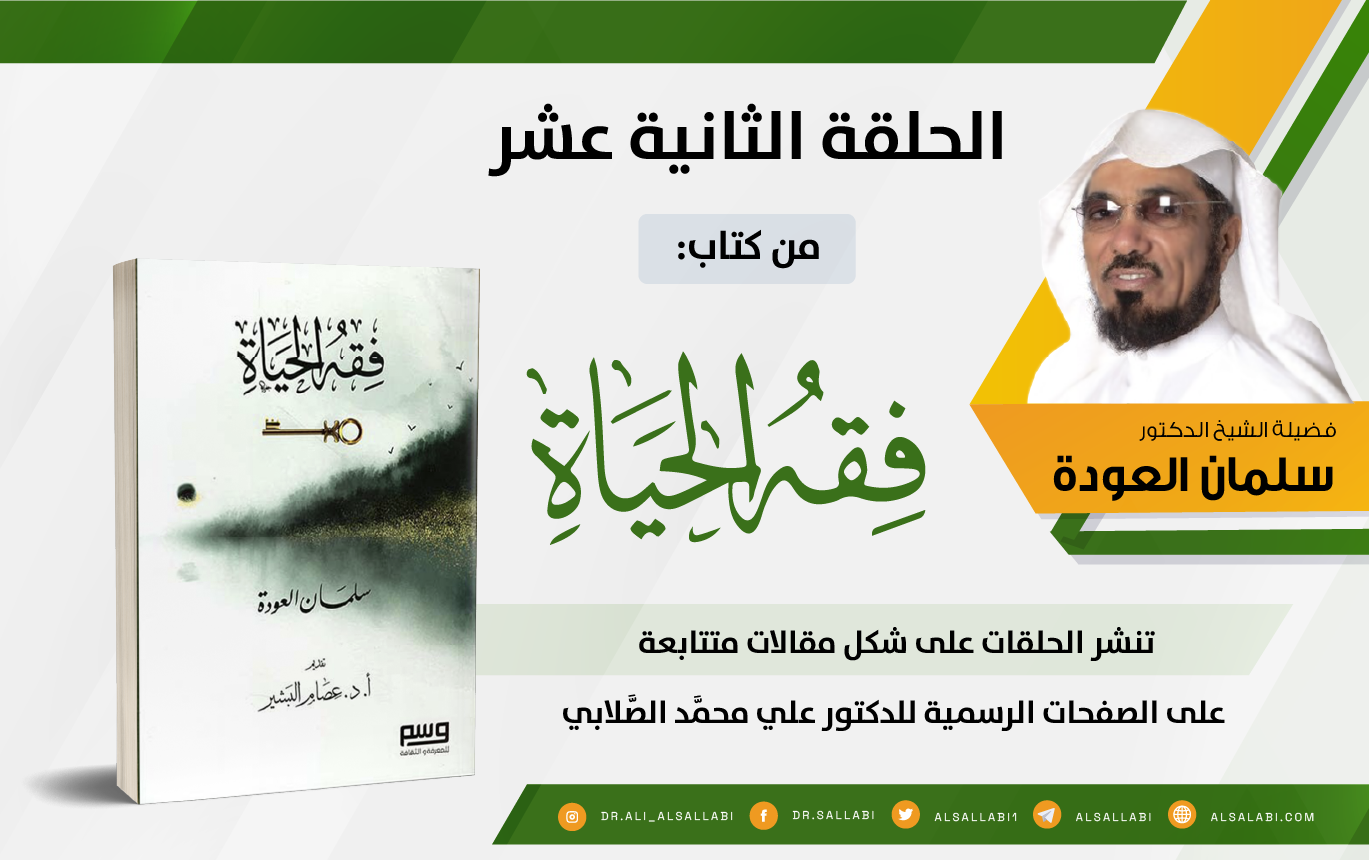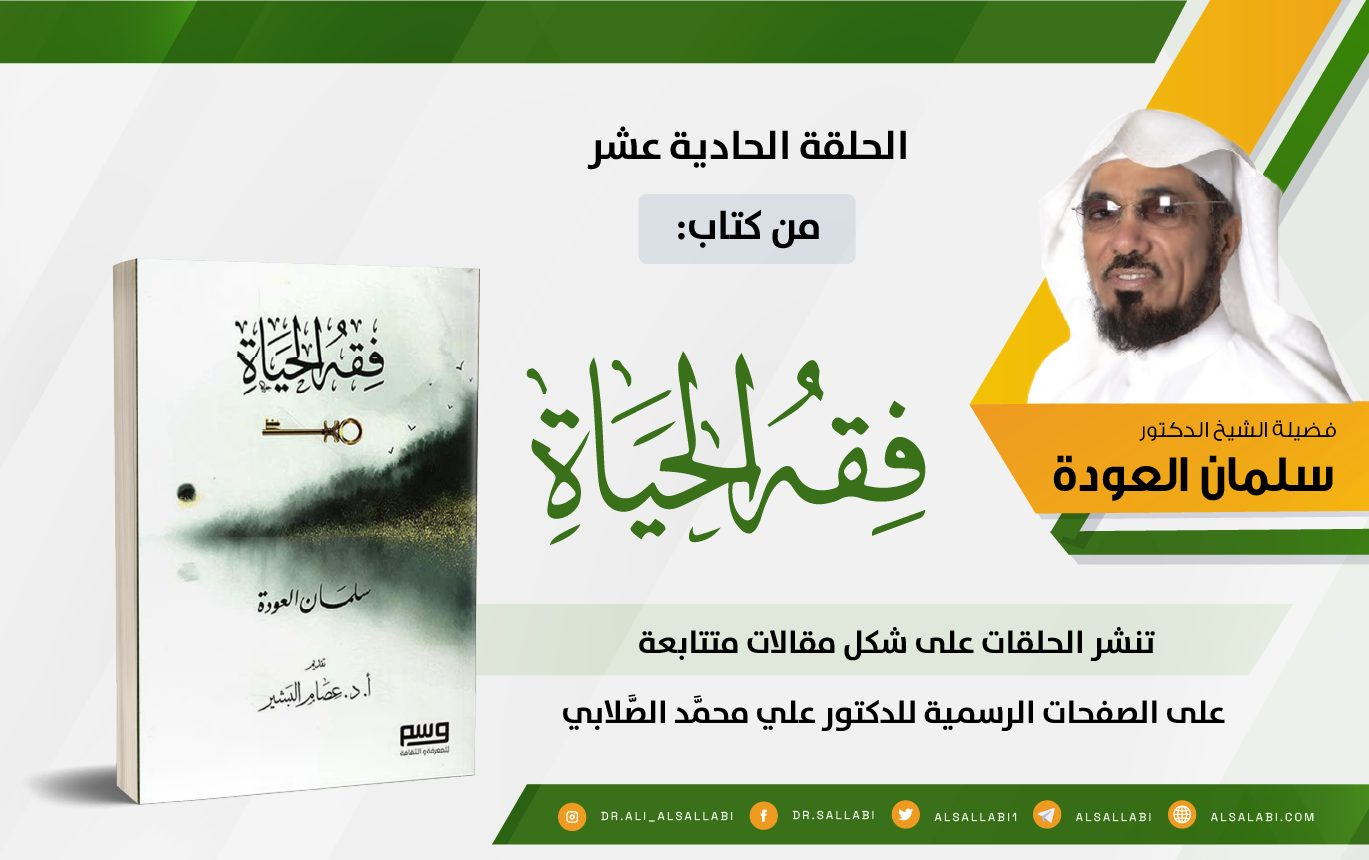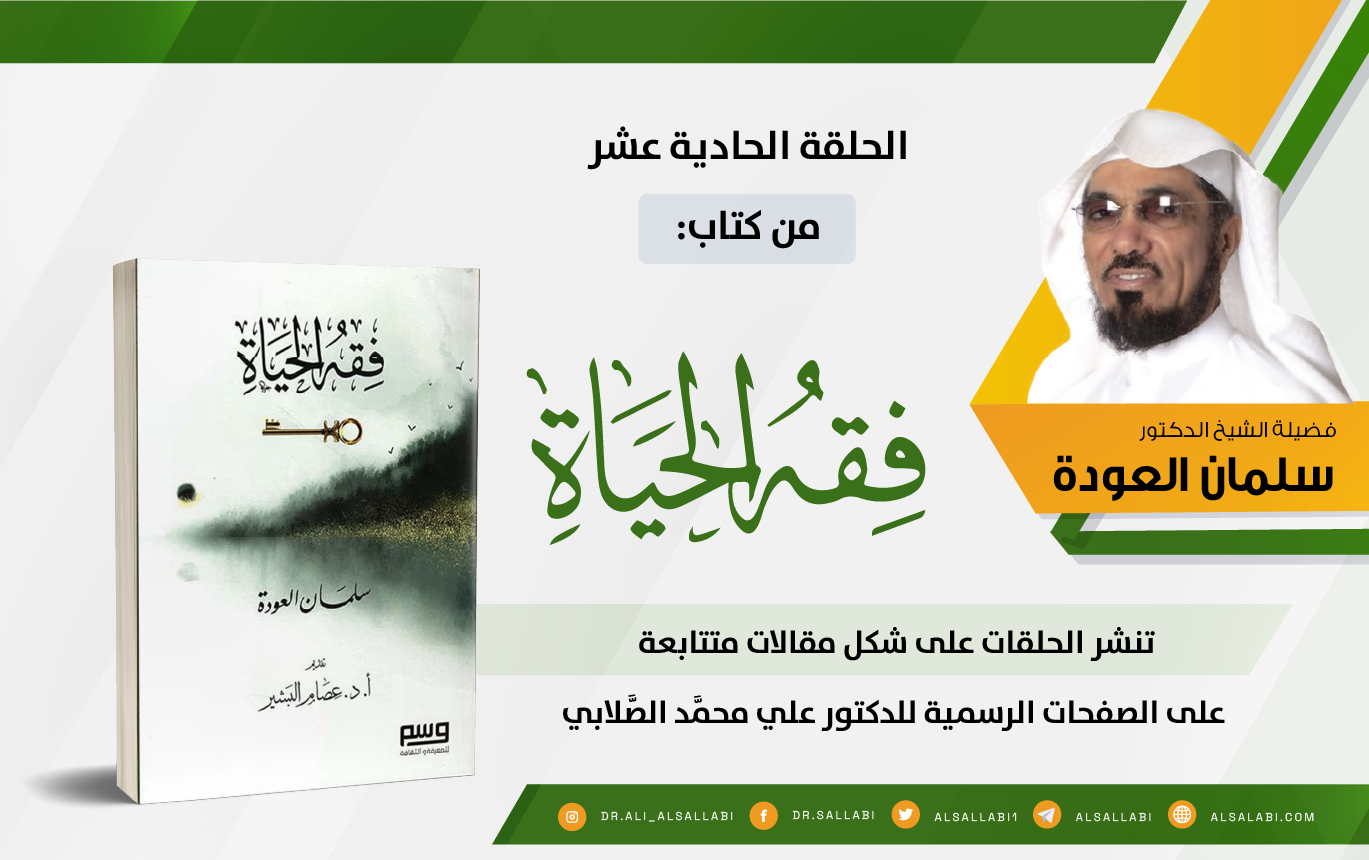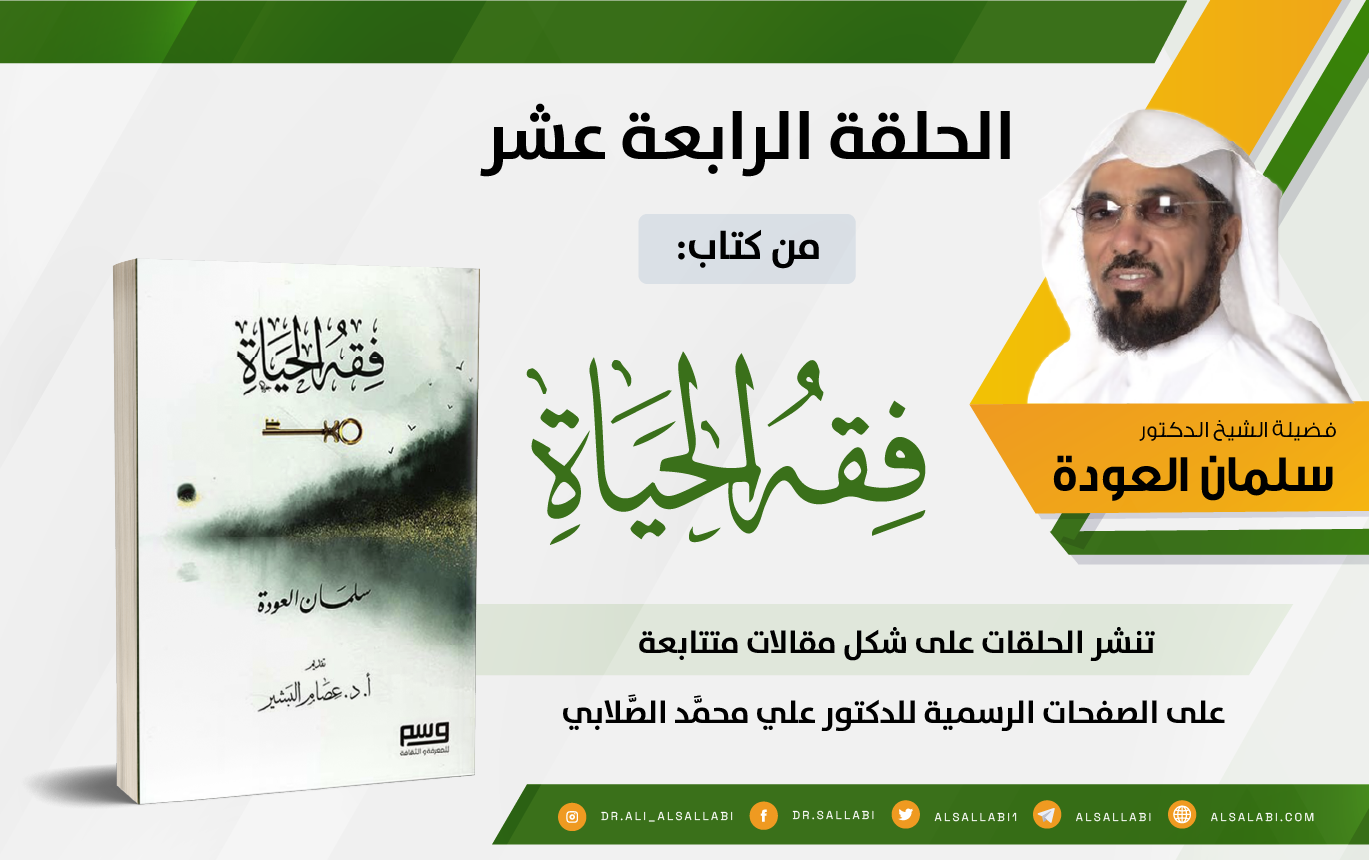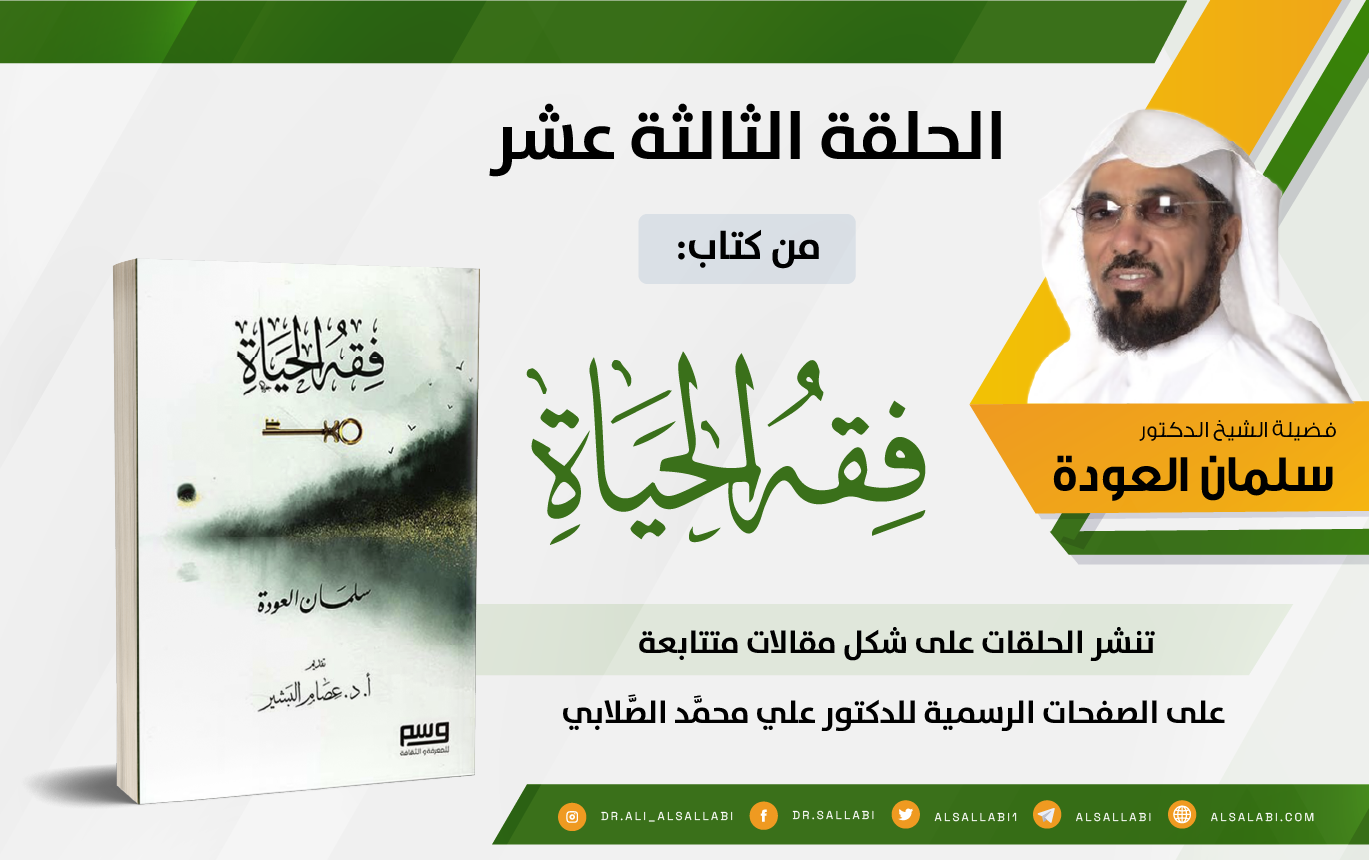(حقيقة الخلاف الذي أقرَّته الشريعة)
اقتباسات من كتاب "فقه الحياة" لمؤلفه الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة (فرج الله عنه)
الحلقة: الثانية عشر
ذو الحجة 1444ه/ يوليو 2023م
الناظر في آيات القرآن الكريم، يجد أنَّ الله عز وجل ذكر الخلاف والنزاع في مورد الذمِّ كثيرًا، وذكره أحيانًا على أنه حالٌ تَعْرِضُ للمؤمنين، كما في قوله عز وجل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾، وقوله عز وجل: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّـهِ﴾.
وهذه الحال العارضة المقبولة هي التي تقع بين علماء الأُمَّة من الصحابة فَمَن بعدَهم، ومثلُ هذا لا يُوْجِب الذمَّ، ولا الطّعْنَ، ولا التأثيم باتفاق العلماء.
فإنَّ مَن عُلِمَ منه الاجتهادُ السائغ، لا يجوز أن يُذْكَر على وجه الذمِّ والتأثيم، حتى لو عُلِمَ خطؤه، فإنَّ الله قد غفر له هذا الخطأ، وأصلُ اجتهادِه محمود في الشريعة، وهو متردِّد بين أجر وأجرين، كما ثَبَتَ في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الـمُتَّفق على صحته.
وتحريم الطعن والذمِّ لا يُوجِب قبولَ الخطأ، ولا تَرْكَ البيان، كما قرَّر هذا المعنى وبَسَطَه غيرُ واحـد من العلماء.
وليس مِن شرع الله ولا قَدَرِه، أن يَتَّفِق علماء الأمَّة في سائر مواضع الاجتهاد، فمَن لم يَقْدُر لهذا المقام قَدْرَه؛ فقد اتَّخذ العلمَ بغيًا، وهذا مِن أعظم أسباب الفساد الذي وقع لأهل الكتاب، وخرجوا به عن حقيقة الإسلام الذي بُعث به جميع المرسلين، ولهذا قال عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّـهِ الْإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
وإذا كان المجتهدون يُؤمَرون بالتَّعَاذُر، وعدم الطعن على المخالِف؛ فكيف بالعامَّة الذين لا اجتهادَ لهم أصلًا، وإنما فاضِلُهم مقلِّدٌ لأهل العلم!
إن الخلاف الـْمَبْنيَّ على مقام الديانة والعلم، وهو: اختلاف أهل الاجتهاد الـْمُعْتَبَرِ في الأُمَّة، إذا تحوَّلت الآراء فيه إلى ولاءات خاصَّة، ومفهومات للحزبيَّة والطائفيَّة؛ فإنه يخرج بذلك عن كونه رحمةً ومُتَابعةً لحكم الله ورسوله ﷺ؛ ليكون تمزيقًا لأهل الإسلام، ورجوعًا إلى أمور الجاهليَّة، واتباعًا لسنَّة أهل الكتاب المنحرفين عن هَدْي أنبيائهم.
ومما يجب على أهل العلم فِقْهُهُ وتعليمه للناس: ألا تُسْتَباح قواعدُ الشريعة ومقاصدُها بالمخالفة والردِّ لتأويلٍ يستعملُه ناظر، ولو كان حَسَنَ القصد والإرادة.
ومما يدركه الـمُتَأمِّل: أن جُلَّ البغي في الأمَّة، يحصل بسبب تأويل سائغ عند أصحابه، ولكنَّهم تَحَلَّلوا به مِن عواصم الشريعة، ومُحْكَمَاتها؛ لمعنًى غَلَبَ في نفوسهم، تزيدُه الغيرة، وينقُصُه العلم.
وإذا كان كلُّ عاملٍ صادق في هذه الأمَّة يَعنيه أَمْرُ اجتماعها والتفافها، وتَرْكُ التنازع والاختلاف المذموم بين خاصَّتها، خصوصًا في أزمنةِ الضائقة والضعف وتسلُّط العدوِّ؛ فإنَّ مِن المعلوم قَدَرًا وشرعًا أنَّ هذا الاتفاق لا يكون باتِّحاد القول في مفردات المسائل وآحادها؛ إذْ هذا لم يقع لأبي بكر وعمر والراشدين، ولا للخيرة مِن أصحاب محمد ﷺ حالَ حياته؛ إذ اختلفوا في تفسير هذا الحرف: «لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظةَ».
ومعظمُ المسائل التي اختلف فيها مَن بعدَهم في أبواب الفقه أو التفسير أو غيرهما، فإنما قَفَوا بذلك أثرهم، وكان لهم متبوع مِن الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا الاختلاف راجعٌ إلى اختلافٍ في قَدْرِ العلم وسَعَتِه، أو اختلاف في تكوين العقل ومَدْرَكِه وحِدَّتِه، أو اختلاف في الطبع وما يغلب على المرء من الحال والمزاج، أو اختلاف في الموقف والظرف المحيط بالمجتهد..
كما أنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل شريعَته وكتابَه على مُقْتَضى قواعد اللغة التي يكون فيها ما هو قطعيُّ الدّلالة، وما ليس كذلك، وما هو مُفَسَّر، وما هو مُجْمَل، وما هو مُحْكَم، وما هو مُتَشابه، وما هو ناسخ، وما هو منسوخ، ولو شاء لجعلَها حرفًا واحدًا لا يختلف عليه الناس، غير أنه عزَّ وجلَّ أنزلها لناس خَلَقَهم، وهو أعلم بهم، ﴿أَلا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ولهذا جمع عز وجل بين هذين المعنيين في قوله تعالى: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فهو الخالق المالك المتصرِّف، وهذا مِن معنى الرُّبوبيَّة، وهو الإله المعبود الآمر الناهي، وهذا من معنى الألوهية.
والموقف الذي أوجبته الشريعةُ: أن يعتصم أهل الإسلام بالمنهج الشرعيِّ في فقه الخلاف السائغ، وأن يَسَعَهم ما وَسِعَ الـْمُوَفَّقين مِن أصحاب محمد ﷺ وسَلَفِ هذه الأمة، مِن التوسعة في العذر، وحِفْظِ مقام الأخوة الدينيَّة، وإحسان الظنِّ، وتَرْكِ البغي والتسلُّط، وأن يعتصموا بعِصَم الإسلام الجامعة، ولا يتفرَّقوا بمُوجِب الاجتهادات الخاصَّة، والآراء المتنازعة، ولهذا قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِن النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.
فالأخوَّة الدينيِّة: لفظ جامع ينتظِم كلَّ مَن صحَّ له عَقْدُ الإسلام كائنًا ما كان خطؤه، فمَن كَمُلَ له الإسلام والإيمان كَمُلت له حقوق الأخوَّة، وإلا قُدِّرَ له مِن هذه الحقوق والتولِّي بقَدْرِه.
وهي لا ترتبط بالموافقة أو المخالفة في رأي، أو مذهب، أو اجتهاد إذا كان مِن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.
ولهذا جاء في الآية بعدها قوله عز وجل: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
وهاهنا تجد النهي عن التفرُّق مطلقًا، فالتفرُّق مذموم بإطلاق، حتى جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي ثعلبة الْخُشَنيِّ رضي الله عنه، ما يدُلُّ على النهي عن التفرُّقِ الحسِّيِّ فضلًا عن المعنويِّ، حيث قال رضي الله عنه: كان الناس إذا نـزلوا منـزلًا تفرَّقوا في الشعاب والأودية، فقال ﷺ: «إن تَفَرُّقَكم في هذه الشِّعابِ والأوديةِ، إنَّما ذلكم من الشَّيطانِ». فلم ينـزلْ بعد ذلك منـزلًا إلا انضمَّ بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بُسِطَ عليهم ثوبٌ لعَمَّهم.
وهذا المعنى كثيرُ التردُّد في الكتاب العزيز، خصوصًا حين الحديث عن الأمم الكتابيَّة وما عَرَضَ لها في دينها.
أمَّا عن الاختلاف فلمْ يَرِدِ النهيُّ مطلقًا، بل مقيَّدًا يتبيَّن به أن ثَمَّت خلافًا مردودًا، وخلافًا مقبولًا؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾، فهذا الاختلاف في موضع الذمِّ؛ لأنه إعراضٌ عن البيِّنات والهدى، واتِّباع للهوى، وفي مواضع أخرى رَبْطُ الاختلاف بالبغي والعدوان.
والمطلوب أن يكون ثَمَّتَ اتفاقٌ على الأصول والـْمُحْكَمَات في الشرع التي جاءت جمهرةُ نصوص الكتاب والسنة بتقريرها، وتَوَافَرَ العلماءُ عليها خَلَفًا عن سَلَفٍ، وهو مَحَلُّ الإجماع الثابت المستقرِّ.
ثم يكون الاتِّفاق على طريقة التعامل مع الخلاف؛ بحيث لا يخرج عن إطاره، ولا يُؤَثِّر على حقوق الإخاء الدينيِّ بين خاصَّة المسلمين وعامَّتهم، ولا يُنْتِج تفرُّقًا مذمومًا وبغيًا بين المؤمنين، ولا يمنع من الردِّ والنصيحة والبيان وإظهار الْحُجَّة، دون أن يكون ذلك مُلْزِمًا، أو أنْ يظنَّ به صاحبُه أنه حَسْمٌ لمادَّة الخلاف.
إننا كثيرًا ما نتوجَّع على الوحدة الضائعة، ونقصد بهذا أن يجتمع الناس على ما نظنُّ وما نرى، وهذا ما لم يَتَوَفَّر للخاصَّة مِن أصحاب محمد ﷺ، وأئمَّة السلف الصالح، ولكن في الأزمات الحادَّة التي تضرب الأُمَّة، تمسُّ الحاجة إلى نوع مِن التأليف، وتجاوُز الحظوظ الشخصيَّة، ومقابلة السيِّئة بالحسنة، والاشتغال بالعمل الجادِّ الـْمُثْمِر.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب"فقه الحياة" للشيخ سلمان العودة، صص 39-44