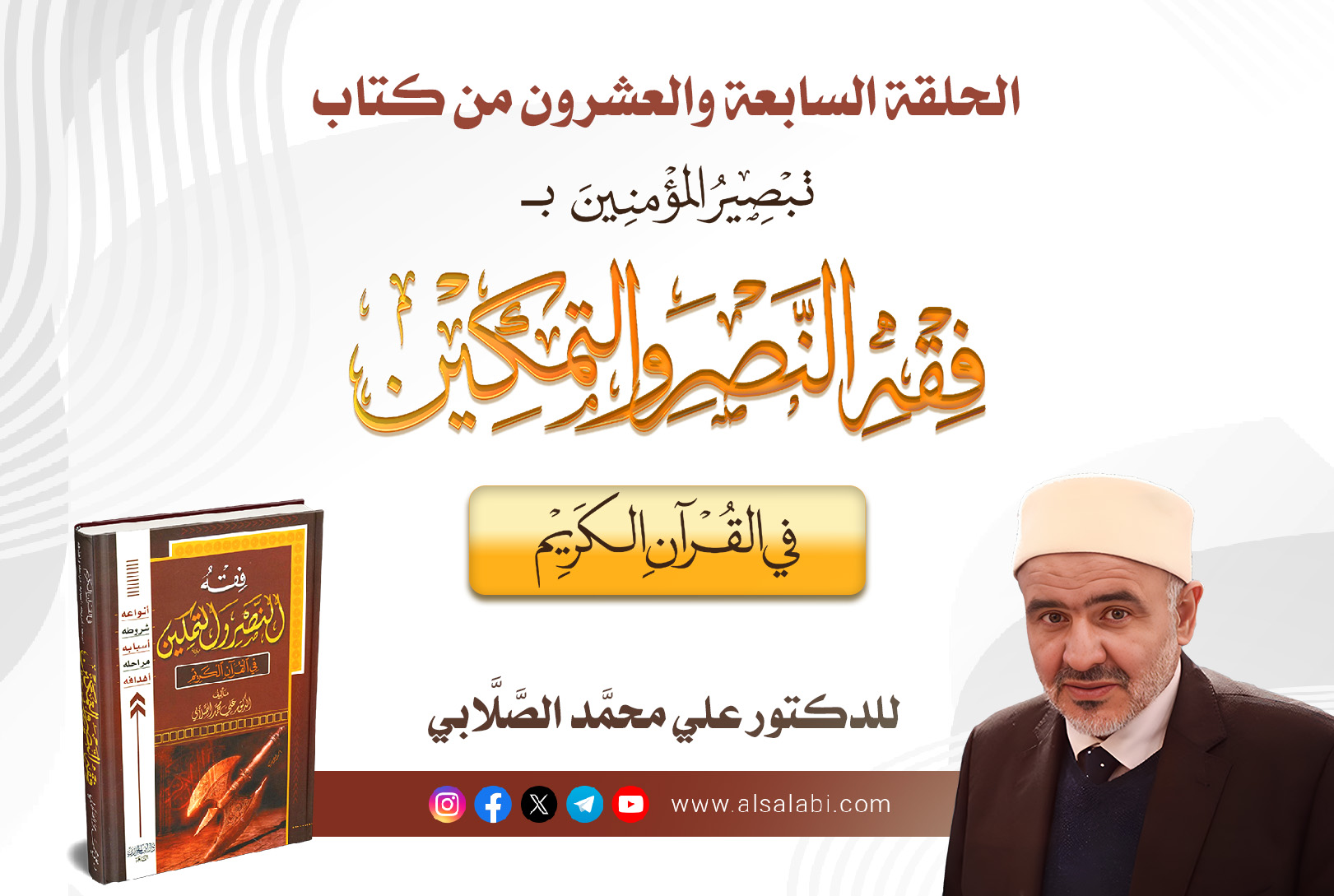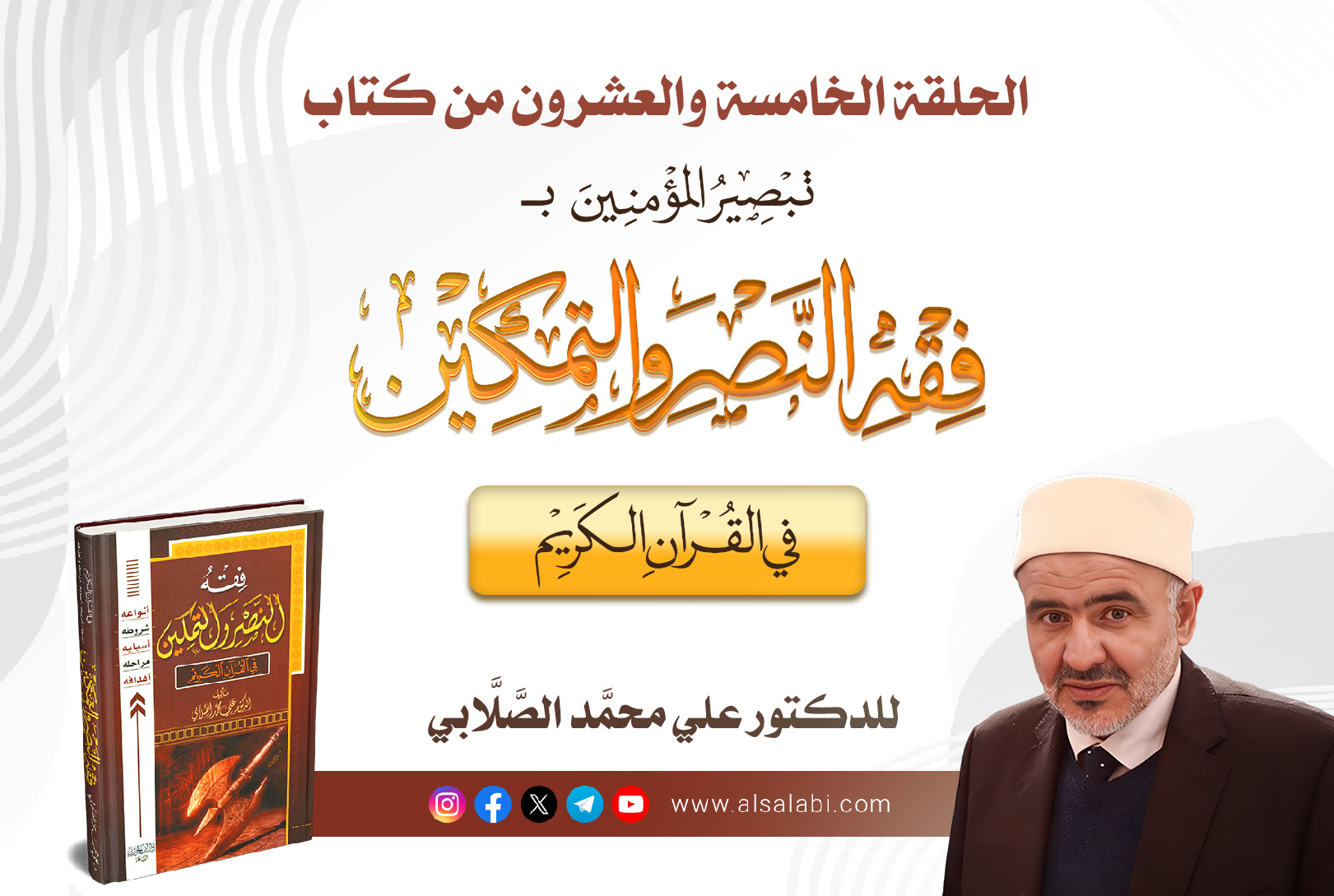فقه إحياء الشعوب في قصة ذي القرنين ..
مختارات من كتاب (فقه النصر والتمكين)
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
الحلقة: السابعة والعشرون
إن حركة ذي القرنين الدعوية والجهادية جعلته يحتك بالشعوب والأمم, وتكلم القرآن الكريم عن رحلاته الإيمانية:
1- الرحلة الأولى:
لم يحدد القرآن الكريم نقطة الانطلاق فيها وحدد النهاية إلى مغرب الشمس, ووجد عندها قومًا, فدعاهم إلى الله تعالى, وسار فيهم بسيرة العدل والإصلاح, قال تعالى: " أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا" [الكهف:87].
إنها سياسة العدل التي تورث التمكين في الحكم والسلطة, وفي قلوب الناس الحب والتكريم للمستقيمين, وإدخال الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم, فالمؤمن المستقيم يجد الكرامة والود والقرب من الحاكم, ويكون بطانته وموضع عطفه وثقته ورعاية مصالحه وتيسير أموره.
أما المعتدي المتجاوز للحد, المنحرف الذي يريد الفساد في الأرض فسيجد العذاب الرادع من الحاكم في الحياة الدنيا, ثم يرد إلى ربه يوم القيامة ليلقى العقوبة الأنكى بما اقترفت يداه في حياته الأولى.
ولم يعين السياق القوم الذين اتخذ فيهم ذو القرنين هذه السياسة الحكيمة كما أهمل ذكر المدة التي مكثها بينهم, والنتائج التي توصل إليها, وكأن الأمر المفروغ منه أن تثمر هذه السيرة العادلة, والمبادئ السامية حضارة ربانية وتقدمًا وسعادة وطمأنينة, لذا لا داعي لذكرها والوقوف عندها (1).
2- الرحلة الثانية:
وهي رحلة المشرق حيث يصل إلى مكان يبرز لعين الرائي أن الشمس تطلع من خلف الأفق, ولم يحدد السياق أهو بحر أم يابسة؟ إلا أن القوم الذين كانوا عند مطلع الشمس كانوا في أرض مكشوفة بحيث لا يحجبهم عن شروقها مرتفعات جبلية أو أشجار سامقة, وذهب الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- إلى أن المقصود " لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا" [الكهف:90], هي بلاد القطب الذي تكون فيه الشمس ستة شهور لا تغيب طوال هذه الشهور ولا يوجد ظلام يستر الشمس في هذه الأماكن (2).
ونظرًا لوضوح سياسة ذي القرنين في الشعوب التي تمكن منها, وهو الدستور المعلن في رحلة الغرب لم يكرر هنا إعلان مبادئه, لأنها منهج حياة ودستور دولة مترامية الأطراف وسياسة أمم, فهو ملتزم بها أينما حل أو ارتحل (3).
3- الرحلة الثالثة:
تختلف عن الرحلتين السابقتين من حيث طبيعة الأرض والتعامل مع البشر وسكان المنطقة, ومن حيث الأعمال التي قام بها, فلم يقتصر فيها على الأعمال الجهادية لكبح جماح الأشرار والمفسدين؛ بل قام بعمل عمراني هائل, أما الأرض فوعرة المسالك, وأما السكان -وكأن وعورة الأرض قد أثرت على طبائعهم وطريقة تخاطبهم مع غيرهم- فهناك في التفاهم والمخاطبة بحيث لا يكاد الإنسان منهم يقدر على التعبير عما في نفسه, ولا أن يفقه ما يحدثه به غيره من غير بني قومه " وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً" [الكهف: 93], إما لسبب في أسلوب التخاطب والتعامل -كما أسلفنا- أو من التخلف الحضاري والبدائية في العادات والمفاهيم والمصطلحات, فلما وجدوا القوة في دولة ذي القرنين والعدل والصلاح في سيرته -وعدل السلطان يفتح أمامه القلوب قبل فتح الجيوش والأمصار- لجأوا إليه بحمايتهم من هجمات تلك القبائل الهمجية المفسدة, قبائل يأجوج ومأجوج التي كانت تشن عليهم هجماتهم من خلف الجبلين المتقابلين من الممر الضيق الذي بينهما, وذلك بإقامة السد بين الصدفين, مقابل خراج يدفعونه إليه في أموالهم, ونظرًا لأن القضية التي وضعها ذو القرنين نصب عينيه هي الإصلاح ومقاومة الفساد والشر, والحكم بالعدل بين الناس, ولم يكن همه جمع المال أو قصد العلو في الأرض بإذلال الشعوب, فقد رفض عرضهم, وتطوع بإقامة السد على أن يتطوعوا هم من جانبهم بتقديم الجهد البشري, فمنه الخبرة والتصميم والإشراف, وعليهم الطاقة العمالية والمواد الأولية المتوافرة في بلادهم (4).
ونلاحظ من السياق القرآني أن هؤلاء القوم اتصفوا بصفات منها:
1- هم قوم متخلفون: " لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً" وهذا إما معناه أنهم لا يفقهون لغة غيرهم من الأقوام الأخرى, لأنهم لم يطَّلعوا عليها ولم يتعلموها, فهم منغلقون على لغتهم فقط, وإما معناه أن الكلام لا ينفع معهم, لأنهم لا يفقهون ولا يتفاعلون معه, ولا يتفاهمون مع قائله, لا يفعلون هذا لجفاء وغلظة عندهم, أو لغفلة وسذاجة في طبيعتهم.
2- هم قوم ضعفاء, ولذلك عجزوا عن صد هجمات يأجوج ومأجوج, والوقوف في وجههم, ومنع إفسادهم.
3- هم قوم عاجزون عن الدفاع عن أرضهم, ومقاومة المعتدين, ولذلك لجأوا إلى قوة أخرى خارجية, قوة ذي القرنين, حيث طلبوا منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم.
4- هم قوم اتكاليون كسالى, لا يريدون أن يبذلوا جهدًا ولا أن يقوموا بعمل, ولذلك أحالوا المشكلة على ذي القرنين, وأوكلوا إليه حلها, أما هم فمستعدون لدفع المال له (5).
لقد كان فقه ذي القرنين في التعامل مع الشعوب المستضعفة هو السعي الجاد لنقلها من الجهل والتخلف والكسل والضعف إلى العلم والتقدم والنشاط والقوة, فكان يدير العمل بروح الجماعة, ويشترك بنفسه مع إشراك غيره, ويدل على ذلك ضمير المتكلم الذي يتقابل في تسلسل متتابع رفيع مع ضمير المخاطب في النظم القرآني الكريم مما يشير إلى روح الحماس والحيوية والتعاون المشترك (6), " قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ` آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا" [الكهف: 96،95] لقد كان ذو القرنين حريصًا على مصلحة الناس, ناصحًا لهم فيما يعود عليهم بالنفع, ولهذا طلب منهم المعونة الجسدية, لما في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم (7). ومن نصحه وإخلاصه لهم, أنه بذل ما في الوسع والخدمة أكثر مما كانوا يطلبون, فهم طلبوا منه أن يجعل بينهم وبين القوم المفسدين سدًا, أما هو فقد وعد بأن يجعل بينهم ردمًا, (والردم هو الحاجز الحصين, والحجاب المتين وهو أكبر من السد وأوثق, فوعدهم بفوق ما يرجون) (8.
لقد عفَّ ذو القرنين عن أموال المستضعفين وشرع في تعليمهم النشاط والعمل والكسب والسعي, فقال لهم: " فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا" [الكهف:95].
إن هذا العبارة القرآنية معلم بارز في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات والقدرات والقوى.
إن القيادة الحكيمة هي التي تستطيع أن تفجر طاقات المجتمع وتوجهه نحو التكامل لتحقيق الخير والغايات المنشودة.
إن المجتمعات البشرية غنية بالطاقات المتعددة في المجالات المتنوعة في ساحات الفكر والمال والتخطيط والتنظيم, والقوى المادية, ويأتي دور القيادة الربانية في الأمة لتربط بين كل الخيوط والخطوط والتنسيق بين المواهب والطاقات وتتجه بها نحو خير الأمة ورفعتها.
إن أمتنا الإسلامية مليئة بالمواهب الضائعة والطاقات المعطلة, والأموال المهدرة, والأوقات المبددة, والشباب الحيارى, وهي تنتظر من قيادتها في كل الأقطار والدول والبلاد لكي تأخذ بقاعدة ذي القرنين في الجمع والتنسيق والتعاون ومحاربة الجهل والكسل والتخلف (9) " فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ".
إن ذا القرنين لم يكن موقفه مع المستضعفين حمايتهم, وإنما توريثهم أسباب القوة حتى يستطيعوا أن يقفوا أمام المفسدين, لقد كان ذو القرنين يستطيع أن يبقى حتى يبدأ يأجوج ومأجوج في الهجوم, ثم يهاجم ويهزمهم, ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه ليس من وظيفة الحاكم أو الملك أن يظل في انتظار هجوم الظالم, ولكن وظيفته منع وقوع الظلم.
كيف منع ذو القرنين وقوع الظلم؟ لم يأت بجيوش لحماية المستضعفين مع قدرته على ذلك, وإنما طلب منهم أن يعينوه ليساعدهم على حماية أنفسهم ويتعلموا فنون الحماية ويكسبوا خبرات ويتدربوا على العمل الجاد المثمر الذي يجعلهم يبنون السد بأيديهم؛ وهذا أدعى للحفاظ عليه وإصلاحه إن أصابه شيء.
إن ذا القرنين رفض أن يكون هؤلاء المستضعفون عاطلين, قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهذه تلفتنا إلى أن لله سبحانه وتعالى عطاء إمكانات, وعطاء ذاتي في النفس.. عطاء الإمكانات هو ما تستطيع أن توفره من وسائل تعينك على أداء العمل, والعطاء الذاتي في النفس هو القوة الذاتية في داخلك التي تعطيك طاقة العمل, وكثير منا لا يلتفت إلى عطاء النفس لا يلتفت إلى أنه فيه قوة يستطيع أن يعمل بها أعمالاً كثيرة, وأنه لا يستخدمها وأن لديه قوة تحمل وبإمكانه أن ينتقل من مكان إلى آخر.. وأن يعمل أعمالاً كثيرة.
هذه القوة معطلة عند عدد كبير من الناس, فهي غير مستخدمة, ويستطيع الرجل أن يفعل بها أشياء كثيرة, وأمامه المجالات التي يستخدم فيها طاقته؛ ولكنه لا يستخدمها, عنده قوة تفكير لو دربها على العلم لفتحت له أبوابًا كثيرة يرتزق منها؛ ولكنه يبقيها كسولة فلا تفكر في شيء ولا يستخدمها لينميها.
----------------------------------------
مراجع الحلقة السابعة والعشرون:
() انظر: مباحث في التفسير الموضوعي, ص 305.
(2) القصص القرآني في سورة الكهف ص87.
(3) انظر: مباحث في التفسير الموضوعي, ص 306.
(4) المصدر السابق, ص 307.
(5) انظر: مع قصص السابقين (2/338).
(6) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/627).
(7) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (3/243).
(8) انظر: روح المعاني (16/40).
(9) انظر: مع قصص السابقين (2/342).
يمكنكم تحميل فقه النصر والتمكين
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمد الصلابي