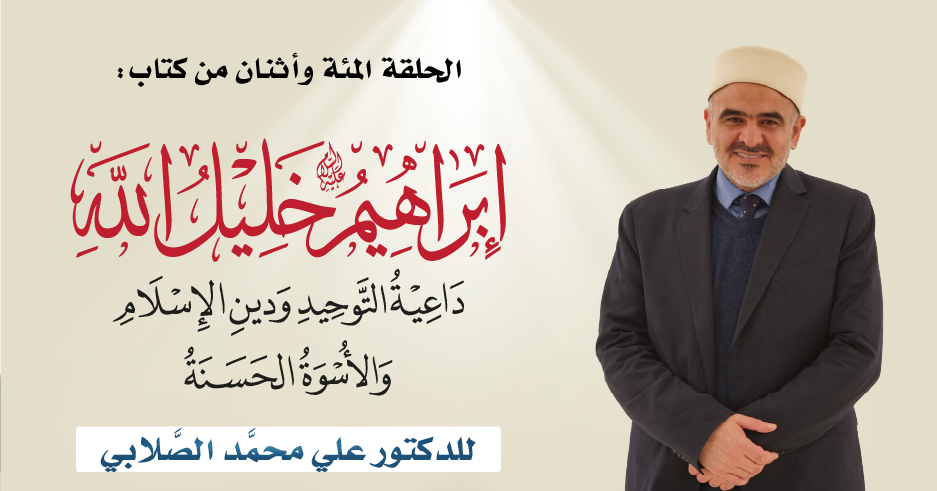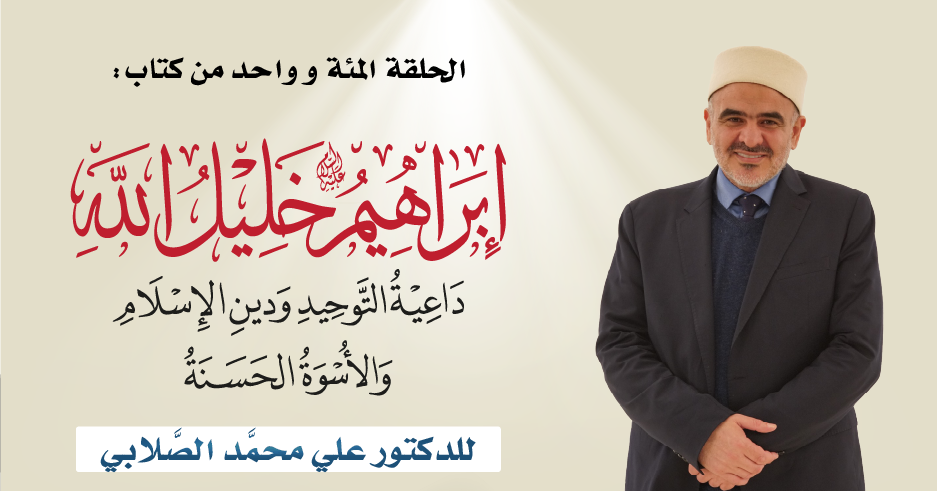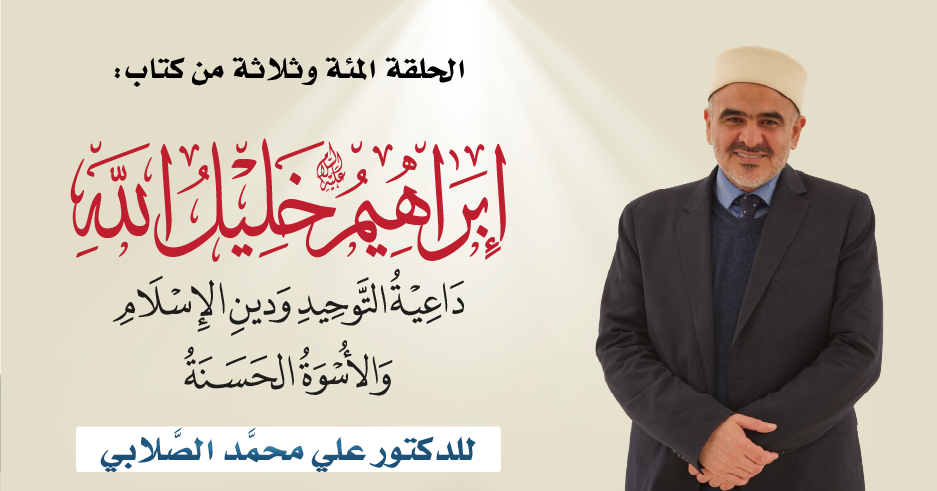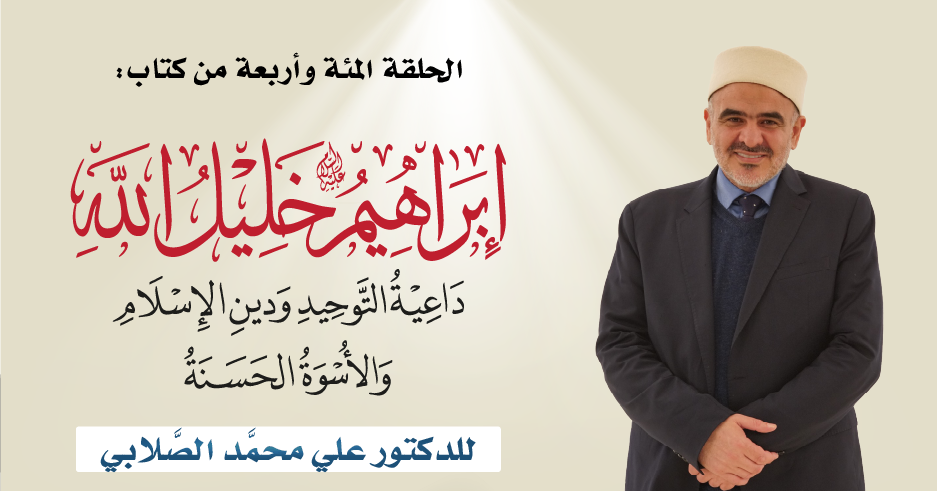تأملات في الآية الكريمة: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}
من كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
الحلقة: 102
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1444ه / سبتمبر 2022م
- قول الرازي:
اعلم أن الله سبحانه وصفهم أولاً بالصلاح؛ لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى، ثم ترقى فوصفهم بالإمامة، ثم ترقى فوصفهم بالنبوّة والوحي، وإذا كان الصلاح الذي هو أول العصمة أول مراتب النبوّة دلّ ذلك على أن الأنبياء معصومون، فإن المحروم أول المراتب أولى بأن يكون محروماً عن النهاية، ثم إنه سبحانه كما بيّن أصناف نعمه عليهم بيّن بعد ذلك اشتغالهم بعبوديته، فقال تعالى: {وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}، وكأنه سبحانه لما وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام، فهم أيضاً وفوا بعهد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة(1).
- قول السعدي:
إنَّ من صلاحهم، هو أن الله جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماماً يهتدي به المهتدون، ويمشي على خلقه السالكون، وذلك لما صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون، وفي قوله: {يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} أي: يهدون الناس بديننا لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته، ولا يكون العبد إماماً حتى يدعو إلى أمر الله، وفي قوله: {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ} يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات كلها، من حقوق الله وحقوق العباد، وفي قوله: {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ} هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر، كان قائماً بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع؛ لأن أفضل الأعمال التي فيها حق والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، وفي قوله: {وَكَانُوا لَنَا} أي: لا لغيرنا {عَابِدِينَ} أي: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم فاتصفوا بما أمر الله به الخلق، وخلقهم لأجله(2).
- قول ابن عاشور:
إنَّ تخصيص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بشأنهما؛ لأنَّ بالصّلاة صلاح النفس، إذ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالزكاة صلاح النفس، وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين، وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم - عليه السّلام -، ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة أنّه أوحي إليهم الأمر بذلك كما هو بيّن، ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى كما دل عليه فعل الكون المفيد تمكّن الوصف، ودلّت عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أنهم أفردوا الله بالعبادة، فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من وقت التكليف، كما قال يوسف: {مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} ]يوسف:38[، وقال تعالى في الثناء عن إبراهيم: {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ]آل عمران:67[(3).
- قول الشنقيطي:
يشمل الضمير في قوله: {وَجَعَلْنَاهُمْ} كل المذكورين: إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب - عليهم السّلام -، كما جزم به أبو حيان في البحر المحيط، وهو الظاهر، وقد دلَّت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة، أي جعلهم رؤساء في الدين، يُقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، وقوله: {بِأَمْرِنَا} أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم، بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد.
وتبيّن هذه الآية الكريمة أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته المذكور في سورة البقرة أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضها، وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة بخلاف غيرهم، كإسحاق ويعقوب، فإنهم ينالون كما صرح به تعالى في قوله هنا: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً}، وطلب إبراهيم هو المذكور في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} ]البقرة:124[. وفي قوله: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}؛ أيّ واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير، فأجاب الله بقوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} أي: لا ينال الظالمين عهدي بالإمامة، على الأصوب، ومفهوم قوله: {الظَّالِمِينَ} أن غيرهم ينال الظالمين عهدي بالإمامة، كما صرّح به هنا، وهذا التفصيل المذكور في ذرية إبراهيم أشار له تعالى في سورة الصافات بقوله: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ} ]الصافات:113[.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ} أي أن يفعلوا الطاعات، ويأمروا الناس بفعلها، وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات، فهو من عطف الخاص على العام وعكسه في القرآن الكريم من باب الإطناب في بلاغتنا العربية.
وفي قوله: {وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} أي: مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر بإخلاص، فهم يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهونهم عنه كما قال نبي الله شعيب: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} ]هود:88[، وفي وقوله {أَئِمَّةً} معلوم أنه جمع إمام، والإمام: هو المُقتدى به ويطلق في الخير كما هنا، وفي الشر كما في قوله: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} ]القصص:41[(4).
وفي قوله تعالى: {وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} أي: كانوا مطيعين وخاضعين لله تعالى وحده، وهي شهادة عالية رفيعة من الله تعالى، تدلُّ على براءتهم من جميع افتراءات المفترين وسهام المغرضين، المذكورة في الكتب التي يتداولها أهل الكتاب والتي حاولوا بها تشويه سمعتهم عليهم الصلاة والسلام(5).
مراجع الحلقة الثانية بعد المائة:
(1) التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)، (22/193).
(2) تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، (5/245-246).
(3) تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، (17/111).
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، (4/592-593).
(5) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، (5/374).
يمكنكم تحميل كتاب إبراهيم خليل الله دَاعِيةُ التَّوحِيدِ وَدينِ الإِسلَامِ وَالأُسوَةُ الحَسَنَةُ
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي