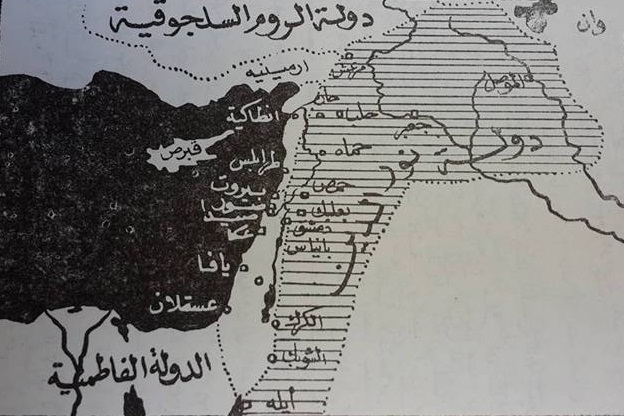إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم، ومن أهم هذه القواعد العدل. قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ). [النحل: 90]. وأمر الله بفعل -كما هو معلوم- يقتضي وجوبه، وقال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ). [النساء: 58].
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً). [النساء: 135].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر". والعدل أساس الحكم، وإقامته بين الناس في الدين الإسلامي تُعدُّ من أقدس الواجبات، وأهمِّها، وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل، ولقد كان نور الدين محمود زنكي قدوة في عدله؛ أسر القلوب، وبهر العقول، فقد كانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس، وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحاً منقطع النظير، حتى اقترن اسمه بالعدل، ولُقّب بالملك العادل، وكان من أسباب نصر الله له على الباطنية، والصليبيين إقامته للعدل في الرعية، وإيصال الحقوق إلى أهلها؛ فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة، ويولد جيلاً محارباً، وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنها، رعية تحب حكامها وتطيعهم؛ لأنهم أقاموا العدل على أنفسهم، وأقاموا العدل على غيرهم، وأما الظلم فهو ظلمات في الدنيا والآخرة، وهو مؤذن بزوال الدول، وقد حرم الله الظلم على نفسه، فقد قال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. وقال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ). [الصافات: 22]. وقال تعالى: (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). [النمل: 52]. وقد سجل التاريخ أن نور الدين محمود ساد العدل في دولته، وتم إيصال الحقوق إلى الناس، فنشطوا في الجهاد والدفاع عن دينهم وعقيدتهم، وأوطانهم وأعراضهم، ومن أبرز أعماله الإصلاحية والتجديدية إقامته للعدل في دولته، وقد أولى نور الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيراً، وجعلها في قمة أجهزته الإدارية، وخوّل القضاة على اختلاف درجاتهم في سلم المناصب القضائية صلاحيات واسعة، إن لم نقل مطلقة، ومنحهم استقلالاً تاماً، لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادئ الحق والعدل، وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم، وتُوجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين، وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء، أو طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى الأمر. وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: حرام على كل من صحبني لا يرفع إليّ قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إليّ. ويحكي خادمه شاذبخت الطواشي الهندي – الذي كان أحد نوابه في حلب – هذه الحادثة ذات الدلالة الواضحة في هذا المجال: كنت يوماً أنا ورجل واقفين على رأس نور الدين وقد صلّى المغرب، وجلس وهو مفكر فكراً عظيماً، وجعل ينكش بإصبعه الأرض، فعجبنا من فكره وقلنا: في أي شيء يفكر؟ في عائلته أو في وفاء ديْنه؟ وكأنه فطن بنا فرفع رأسه وقال: ما تقولان؟ فأجبناه بعد تردّد فقال: والله إني أفكر في والٍٍ ولّيته أمور المسلمين فلم يعدل فيهم، أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني وأخاف المطالبة بذلك من الله (أمام الله): فبالله عليكم.. وإلاّ فخبزي عليكم حرام – لا تريان قصة مظلوم لا ترفع إليّ، أو تعلمان مظلمة، إلاّ وأعلماني بها، وارفعاها إليّ. وقد وصف ابن الأثير نور الدين بأنه: كان يتحرى العدل، وينصف المظلوم من الظالم كائناً من كان القوي، والضعيف عنده في الحق سواء، فكان يسمع شكوى المظلوم، ويتولى كشف ذلك بنفسه، ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير، فلا جرم أن سار ذكره في شرق الأرض وغربها.
1- دار العدل أو المحكمة العليا: كانت قمة إجراءاته القضائية إنشاءه داراً في دمشق لكشف المظالم سماها (دار العدل)، وكانت أشبه بمحكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين، ثم عُمّمت صلاحياتها، فامتدت أقضيتها إلى سائر أبناء الأمة، وقد جاء إنشاؤها بسببٍ من تزايد عدد من كبار الأمراء في دمشق، وبخاصة أسد الدين شيركوه وتماديهم في اقتناء الأملاك، وتجاوز بعضهم حقوق البعض الآخر، فكثرت الشكوى إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض، لكنه لم يقدم على الإنصاف من شيركوه، فأنهى الحال إلى نور الدين، فأصدر أمره حينئذ ببناء دار العدل. يقول ابن الأثير: فلما سمع شيركوه ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلاّ بسببي وحدي، وإلاّ فمن هو الذي يمتنع على كمال الدين؟ والله لئن حضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنّه، فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه، وأرضوه بأي شيء أمكن، ولو أتى على جميع ما بيدي!! فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب. فقال: خروج أملاكي من يدي أسهل عندي من أن يراني نور الدين بعينه أني ظالم، أو يساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة (أي القضاء)!! فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم، وأرضوا خصماءهم وأشهدوا عليهم، فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين، فعرف الحال، فقال: الحمد لله؛ إذ أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. وثبت لنور الدين أهمية هذه الدار فعممها في غير دمشق، وكان نور الدين يجلس في دار العدل مرتين في الأسبوع، وقيل أربع مرات أو خمس للنظر في أمور الرعية وكشف ظلاماتهم: لا يطلب بذلك درهما ولا ديناراً، ولا زيادة ترجع إلى خزانته، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وكان يحضر معه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري وكبار العلماء والفقهاء من سائر المذاهب لاعتمادهم كمجلس استشاري لاتخاذ القرارات النهائية، ويأمر بإزالة الحاجب والبواب حتى يصل إليه الضعيف والقوى والفقير والغني، ويكلمهم بأحسن الكلام، ويستفهم منهم بأبلغ النظام، حتى لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمال، ولا القوي في دفع الضعيف بالمقال، ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها والمكالمة معه، فتغلب خصمها طمعاً في عدله، ويعجز الخصم عن دفعها خوفاً من عدله، فيظهر الحق عنده فيجري الله على لسانه ما هو موافق للشريعة، ويسأل العلماء والفقهاء عما يشكل عليه من الأمور الغامضة فلا يجري في مجلسه إلاّ محض الشريعة. ولم يميز نور الدين في دار العدل هذه بين أبناء رعيته على أي دين كانوا؛ فكان كما يقول ابن الأثير: ينصف المظلوم، ولو أنه يهودي، من الظالم ولو أنه ولده، أو أكبر أمير عنده، وكان قبل إنشائه هذه الدار يجلس كل يوم ثلاثاء في المسجد المعلق بدمشق: ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى نساؤهم، الأمر الذي يفسر لنا ما أورده الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي من تواجد العدد الكبير من اليهود في دمشق وحلب؛ إذ بلغ في الأولى نحو ثلاثة آلاف، وفي الثانية نحو ألف وخمسمائة، وأما النصارى المتواجدون في دولة نور الدين فإنهم لم يُمسّوا بأذى – على الرغم من ظروف الصراع الإسلامي الصليبي – وعوملوا كمواطنين لهم حق الرعاية الكاملة، ولم يعُرف عنه أنه هدم في حياته كنيسة ولا آذى قساً أو راهباً، وقد كان الصليبون إذا دخلوا بلداً قتلوا جلة أهله المسلمين، ولو أنه تأثر بذلك وعاملهم بالمثل لقام له في ذلك عذر، ولكنه كان إنساناً عظيماً لا يقيس نفسه بأولئك الجفاة الذين أساؤوا حتى إلى نصارى البلاد، فظلت الكنائس في بلاده عامرة بأهلها، بل إن الصليبيين كانوا إذا خرجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء، وأمنوا إلى عدله وإنصافه.
2- استجابته للقضاء: طلب مرة من قبل أحد المدّعين، فما كان من أحد كبار موظفيه إلاّ أن دخل عليه ضاحكاً وقال مستهزئاً: يقوم المولى إلى مجلس الحكم، فأنكر نور الدين على الرجل سخريته وقال: تستهزئ بطلبي إلى مجلس الحكم؟ وأردف: يُحضر فرسي حتى نركب إليه، السمع والطاعة؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). [النور: 51]. ثم نهض وركب حتى دخل باب المدينة واستدعى أحد أصحابه وقال له: أمضِ إلى القاضي، وسلّم عليه، وقل له: إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر الشرع!! ويوماً كان يلعب الكرة – هوايته المفضلة – في دمشق، فرأى رجلاً من أتباعه يحدث آخر ويومئ بيده إليه، فأرسل إليه يسأله عن حاله، فأعلمه أن له مع نور الدين خصومة حول بعض الأملاك، وطلب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة، فتردّد الغلام في عرض الموضوع على نور الدين، ولكن هذا ألحّ عليه، فلما تبين له الأمر ألقى العصا من يده وخرج من الميدان، وسار إلى القاضي كمال الدين وقال له: إنني قد جئت محاكماً!! فاسلك معي ما تسلكه مع غيري، فلما حضر المدعي ساوى كمال الدين بينه وبين خصمه، وإذ لم يثبت ضده شيء قال للقاضي ولكافة الحضور: هل ثبت له عندي حق؟ قالوا: لا فقال: اشهدوا أنني قد وهبت له هذا المال الذي حاكمني عليه، وقد كنت أعلم أنه لاحق له عندي، وإنما حضرت لئلا يظن أنني ظلمته، فحيثما ظهر أن الحق لي وهبته إياه. تلك غاية العدل والإنصاف، بل غاية الإحسان، وهي درجة وراء العدل. فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه، كما علق ابن الأثير. وفي عام (558ﻫ - 1162م) أدّعى رجل على نور الدين أن أباه (زنكي) أخذ من ماله شيئاً بغير حق، وأنه يطالب بذلك. فقال نور الدين: أنا لا أعلم شيئاً عن ذلك، فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتها، وأنا أرد إليك ما يخصني، فإني ما ورثت جميع ماله فقد كان هناك ورثة غيري، فمضى الرجل ليحضر البينة.
3- لا عقوبة على الظنّة والتهمة: لم يكن نور الدين يصدر العقوبة على الظنّة والتهمة، بل يطلب الشهود على المتهم، فإن قامت عليه البيّنة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعدّ، فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته، مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنّة، وأمنت بلاده مع سعتها، وقلّ المفسدون ببركة العدل واتّباع الشرع المطهر.
4- من عدله بعد موته: ومن عدله أيضاً بعد موته وهو من أعجب ما يُحكى: أن إنساناً كان بدمشق استوطنها وأقام بها لِما رأى من عدل نور الدين رحمه الله، فلّما توفي تعّدى بعض الأجناد على هذا الرجل فشكاه، فلم يُنصَف، فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شق ثوبه وهو يقول: يا نور الدين، لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا، أين عدلك؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من الخلق ما لا يُحصى، وكلّهم يبكي ويصيح، فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ البلد والرعية وإلاّ خرجت عن يدك، فأرسل إلى ذلك – وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس معه – فطيّب قلبه ووهبه شيئاً وأنصفه، فبكى أشّد من الأول، فقال له صلاح الدين: لِمَ تبكي؟ قال: أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته، فقال صلاح الدين: هذا هو الحق، وكل ما نحن فيه من عدل فمنه تعلّمناه.
5- رقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى: قال ابن الأثير: وحكى لي من أثق به أنّه دخل يوماً إلى خزانة المال، فرأى فيها مالاً أنكره فسأله عنه، فقيل: إن القاضي كمال الدين أرسله، وهو من جهة كذا. فقال: إن هذا المال ليس لنا ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء، وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين، فردّه إلى الخزانة وقال: إذا سألك الملك العادل عنه فقولوا له عنّي: إنه له. فدخل نور الدين الخزانة مّرة أخرى فرآه فأنكر على النّواب وقال: ألم أقل لكم يُعاد هذا المال على أصحابه؟ فذكروا له قول كمال الدين، فردّه إليه وقال للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذا المال، وأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى، يُعاد قولاً واحداً.
6- رجال القضاء في دولة نور الدين: اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية على رجال ثقات عرف كيف ينتقيهم، بعد أن رأى فيهم من الفقه الواسع والتقوى العميقة ما يؤهلهم لتسلم منصب القضاء الذي تربع في عهده – كما رأينا – قمة مؤسسات الدولة، وحظي باستقلال تام، وأصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بمن فيهم السلطان نفسه، وكبار أمرائه، ويبرز من بين حشد كبير من القضاة آل الشهرزوري، وعلى رأسهم كمال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري، أولئك الذين كانوا قد تخصصوا منذ عهد عماد الدين زنكي في القضاء، وما قبله، وبرعوا فيه.
أ- القاضي كمال الدين الشهرزوري: حدث في مطلع عام (555ﻫ /1160م) أن تقدم قاضي دمشق زكي الدين أبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها إعفاءه من القضاء، فأجابه إلى طلبه، وولي قضاء دمشق القاضي الإمام كمال الدين بن الشهرزوري، وهو كما يصفه ابن القلانسي المعاصر له: المشهور بالتقدم، ووفور العلم، وصفاء الفهم، والمعرفة بقوانين الأحكام، وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة، وتجنب الهوى والظلم، وحكم بين الرعايا بأحسن أفعال في حالة غيابه أو اشتغاله بمهمة ما، فإن ولده محي الدين ينوب عنه في منصبه، كان كمال الدين قد وُلد عام (491ﻫ/1097م) وتفقه ببغداد، وسمع الحديث من كبار المحدثين، وقد تخرج من النظامية، وكان يتردد إلى بغداد وخراسان رسولاً من عماد الدين زنكي، ثم ما لبث أن وفد على نور الدين وأصبح بعد أقل من عامين (557 – 1161م) قاضياً لقضاة الدولة كلها، وأمر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا الكتب نيابة عنه، وهناك من يقول إن زكي الدين قاضي دمشق لم يتقدم بالإعفاء عام (555ﻫ/1160م)، وإنما أعفاه نور الدين بسبب امتناعه عن أن يكون أحد نواب كمال الدين، ومهما يكن من أمر فإن كمال الدين تمكن من منصبه، وأصبح في دمشق كما يقول العماد: الحاكم المطلق، وأصبحت دولته نافذة الأوامر، منتظمة الأمور. و ورد عنه كذلك أنه ارتقى إلى درجة الوزارة، فكان له الحل والعقد في أحكام الشام. وكان له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على البر وحفظ الأصدقاء، ومن ثقافته الواسعة وخبرته الفقهية والقضائية والسياسية، خير معين على مواصلة الطريق حتى النهاية، ولم يكتف كمال الدين بمهامه القضائية، بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والإعمار، فأشرف بنفسه على بناء أسوار دمشق ومدارسها ومارستاناتها، وقد فوّضه نور الدين مهمة الإشراف على دار الضرب، وأوقاف الدولة، وتوجيه مصارفها لبناء الأسوار، وحفظ الثغور، فأنجز مهمته على خير وجه، كما أولى عناية خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق والإنفاق عليه بسخاء. وزاد نور الدين على ذلك كله، فاعتمده مبعوثاً إلى الخليفة العباسي في بغداد، كما اعتمد ابنه محي الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة لها، فضلاً عن النظر في أمور ديوانها، وكان محي الدين هذا، كما يصفه العماد: من أهل الفضل، وله نظم ونثر وخطب، وكانت معرفته بالفقه في أيام التفقه في بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة (535ﻫ - 1140م)، كما اعتمد في حماة وحمص على قضاة آخرين من بني الشهرزوري أنفسهم. وعندما دخل الموصل عام (566ﻫ - 1170م) أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين الشهرزوري.
ب- الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون: تولى قضاء سنجار ونصيبين وحران وغيرها من مدن ديار بكر، وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة، ينوب عنه في سائر المدن نواب أشرف على تعينيهم بنفسه، فقد وُلد بالموصل سنة (492ﻫ أو 493ﻫ - 1099م)، وتفقّه على جماعة من العلماء وانتقل إلى حلب سنة (545ﻫ - 1150م)، ثم قدم دمشق لدى دخول نور الدين إليها عام (549ﻫ -1154م)، ودرس في جامع دمشق، وتولّى أوقاف المساجد، ثم رجع إلى حلب وأقام بها، وصنف كتباً كثيرة في الفقه والمذاهب، ودرس على يديه عدد كبير من التلاميذ، وانتفعوا به، وكان فقيهاً من طراز أول، ووُصف بأنه من أفقه أهل عصره، وأنه إمام أصحاب الشافعي يومذاك، وكان متوحداً في العلم والعمل، وسرعان ما تقدم عند نور الدين، فكلّفه بالإشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وبعلبك وغيرها، ثم ما لبث أن ولاه قضاء ديار بكر ومنحه – كما سبق وأن ذكرنا – صلاحيات واسعة. كما اعتمده عام (566ﻫ - 1170) رسولاً إلى الخليفة المستضيء في بغداد. وقد توفي عام (585ﻫ - 1189م).
7- رفع الضرائب والمكوس: لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا عشراً إلا وأطلقها جميعها في بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرها، مما كان تحت حكمه، فقد كان المكس في مصر يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون ديناراً، أي 45% وهذا إلغاء للمكوس، لم تتسع له نفس غيره، وكان رحمه الله نادماً على ما فاته في أمر المكوس، فقد روى أبو شامة أن الملك العادل كان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول: اللهم أرحم العشّار المكَّاس.. وكان قد دعا أحد معاونيه – موفق الدين خالد – وقال له: اقعد واكتب بإطلاق المؤن والمكوس والأعشار، واكتب للمسلمين أني قد رفعت عنكم ما رفعه الله تعالى عنكم، وأثبت ما أثبته الله عليكم. وقد أمر بقراءة المناشير في الأقاليم في المساجد على الناس. روى أبو شامة: أن الملك العادل نور الدين لما دخل الموصل سنة 566ﻫ، أمر بإسقاط جميع المكوس والضرائب وأنشأ بذلك منشوراً يُقرأ على الناس فيه: وقد قنعنا من الأموال باليسير من الحلال، فسحقاً للسّحت، ومحقاً للحرام الحقيق بالمقت، وبعداً لما يبعد من رضا الرب، وقد استخرنا الله وتقربنا إليه بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة، ومحو كل سنة سيئة شنيعة، ونفي كل مظلمة فظيعة، وإحياء كل سنة حسنة.. إيثاراً للثواب الآجل على الحطام العاجل. وقرئ منشور آخر بإسقاط المكوس بمصر على المنبر في القاهرة عام 567ﻫ بعد صلاة الجمعة، عن السلطان صلاح الدين، في أيام نور الدين، وقد جاء فيه: وقد رأينا إسقاط المكوس الديوانية بمصر والقاهرة، وأن نتجرد فيها، لنلبس أثواب الأجر الفاخرة، ونطهر منها مكاسبنا ونكفي الرعية ضرهم.. ونضع المكوس فلا ترفعها من بعد، يد حاسب ولا قلم كاتب. وهدد من لا يطيق ذلك من المسؤولين: ومن أزالها زلّت قدمه، ومن أحلّها حلّ دمه، ومن قرأه أو قرئ عليه فليتمثل ما أمرنا به، وليمضه مرضياً لربه، ممضياً لما أمر به. ولم ترق هذه الخطة في إلغاء الضرائب لرجال الدولة، فاحتج أسد الدين شيركوه بقوله: فالأجناد الذين تأتي أرزاقهم من هذه الجهات، من أين تعطيهم أرزاقهم؟ أي رواتبهم؟ فأجابه نور الدين: إن كنا نغزو من هذه الجهات؛ أي من هذه الموارد نتركها ونقعد ولا نخرج. ولم يكتف نور الدين بذلك، بل أمر خطباء المساجد أن يطلبوا من الناس، أن يسامحوه فيما جُبي منهم قبلاً من هذه الضرائب، وكتب إلى الخليفة كتاباً يعلمه بما أطلق، وبمقدار ما أطلق، ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ بأن يستعجلوا من التُّجَار ومن جميع المسلمين له في حلًّ مما كان قد وصل إليه، يعني من أموالهم فتقدّم بذلك، وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك.
وعندما خرج لأخذ شيزر خرج أبو غانم بن المنذر في صحبته، فأمره نور الدين -رحمه الله- بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحَرَّان وسنجار والرحبة. وعزاز، وتل باشر، وعداد العرب، فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاً، وأطلقه مسامحاً لمن علم ضعفه من الرعايا عن عمارة ما أخربته أيدي الكُفّار، أبادهم الله، عند استيلائهم على البلاد وظهور كلمتهم في العباد، رأفة بالمسلمين المثاغرين، ولطفاً بالضعفاء المرابطين، الذين خَصّهم الله سبحانه بفضيلة الجهاد، واستمنحهم بمجاورة أهل العناد اختباراً لصبرهم وإعظاماً لأجرهم، فصبروا احتساباً، وأجزل الله لهم أجراً وثواباً (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ). [الزمر: 10]، وأعاد عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمُريَّة، وأقرها من الدولة الإسلامية بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدمين، واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين، فطمس عنهم بذلك معالم الجَوْر وهدم أركان التعدَّي، وأقر الحق مقَّره لقوله تعالى:(مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا). [الأنعام: 160]، (وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ) [البقرة: 261]. ثم لما أعانه الله بعونه وأيّده بنصره، وقمع به عادية الكفر، وأظهر بهمته شعائر الإسلام، وأظفره بالفئة الطّاعنة، وأمكنه من ملوكها الباغية، فجعلهم بين قتيل غير مقاد، وهارب ممنوع الرُّقاد (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ). [ص:38 –40] علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة الباقية، واستبقى ملكه الزّائل بأن قدّمه أمامه، وجعله ذُخراً للمعاد؛ فالتقوى مادة دارَّة إذا انقطعت المواد، وجادّة واضحة حين تلتبس الجَوادّ (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ). [الإنفطار: 19] فصفح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضَّرائب والمكوس، وأسقطها من دواوينه، وحرّمها على كل متطاول إليها، ومتهافت عليها، تجنّباً لإثمها واكتساباً لثوابها، فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه – اتباعاً لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم – في كل سنة من العين مئة ألف وستة وخمسين ألف دينار.
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك، أن نشط الناس للعمل، فأخرج التجار أموالهم، ومضوا يتاجرون، وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يُجبى من وجوه الحرام، بينما كان ما ألغاه من المكوس المستحدثة لا يزيد عن (165.000) مائة وخمسة وستين ألف دينار. ويقول ابن خلدون: العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها، انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته، يكون انقباض أيديهم عن المكاسب، وكسدت أسواق العمران، وانتقضت الأحوال ويقول: العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم.. يفضي إلى الخلل والفساد دفعة، وتنتقص الدولة سريعاً.
وكانت هناك أمور عديدة ساعدت نور الدين على إلغاء المكوس، وأهمها على الإطلاق توفيق الله له، فقد رأى له وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه يغسل ثيابه، وقصَّ ذلك عليه ففكر ساعة، ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس، وقال: هذا تفسير منامك. وكان في تهجده يقول: ارحم العشّار المكّاس، وبعد أن أبطل ذلك استعجل الناس في حِلَّ وقال: والله ما أخرجناها إلاّ في جهاد عدوِّ الإسلام، يعتذر بذلك إليهم عن أخذها منهم، ومن الأسباب التي كانت محركة لنور الدين في إبطال تلك المظالم والخلاص من تلك المآثم موعظة أبي عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي، فقد قال قصيدة في نور الدين، وقدمها له جاء فيها:
مثَّلْ وقوفَك أيُّها المغرورُ*** يومَ القيامِة والسماءُ تمورُ
إنْ قيل نورُ الدينِ رحْتْ مسلَّماً*** فاحذرْ بأنْ تبقى وما لَكَ نورُ
أَنَهَيْتَ عن شرب الخمور وأنت من*** كأسِ المظالمِ طافحٌ مخمورُ
عطَّلْتَ كاساتِ المُدامِ تعفُّفاً***وعليكَ كاساتُ الحرامِ تدورُ
ماذا تقول إذا نُقلتَ إلى البِلى*** فرداً وجاءك منكرٌ ونكيرُ
وتَعَلَّقتْ فيك الخصومُ وأنت***في يوم الحساب مُسَحَّبٌ مجرورُ
وتَفَرّقَتْ عنك الجنودُ وأنت***في ضيق اللُّحود مُوَسَّدٌ مقبورُ
وَوَدِدْتَ أنك ما وَليْتَ ولايةً***يوَماً ولا قال الأنامُ أميرُ
وبقِيْتَ بعد العزِّ رَهْنَ حُفيرةٍ***في عالم الموتى وأنتَ حقيرُ
وَحُشرتَ عُرياناً حزيناً باكياً***قلَِقاً ومالك في الأنام مُجيُر
أَرضِيتَ أن تحيا وقَلْبُك دارسٌ*** عافي الخراب وجسمُك المعمورُ
أرضيتَ أن يحظى سواك بقُربه*** أبداً وأنت مُبَعَّدٌ مهجور
مهَّد لنفسك حُجَّةً تنجو بها***يوم المَعادِ لعلكَّ المَعْذُورُ
وكان هذا الرجل من الصالحين الكبار فلما سمعها نور الدين بكى، وأمر بوضع المكوسات والضرائب في سائر بلاده، فرحم الله الواعظ والمتعظ، ووفق من أراد الاقتداء بهم.
8- ما قيل من الشعر في عدله:
قال ابن منير:
بنور الدينِ روَّض كلُّ مَحْلٍ***من الدنيا وجُدَّد كُلُّ بالِ
وَصَوَّب عَدْلُه في كُلَّ أوب*** فعوّض عاطِلاً منه بحالِ
وُينكي رأيُهُ رأيَ المحامي*** ويَقْتُلُ خوفُه قبل القتالِ
لقد أحصدتَ للإسلام عِزاً*** يفوتُ سَنامُه يَدَ كُلَّ قالِ
وقال أيضاً:
وانتشى دين محمدٍ محمودُهُ***من بعد ما عَلَقت دماً عَبَراتُهُ
رددْتَ على الإسلام عصَر شبابهِ***ثباته من دونه وثباتُهُ
أرسى قواعدَه ومَدَّ عِمادَهُ*** صُعُداً وشيَّد سوره سوراتُهُ
وأعاد وجه الحقَّ أبيضَ ناصعاً*** إصلاتُهُ وصِلاتُهُ وصَلاتُهُ
وقال أيضاً:
لا تأمنوا في الله بطشة ثائِرِ***لله ملءُ سريره أسرارُ
صافٍ إذا كُدِرَ المعادِنُ عادِلٌ*** إنْ حاف حُكّام الملوكِ وجاروا
وقال أيضاً:
أوَ لَسْتَ مَنْ ملأ البسيطة عَدْلُهُ*** واجتبّ بالمعروف أنفَ المُنكَرِ
حدبُ الأب البَّر الكبير، ورأفةُ*** الأمِّ الحفية باليتيم الأصغرِ
يا هضبةَ الإسلامِ من يعُصمْ بها*** يأمَنْ، وَمَنْ يَتَولَّ عنها يَكْفُرِ
وقال أيضاً:
لا مُلْكَ إلا مُلْكُ محمودِ الذي***تَخذَ الكتابَ مظاهراً ووزيرا
تمشى وراء حدودِه أحكامُهُ*** تأْتَمُّهُنّ فيحكمُ التقديرا
يقظانَ ينشرُ عَدْلَهُ في دولةٍ*** جاءت لِمَطْويِّ السماحِ نشورا
وقال أيضاً:
يا سائلي عن نهجِ سيرتِهِ*** هل غير مفرقِ هامةِ الفجرِ
عدلٌ حقيقٌ مَن تأمَّله*** أنْ يحيي العمرين بالذكرِ
وقال أيضاً:
ثنى يدَه عن الدنيا عفافٌ*** ومال بها عن الأموال زهدُ
رأى حطَّ المكوسِ عن الرعايا*** فأهدر ما أنشاه بعدُ
ومدّ لها رواقَ العدلِ شرعاً*** وقد طُوي الرواقُ ومَن يمدُّ
وبات وعند بابِ العرشِ منها*** لدولته دعاءٌ لا يُردُّ
وقال العماد الأصفهاني في عدله:
يا محييَ العدلِ الذي في ظلّه*** من عدلهِ رعتِ الأسودُ مع المهَا
محمودٌ المحمودُ مِن أيامِهِ*** لبهائِها ضحك الزمانُ وقَهْقَهَا
إن الملك العادل نور الدين زنكي حرص على بناء مجتمع العدل والقوة، وسوف يأتي الحديث -بإذن الله- عن اهتمام نور الدين بالقوة العسكرية، ولا شك أن القوة العسكرية لا يمكن بناؤها في مجتمع ضعيف؛ فهي جانب من جوانب المدينة المتكاملة، فالمجتمع القوي عسكرياً يلزم أن يكون قوياً في صناعاته الأخرى؛ لأن الأمن العسكري يحتاج إلى الأمن الثقافي والأمن الغذائي والأمن الصحي، وهذه الأمور عمل نور الدين على توفيرها كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ). [الحديد: 25]. فهذه الآية الكريمة توضح الأسس اللازمة لبناء مجتمع قوي متحضر، يقوم على العدل والقوة؛ فالكتاب والميزان لإقامة العدل، والحديد لإيجاد القوة التي تحمي العدل، وتكفل استمراره، ولو أردنا تحويل هذا الشرح إلى لغة لقلنا إن الآية تشير إلى أن المجتمع المتحضر ينبغي أن تتوفر له الأيدلوجية الصالحة زائد (التكنيك) المتقدم؛ فالأيديولوجية تحفظ البنية الاجتماعية متماسكة بعيدة عن التجزئة والتشرذم، وتمنحها الأهداف ووحدة الحركة والتصميم والإرادة، وتمنع ذوبانها في البنى الاجتماعية المغايرة في العقيدة والفكر والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي، والتكنيك يمنحها فرص التقدم على الآخرين علمياً وصناعياً، ليس من أجل إذلالهم واستعمارهم؛ فالأيديولوجية الإسلامية لا تسمح بذلك، بل لإقامة العدل في الأرض بعد إقامته في المجتمع الإسلامي، ثم لضمان استمرار العدل الذي أرسل الله تعالى الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – لبيانه ووضع الموازين الحق له، فنزول الكتب السماوية وخاتمها القرآن الكريم يهدف إلى تثبيت موازين العدالة، وبيان الأسباب والوسائل اللازمة لتحقيقها، فالناس يقومون بالعدل، ويحيون بالأمل، ويسعون بالأمن، وينتفعون بالعمل والإنتاج. إن العدل الشامل لا يتحقق إلاّ بتطبيق شرع الله تطبيقاً قائماً على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، والمعرفة الدقيقة بالواقع من ناحية، وبمقاصد الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى، وهو أمر لا يتحقق إلاّ بتكوين العدد المناسب من العلماء المجتهدين النابهين.
المصدر :الاسلام اليوم