التداول على الحكم بعد وفاة الرسول ح 5
بقلم د. علي محمد الصلابي
10ـ إقرار مشروع توثيق دستور الأمة:
إن دستور الدولة الإسلامية هو القرآن الكريم، ومعه السنة النبوية، شارحة ومفصلة وموضحة له، وكان القرآن الكريم في بداية الأمر يكتب على الجلود والألواح وجريد النخل التي توزعت في بيوت الصحابة، وقد مرّ جمع القرآن الكريم من عهد النبوة إلى خلافة أبي بكر بمراحل من أهمها:
أ ـ جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وردت لفظ “الجمع” بمعنى:”الحفظ مع دقة الترتيب” عدة مرات في كتاب الله وذلك من مثل قوله تعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ١٦ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ١٧ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ١٩﴾ [القيامة: 16-19].
كما وردت لفظة “الجمع” بمعنى: ”الكتابة والتدوين” والمعنى الأول آتاه الله تعالى ـ لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ـ ولعدد غير قليل من صحابته الكرام وممن تابعهم من الصالحين إلى اليوم وحتى يوم الدين، وهؤلاء تدارسوا القرآن الكريم ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه ليتمكنوا من القراءة به في الصلوات المكتوبة وفي النوافل وفي الاستشهاد. وأما جمع القرآن الكريم بمعنى تدوينه كتابة فقد جمع كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن تتفق على ترتيب آيات القرآن، حسبما عليه المصحف الآن إنما هو ترتيب توقيفي، لم يجتهد فيه رسول الله ولا أحد من الصحابة في عهده أو من بعده وإنما كان يتلقى ترتيبها بعضها إلى جانب بعض، وحياً من عند الله بواسطة جبريل.
روى أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص، قال: كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ شخص ببصره ثم صوّبه، قال:«أتاني جبريل فأمرني أن ضع هذه الآية هذا الموضع من السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: 90]».
إن من مظاهر عناية الله بالقرآن الكريم وحفظه ما تمّ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من حفظ القرآن في صدورهم وكتابة في الصُحف. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في ذلك أرقى مناهج التوثيق. ذلك أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منَّجماً في ثلاث وعشرين سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت السورة تُدَوّن ساعة نُزولها؛ إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ما نزلت عليه آية أو آيات قال: «ضعوها في مكان كذا …وكذا» .
ولهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن توقيفي، بمعنى أن ترتيبه بهذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في المصاحف إنما هو بأمر الله ووحي من الله .
وما يقال عن ترتيب آيات القرآن هو الذي يقوله إجماع المؤرخين والمحدّثين والباحثين عن ترتيب السور ووضع البسملة في رؤوسها، قال القاضي أبو بكر بن الطبيب رواية عن مكي رحمه الله في تفسير سورة “براءة” إن ترتيب الآيات من السور، ووضع البسملة في رؤوسها هو توقيف من الله عز وجل، ولما لم يؤمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة .
هذا عن ترتيب آيات القرآن وسوره، أما كتابته فمن المعلوم أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب، أجمع على ذلك عامة المؤرخين وكل المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله، لذا فقد كان يعهد بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن إلى أشخاص من الصحابة بأعيانهم كانوا يُسمون كتاب الوحي، وأشهرهم الخلفاء الأربعة وأُبي ابن كعب وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، والزبير بن العوام، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، وقد كانوا يكتبون ما يتنزل من القرآن تباعاً حسب الترتيب الذي يأتي به جبريل فيما تيسر لهم، من العظام الموقفة والمخصصة لذلك وألواح الحجارة الرقيقة والجلود، وقد كانوا يضعون ما يكتبونه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكتبون لأنفسهم إن شاؤوا صوراً عنها يحفظونها لديهم، وقد كان من الصحابة من يتتبع ما ينزل من آيات القرآن وتتبع ترتيبها فيحفظها عن ظهر قلب حتى كان فيهم من حفظ القرآن كله، فمن المشاهير أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وآخرون .
وظل الصحابة يعكفون على حفظ القرآن غيباً، حتى ارتفعت نسبة الحفاظ منهم إلى عدد لا يحصى. يتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القرآن وعاه الأوائل من الصحابة وبلغوه إلى من بعدهم بطريقتين اثنتين:
أحدهما: الكتابة التي كانت تتم للقرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأشخاص بأعيانهم وكَّلَ إليهم هذا الأمر ولم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلا والقرآن مكتوب كله في بيته.
الثانية: حفظه في الصدور عن طريق التلقي الشفهي من كبار قراء الصحابة وحفّاظهم الذين تلقوه بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقرهم على كيفية النطق والأداء .
وكان كل مايكتب من آيات وسور القرآن الكريم بعد نزول الوحي بها مباشرة يُحفظ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع استنساخ كُتّاب الوحي نُسَخاً لأنفسهم من جميع ما أُمْلِي على كل منهم. ولذلك تم جمع القرآن الكريم كتابة وحفظاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وثبت أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة واحدة في كل سنة ثم عارضه في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم مرتين .
ومعنى هذا أن القرآن الكريم كان في صورته التامة في هذه السنة التي تمّ عرضه فيها مرتان، ولذلك شواهد كثيرة ذكرها العلماء من أظهرها ما أورده البغوي عن أبي عبد الرحمٰن السلمي أنه قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرأون القراءة العامة فيه، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده الصّدِّيق في جمعه أولاً. وولاَّه عثمان كتابة المصحف. على أن القرآن رغم ذلك لم يجمع بين دفتين في مصحف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لضيق الوقت بين آخر آية نزلت من القرآن وبين وفاته .
ب ـ جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه:
كان ضمن شهداء المسلمين في حرب مسيلمة الكذّاب في اليمامة كثير من حفظة القرآن، وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع القرآن حيث جمع من الرقاع والعظام والسعف ومن صدور الرجال، وأسند أبو بكر الصّدِّيق رضي الله عنه هذا العمل العظيم والمشروع الحضاري الضخم إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. يروي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بعث إليَّ أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليَمامة بقُراءِ القرآن… وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف أفعل شيئاَ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبوبكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتَبّع القرآن فاجمعه، قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليّ مما كلّفني من جمع القرآن، فتتبعت القرآن من العسب ، واللخاف وصدور الرجال والرقاع ، والأكتاف ، قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، قال تعالى:﴿ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة، آية : 128) حتى خاتمة براءة. وكانت الصحف عند أبي بكر في حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم .
وعلَّق البغوي على هذا الحديث فقال: فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئاً. والذي حملهم على جمعه ما جاء في الحديث وهو أنه كان مفرقاً في العسب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله ودعوه إلى جمعه، فرأى في ذلك رأيهم فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا، أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين«.
وقد اختار أبوبكر رضي الله عنه زيد بن ثابت لهذه المهمة العظيمة وذلك لأنه رأى فيه المقومات الأساسية للقيام بها وهي:
ـ كونه شاباً، حيث كان عمره 21 سنة، فيكون أنشط لما يطلب منه.
ـ كونه أكثر تأهيلاً، فيكون أوعى له، إذ من وهبه الله عقلاً راجحاً فقد يسر له سبل الخير.
ـ كونه ثقة، فليس هو موضعاً للتهمة، فيكون عمله مقبولاً وتركن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب.
ـ كونه كاتباً للوحي، فهو بذلك ذو خبرة سابقة في هذا الأمر وممارسة عملية له فليس غريباً عن هذا العمل، ولا دخيلاً عليه .
هذه الصفات الجليلة جعلت الصّدِّيق يُرشح زيداً لجمع القرآن، فكان به جديراً، وبالقيام به خبيراً.
ـ ويضاف لذلك أنه أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الإتقان، وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن فكان لا يثبت شيئاً من القرآن إلا إذا كان مكتوباً بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظاً من الصحابة. فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، خشية أن يكون في الحفظ خطأ أو وهم، وأيضاً لم يقبل من أحد شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن .
وعلى هذا المنهج استمر زيد رضي الله عنه في جمع القرآن حذراً متثبتاً مبالغاً في الدقة والتحري .
إن زيداً اتبع طريقة في الجمع نستطيع أن نقول عنها في غير تردد أنها طريقة فذة في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية، وأنها طريقة التحقيق العلمي المألوف في العصر الحديث وأن الصحابي الجليل قد اتبع هذه الطريقة بدقة دونها كل دقة، وأن هذه الدقة في جمع القرآن متصلة بإيمان زيد بالله، فالقرآن كلام الله جل شأنه فكل تهاون في أمره أو إغفال للدقة في جمعه وِزر. ما كان أحرص زيداً في حسن إسلامه وجميل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عنه.
إن ما قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من خليفة المسلمين أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه ومشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاونة عمر رضي الله عنه وأُبيّ بن كعب ومشاركة جمهور الصحابة ممن كان يحفظ القرآن ويكتبه ، وإقرار جمع من المهاجرين والأنصار مظهر من مظاهر العناية الربانية بحفظ القرآن الكريم وتوفيق من الله للأمة الإسلامية وترشيد منه لمسيرتها ويتضمن ذلك ـ أيضاً ـ كما قال أبو زهرة: حقيقتين مهمتين تدلان على إجماع الأمة كلها على حماية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل، وأنه مصون بعناية الله سبحانه وتعالى، ومحفوظ بحفظه وإلهام المؤمنين بالقيام عليه وحياطته .
الأولى: أن عمل زيد رضي الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة ولكنه إعادة مكتوب .
فقد كتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل زيد الابتدائي هو البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كتب عليها والتأكد من سلامتها بأمرين: بشهادة اثنين على الرقعة التي فيها الآية والآيتان أو الآيات، وبحفظ زيد نفسه، وبالحافظين من الصحابة، وقد كانوا الجمع الغفير والعدد الكبير فما كان لأحد أن يقول: إن زيداً كتب من غير أصل مادي قائم، بل إنه أخذ من أصل قائم ثابت مادي وبذلك تقرر ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كتابة زيد، بل ما كتب في عصره عليه الصلاة والسلام وأملاه وما حفظه الروح القدس.
الثانية: أن عمل زيد لم يكن عملاً أحادياً، بل كان عملاً جماعياً من مشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طلب أبوبكر إلى كل من عنده شيء مكتوب أن يجيء به إلى زيد، وإلى كل من يحفظ القرآن أن يدلي إليه بما يحفظه، واجتمع لزيد من الرقاع، والعظام وجريد النخل ورقيق الحجارة وكل ما كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك بدأ زيد يرتبه ويوازنه ويستشهد عليه، ولا يثبت آية إلا إذا اطمأن إلى إثباتها، كما أوحيت إلى رسول الله . واستمر الأمر كذلك حتى إذا ما أتم زيد ما كتب تذاكره الناس وتعرفوه وأقروه، فكان المكتوب متواتراً بالكتاب ومتواتراً بالحفظ في الصدور وما تم كتاب في الوجود غير القرآن .
وإنها لعناية من الرحمٰن خاصة بهذا القرآن العظيم ، وكان هذا الفعل من أبي بكر في جمعه للقرآن الكريم بين دفتين من فقه المصالح المرسلة، الذي ينظر إلى مصالح الأمة العليا في باب الاجتهاد وبذلك تم توثيق أهم مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، كمرجعية عليا للدولة.
11ـ تحديد مدة الرئاسة:
لا مانع شرعاً من إضافة شرط يحدد مدة ولاية الرئاسة، حيث إن روح النظام الإسلامي لا تتنافى إطلاقاً مع توقيت الرئاسة بمدة زمنية محددة إذا ما تضمن عقد الرئاسة ذلك وتم النص على ذلك في الدستور لأن:
أ ـ التوقيت لا ينافي طبيعة العقد:
إن عقد الرئاسة من العقود الرضائية، يصح بما يصح به العقود، ويبطل بما تبطل به، وطرفا العقد هما الرئيس والشعب، ولكل منهما حقوق وواجبات مقررة من قبل الشرع ولا يوجد ما يمنع أن يعرض أحد الأطراف شروطاً أخرى بشرط ألا تخالف النظام العام الإسلامي.
فالعاقدين يمكنهم أن يحددوا نطاق عقدهم فيما لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ويجوز للمواطنين أن يشترطوا فترة محددة للبيعة، فهذا لا يخالف الشريعة الإسلامية نصًّا أو روحاً، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل شرعي يحرمه ، ويجدر بنا أن نذكر أنه إذا وضع المسلمون شرط توقيت فترة الرئاسة وقَبِل الرئيس هذا الشرط وتم تنصيبه على هذا الأساس، فعليه الالتزام به مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ٩١﴾ [النحل: 91].
ـ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ٣﴾ [الصف: 2-3].
ـ وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ٢٥﴾ [الرعد: 25].
ـ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له« .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان« .
ب ـ وهذا الشرط يحقق مقاصد الشريعة ومصلحة المسلمين، حيث أنه سيسمح لهم بالآتي:
ـ بإمكانية تبادل السلطة في المجتمع الإسلامي بالطرق السلمية، مما يتفادى معه الثورات وحركات الخروج المسلح التي كان لها أسوأ الأثر على الشعوب.
ـ إن تطبيق هذا الشرط يمنح فرصة للشعب للقيام برقابة شعبية متجددة على رئيس الدولة، كما تسمح لهم بإبعاده عن السلطة واستبداله بالأصلح إذا حاد عن الطريق الذي يرتضيه للشعب.
ـ إن تحديد فترة زمنية للرئاسة يعتبر دافعاً للرئاسة لأجل معلوم، فيكون بذلك حافزاً له، فلا يستكين بأن مدة رئاسته وأعماله محسوبة وذلك بخلاف من يتولى الحكم مدى الحياة.
ـ إن تحديد مدة عقد الرئاسة يعطي للأمة الإسلامية الفرصة لاختيار الرئيس الأنسب لظروف وحاجات المجتمع في كل فترة من الفترات التي تمر بها الشعوب، ولتوضيح ذلك نقول: إن الولاية لها ركنان (القوة والأمانة)، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]. ولما كان اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، فعلى المؤمنين اختيار الأصلح من حيث وقائع الظروف المعاصرة، فإذا كان يهددهم عدو جبار فليختار في هذه الفترة المرشح الأعظم قوة ومهابة عند الأعداء من الأعظم أمانة، وبذلك تعطى فترة الرئاسة المحددة للمواطنين القدرة على اختيار الرئيس الذي يحقق لهم نفعاً أكثر ومصلحة أكثر في وقت بعينه .
جـ ـ العلماء القائلون بتحديد مدة الرئاسة:
ـ قال الدكتور عبد الرزاق السنهوري: هناك سؤال آخر: هل من جوهر نظام الخلافة نفسه أن يكون منصب الخلافة لمدى الحياة، أو غير محددة المدة؟ وأن الموت وحده إذا لم يتوافر أي من الأسباب الأخرى هو الذي ينهي ولاية الخلافة؟ وبعبارة أخرى هي يمكن أن يعين الرئيس لمدة محددة معينة وأن تنتهي ولايته تلقائياً بحكم القانون عند انتهاء هذه الفترة؟
وللسؤال أيضاً أهمية فيما يتعلق بشرعية النظم الجمهورية من وجهة نظر الفقه الإسلامي.. ورغم أن مثل هذه الحالة لم تواجه من قبل نظرياً أو عملياً في التاريخ الإسلامي، ورغم أن المفهوم التقليدي للخلافة أن تنصيب الخليفة يكون لمدى الحياة، ولكنه لا يوجد حسب رأينا في مبادئ الفقه الإسلامي أي مانع من تحديد مدة الولاية .
ـ قال توفيق الشاوي: الذي اعتبر أن الخلافة عقد بيع حر، فتستمر الخلافة مدى الحياة إذا لم يتضمن العقد تحديداً لمدة الولاية، وإلا فإنه يمكن أن يتضمن العقد شروطاً على سلطة الحاكم بتحديد مدة ولايته .
ـ قال القرضاوي: بجواز التحديد، ومحمد أسد وهو يرى أنه لا ضير أن تكون مدة الإمارة محدودة بزمن معين طالما أن الشريعة لم تنص على هذه المسألة بشيء .
وقال القرضاوي: أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمير، ففي هذا الاحتجاج شيء من المغالطة، فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة.. أما الأمر الآخر وهو التحديد أو التأقيت فلم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنه، وقد قالوا: لا ينسب إلى ساكت قول .
ـ وقال الأستاذ محمود المرداوي: ومما لا شك فيه أن بيعة المسلمين لخلفائهم لم يشترط فيها تحديد زمني لمدة خلافة كل منهم، ولكن عدم اشتراطهم ذلك لا يعني حرمة الاشتراط، فليس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة في منصبه إلى وفاته، ولئن اعتبر ذلك إجماعاً من الصحابة، فإن فعل الصحابي غير ملزم من جهة، ومن جهة أخرى فإجماع الأمة على أمر في زمن يلغيه إجماع آخر في زمن آخر إن كانت مصلحة الأمة في ذلك .
وروى مسلم في صحيحه قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تقوم الساعة والرّوم أكثر الناس»، فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن قلت ذلك أن فيهم لخصالاً أربعاً: أنهم لأحلم الناس عند فتنة.
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة.
وأوشكهم كرة بعد فرة.
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك.
فمنعة الأمة أي أمة من ظلم الملوك أمر استحسنه السلف حتى الملوك أنفسهم، ولا تكون المنعة في الشعب بالفطرة، ولكنها بالنظم التي تصطلح عليها الشعوب وتقيد حكامها بها، وتلزمهم بممارستها، فيحكمون الشعوب بموجب منهج وضعته لهم، فليس لهم أن يخالفوه ولعل ذلك هو مفهوم حكم الشعب بالشعب. وإن من خصائص هذا الحكم تحديد فترة حكم الحاكم بسنوات معينة متفق على تحديدها، مما يجعل الرئيس مقيداً بمراقبة الشعب له، وبرغبته في إرضاء الشعب ليعاد انتخابه فترة أخرى مدفوعاً بإحساسه بكرامته وحسن سمعته وسمعة الحزب الذي رشحه وأوصله إلى هذا المنصب .
ـ وقال ضياء الريس: إن الإمام يبقى ما بقي صالحاً، ثم إذا تغير يجب أن يزال ويبايع غيره، وهذا شيء غير التحديد الزمني، على أننا نقول أيضاً إنه مادام علماء الإسلام قد قرروا أن الإمامة أو الدولة تقام بمقتضى عقد وقرروا حرية التعاقد، فقياساً على ما ساقوا من حديث بالنسبة لعقود أخرى يكون من حق طرفي العقد أن يضيفا من الشروط ما يريانه ملائماً، مادامت الشروط لا تتنافى مع طبيعة العقد ومادامت تحقق المصلحة العامة، وبناء على ذلك لا يكون هناك مانع من أن تشترط الأمة أن يكون العقد محدداً بأجل زمني قابل للتجديد أو غير قابل .
د ـ كيف تحدد مدة الرئاسة؟
تكلم المجوزون لتحديد الرئاسة عن كيفية هذا التحديد ومدته فقالوا إن مدة الرئاسة ينبغي أن لا يكون هناك إفراط في طولها أو في قصرها حتى لا تكون مدعاة لإثارة الفتن والقلاقل، وتم تحديدها بين خمس إلى عشر سنوات ، وكذلك اختار حسن الترابي أن تحدد مدة الولاية بأجل مسمى وألا يقصر الأجل فيؤدي ذلك إلى الاضطراب في سياسة البلاد، وأن لا تطول ليمهل الرئيس للآخرين مجال التداول على السلطة والاستفادة من خبراتهم التي تحتاجها الأمة، والأفضل أن يتوسط الأجل سنوات معدودة نحو عشر سنوات تقريباً قياساً على إمارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجارة موسى عند شعيب عليهما السلام ، فالمطلوب وجود تباعد زمني ما بين تجديد الولايتين لأن تقارب المدة تحصل منه مفاسد كبيرة .
إن نصوص القرآن والسنة ليس فيها ما يدل على منع التحديد أو على أن الرئاسة منصب يتولاه مدى الحياة، فهذه الأمور من التفصيلات المنظمة للإمامة، والقرآن الكريم لم يهتم بتفصيل هذه الأمور بقدر ما اهتم بتقرير المبادئ العامة لها، مما يدل على أنها من المتغيرات بحسب الزمان ومكان وثقافة الشعوب، وتطور وعيها السياسي، ونظرتها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
12ـ مدنية دولة الصّدِّيق:
كان الإجماع على بيعة أبي بكر انتصاراً لمبدأ الشورى على العصبيات الوراثية التي كانت تسود في الجاهلية، وبهذا القرار الإجماعي دخل الإسلام مرحلة جديدة إذ أنشأ الصحابة دولة مدنية لا يرأسها نبي يتلقى الوحي، كما كان الأمر في حياة الرسول، بل يتولاها رجل اختاروه بالإجماع بعد تشاور وتنافس وخلاف، فأصبحت الخلافة بذلك حكومة مدنية بخلاف حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الطابع الديني الموجه الإلهي. ولكن أبابكر اختار أن يسمى خليفة الرسول ليؤكد عزمه على السير على المنهج الذي وضعه النبي قبل وفاته في الشؤون الدينية والدنيوية، وبعده جاء عمر واتخذ لقب أمير المؤمنين، لتأكيد صفته كممثل للأمة وجماعة المسلمين . لقد كانت دولة الصّدِّيق مدنية شورية، لأن من يترأس الدولة لم تكن سلطته مطلقة ويكفي ذلك أن ترجع إلى خطبة أبي بكر، بعد تولي الخلافة حيث قال: «إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني» ثم أضاف: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم». ومعنى ذلك أنه أعطى للأمة حق الرقابة على عمله ومحاسبته، فضلاً عن أنها هي التي اختارته بواسطة من يمثلونها، وهذان المبدآن هما أساس النظام الديمقراطي في العصر الحديث، إن حكومة الصّدِّيق قامت على الأصول الشورية الثابتة وروحها التي هي أهم من الأشكال المتغيرة والقابلة للتطور ومن هذه الأصول العامة الثابتة ما يلي:
ـ أنه كان يرى أنه مسؤول عن المال العام.
ـ ومسؤول عن أيّ خطأ أو انحراف عن العدل.
ـ وكان يتشاور مع الناس ويخضع لرقابتهم.
ـ وكان يلتزم بأحكام الشريعة والعدالة.
ـ وكان يتولى القضاء بنفسه أو يعين قضاة يتولون هذه المهمة، وسار الخلفاء بعد ذلك على نفس النهج .
كانت دولة الصّدِّيق قائمة على الشورى والمواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة، وحقوق المرأة …إلخ المستمدة من مقاصد القرآن الكريم والتوجيهات النبوية الرشيدة.
إن دولة الصّدِّيق الإسلامية مدنية بامتياز وليست دولة دينية فهناك فرق كبير بين الدولة الإسلامية أي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام والدولة الدينية التي عرفها الغرب النصراني في العصور الوسطى، وعلى ذلك أن هناك خلطاً كبيراً بين ما هو إسلامي وما هو ديني، فكثيرون يحسبون أن كل ما هو إسلامي يكون دينياً والواقع أن الإسلام أوسع وأكبر من كلمة دين. حتى إن علماء الأصول المسلمين جعلوا “الدين” إحدى الضرورات الخمس، أو الست التي جاءت الشريعة لحفظها وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وزاد بعضهم العرض. أضرب مثلاً موضحاً، نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة، وهذه التربية تشمل أنواعاً من التربية تبلغ بضعة عشر نوعاً، إحداها التربية الدينية، إلى جوار التربية العقلية والجسمية والخلقية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والأدبية والمهنية والفنية والجنسية.. ألخ.
فالتربية الدينية شعبة واحدة من شعب التربية الإسلامية الكثيرة، فالخطأ كل الخطأ الظن بأن الدولة الإسلامية التي ـ قادها الصّدِّيق ـ دولة دينية، إنما الدولة الإسلامية “دولة مدنية” تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشورى، ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، بل يعتبر الإسلام هذا واجباً كفائياً على المسلمين، ويصبح فرض عين إذا قدر عليه وعجز غيره عنه أو جبن عن أدائه.
إن الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق، فهناك شريعة تحكمه، وقيم توجهه، وأحكام تقيده، وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته، بل وضعها له ولغيره “رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس” ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس، أن يلغوا هذه الأحكام أو يجمدوها، فلا ملك ولا رئيس ولا برلمان ولا حكومة ولا مجلس شورى، ولا لجنة مركزية ولا مؤتمر للشعب، ولا أيِّ قوة في الأرض تملك أن تغير من أحكام الله الثابتة .
إن عهد الخلافة الراشدة يعتبر مرجعية كبرى في الفقه السياسي وبناء الدول وازدهار الحضارات، لذلك يجب دراسته بكل دقة، لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر حجة في فقه “الرئاسة” المنضبطة بمقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية.
وإذا كان البريطانيون يعتبرون “الماجنا كارتا” الميثاق الأساسي لحرياتهم والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الإنسان ميثاقهم، فإن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية، وهي ميثاق عملي، وليست مجرد بيان قولي .
أما البيان القولي فإننا نجده في خطبة الوداع التي ألقاها الرسول الكريم في حجة الوداع، ويكفي أن نذكر منها المقتطفات الآتية:
«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا.. استوصوا بالنساء خيراً.. لقد تركت فيكم ما إن أطعتموه فلن تضلوا بعده أبداً كتاب الله وسنة رسوله.. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا فضل لأبيض على أحمر ولا أحمر على أبيض إلا بالتقوى« .
13ـ تحديد مسؤولية الحاكم “العقد الاجتماعي”:
فالحاكم مسؤول بين يدي الله وبين الناس، وهو أجير لهم وعامل لديهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، وأبوبكر رضي الله عنه يقول عندما وُلّي الأمر وصعد المنبر: «أيها الناس كنت أحترف لعيالي فأكتسب قوتهم، فأنا الآن أحترف لكم، فارضوا لي من بيت مالكم«.
وهو بهذا قد فسر “نظرية العقد الاجتماعي” أفضل وأعدل تفسير، بل هو وضع، فما هو إلا تعاقد بين الأمة والحاكم على رعاية المصالح العامة، فإن أحسن فله أجره وإن أساء فعليه عقابه ، وأما عن مسؤولية الحاكم فإن الأصل فيها في النظام الإسلامي أن المسؤول فيها هو رئيس الدولة كائناً من كان، له أن يتصرف، وعليه أن يقدم حساب تصرفه للأمة، فإن أحسن أعانته وإن أساء قومته، ولا مانع في الإسلام من أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة هذه السلطة وتحمل هذه المسؤولية، كما عرف في “وزارة التفويض” في كثير من العهود الإسلامية، ورخص الفقهاء المسلمون في ذلك وأجازوه مادام فيه مصلحة، والقاعدة في مثل هذه الأمور رعاية المصلحة العامة، قال الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية والوزارة على ضربين، وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ .
ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية التي تبنى عليها مسؤولية الحاكم فيما يلي:
ـ أن الحاكم هو أجير للأمة وعامل لديها ضمن حقوق وواجبات ينظمها الدستور والقانون.
ـ أن الحكم عبارة عن عقد اجتماعي بين الأمة والحاكم لرعاية مصالحها.
ـ أن البيعة بين الأمة والحاكم بيعة موقوتة.
ـ أن الحكم قائم على مبدأ الفصل بين السلطات.
ـ للحاكم أن يختار الكيفية المناسبة لممارسة صلاحياته إما بالتفويض أو بالتنفيذ المباشر أو حسب ما يقرر الدستور.
ـ أن يمارس الحاكم صلاحياته وسلطاته في ضوء مبدأ سيادة القانون .



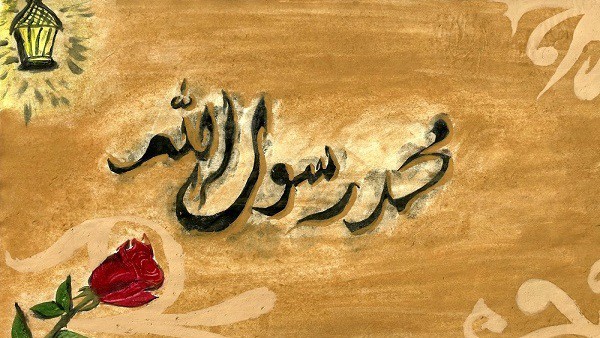


.jpg)