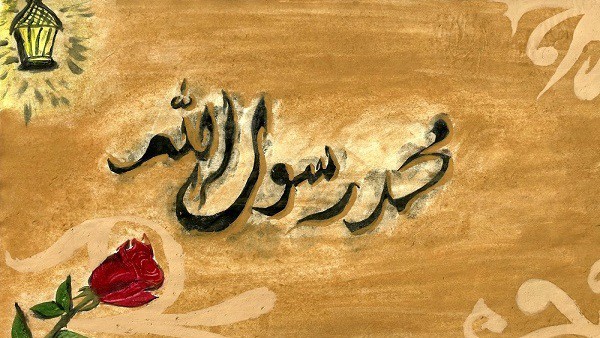التداول على الحكم بعد وفاة الرسول ح 2
بقلم د. علي محمد الصلابي
ثانياً: التحليل السياسي للأحداث في سقيفة بن ساعدة:
1ـ الأنصار يعتقدون أنهم أحق بالخلافة من غيرهم:
وهذه القناعة لم تنشأ من فراغ، ولم تكن رغبة دنيوية في الحكم بل كان لها أسبابها، فالأنصار كفئة أساسية ومؤسسة من فئات المجتمع الإسلامي، كانوا يرون في أنفسهم بأنهم مؤهلين لهذا الأمر، وكانت الدوافع خوفهم وحرصهم على الدولة الإسلامية من التفرق والتنازع، فهم يرون أنهم الأجدر لمجموعة من الأسباب من أهمها:
أ ـ أنهم هم وليس غيرهم من مدحهم الله بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
فالآية تنصف الأنصار بمجموعة من المزايا وهي:
ـ الإيمان.
ـ تؤكد صدق حبهم للمهاجرين.
ـ صفاء ونقاء قلوبهم (سلامة فطرتهم).
ـ إيثارهم مما في أيديهم لإخوانهم المهاجرين.
ـ أنهم مفلحون من جراء أعمالهم هذه، فهي شهادة لهم لا تقدر بثمن.
ب ـ تأييدهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منذ بداية الأمر، وأنَّ قادتهم ونقباءهم هم بايعوه أول مرة عند الصفا وفي بيعتي العقبة، وتضحياتهم التي لا تعد ولا تحصى من أجل الإسلام، كما أنهم كانوا أساس الإسلام ومادته ولقد كانوا هم الأكثرية في بادئ الأمر، لأن المهاجرين كانوا قلة، وقد سلموا بلدهم وأرضهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا أنفسهم وأولادهم وأموالهم وإمكاناتهم تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ج ـ مديح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، وفي أكثر من مناسبة، ووصيته صلى الله عليه وسلم بهم ومن ذلك:
ــ قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار» .
وصيته صلى الله عليه وسلم بهم بقوله: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم
ــ ربطه صلى الله عليه وسلم حبَّ الأنصار بإيمان الإنسان بقوله: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله» .
ــ وفي حديث آخر قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار» .
ــ اختصاصهم بدعوته صلى الله عليه وسلم لجمع الأنصار، وأبنائهم وذرياتهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار» .
ــ قوله صلى الله عليه وسلم لهم يوم فتح مكة: «أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم» .
ــ تزكية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لهم في جانب نخوتهم وشهامتهم وأمانتهم، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: «ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها« .
د ـ بنى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عاصمة دولته على أرضهم، وانطلق منها لبقاع الأرض، واختارهم على قومه، فهو صلى اللهعليه وسلم لم يبقَ في مكة يوم فتحها، بل رجع مع الأنصار إلى مدينتهم كأنه واحد منهم، وهذا الأمر كان وفاءً لهم بما سبق له صلى الله عليه وسلم أن واعدهم في لقاءاته الأولى بهم، وتحديداً يوم بيعة العقبة الكبرى، حين قال لهم صلى الله عليه وسلم: «الدم الدم، والهدم الهدم» .
هـ ـ كانوا أبعد الناس عن الامتيازات والمغانم طيلة فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يميزهم بشيء دون الناس بل على العكس من ذلك، فلربما فضل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الآخرين عليهم أحياناً، وقصة غزوة حنين ما زالت في الأذهان يوم أعطى للمؤلفة قلوبهم ما أعطى صلى الله عليه وسلم؛ وقال للأنصار: «أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله إلى بيوتكم» .
و ـ خبرتهم وحنكتهم في أمر السياسة التي اكتسبوها من جراء ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة فترة بناء الدولة الإسلامية فقد كانوا معه خطوة بخطوة لم يفارقوه أبداً.
ز ـ تخصصهم بحمل القرآن الكريم الذي هو الركن الأساسي في دستور المسلمين، فلقد كان بعض من رجالهم هم من يحفظوه في صدورهم.
فقد اشتهر من الأنصار، كل من أبيّ، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وزيد بن ثابت.
2ـ خطر الانشقاقات السياسية على كيان الدولة:
لمّا علم المهاجرون باجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، شعروا بخطر داهم يمكن أن يشق عصا مواطني الدولة، ويشتت جهودهم، ويمزق وحدتهم، ويهدد كيان دولتهم وكان بإمكان المهاجرين عقد مؤتمر خاص بهم والبحث في الموضوع لوحدهم ولكن من حنكتهم السياسية ورجاحة عقولهم، وفطنتهم وحكمة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم، حرصوا على الحضور مع إخوانهم لمواجهة الأمر بالعقل والتدبير الحسن وهذا هو الحل المناسب للموضوع، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، ولمّا اقترح على المهاجرين تجاوز الأنصار قال عمر رضي الله عنه: والله لنأتينَّهم، لأن مصلحة الأمة والدولة فوق كل مصلحة ولابد من الشورى.
لقد تعامل قادة المهاجرين مع الأمر الواقع بغاية الذكاء والدهاء السياسي، ودفعوا المخاطر المحتملة، وناقشوا وحاوروا الأنصار، ووصلوا إلى نتيجة تمّ الإجماع عليها وهي اختيار أبي بكر الصّدِّيق رئيس الدولة.
ولو لم يحضروا لحدث واحد من الأمرين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:”خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا”
ــ فإما بايعناهم على ما نرضى.
ــ وإمّا نخالفهم فيكون فساد .
3ـ الأنصار يرشحون سعد بن عبادة:
كان سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وأحد الأشراف الأمراء في الجاهلية والإسلام، وكان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة .
وكان الأنصار قد هيأوا سعد بن عبادة رضي الله عنه ليولوه الأمر، وهم يعتقدون أنه الأصلح لرئاسة الأمة الإسلامية بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو في خدمة دولة الإسلام بشكل عام، وها هي فرصة الأمر بأعلى درجات المعروف وهو الحكم بما أنزل الله مواتية، ولقد كانت لهم أسبابهم المنطقية فقد اشتمل تاريخ سعد بن عبادة رضي الله عنه:
أ ـ جاء في أسد الغابة في معرفة الصحابة للجزري: وكان نقيب بني ساعدة، وشهد بدراً ـ عند بعض رواة السير ـ وكان سيداً جواداً، وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، وكان وجيهاً في الأنصار ذا رياسة وسيادة، يعترف قومه له بها، ولأهله في الجواد أخبار حسنة .
ب ـ إنه كان من أوائل من أسلم من الأنصار وقد شهد بيعة العقبة الكبرى وكان نقيباً من الاثني عشر نقيباً، وكان ممن أمسكت به قريش فأسرته بعد البيعة وضربوه وعذبوه ولكن الله نجاه منهم.
ج ـ موقفه المشرف يوم غزوة الخندق “الأحزاب” حين استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسعد بن معاذ رضي الله عنه بأن يعطي ثلث ثمار المدينة لغطفان مقابل أن ينسحبوا من قريش ويعودوا إلى ديارهم، فكان له رضي الله عنه فهماً وكلاماً جميلاً؛ بأن عطفان وغيرهم كانوا لا يطمعون منهم بثمرة واحدة وكانوا على جاهليتهم إلا إما كرماً منهم أو بيعاً، فكيف وقد أعزهم الله بالإسلام، وكان رأيهم ليس لديهم لغطفان إلا القتال .
د ـ حامل راية الأنصار في غزوة بني المصطلق وفي غزوة خيبر وفي فتح مكة.
هـ ـ له مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان يسميه “أخي” فكان يخصه بزيارات خاصة في بيته، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة»؟ فقال: صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعوده منكم؟» فقام، وقمنا معه، ونحن بضعة عشر ما علينا نعال، ولا خفاف، ولا قلانس، ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله، حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه .
و ـ التزامه الأدبي مع قرابته ووفاؤه اللافت لهم ولاسيما أمه فقد كان أصيلاً باراً بوالديه، فحين ماتت أمه جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء»، قال: فحفر بئراً، وقال: «هذه لأم سعد» .
ز ـ تكليفه من قِبَل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببعض المهام الخاصة ومن ذلك:
ــ اختاره صلى الله عليه وسلم ضمن الوفد الذي أرسل للتأكد من خيانة بني قريظة، وذلك أثناء غزوة الخندق، وأتمَّ مع الفريق الذي معه المهمة على أكمل وجه.
ــ استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة عند خروجه صلى الله عليه وسلم لغزوة الغابة لاسترداد إبل المسلمين اللقاح، التي أغار عليها عيينه بن حصن الفزاري في خيل لغطفان،
المراجع:
فهذا باطل ومحض افتراء فقد ثبت من خلال الروايات الصحيحة أن سعداً بايع أبا بكر، فعندما تكلم أبو بكر يوم السقيفة، فذكر فضل الأنصار وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو سلك الناس وادياً، وسلكت الأنصار وادياً أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» .
ثمّ ذكّر سعد بن عبادة بقول فصل وحجة لا ترد فقال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم»
قال سعد: صدقت ونحن الوزراء وأنتم الأمراء، فتتابع القوم على البيعة وبايع سعد .
وبهذا تثبت بيعة سعد بن عبادة، وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعة أبي بكر، ولا يعود أي معنى للترويج لرواية باطلة، بل سيكون ذلك مناقضاً للواقع واتهاماً خطيراً أن ينسب لسيد الأنصار العمل على شق عصا المسلمين والتنكر لكل ما قدمه من نصرة وجهاد وإيثار للمهاجرين، والطعن بإسلامه من خلال ما ينسب إليه من قول: لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي، وأخضب سنان رمحي، وأضرب بسيفي فكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمِّع بجماعتهم ولا يقضي بقضائهم ولا يفيض بإفاضتهم، أي: في الحج.
إن هذه الرواية التي استُغِلَّت للطعن بوحدة المهاجرين والأنصار وصدق أخوتهم ما هي إلا رواية باطلة للأسباب التالية: أن الراوي صاحب هوى، وهو “إخباري تالف لا يوثق به”، ولاسيما في المسائل الخلافية.
قال الذهبي عن هذه الرواية: وإسنادها كما ترى، أي في غاية الضعف أما متنها فهو يناقض سيرة سعد بن عبادة وما في عنقه من بيعة على السمع والطاعة ولما روي عنه من فضائل .
4ـ أبو بكر وتعامله مع النفوس وقدرته على الإقناع:
استطاع أبو بكر أن يدخل في نفوس الأنصار فيقنعهم بما رآه هو الحق، من غير أن يٌعرِّض المسلمين للفتنة، فأثنى على الأنصار ببيان ما جاء في فضلهم من الكتاب والسنة، والثناء على المخالف منهج إسلامي يقصد منه إنصاف المخالف وامتصاص غضبه وانتزاع بواعث الأثرة والأنانية في نفسه ليكون مهيّأ لقبول الحق إذا تبين له، وقد كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأمثلة التي تدل على ذلك، ثم توصل أبو بكر من ذلك إلى أنّ أفضلهم وإن كان كبيراً لا يعني أحقيتهم في الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصَّ على أن المهاجرين من قريش هم المقدّمون في هذا الأمر .
وقد ذكر ابن العربي المالكي أن أبا بكر استدل على أن أمر الخلافة في قريش بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيراً، وأن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم، ومما احتج، أبو بكر على الأنصار قوله: إن الله سمّانا “الصادقين” وسمّاكم “المفلحين” إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 8-9].
وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية؛ فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه .
وبيَّن الصّدِّيق في خطابه أن مؤهلات القوم الذين يرشحون للخلافة أن يكونوا من يدين لهم العرب بالسيادة، وتستقر بهم الأمور، حتى لا تحدث الفتن فيما إذا تولى غيرهم، وأبان أن العرب لا يعترفون بالسيادة إلا للمسلمين من قريش لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولِمَ استقر في أذهان العرب من تعظيمهم واحترامهم. وبهذه الكلمات النيرة التي قالها الصّدِّيق اقتنع الأنصار بأن يكونوا وزراء معينين وجنوداً مخلصين، كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك توحد صف المسلمين .
5ـ التنافس بين المرشحين:
رأى أبو بكر الصّدِّيق أن يرشح كلاً من عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فعمر من المحدثين الملهمين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أبو عبيدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» .
ثم برز مرشح آخر قدَّم نفسه وهو من الأنصار وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه ويبدو أنه له فهم آخر وهو من عُرف بـ(ذي الرأي)، فقدَّم نفسه في حملة إعلامية أمام الجميع، بأنه صاحب الرأي والمشورة وهو الجواد والكريم بقوله: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، وقدَّم مقترحاً جديدًا بقوله: منا أمير ومنكم أمير، ولكن هذا المبدأ “منا أمير ومنكم أمير” رُفض، لأن ذلك ليس من أصول السياسة الإسلامية التي أقرت منذ البداية بوجود رئيس واحد على هرم السلطة .
وأوضح عمر رضي الله عنه؛ إن إقامة أميرين بمثابة: وضع قوة في مواجهة قوة أخرى، مما يفضي حتماً إلى التنازع، وقال: هيهات أن يجتمع اثنان في قرن. سيفان في غمد واحد لا يصطلحان. وتوحدت وجهات النظر بعد نقاش وحوار ووضعت الرئاسة في محلها الصحيح .
6ـ ترشيح أبي بكر رضي الله عنه لرئاسة الدولة:
وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد آن الأوان لتقديم مقترح لا يختلف فيه اثنان من الصحابة، شخص له من الامتيازات والمناقب والشمائل، ما لا يعد ولا يحصى، فقدّم أبا بكر الصّدِّيق وقال له: ابسط يدك نُبايعك، فلما جاء عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما ليبايعا أبا بكر الصّدِّيق، سابقهم صحابي من الأنصار هو بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه، وكان موقفاً نبيلاً منه، فبايعه رضي الله عنه المهاجرون، ثم الأنصار، وحُسِم الأمر لأبي بكر رضي الله عنه وكانت هذه البيعة تمثل بيعة أهل الحل والعقد في الأمة.
وبعد أن بايع أهل الحل والعقد وأهل الشورى في الدولة أبا بكر الصّدِّيق رضي الله عنه كرئيس للدولة لم يكتف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك لما يمتلك من حكمة رجل السياسة والرأي، فجمع الناس في اليوم الثاني وأعلن البيعة لأبي بكر ورئيساً للدولة وفق المصطلحات السياسية المعاصرة، فبايعه الناس جميعاً ولم يتخلف إلا من كان له عذر وهم قلة يُعدّون على أصابع اليد، وقد بايعوا فيما بعد.
لقد كان في أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه من المواصفات مالم تكن في غيره، بحيث اجتمعت عليه الأمة بهذا الشكل فلم يكن الأمر بالهين، فقد كان الناس من المهاجرين والأنصار وغيرهم بالأمس القريب تحت إمرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما كانت فيه من مواصفات هائلة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها من الوجود كافة، فأي شخص في نظر الناس لا يمثل في القيمة والمكانة شيئاً أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من السهل تجاوز هذا الشعور لدى الناس. ولكن رغم كل ذلك فقد قبلوا بأبي بكر رضي الله عنه رئيساً لهم، لأنهم يعرفون قبل غيرهم بم كان يمتاز أبو بكر الصّدِّيق رضي الله عنه عن بقية الصحابة فضلاً عن بقية الناس، فقد تحلى بصفات وملكات وأخلاق نادرة أهلته لرئاسة الدولة منها:
أ ـ تميز بأنه ظَلَّ طول حياته بعد الإسلام متمتعاً بثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وشاهدته له واستخلافه إياه في القيام ببعض أركان الدين الأساسية وفي مهمات الأمور، والصحبة في مناسبات خطرة دقيقة لا يستصحب فيها الإنسان إلا من يثق به كل الثقة، ويعتمد عليه كل الاعتماد.
ب ـ تميز بالتماسك والصمود في وجه الأعاصير والعواصف التي تكاد تعصف بجوهر الدين ولُبهِّ، وتحبط مساعي صاحب رسالته، وتنخلع لها قلوب كثير ممن قوي إيمانهم وطالت صحبتهم، ولكن يثبت هذا الفرد في وجهها ثبوت الجبال الراسيات ويمثل دور خلفاء الأنبياء الصادقين الراسخين ويكشف الغطاء عن العيون، وينفض الغبار عن جوهر الدين وعقيدته الصحيحة.
ج ـ تميز في فهمه الدقيق للإسلام، ومعايشته له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أطواره وألوانه، وحرب وخوف وأمن ووحدة واجتماع، وشدة ورخاء.
د ـ تميز بشدة غيرته على أصالة هذا الدين وبقائه على ما كان عليه في عهد نبيِّه غيرة أشد من غيرة الرجال على الأعراض والكرامات، والأزواج والأمهات والبنين والبنات، ولا يحوله عن ذلك خوف أو طمع أو تأويل أو عدم موافقة من أقرب الناس وأحبهم إليه.
هـ ـ كان دقيقاً كل الدقة وحريصاً أشد الحرص في تنفيذ رغبات الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يخلفه في أمته بعد وفاته، لا يحيد عن ذلك قيد شعرة ولا يساوم فيه أحداً ولا يخاف لومة لائم.
و ـ كان أبو بكر من الزاهدين في متاع الدنيا والتمتع به، زهداً لا يُتصور فوقه إلا عند امامه وهاديه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وألا يخطر بباله تأسيس الملك والدولة وتوسيعها لصالح عشيرته وورثته كما اعتادت ذلك الأسر الملوكية الحاكمة في أقرب الدول والحكومات من جزيرة العرب كالروم والفرس، وقد اجتمعت هذه الصفات في سيدنا أبي بكر وغيرها وتمثل بها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته واستمرت معه حتى توفاه الله تعالى، بحيث لا يسع مُنكر أن ينكره أو مشكّك يشك في صحته، فقد تحقق بطريق البداهة والتواتر .
لقد تبيَّن للدارسين أن تعيين الخليفة فرض على المسلمين يرعى شؤون الأمة ويقيم الحدود ويعمل على نشر الدعوة الإسلامية وعلى حماية الدين والأمة بالجهاد وعلى تطبيق الشريعة وحماية حقوق الناس ورفع المظالم، وتوفير الحاجات الضرورية لكل فرد وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع كما مرّ معنا.
7ـ زهد عمر وأبي بكر في الخلافة:
بعد أن أتم أبو بكر حديثه في السقيفة قدّم عمر وأبا عبيدة للخلافة، ولكن عمر كره ذلك وقال فيما بعد: فلم أكره مما قال غيرها: كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقرِّبني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر .
ومن هذه القناعة من عمر بأحقية أبي بكر بالخلافة، قال له: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده قال: فبايعته وبايعه المهاجرون والأنصار، وجاء في رواية: قال عمر: … يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤمَّ الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟، فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر .
وهذا ملحظ مهم وُفّق إليه عمر رضي الله عنه، وقد اهتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فأصرَّ على إمامة أبي بكر، وهو من باب الإشارة بأنه أحق من غيره بالخلافة، وكلام عمر رضي الله عنه في غاية الأدب والتواضع والتجرد من حظ النفس، ولقد ظهر زُهد أبي بكر في الإمارة في خطبته التي اعتذر فيها عن قبول الخلافة حيث قال: «وَاللَّهِ، مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الإِمَارَةِ يَوْمًا وَلا لَيْلَةً قَطُّ، وَلا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، وَلا سَأَلْتُهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرٍّ وَلا عَلانِيَةٍ، وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِي فِي الإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلا يَدَ إِلا بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي الْيَوْمَ» .
وقد ثبت أنه قال: وددّتُ أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، أبي عبيدة أو عمر وكنت وزيراً، وقد تكررت خطب أبي بكر في الاعتذار عن تولي الخلافة وطلبه بالتنحي عنها فقد قال: … أيها الناس هذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم، وأكون كأحدكم، فأجابه الناس: رضينا بك قسماً وحظاً وأنت ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قام باستبراء نفوس المسلمين من أية معارضة لخلافته واستحلفهم على ذلك فقال: أيها الناس أذكر الله أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه، فقام علي بن أبي طالب، ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رجلاً على عتبة المنبر والأخرى على الحصى وقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدّمك رسول الله فمن ذا يؤخرك؟ ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد في أمر الخلافة والمسؤولية، بل إنها روح العصر.
8ـ حرص الجميع على وحدة الأمة:
من هذه النصوص التي تمّ ذكرها يمكن القول: إن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة لا يخرج عن هذا الاتجاه، بل يؤكد حرص الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلامية واستعدادهم المستمر للتضحية في سبيلها، فما اطمأنوا على ذلك حتى استجابوا سراعاً لبيعة أبي بكر الذي قبل البيعة لهذه الأسباب، وإلا فإن نظرة الصحابة مخالفة لرؤية الكثير ممن جاء بعدهم ممن خالفوا المنهج العلمي، والدراسة الموضوعية، بل كانت دراستهم متناقضة مع روح ذلك العصر، وآمال وتطلعات أصحاب رسول الله من الأنصار وغيرهم، وإذا كان اجتماع السقيفة أدى إلى انشقاق بين المهاجرين، والأنصار كما زعمه بعضهم، فكيف قبل الأنصار بتلك النتيجة وهم أهل الديار وأهل العدد والعدة؟ وكيف انقادوا لخلافة أبي بكر ونفروا في جيوش الخلافة شرقاً وغرباً مجاهدين لتثبيت أركانها ولو لم يكونوا متحمسين لنصرتها .
فالصواب اتضح على حرص الأنصار على تنفيذ سياسة الدولة والاندفاع لمواجهة المرتدين، وأنه لم يختلف أحد من الأنصار عن بيعة أبي بكر فضلاً عن غيرهم من المسلمين وأن أخوة المهاجرين والأنصار أكبر من تخيلات الذين سطروا الخلاف بينهم في روايتهم المغرضة .
9ـ حديث: الأئمة من قريش:
ورد حديث: «الأئمة من قريش» في الصحيحين، وكُتب الحديث الأخرى، بألفاظ متعددة، ففي صحيح البخاري عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّه اللهُ في النار على وجهه ما أقاموا الدين»، وفي صحيح مسلم:«لا يزال الإسلام عزيزاً بخلفاء كلهم من قريش» .
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»، وعن بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك الأنصاري: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد كنا في بيت من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادتي الباب، فقال: «الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا أوفوا وإن حكموا عدلوا» .
وفي فتح الباري أورد ابن حجر أحاديث كثيرة تحت باب الأُمراء من قريش أسندها إلى كتب السُنن والمسانيد والمصنفات، فالأحاديث في هذا الباب كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب من كُتب الحديث، وقد رويت بألفاظ متعددة إلا أنها متقاربة تؤكد جميعها أن الإمرة المشروعة في قريش، ويقصد بالإمرة الخلافة فقط، أما ما سوى ذلك فيتساوى فيه جميع المسلمين، وبمثل ما أوضحت الأحاديث النبوية الشريفة أن أمر الخلافة في قريش، حذرت من الانقياد الأعمى لهم، وأن هذا الأمر فيهم ما أقاموا الدين كما سلف في حديث معاوية، وكما جاء في حديث أنس: «إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا أوفوا وإن حكموا عدلوا، ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
وبهذا حذرت الأحاديث من اتباع قريش إذا زاغوا عن الحُكم بما أنزل الله، فإن لم يتمثلوا ويطبقوا مثل هذه الشروط، فإنهم سيصبحون خطراً على الأمة، وحذّرت الأحاديث الشريفة من اتباعهم على غير ما أنزل الله ودعت إلى اجتنابهم والبُعد عنهم واعتزالهم، لما سيترتب على مؤازرتهم آنذاك من مخاطر على مصير الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: «إن هلاك أمتي أو فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش»، وعندما سئل صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لو أن الناس اعتزلوهم»، ومن هذه النصوص تتضح الصورة لمسألة الأئمة من قريش وأن الأنصار انقادوا لقريش ضمن هذه الضوابط وعلى هذه الأسس، وهذا ما أكدوه في بيعاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والصبر على الأثرة وأن لا ينازعوا الأمر أهله، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهاناً .
فقد كان للأنصار تصور تام عن مسألة الخلافة، وأنها لم تكن مجهولة عندهم، وأن حديث: «الأئمة من قريش» كان يرويه كثير منهم، وأن الذين لا يعلمونه سكتوا عندما رواه لهم أبو بكر الصّدِّيق، ولهذا لم يراجعه أحد من الأنصار عندما استشهد به، فأمر الخلافة تمَّ بالتشاور والاحتكام إلى النصوص الشرعية والعقلية التي أثبتت أحقية قريش بها، ولم يسمع عن أحد من الأنصار بعد بيعة السقيفة أنه دعا نفسه بالخلافة، ممّا يؤكد اقتناع الأنصار، وتصديقهم لما تمّ التوصل إليه من نتائج، وبهذا يتهافت ويسقط قول من قال: إن حديث «الأئمة من قريش» شعار رفعته قريش لاستلاب الخلافة من الأنصار أو أنه: رأي لأبي بكر وليس حديثاً رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فكراً سياسياً قرشياً، كان شائعاً في ذلك العصر يعكس ثقل قريش في المجتمع العربي في ذلك الحين، وعلى هذا فإن نسبة هذه الأحاديث إلى أبي بكر وأنها شعار لقريش، ما هي إلّا صورة من صور التشويه التي يتعرض لها تاريخ العصر الراشدي وصدر الإسلام الذي قام أساساً على جهود المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وعلى روابط الأخوة المتينة بين المهاجرين والأنصار، حتى قال فيهم أبو بكر: نحن الأنصار، كما قال القائل:
أبوا أن يملونا ولو أن أُمَّنا
تلاقي الذي يلقون منا لملت
10ـ الشورى الجماعية في حادثة السقيفة:
أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادئ منها: أن قيام الأمة لا تقام إلا بالاختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً والأكفأ إدارة، فاختيار الخليفة رئيس الدولة وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن الرئاسة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية، وأن إثارة (قريش) في سقيفة بني ساعدة باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان، ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام، وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين حيث لا هرج ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات، ولا نقض للاتفاق، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية .
وقد استدل الدكتور توفيق الشاوي على بعض الأمثلة التي صدرت بالشورى الجماعية في سقيفة بني ساعدة حيث قال:
ـ أول ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن “نظام الحكم ودستور الدولة” يقرر بالشورى الحرة تطبيقاً لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن، ولذلك كان هذا المبدأ محل إجماع، وسند هذا الإجماع النصوص القرآنية التي فرضت الشورى، أي إن هذا الإجماع كشف وأكد أول أصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام وهو الشورى المُلزِمة، وهذا أول مبدأ دستوري تقرر بالإجماع بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييداً وتطبيقاً لنصوص الكتاب والسنة التي أوجبت الشورى .
ـ تقرر يوم السقيفة أيضاً أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية وتحديد سلطانه يجب أن يتم بالشورى، أي بالبيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ـ الدستور في النظم المعاصرة ـ وكان هذا ثاني المبادئ الدستورية التي أقرها الإجماع، وكان قراراً اجماعياً كالقرار السابق.
ـ تطبيقاً للمبدأين السابقين، قرر اجتماع السقيفة اختيار أبي بكر ليكون الخليفة الأول للدولة الإسلامية .
ثم إن هذا الترشيح لم يَصِحَّ نهائياً إلا بعد أن تمت له البيعة العامة، أي موافقة جمهور المسلمين في اليوم التالي بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قبوله لها بالشروط التي ذُكرت، وسنأتي على ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى.
بوابة القليوبية


.jpg)
.jpeg)
.jpg)