سيرة الإمام محمد بن علي السنوسي؛ نشأته ونبوغه المبكر
بقلم: الدكتور علي محمّد الصلابي
الحلقة الأولى
16 محرم 1440 ه
15 سبتمبر 2019م
محمد بن علي السنوسي؛ اسمه ونسبه وشيوخه وطلبه العلم
أولاً: اسمه ونسبه:
هو الشيخ محمد بن علي بن السنوسي بن العربي بن محمد بن عبد القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف بن عبد الله بن خطاب بن علي بن يحيى بن راشد بن أحمد المرابط بن منداس بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن يوسف بن زيان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن إدريس بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة بن علي بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي.
ولد سنة (1202 هـ) صبيحة يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول عند طلوع الفجر الموافق ل 1787م، ولذلك سماه والده محمداً تيمناً باسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانت ولادته بضاحية (مَيْثا) الواقعة على ضفة وادي شِلْف بمنطقة الواسطة التابعة لبلدة مستغانم في الجزائر، وتوفي والده بعد عامين من ولادته، وتولت عمته فاطمة تربيته وتنشئته تنشئة صالحة، وكانت من فضليات أهل زمانها، ومتبحرة في العلوم ومنقطعة للتدريس والوعظ، يحضر دروسها ومواعظها الرجال.
واهتمت السيدة فاطمة بابن أخيها الذي أظهر حباً عظيماً لتحصيل العلوم، فأخذ يطلب العلوم من شيوخ مستغانم، وغيرها من البلاد المجاورة لها، مع تعهد عمته له، ومن أشهر شيوخه في تلك المرحلة، ممن أخذ عنهم القران الكريم مع القراءات السبع: محمد بن قعمش الطهراوي زوج عمته، وابنه عبد القادر؛ وكانا عالمين جليلين صالحين، وابن عمه الشيخ محمد السنوسي الذي تولاه بعد وفاة عمته في الطاعون عام (1209 هـ) وعمره لم يتجاوز السابعة، وأتم على ابن عمه حفظ القران الكريم برواياته السبع مع علم رسم الخط للمصحف والضبط وقرأ عليه الرسالات الاتية: مورد الظمان، المصباح، العقيلية، الندى، الجزرية، الهداية المرضية في القراءة المكية، حرز الأماني للشاطبي، وغيرها مما هو من وظائف قارئ القرآن.
وبعد أن أتم ما يلزمه من لوازم حفظ القران وإتقانه شرع ابن عمه الشيخ محمد السنوسي في تعليمه العلوم العربية ثم الدينية بالتدريج، وتربيته على العمل بما تعلم، وكان يزوده بتراجم العلماء والقادة والفقهاء، وتوفي ابن عمه عام (1219 هـ) فجلس محمد بن علي عند شيوخ من مستغانم؛ وهم: محيي الدين بن شلهبة، ومحمد بن أبي زوينة، وعبد القادر بن عمور، ومحمد القندوز، ومحمد بن عبد الله، وأحمد الطبولي الطرابلسي، وكلهم من جهابذة العلماء في زمانهم، ومكث يطلب العلم في مستغانم سنتين كاملتين.
وفي أوائل (1221 هـ) خرج من مستغانم إلى بلدة مازونة ومكث بها سنة واحدة، وتتلمذ على مجموعة من المشائخ؛ هم: محمد بن علي بن أبي طالب، أبو رأس المعسكري، وأبو المهل أبو زوينة.
وبعد ذلك رحل إلى مدينة تلمسان وأقام بها ما يقارب السنة، وتتلمذ على كبار شيوخها.
ثانياً: نبوغ مبكر:
كان الشيخ محمد بن علي السنوسي في صغره يميل إلى الانزواء والانفراد، ويمضي وقتاً طويلاً في التفكير العميق، ويتألم من حال الأمة وما وصلت إليه من الضعف والهوان والضياع، وكان يبحث عن عوامل النهوض، وأسباب توحيد صفوف الأمة، وإحياء الملة الإسلامية، وحدث ذات مرة أن وجده بعض العلماء جالساً فوق كثيب من الرمال تظهر على صفحات وجهه المشرق علامات التفكير العميق، فلما سألوه عن السبب في ذلك، أجاب بأنه: «يفكر في حال العالم الإسلامي الذي لا يعدو عن كونه قطيعاً من الغنم لا راعي له؛ على الرغم من وجود سلاطينه وأمرائه ومشايخ طرقه وعلمائه، فمع أن هناك عدداً كبيراً من المرشدين وعلماء الدين الموجودين في كل مكان، فإن العالم الإسلامي لا يزال مفتقراً أشد الافتقار إلى مرشد حقيقي يكون هدفه سوق العالم الإسلامي أجمع إلى غاية واحدة ونحو غرض واحد، والسبب في هذا انعدام الغيرة الدينية لدى العلماء والشيوخ، وانصرافهم إلى الخلافات القائمة بينهم؛ التي قد فرقتهم شيعاً وجماعات، فأصبحوا لا يُعْنَونَ بنشر العلم والمعرفة، ولا يعملون بأوامر الدين الحنيف، وهو دين توحيد أساسه الاتحاد وجمع الكلمة.
زد على هذا أن على هؤلاء العلماء والشيوخ واجب عظيم في حق الملة الإسلامية، إذ إن الشعوب المجاورة في السودان والصحراء من إفريقية الغربية لا تزال تعبد الأوثان، ومع هذا فإنهم بدلاً من وعظ هذه الشعوب الوثنية وإرشادهم إلى الدين القويم، ما زالوا يفضلون القبوع في كل مسجد من مساجد المعمورة غير عاملين بعلمهم، لا هَمَّ لهم إلا راحة أجسامهم، حريصين على لذاتهم، غير قائمين بواجبات مراكزهم، لا ضمائر لهم تؤنبهم على إهمالهم إرشاد هؤلاء المساكين، الوثنيين».
ومع ذلك فقد بُلِّغ السيد من القوافل الواصلة إلى بلده مستغانم أن الإسلام مغلوب على أمره في كل محل، «وأن المقاطعات والخطط المعمورة تذهب من أيدي المسلمين في كل وقت وبسرعة البرق، فالإسلام في حالة التدهور المخيف».
ثم ختم كلامه بقوله: «هذا ما أفكر فيه! فلما سألوه: وماذا يجب على المسلمين عمله لتلافي ما ذكرت، أجاب: سأجتهد، سأجتهد».
لقد كان تفكيره في حال الأمة مبكراً، واجتهد في البحث عن العلل والأسباب التي أدت إلى التدهور والضعف المخيف في كيان الأمة، وذكر أن من أسباب هذا الضياع فقدان القيادة الراشدة، وغياب العلماء الربانيين، وانعدام الغيرة الدينية، والانشغال بالخلافات التي فرقتهم شيعاً وجماعات، والتفريط في حق دعوة الناس إلى الإسلام، وضياع الأقاليم الإسلامية، ولذلك اهتم بالبحث عن عوامل النهوض؛ فرأى أن بدايتها في الإيمان العميق الذي هو أساس كل خير وسبب لحصول البركات ونزول الأرزاق، قال تعالى: [الأعراف: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [الأعرَاف: 96].
إن الإيمان هو القضية الأولى والأساسية لهذه الأمة، فإذا تخلف المسلمون عن غيرهم في وسائل الحياة الحرة الكريمة فمردُّ ذلك إلى انحرافهم عن فهم الإسلام فهماً سليماً، وعن ضعف إيمانهم بقِيمه ومُثُلِه، ولا سبيل إلى إصلاح حالهم ومالهم إلا بالإيمان على الوجه الذي بيَّنه الله في كتابه، ورسوله (ص) في سنته. وهو أن يكون طاقة دافعة إلى العمل، وقوة محركة للبناء، وحافزاً طبيعياً للتفوق.
وقد وصل إلى حقيقة مهمة؛ ألا وهي أهمية العلم في نهوض الأفراد والجماعات والأمم، لأن العلم ظهير الإيمان، وأساس العمل الصالح، ودليل العبادة.
لقد كان شغفه بالعلم عظيماً، ورحم الله أبا إسحاق الألبيري عندما قال:
فَلَوْ قَدْ ذُقْتَ من حلواه طَعْماً لاثرتَ التعلُّم واجتهدْتَا
ولم يشغلْكَ عنه هوىً مطاعٌ ولا دنيا بزخْرُفِهَا فُتِنْتَا
ولا ألهاكَ عنه أنيقُ روضٍ ولا خِدْر بزينَتِها كَلِفْتَا
فقُوْتُ الرُّوح أرواحُ المعاني وليس بأن طَعِمْتَ ولا شربْتَا.
المراجع:
1. علي محمد الصلابي، الإمام محمد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس، دار الروضة، إستانبول، 2018.
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book180.pdf
2. عبد القادر بن علي، الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية، 1/8.
3. محمد فؤاد شكري، السنوسية دين ودولة، ص 11.
4. الدجاني، الحركة السنوسية، 2 47، نقلاً عن حاضر العالم الإسلامي.


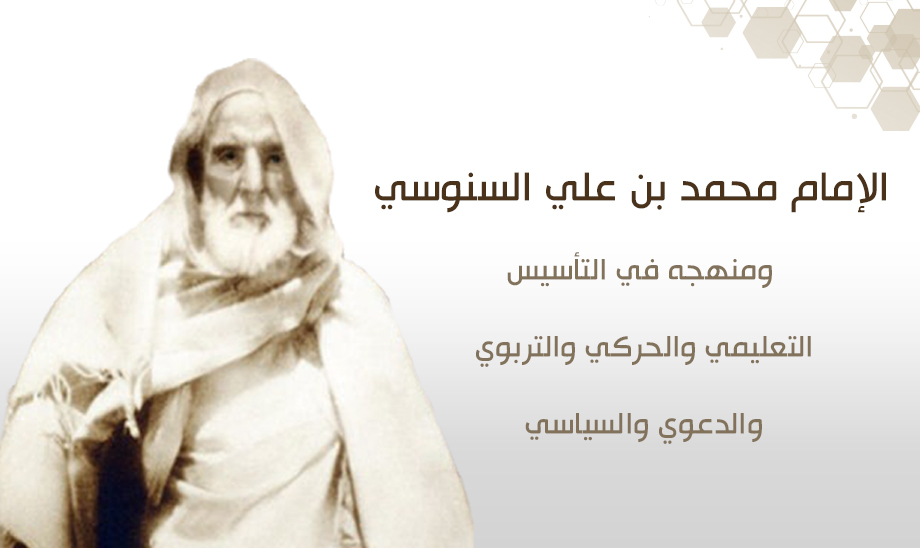

.jpg)

