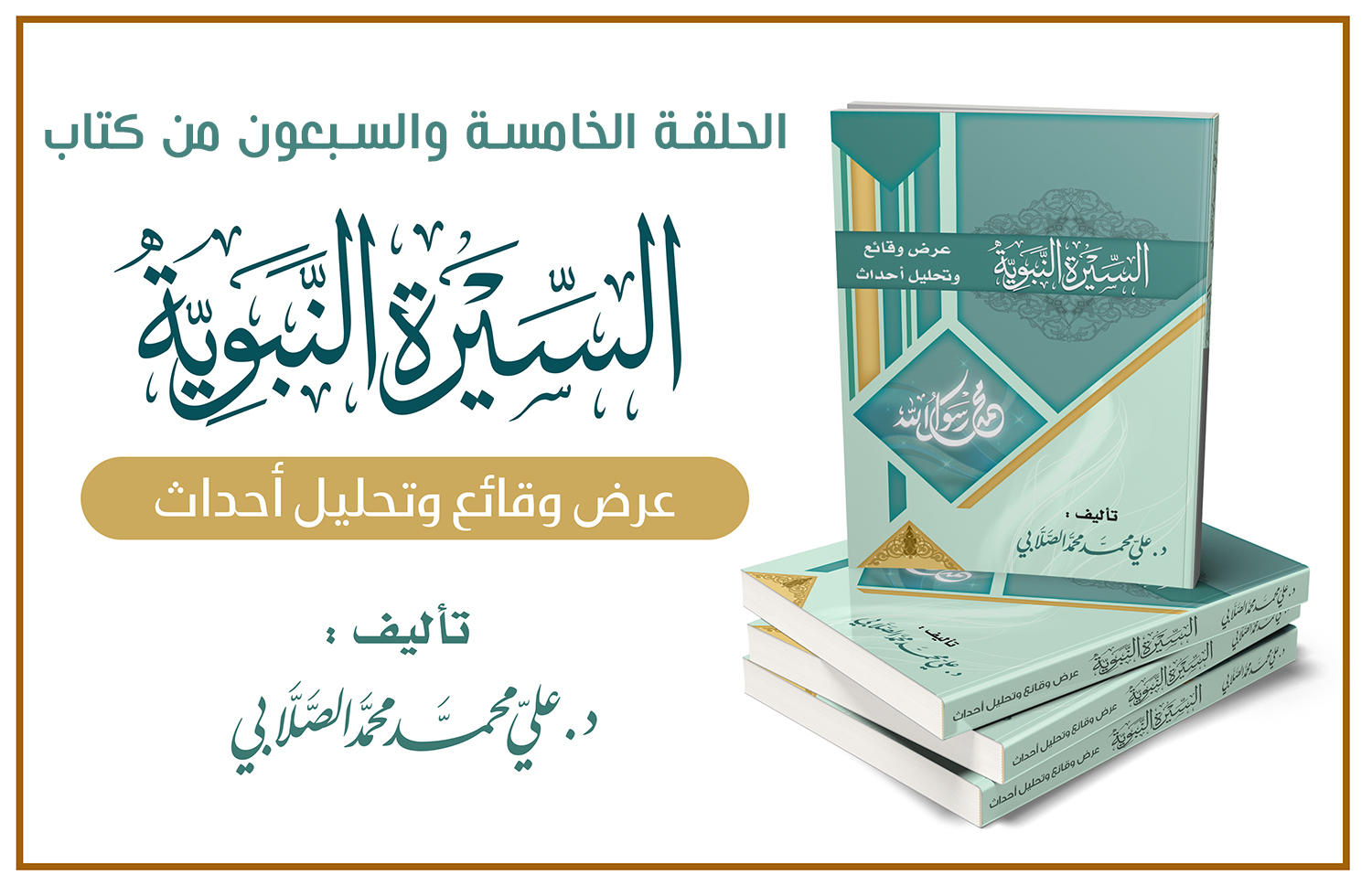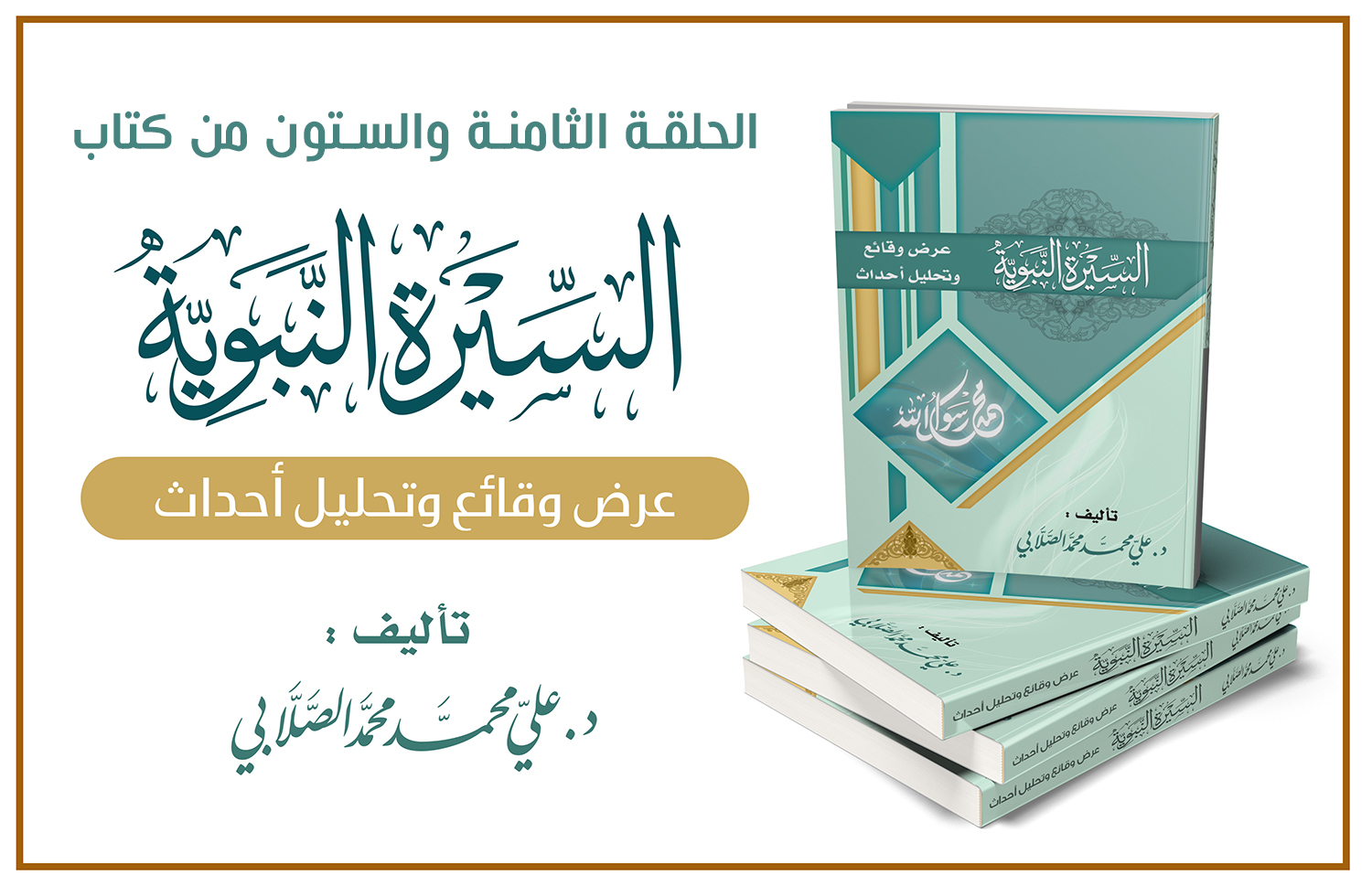الحلقة الخامسة والسبعون (75)
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم والمسلمون في ساحة معركة بدر
أولاً: بناء عريش القيادة:
بعد نزول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، على أدنى ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء عريشٍ له؛ يكون مقرّاً لقيادته، ويأمن فيه من العدوِّ، وكان ممَّا قاله سعدٌ في اقتراحه: «يا نبيَّ الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه، ونُعِدُّ عندك ركائبك، ثم نَلْقَى عدوَّنا، فإن أعزَّنا الله، وأظهرنا على عدوِّنا؛ كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى؛ جلستَ على ركائبك، فلحِقْتَ بمن وراءنا، فقد تخلَّف عنك أقوامٌ، يا نبيَّ الله! ما نحن بأشدَّ لك حبّاً منهم، ولو ظنُّوا أنَّك تلقى حرباً، ما تخلَّفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك، ويجاهدون معك» فأثنى عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خيراً، ودعا له بخيرٍ، ثمَّ بنى المسلمون العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، على تلٍّ مشرفٍ على ساحة القتال، وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه، وكانت ثُلَّةٌ من شباب الأنصار، بقيادة سعد بن معاذٍ، يحرسون عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ابن هشام (2/272 - 273) والبيهقي في الدلائل (3/44)] . ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها:
1 - لابدَّ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة، يتمكَّن القائد فيه من متابعة المعركة، وإدارتها.
2 - ينبغي أن يكون مقرُّ القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له.
3 - ينبغي الاهتمام بحياة القائد، وصونها من التعرُّض لأيِّ خطرٍ.
4 - ينبغي أن يكون للقائد قوَّةٌ احتياطيَّةٌ أخرى، تعوِّض الخسائر الَّتي قد تحدث في المعركة.
ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال:
من المِنَنِ الَّتي منَّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدرٍ: أنَّه أنزل عليهم النُّعَاسَ، والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم، قال تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾ [الآنفال: 11] .
قال القرطبيُّ: «وكان هذا النُّعاس في الليلة الَّتي كان القتال من غدها، فكان النَّوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهمِّ، ولكنَّ الله ربط جأشهم.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المِقْدَاد على فرسٍ أَبْلَقَ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرةٍ يُصلِّي، ويبكي حتَّى أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنَّوم في هذه الليلة وجهانِ:
- أحدهما: أنْ قوَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد.
- الثَّاني: أنْ أمَّنهم بزوال الرُّعب من قلوبهم، كما يقال: الأمن مُنِيمٌ، والخوفُ مُسْهِرٌ».
وبيَّن - سبحانه وتعالى -: أنَّه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم، في وقتٍ لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار، وذلك فضلاً منه، وكرماً، وإسناد هذا الآنزال إلى الله للتَّنبيه على أنَّه أكرمهم به.
قال الإمام الرَّازي: «وقد عُلِم بالعادة: أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً، ويغتمُّ إذا لم يتمكَّن من الاغتسال، ويضطرب قلبه لأجل هذا السَّبب، فلا جَرَمَ عدَّ - تعالى وتقدَّس - تمكينهم من الطَّهارة من جملة نعمه».
وقوله تعالى: فقد روى ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ جريرٍ عن ابن عباس قال: «نزل النَّبي صلى الله عليه وسلم - يعني حين سار إلى بدرٍ - والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ دِعْصَةٌ - أي كثيرةٌ مجتمعةٌ - فأصاب المسلمين ضعفٌ شديدٌ، وألقى الشَّيطان في قلوبهم الغيظ، فوسوس بينهم: (تزعمون: أنَّكم أولياء الله، وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مُجْنِبينَ)، فأمطر الله عليهم مطراً شديداً، فشرب المسلمون، وتطهَّروا، وأذهب الله عنهم رجز الشَّيطان، وثبت الرَّمل حين أصابه المطر، ومشى النَّاس عليه، والدَّواب، فساروا إلى القوم».
فقد بيَّن - سبحانه -: أنَّه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة، فتطهَّروا به حسِّيّاً، ومعنويّاً؛ إذ ربط الله به على قلوبهم، وثبَّت به أقدامهم؛ وذلك: أنَّ النَّاظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالاً متحرِّكةً لا زالت حتَّى اليوم، ومن العسير المشي عليها، ولها غبارٌ كبيرٌ، فلـمَّا نزلت الأمطار تماسكت تلك الرِّمال، وسَهُل السَّير عليها، وانطفأ غبارها، وكلُّ ذلك كان نعمةً من الله على عباده.:
ابتكر الرَّسول صلى الله عليه وسلم في قتاله مع المشركين يوم بدرٍ أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى، لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل صلى الله عليه وسلم بنظام الصُّفوف، وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4] .
وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصَّلاة، وتقلُّ هذه الصُّفوف، أو تكثر تَبَعاً لقلة المقاتلين، أو كثرتهم، وتكون الصُّفوف الأولى من أصحاب الرِّماح؛ لصدِّ هجمات الفُرْسان، وتكون الصُّفوف الَّتي خلفها من أصحاب النِّبال؛ لتسديدها من المهاجمين على الأعداء، وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدرٍ:
1 - رهاب الأعداء، ودلالةٌ على حسن وترتيب النِّظام عند المسلمين.
2 - جعل في يد القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم قوَّة احتياطيَّة، عالج بها المواقف المفاجئة في صدِّ هجومٍ معاكس، أو ضرب كمينٍ غير متوقَّعٍ، واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة، والفُرْسان، ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوَّل مرَّةٍ في غزوة بدرٍ سبقاً عسكريّاً، تميَّزت به المدرسة العسكريَّة الإسلاميَّة على غيرها منذ أربعةَ عَشَرَ قرناً من الزَّمان.
ويظهر للباحث في السِّيرة النَّبويَّة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية الجديدة، وخاصَّةً تلك الَّتي لم يعهدْها العرب من قبل، على نحو ما قام به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في يوم بدرٍ، وأُحدٍ، وغيرهما.
فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكَرِّ والفَرِّ، وقد علَّق اللواء محمود شيت خطَّاب على كلا الأسلوبين القتاليين بقوله: «إنَّ القتال بأسلوب الكرِّ، والفرِّ، هو أن يهجم المقاتلون بكلِّ قوَّتهم على العدوِّ؛ النَّشابة منهم، والَّذين يقاتلون بالسُّيوف، ويطعنون بالرِّماح، مشاةً، وفُرْساناً، فإن ثبت لهم العدوُّ، أو أحسُّوا بالضَّعف؛ نكصوا، ثمَّ أعادوا تنظيمهم، وكَرُّوا من جديدٍ، وهكذا يكرُّون، ويفرُّون حتَّى يكتب لهم النَّصر، أو الآندحار.
والقتال بأسلوب الصَّفِّ يكون بترتيب المقاتلين صفَّين، أو ثلاثة صفوفٍ، أو أكثر، على حسب عددهم، وتكون الصُّفوف الأماميَّة من المسلمين مسلحةً بالرِّماح؛ لصدِّ هجمات الفُرْسان، وتكون الصُّفوف المتعاقبة الأخرى مزوَّدةً بالنِّبال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء.
وتبقى الصُّفوف بقيادة قائدها، وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرِّ، والفرِّ زخمه وشدَّته، عند ذاك تتقدَّم الصُّفوف متعاقبةً متساندةً للزَّحف على العدوِّ، ومطاردته عند هزيمته.
ويرى اللِّواء (خطاب) أنَّ أسلوب الصَّفِّ يتميَّز عن أسلوب الكرِّ، والفرِّ، بأنَّه يؤمن التَّرتيب (بالعمق)، فتبقى دائماً بيد القائد قوَّةٌ احتياطيَّة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن يصدَّ هجوماً مقابلاً للعدو، أو يضرب كميناً لم يتوقعه، أو يحمي الأجنحة الَّتي يهددها العدوُّ بفُرْسانه، أو مشاته، ثمَّ يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة».
وقد تحدَّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليَّة الجديدة؛ الَّتي استحدثها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في معاركه، والَّتي لم يكن للعرب عهدٌ بها، فقال مشيراً إلى ذلك: «وكان أسلوب الحرب أوَّل الإسلام كلُّه زحفاً، وكان العرب إنما يعرفون الكرَّ، والفرَّ...».
وبيَّن أفضلية الأساليب الَّتي استحدثها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «وقتال الزَّحف أوثق وأشدُّ من قتال الكرِّ، والفرِّ؛ وذلك لأنَّ قتال الزَّحف ترتب فيه الصُّفوف، وتسوَّى كما تسوى القداح، أو صفوف الصَّلاة، ويمشون بصفوفهم إلى العدوِّ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع، وأصدق في القتال، وأرهب للعدوِّ؛ لأنَّه كالحائط الممتدِّ، والقصر المشيد لا يطمع في إزالته».
ومن جهة النَّظرة العسكرية فإنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبراعته العسكريَّة؛ لأنَّ التَّعليمات العسكريَّة الَّتي كان يصدرها خلال تطبيقه لها، تطابق تماماً الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة.
وتفصيل ذلك: فقد اتَّبع صلى الله عليه وسلم أسلوب الدِّفاع ولم يهاجم قوَّة قريشٍ، وكانت توجيهاته التَّكتيكيَّة الَّتي نفَّذها جنودُه بكلِّ دقَّةٍ سبباً في زعزعة مركز العدوِّ، وإضعاف نفسيته؛ وبذلـك تحقَّق النَّصر الحاسم - بتوفيق الله - على العدوِّ برغم تفوُّقـه (بنسبة 3 إلى 1)، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتصرَّف في كلِّ موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال، والظروف، وقد طبَّق الرَّسول صلى الله عليه وسلم في الجانب العسكريِّ أسلوب القيادة التَّوجيهيَّة في مكانها الصَّحيح، أمَّا أخذه بالأسلوب الإقناعيِّ في غزوة بدرٍ؛ فقد تجلَّى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضعَ متعدِّدةٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يقود جنده بمقتضى السُّلطة؛ بل بالكفاءة، والثِّقة، وهو صلى الله عليه وسلم أيضاً لا يستبدُّ برأيه، بل يتَّبع مبدأ الشُّورى، وينزل على الرَّأي الَّذي يبدو صوابه، ومارس صلى الله عليه وسلم في غزوة بدرٍ أسلوب القيادة التَّوجيهيَّة، فقد تجلَّى في أمورٍ؛ منها:
الأمر الأوَّل: أمره صلى الله عليه وسلم الصَّحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لأنَّ الرَّمي يكون أقربَ إلى الإصابة في هذه الحالة: «إن دنا القوم منكم؛ فانضحُوهم بالنَّبْل» [ابن هشام (2/278) والبيهقي في الدلائل (3/81)] .
الأمر الثاني: نهيه صلى الله عليه وسلم عن سلِّ السيوف إلى أن تتداخل الصُّفوف: «ولا تسلُّوا السُّيوف حتَّى يغشوكم» [أبو داود (2664)] .
الأمر الثالث: أمره صلى الله عليه وسلم الصَّحابة بالاقتصاد في الرَّمي: «واسْتَبْقُوا نَبْلَكم» [البخاري (2/3984) و3985) وأبو داود (2663)].
وعندما تقارن هذه التَّعليمات الحربيَّة بالمبادئ الحديثة في الدِّفاع؛ تجد أنَّ رسول الله (ﷺ) كان سباقاً إليها، من غير عكوفٍ على الدَّرس، ولا التحاقٍ بالكلِّيات الحربيَّة، فالنَّبيُّ (ﷺ) يرمي مِنْ وراء تعليماته الَّتي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت النِّيران إلى اللحظة الَّتي يصبح فيها العدوُّ في المدى المؤثِّر لهذه الأسلحة، وهذا ما قصده صلى الله عليه وسلم في قوله: «واسْتَبْقوا نَبْلكم» [سبق تخريجه] .
- فرصة الاستفادة من الظُّروف الطَّبيعية أثناء قتال الأعداء:
ولم يهملْ صلى الله عليه وسلم فرصةَ الاستفادة من الظروف الطَّبيعية أثناء قتال العدوِّ، فقد كان يستفيد من كلِّ الظُّروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل بدء القتال يوم بدرٍ، يقول المقريزي: «وأصبح صلى الله عليه وسلم ببدرٍ قبل أن تنزل قريش، فطلعت الشَّمس وهو يصفُّهم، فاستقبل المغرب، وجعل الشَّمس خلفه، فاستقبلوا الشَّمس».
وهذا التَّصرُّف يدلُّ على حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم ، واستفادته حتَّى من الظُّروف الطَّبيعية، لما يحقِّق المصلحة لجيشه؛ وإنَّما فعل ذلك لأنَّ الشَّمس إذا كانت في وجه المقاتل، تسبِّب له عَشَا البصر؛ فتقلُّ مقاومته، ومجابهته لعدوِّه. وفيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنَّ الظروف الطَّبيعيَّة كالشَّمس، والرِّيح، والتَّضاريس الجغرافيَّة، وغيرها لها تأثيرٌ عظيمٌ على موازين القوى في المعارك، وهي من الأسباب الَّتي طلب الله منَّا الأخذ بها؛ لتحقيق النَّصر، والصُّعود إلى المعالي.
- سَوَّاد بن غَزِيَّة في الصفوف:
كان صلى الله عليه وسلم في بدرٍ يعدِّل الصُّفوف، ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمةً، متراصةً؛ وبيده سَهْمٌ لا ريش له، يُعَدِّل به الصَّف، فرأى رجلاً اسمه سَوَّاد بن غَزِيَّة وقد خرج من الصَّفِّ، فطعنـه صلى الله عليه وسلم في بطنـه، وقال لـه: «استوِ يا سَوَّاد!» فقال: يا رسولَ الله! أَوْجَعْتَنِـي! وقـد بعثك الله بالحـقِّ، والعـدل، فأَقِدْنـي، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: «استَقِدْ»، فاعتنقه، فقبَّل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا يا سَوَّاد!» قال: يا رسولَ الله! حضر ما ترى؛ فأردت أن يكون اخر العهد بك أن يمسَّ جلدي جلْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام (2/278 - 279)].
ويُستفاد من قصَّة سَوَّاد رضي الله عنه أمورٌ؛ منها:
1 - حرص الإسلام على النِّظام.
2 - العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القَوَد من نفسه.
3 - حب الجندي لقائده.
4 - تذكُّر الموت، والشَّهادة.
5 - جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركٌ، ومسُّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَوَّاد.
6 - بطن الرَّجل ليس بعورةٍ؛ بدليل: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه، ولو كان عورةً؛ لما كشف عنه.
- تحريض النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال:
كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يربِّي أصحابَه على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويَّةٍ، راسخةٍ، ثابتةٍ، ثبات الشُّمِّ الرَّواسي، فيملأ قلوبهم شجاعةً، وجرأةً، وأملاً في النَّصر على الأعداء، وكان يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القويَّة أسلوب التَّرغيب والتَّرهيب؛ التَّرغيب في أجر المجاهدين الثَّابتين، والتَّرهيب من التولِّي يوم الزَّحف، والفرار من ساحات الوَغَى، كما كان يحدِّثهم عن عوامل النَّصر، وأسبابه؛ ليأخذوا بها، ويلتزموها، ويحذِّرهم من أسباب الهزيمة؛ ليقلعوا عنها، وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها.
وكان صلى الله عليه وسلم يحثُّ أصحابه على القتال، ويحرِّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الآنفال: 65]، وقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً ﴾ [النساء: 84] .
وفي غزوة بدرٍ الكبرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا إلى جنَّةٍ عرضها السَّموات، والأرض»، فقال عُمَيْرُ بنُ الحُمَامِ الأنصاريُّ رضي الله عنه: يا رسولَ الله! جَنَّةٌ عرضُها السَّموات والأَرضُ؟! قال: «نعم» قال: بَخٍ، بخٍ! (كلمة تعجب)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يحملُك على قولك: بَخٍ بَخٍ؟!» قال: لا والله! يا رسولَ الله! إلا رجاءَ أن أكون من أهلها. قال: «فإنَّك من أهلها» فأخرج تمراتٍ من قَرَنِهِ (جعْبَة النُّشَّاب)، فجعل يأكل منهنَّ، ثم قال: لئن أنا حَيِيتُ حتَّى آكل تمراتي هذه، إنَّها لحياةٌ طويلةٌ، قال: فرمى بما كان معه من التَّمر، ثمَّ قاتلهم حتَّى قُتل. [مسلم (1901)] .
وفي روايةٍ قال: قال أنسٌ رضي الله عنه: فرمى ما كان معه من التَّمر، وقاتل؛ وهو يقول:
|
رَكْضاً إلى اللهِ بِغَيْرِ زَادٍ |
|
إلا التُّقَى وَعَمَلَ المَعَادِ |
||||
|
والصّبْرَ في الله على الجِهَادِ |
|
وكُلُّ زادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ |
||||
|
|
|
|
غَيْرَ التُّقَى والبِرِّ والرَّشَادِ |
|
||
فقاتل - رحمه الله! - حتَّى استُشْهِد.
ومن صور التَّعبئة المعنويَّة: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يبشِّرهم بقتل صَنَادِيد المشركين، وزيادةً لهم في الطُّمأْنينة، كان يحدِّد مكان قتل كلِّ واحدٍ منهم، كما كان يبشِّر المؤمنين بالنَّصر قبل بدء القتال، فيقول: «أبشرْ أبا بكر» ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصَّحابة - رضوان الله عليهم -: «والذي نفسُ محمد بيده! لا يُقاتلهم اليومَ رجلٌ، فَيُقْتَل صابراً محتسباً، مقبلاً غيرَ مُدْبرٍ، إلا أدخله الله الجنَّة» [ابن هشام (2/279)] .
وقد أثَّرت هذه التَّعبئة المعنويَّة في نفوس أصحابه - رضوان الله عليهم - والَّذين جاؤوا من بعدهم بإحسانٍ.
وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين ألاَّ يتقدمَ أحدٌ إلى شيءٍ حتَّى يكون دونه، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: .... فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه حتَّى سبقوا المشركين إلى بدرٍ، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَقْدُمَنَّ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دونَه»، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قوموا إلى جنَّةٍ عَرْضُها السمواتُ والأرضُ» [سبق تخريجه] .
- دعاؤه صلى الله عليه وسلم واستغاثته:
قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الآنفال: 9]، لـمَّا نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه، وأصدر أوامره لهم، وحرَّضهم على القتالِ؛ رجع إلى العريش الَّذي بُني له، ومعه صاحبه أبو بكرٍ رضي الله عنه، وسعد بن معاذٍ على باب العريش لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَيْفَه، واتَّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربِّـه يدعوه، ويناشده النَّصر الَّذي وعده، ويقول في دعائه: «اللَّهمَّ أَنْجِزْ لي ما وعدتني! اللَّهُمَّ اتِ ما وعدتني! اللَّهُمَّ إن تُهْلِكْ هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تُعْبدْ في الأرض!» فما زال يهتفُ بربِّه، مادّاً يديه، مستقبلَ القبلة، حتَّى سقط رداؤُهُ عن مَنْكَبيه، فأتاه أبو بكرٍ، فأخذ ردَاءَهُ، فألقاه على مَنْكبيه، ثمَّ التزمه من ورائه، وقال: يا نبيَّ الله! كفاك مناشدتُك ربَّك، فإنَّه سينجز لـكَ ما وعدك! [مسلم (1763) وأبو داود (2690) والترمذي (3081) وأحمد (1/30)]. فأنزل الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾
وفي رواية ابن عباسٍ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ: «اللَّهمَّ أنشُدُكَ عَهْدَكَ، ووعدك! اللَّهُمَّ إن شئتَ لم تُعْبَدْ» فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك، فخرج صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ [(2915) وأحمد (1/329) والبيهقي في الدلائل (3/50)].
وروى ابن إسحاق: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ هذه قريش، قد أقبلت بخُيَلائها، وفَخْرها، تُحَادُّك وتكذِّبُ رسولَك، اللَّهُمَّ فنصرَك الَّذي وعدتني! اللَّهُم أحنهم الغداة!» [ابن هشام (2/273) والبيهقي في الدلائل (3/110)] .
وهذا درسٌ ربَّانيٌّ مهمٌّ لكلِّ قائدٍ، أو حاكمٍ، أو زعيمٍ، أو فردٍ في التَّجرُّد من النَّفس. وحظِّها، والخلوص، واللُّجوء لله وحدَه، والسُّجود، والجُثُوِّ بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره، ويبقى مشهد نبيِّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو مادٌّ يديه يستغيث بالله، يبقى هذا المشهد محفوراً بقلبه، ووجدانه، يحاول تنفيذه في مثل هذه السَّاعات، وفي مثل هذه المواطن، حيث تناط به المسؤوليَّة، وتُلقى عليه أعباء القيادة.
﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾
بعد أن دعا صلى الله عليه وسلم ربَّه في العريش، واستغاث بـه، خرج من العريش، فأخذ قبضـةً من التُّراب، وحصب بها وجوهَ المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم : «شاهتِ الوجوه» [ابن هشام (2/280)] ثمَّ أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يَصْدُقوا الحملة إثرها، ففعلوا، فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبقَ أحدٌ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الآنفال: 17]، ومعنى الآية: أنَّ الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرَّمي، ونفى عنه الإيصال الَّذي لم يحصل برميته.
ونلحظ: أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المادِّيَّة، والمعنويَّة، وتوكَّل على الله، فكان النَّصر والتَّأييد من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَدْرِ الممكن، مع التَّوفيق الرَّبَّانيِّ في تهيئة جميع أسباب النَّصر متعاونةً، متكافئةً مع التأييدات الرَّبَّانيَّة الخارقة، والغيبيَّة؛ ففي عالم الأسباب تشكِّل دراسة الأرض، والطَّقس، ووجود القيادة والثِّقة بها، والرُّوح المعنويَّة لبناتٍ أساسيةً في صحَّة القرار العسكريِّ، ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين، وكان الطَّقس مناسباً للمعركة، والقيادة الرَّفيعة موجودةً، والثِّقة بها كبيرة، والرُّوح المعنويَّة مرتفعة، وبعض هذه المعاني كان من الله بشكلٍ مباشرٍ، وتوفيقه، وبعضها كان من فِعْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذاً بالأسباب المطلوبة، فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله، وزيدَ على ذلك التأييدات الغيبيَّة، والخارقة؛ فكان ما كان، وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل الله، إذا ما صلحت النِّـيَّات عند الجند، والقادة، ووجدت الاستقامة على أمر الله، وأخذ المسلمون بالأسباب.
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ