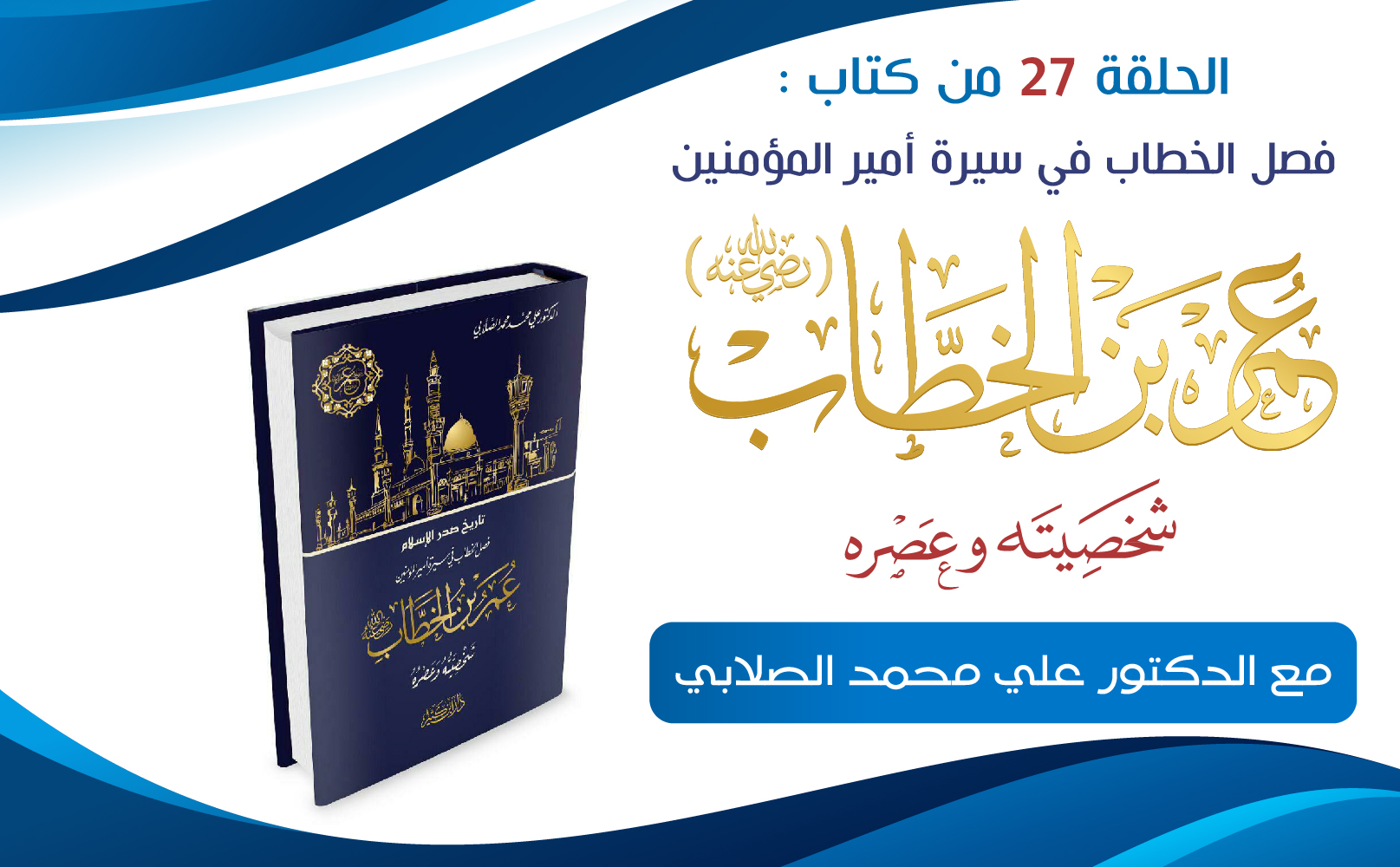الحلقة الثامنة عشر بعد المئة (118)
غزوة تبوك (9 هـ) تاريخها، وأسماؤها، وأسبابها
أوَّلاً: تاريخها، وأسماؤها:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في رجب من العام التَّاسع الهجريِّ، بعد العودة من حصار الطَّائف بنحو ستَّة أشهرٍ.
واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إلى مكانٍ، هو عين تبوك؛ الَّتي انتهى إليها الجيش الإسلاميُّ، وأصل هذه التَّسمية جاء في صحيح مسلم، فقد روى بسنده إلى معاذ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتَّى يضحى النَّهار، فمن جاءها منكم فلا يمسَّ من مائها شيئاً حتَّى اتي». [أحمد (5/237 - 238)، ومسلم (706/10)، وأبو داود (1206)، والترمذي (553)، والنسائي (1/285)، وابن ماجه (1070)].
وللغزوة اسمٌ اخر، وهو غزوة العُسْرَة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدَّث عن هذه الغزوة في سورة التَّوبة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 117].
وقد روى البخاريُّ بسنده إلى أبي موسى الأشعريِّ: قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحُملانَ لهم؛ إذ هم معه في جيش العُسْرَة، وهي غزوة تبوك...، وعَنْوَنَ البخاريُّ لهذه الغزوة بقوله: «باب غزوة تبوك، وهي غزوة العُسْرة». [البخاري تعليقاً (8/138)].
لقد سمِّيت بهذا الاسم لشدَّة ما لاقى المسلمون فيها من الضَّنْكِ، فقد كان الجوُّ شديدَ الحرارة، والمسافة بعيدةً، والسَّفر شاقّاً لقلَّة المؤونة وقلَّة الدَّوابِّ الَّتي تحمل المجاهدين إلى أرض المعركة، وقلَّة الماء في هذا السَّفر الطَّويل، والحرِّ الشَّديد، وكذلك قلَّة المال الذي يُجَهَّز به الجيش، وينفق عليه، ففي تفسير عبد الرَّزَّاق عن معمر، عن ابن عقيل؛ قال: (خرجوا في قلَّةٍ من الظَّهْر، وفي حرٍّ شديدٍ حتَّى كانوا ينحرون البعير، فيشربون ما في كِرْشِهِ من الماء، فكان ذلك عُسْرَةً من الماء)، وهذا الفاروق عمر بن الخطَّاب يحدِّثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين، فيقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطشٌ شديدٌ، حتَّى ظننَّا أنَّ رقابنا ستنقطع حتَّى إن كان أحدُنا يذهب يلتمس الخلاء، فلا يرجع حتَّى يظنَّ أنَّ رقبته تنقطع، وحتى إنَّ الرَّجل لينحر بعيره، فيعصر فرثه؛ فيشربه، ويضع ما بقي على بَطْنِه. [البزار (1841)، والهيثمي في مجمع الزوائد (6/194)].
وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذكره الزُّرقانيُّ - رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب اللَّدنية)، وسمِّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين، وهتكت أستارهم، وفضحت أساليبهم العدائيَّة الماكرة، وأحقادهم الدَّفينة، ونفوسهم الخبيثة، وجرائمهم البشعة بحقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسلمين.
وأمَّا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة 778 ميلاً حسب الطَّريق المعبدة في الوقت الحاضر، وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الرُّوم انذاك.
ثانياً: أسبابها:
ذكر المؤرِّخون أسباب هذه الغزوة، فقالوا: وصلت الأنباء للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الأنباط الَّذين يأتون بالزَّيت مِنَ الشَّام إلى المدينة: أنَّ الروم جمعت جموعاً، وأجلبت معهم لخمُ، وجُذَامُ، وغيرُهم من متنصِّرة العرب، وجاءت في مقدِّمتهم إلى البلقاء، فأراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم قبل أن يغزوه.
ويرى ابن كثير: أنَّ سبب الغزوة هو استجابةٌ طبيعيَّةٌ لفريضة الجهاد، ولذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الرُّوم؛ لأنَّهم أقرب النَّاس إليه، وأولى النَّاس بالدَّعوة إلى الحقِّ لقربهم إلى الإسلام، وأهله، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 123].
والَّذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصَّواب؛ إضافةً إلى أنَّ الأمر الَّذي استقرَّ عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافَّةً بِمَنْ فيهم أهل الكتاب الَّذين وقفوا في طريق الدَّعوة، وظهر تحرُّشهم بالمسلمين، كما روى أهل السِّير.
ولا يمنع ما ذكره المؤرِّخون بأنَّ سبب الخروج هو عزم الرُّوم على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً.
لقد كان المسلمون على حذرٍ من مجيء غسَّان إليهم من الشَّام، ويظهر ذلك جليّاً ممَّا وقع لعمر بن الخطَّاب، فقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهراً، فهجرهنَّ، ففي صحيح البخاريِّ: وكنَّا قد تحدَّثنا: أنَّ ال غسَّان تُنْعِلُ النِّعال لغزونا، فنزل صاحبي الأنصاريُّ يوم نوبته، فرجع إلينا عِشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً، وقال: أنائمٌ هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمرٌ عظيم، فقلت: ما هو؟ أجاءت غسَّان؟ قال: لا! بل أعظم منه، وأهول، طلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه.... [البخاري (5191)، ومسلم (1749)].
ثالثاً: الإنفاقُ في هذه الغزوة وحِرْصُ المؤمنين على الجهاد:
حثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها، وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كلٌّ حسب مقدرته، وكان عثمان رضي الله عنه صاحب القِدْح المعلَّى في الإنفاق في هذه الغزوة، فهذا عبد الرَّحمن بن حُباب يحدِّثنا عن نفقة عثمان، حيث قال: شهدت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يحثُّ على جيش العُسْرَة، فقام عثمان بن عفَّان، فقال: يا رسول الله! عليَّ مئة بعيرٍ بأحلاسها، وأقتابها في سبيل الله، ثمَّ حضَّ على الجيش، فقام عثمان بن عفَّان، فقال: يا رسول الله! عليَّ مئتا بعيرٍ بأحلاسها، وأقتابها في سبيل الله، ثمَّ حضَّ على الجيش، فقام عثمان بن عفَّان، فقال: يا رسول الله! عليَّ ثلاثمئة بعيرٍ بأحلاسها، وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر، وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه! ما على عثمان ما عمل بعد هذه». [أحمد (4/75)، والترمذي (3700)].
وعن عبد الرَّحمن بن سَمُرَة رضي الله عنهما قال: جاء عثمان بن عفَّان إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بألف دينارٍ في ثوبه حين جهَّز النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جيش العُسْرَة، قال: فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقلِّبها بيده، ويقول: «ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردِّدها مراراً». [أحمد (5/63)، والترمذي (3701)].
وأمَّا عمر؛ فقد تصدَّق بنصف ماله، وظنَّ أنَّه سيسبق أبا بكرٍ بذلك، وهذا الفاروق يحدِّثنا بنفسه عن ذلك، حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدَّق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثلَه. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلِّ ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسولَه، قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبداً. [أبو داود (1678)، والترمذي (3675)].
وروي: أنَّ عبد الرَّحمن بن عوفٍ أنفق ألفي درهم، وهي نصف أمواله لتجهيز جيش العُسْرَة.
وكانت لبعض الصَّحابة نفقاتٌ عظيمةٌ، كالعبَّاس بن عبد المطَّلب، وطلحة بن عبيد الله، ومحمَّد بن مَسْلَمة، وعاصم بن عديٍّ رضي الله عنهم.
وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلةٌ، واستطاع أغنياء الصَّحابة أن يبرهنوا: أنَّ مالهم في خدمة هذا الدِّين، يدفعونه عن طواعيةٍ، ورغبةٍ، وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخٌ مشرِّفٌ؛ لأنَّه تاريخ المال في يد الرِّجال، لا تاريخ الرِّجال تحت سيطرة المال، وكما كان الجهاد بالنَّفس فكذلك هو بالمال، وإنَّ الَّذين رُبُّوا على أن يقدِّموا أنفسهم، تهون عليهم أموالُهم في سبيل الله تعالى.
إنَّ في مسارعة الموسرين من الصَّحابة إلى البذل، والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍ إلى فعل الخير، ومقاومةٍ لأهواء النَّفس وغرائزها، ممَّا تحتاج إليه كلُّ أمَّة لضمان النَّصر على أعدائها، وخير ما يفعله المصلحون، وزعماء النَّهضات هو غرس الدِّين في نفوس النَّاس غرساً كريماً.
وقدَّم فقراء المسلمين جهدهم من النَّفقة على استحياءٍ، ولذلك تعرَّضوا لسُخْرِيَةِ وغمز، ولمز المنافقين، فقد جاء أبو عُقَيْلٍ بنصف صاع تمرٍ، وجاء اخر بأكثر منه، فلمزوهما قائلين: إنَّ الله لغنيٌّ عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياءً، فنزلت الآية: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 79].
وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، فكانوا يتَّهمون الأغنياء بالرِّياء، ويسخرون من صدقة الفقراء.
لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنَّهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عُلبَةُ بن زيدٍ أحد البكَّائين صلَّى من اللَّيل، وبكى، وقال: اللَّهمَّ! إنَّك قد أمرت بالجهاد، ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوَّى به مع رسولك، وإنِّي أتصدَّق على كلِّ مسلمٍ بكلِّ مظلمةٍ أصابتني في جسدٍ، أو عرْضٍ، فأخبره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : أنَّه قد غُفِر له.
وفي هذه القصَّة وما جرى فيها آيات من الإخلاص، وحبِّ الجهاد لنصرة دين الله، وبثِّ دعوته في الافاق، وفيها مِنْ لُطف الله بضعفاء المؤمنين الَّذين يعيشون في حياتهم عيشةً عمليَّة.
وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدِّثنـا عن قصَّته: (.... عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك، خرجت إلى أهلي، فأقبلت - وقد خرج أوَّل صحابة رسول الله - فطفقت في المدينة أنادي: ألا مَنْ يحمل رجلاً له سهمه! فإذا شيخٌ من الأنصار، فقال: لنا سهمه على أن نحملَه عقبة، وطعامه معنا. فقلت: نعم، قال: فسر على بركـة الله، فخرجت مع خيـر صاحبٍ حتَّى أفـاء الله علينا، فأصابني قلائصَ، فَسُقْتُهُنَّ حتَّى أتيتُه، فخرج، فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثمَّ قال: سقهن مدبراتٍ، ثمَّ قال: سقهن مقبلاتٍ، فقال: ما أرى قلائصك إلا كراماً إنَّما هي غنيمتُك الَّتي شرطتُ لك، قال: خذ قلائصك يابن أخي! فغير سهمِك أردنا. [أبو داود (2676)].
وهكذا تنازل واثلـة في بداية الأمر عن غنيمتـه ليكسب الغنيمة الآخرويَّة، أجراً، وثواباً يجده عند الله يوم لقائه، وتنازل الأنصاريُّ عن قسم كبيرٍ من راحته، ليتعاقب وواثلة على راحلته، ويقدِّم له الطَّعام مقابل سهمٍ اخر، وهو الأجر، والثَّواب.
إنَّها مفاهيم تنبع من المجتمع الَّذي تربَّى على كتاب الله، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لها نفس الخاصِّيَّة في الإضاءة، وتحمل نَفْسَ البريق، متمِّمٌ بعضها لبعضها الآخر.
وجاء الأشعريُّون يتقدَّمهم أبو موسى الأشعريُّ يطلبون من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على إبلٍ ليتمكَّنوا من الخروج للجهاد، فلم يجد ما يحملهم عليه حتَّى مضى بعضُ الوقت، فحصل لهم على ثلاثةٍ من الإبل.
وبلغ الأمر بالضُّعفاء، والعجزة ممَّن أقعدهم المرض، أو النَّفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقاً للجهاد، وتحرُّجاً من القعود حتَّى نزل فيهم قرآن: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة: 91 - 92].
إنَّها صورةٌ مؤثِّرة للرَّغبة الصَّحيحة في الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان يحسُّه صادقو الإيمان من ألمٍ إذا ما حالت ظروفهم المادِّية بينهم وبين القيام بواجباته، وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممَّن عذر الله لمرضٍ، أو كبر سنٍّ، أو غيره يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين، وهم الَّذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «إنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». [البخاري (4423)، وأحمد (3/103)، وأبو داود (2508)، وابن ماجه (2764)، وابن حبان (4731)].
رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك:
عندما أعلن الرَّسول صلى الله عليه وسلم النَّفير، ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في تثبيط همم النَّاس، قائلين لهم: لا تنفروا في الحرِّ، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: 81 - 82].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو في جهازه لتبوك - للجدِّ بن قيس: يا جدُّ! هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله! أو تَأذن لي، ولا تفتني؟ فوالله! لقد عرف قومي: أنَّه ما من رجل أشدُّ عجباً بالنِّساء منِّي، وإنِّي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألاَّ أصبر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره (10/148 - 149)، والبيهقي في الدلائل (5/213 - 214)، والطبراني في الكبير (2154 و12654)، والهيثمي في مجمع الزوائد (7/30)]، ففيه نزلت الآية: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 49]، وذهب بعضهم إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مبدين أعذاراً كاذبةً، ليأذن لهم بالتخلَّف، فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43].
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديِّ يثبِّطون النَّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم. [ابن هشام (4/160)].
وهذا يدلُّ على مراقبة المسلمين الدَّقيقة، ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود، فقد كانت عيون المسلمين يقظةً تراقب تحرُّكات اليهود، والمنافقين، واجتماعاتهم، وأوكارهم، بل كانوا يطَّلعون فيها على أدقِّ أسرارهم، واجتماعاتهم، وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات، وابتكار أساليب التَّثبيط، واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال، وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة، وأوكارها حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على مَنْ فيه من المنافقين، وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يُنَفِّذُه، وَنُفِّذَ بحزمٍ، وهذا منهج نبويٌّ كريمٌ يتعلَّم منه كل مسؤول في كلِّ زمانٍ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة، ومراكز الإشاعات المضلِّلة الَّتي تُلحق الضَّرر بالأفراد، والمجتمعات، والدُّول؛ لأنَّ التَّردُّد في مثل هذه الأمور يُعَرِّض الأمن، والأمان إلى الخطر، وينذر بزوالها.
لقد تحدَّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة، وفي أثناءها وبعدها، وممَّا جاء من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمَّن استئذانهم، وتخلُّفهم عن الخروج، وكان ممَّن تخلف عبد الله بن أبيِّ بن سلول وقد تحدَّث القرآن عنهم، فقال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [التوبة: 42].
فقد بيَّن - سبحانه وتعالى - موقف المنافقين، وأنَّهم تخلَّفوا بسبب بُعْد المسافة، وشدَّتها، وأنَّه لو كان الَّذي دعوتَهم إليه - يا محمد! - عرضاً من أعراض الدُّنيا، ونعيمها، وكان السَّفر سهـلاً، لاتَّبعوك في الخروج، ولكنَّهم تخلَّفوا، ولم يخرجوا، فالآية تشرح، وتوضِّح ملابسات موقفهم قبـل الخروج إلى الغزوة، وأسباب هذا الموقف، ثمَّ حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾، وكان نزول هذه الآية قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك.
والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله - كذباً، وزوراً - قائلين: لو استطعنا أيُّها المؤمنون! أن نخرج معكم للجهاد في تبوك؛ لخرجنا، فإنَّنا لم نتخلَّف عن الخروج معكم إلا مضطرِّين، فقد كانت لنا أعذارُنا القاهرة الَّتي حملتنا على التخلُّف.
وقوله - سبحانه -: ﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾
قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي: موقعينها في الهُلْكِ - والهُلْكُ: الفناء، والموت، ويطلق على الأضرار الجسميَّة، وهو المناسب هنا - أي: يتسبَّبون في ضرِّ أنفسهم بالأيمان الكاذبة، وهو ضرُّ الدُّنيا، وعذاب الآخرة، وفي هذه الآية دلالةٌ على أنَّ تعمُّد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك.
ثمَّ عاتب الله تعالى نبيَّنا محمَّداً صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾
قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أُناسٍ قالوا: استأذِنوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فإن أذن لكم؛ فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم، فاقعدوا. وهؤلاء هم فريقٌ من المنافقين، منهم عبد الله بن أبيِّ بن سلول، والجدُّ بن قيسٍ، ورفاعةُ بن التَّابوت، وكانوا تسعةً وثلاثين، واعتذروا بأعذارٍ كاذبةٍ.
والآية الكريمة عتابٌ لطيفٌ من اللَّطيف الخبير سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم على ترك الأَوْلى، وهو التوقُّـف عن الإذن إلى انجـلاء الأمر، وانكشـاف الحال، ثـمَّ قـال تعالى: ﴿لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: 44 - 45].
هـذه الآيات أوَّل ما نـزل في التَّفرقـة بين المنافقين والمؤمنين في القتال، فبيَّن سبحانه: أنَّه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان، وترك الجهاد في سبيل الله، وإنَّما هذا من صفات المنافقين الَّذين يستأذنون من غير عذرٍ، وصفهم - سبحانه - بقوله: أي: شكَّت في صحَّة ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ جئتَهم به، وقوله: أي: ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾، يقدمون رِجْلاً، ويؤخِّرون أخرى، وليست لهم قدمٌ ثابتةٌ في شيءٍ.
لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبةً للتَّمييز بين المؤمنين، والمنافقين، وَضَحَتْ فيها الحواجز بين الطَّرفين، ولم يَعُدْ هناك أيُّ مجالٍ للتَّستُّر على المنافقين، أو مجاملتهم؛ بل أصبحت مجابهتُهم أمراً ملحّاً بعد أن عملوا كلَّ مافي وسعهم لمجابهة الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، والدَّعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنَّفير، الَّذي أعلنه الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والَّذي نزل به القرآن الكريم؛ بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافُهم عند حدِّهم واجباً شرعيّاً.
خامساً: إعلان النَّفير، وتعبئة الجيش:
أُعلِن النَّفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حتَّى بلغ عدد من خرج مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثلاثين ألفاً، وقد عاتب القرآن الكريم الَّذين تباطؤوا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: 38].
وقد طالبهم القرآن الكريم بأن ينفروا شباناً، وشيوخاً، وأغنياء، وفقراء، بقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 41].
لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحشد ثلاثين ألف مقاتلٍ من المهاجرين، والأنصار، وأهل مكَّة، والقبائل العربيَّة الأخرى، ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم - على غير عادته في غزواته - هدفه، ووجهتَه في القتال؛ إذ أعلن صراحةً: أنَّه يريد قتال بني الأصفر (الرُّوم)، علماً بأنَّ هديه في معظم غزواته أن يورِّي فيها(1)، ولا يصرِّح بهدفِه، ووجهتِه، وقصدِه حفاظاً على سرية الحركة، ومباغتة العدوِّ(1).
وقد استدلَّ بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التَّصريح لجهة الغزو إذا لم تقتضِ المصلحة ستره، وقد صرَّح صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة - على غير العادة - بالجهة التي يريد غزوها، وجلَّى هذا الأمر للمسلمين، لأسبابٍ منها:
1 - بُعْد المسافـة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أنَّ السير إلى بـلاد الرُّوم يُعدُّ أمراً صعباً؛ لأنَّ التَّحرُّك سيتمُّ في منطقةٍ صحراويَّةٍ ممتَّدة، قليلة الماء، والنَّبات، ولابدَّ حينئذٍ من إكمال المؤونة، ووسائل النَّقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حتَّى لا يؤدِّي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود.
2 - كثرة عدد الرُّوم، بالإضافة إلى أنَّ مواجهتهم تتطلَّب إعداداً خاصّاً، فهم عدوٌّ يختلف في طبيعته عن الأعداء الَّذين واجههم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قبلُ، فأسلحتهم كثيرةٌ، ودرايتهم بالحرب كبيرةٌ، وقدرتهُم القتاليَّة فائقةٌ.
3 - شدَّة الزَّمان، وذلك لكي يقفَ كلُّ امرئ على ظروفه، ويُعِدَّ النَّفقة اللازمة له في هذا السَّفر الطَّويل لمن يعول وراءه.
4 - أنَّه لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبقَ في جزيرة العرب قوَّةٌ معاديةٌ لها خطرها، تستدعي هذا الحشد الضَّخم، سوى الرُّومان، ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك، ودومة الجندل والعقبة.
لقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربيَّة، ومراعاة المصلحة العامَّة في حالتي الكتمان، والتصريح، ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال.
ولـمَّا علم المسلمون بجهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها، وحثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على النَّفقة قائلاً: «من جهَّز جيش العسرة فله الجنَّة». [البخاري تعليقاً (7/65)، والدارقطني (4401)، والبيهقي في الكبرى (6/167)].
واستخلف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمَّد بن مسلمة الأنصاري، وخلَّف عليَّ بن أبي طالبٍ على أهله، فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خلَّفه إلا استثقالاً، وتخفُّفاً منه، فأخذ عليٌّ رضي الله عنه سلاحه، ثمَّ خرج حتَّى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازلٌ بالجُرْفِ، فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون: أنَّك إنَّما خلَّفتني؛ لأنَّك استثقلتني، وتخفَّفت منِّي، فقال: «كذبوا، ولكنِّي خلَّفتك لِمَا تركتُ ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي، وأهلك، أفلا ترضى أن تكون منِّي بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبيَّ بعدي» [البخاري (3706)، ومسلم (2404/31 - 32)]. فرجع عليٌّ إلى المدينة.
وكان استخلاف عليٍّ رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته، ومصاهرته، فكان استخلافه في أمرٍ خاصٍّ، وهو القيام بشأن أهله، وكان استخلاف محمَّد بن مسلمة الأنصاريِّ في الغزوة نفسها استخلافاً عامّاً، فتعلَّق بعض الناس بأن استخلاف عليٍّ يشير إلى خلافته من بعده، ولا صحَّة لهذا القول؛ لأنَّ خلافته كانت في أهله خاصَّةً.
وعندما تجمَّع المسلمون عند ثِنيَّة الوداع بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختار الأمراء، والقادة، وعقد الألوية، والرَّايات لهم، فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، ورايته العظمى إلى الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه، ودفع راية الأوس إلى أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر كلَّ بطنٍ من الأنصار أن يتَّخذ لواءً، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عَبَّادَ بن بِشْرٍ، فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر، وكان دليلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة علقمةُ بن الفَغْوَاء الخزاعيُّ، فقد كان من أصحاب الخبرة، والكفاءة في معرفة طريق تبوك.
وقد انفرد الواقديُّ بالمعلومات عن طريق الجيش، وتوزيع الرَّايات، وهو متروكٌ، ولكنَّـه غزير المعلومات في السِّيرة، وأخـذ مثل هذه المعلومات منـه لا يضرُّ.
ويلاحظ الباحث التَّطوُّر السَّريع لعدد المقاتلين بشكلٍ عامٍّ، ولسلاح الفرسان بشكل خاصٍّ.
إنَّ الَّذي يدرس تاريخَ الدَّعوة الإسلاميَّة ، ونشوءَ الدَّولة الإسلاميَّة ومؤسَّساتها العامَّة - وفي مقدَّمة هذه المؤسسات الجيشُ الإسلاميُّ القوَّة الضَّاربة للدَّولة - يلاحظ أنَّ هناك تطوُّراً سريعاً جدّاً في مجال القوَّة العسكريَّة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلاثمئة وثلاثة عشر مقاتلاً، وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل، تقريباً، وفي غزوة الأحزاب ثلاثة الاف مقاتلٍ، وفي غزوة فتح مكة عشرة الافٍ، وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتلٍ، وأخيراً بلغ عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتلٍ أو يزيد.
وإنَّ الدَّارس يلاحظ هذا التطوُّر السَّريع اللاَّفت للنَّظر في مجال سلاح الفرسان، ففي غزوة بدرٍ كان عدد الفرسان فارسين - في بعض الرِّوايات - وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان ما كان في بدرٍ، ويقفز العدد بعد ستِّ سنوات فقط إلى عشرة الاف فارس، وهذا يعود إلى انتشار الإسلام في الجزيرة العربيَّة وبخاصَّةٍ في البادية؛ ذلك لأن أهلها يهتمُّون باقتناء الخيول، وتربيتها أكثر من أبناء المدن.
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ


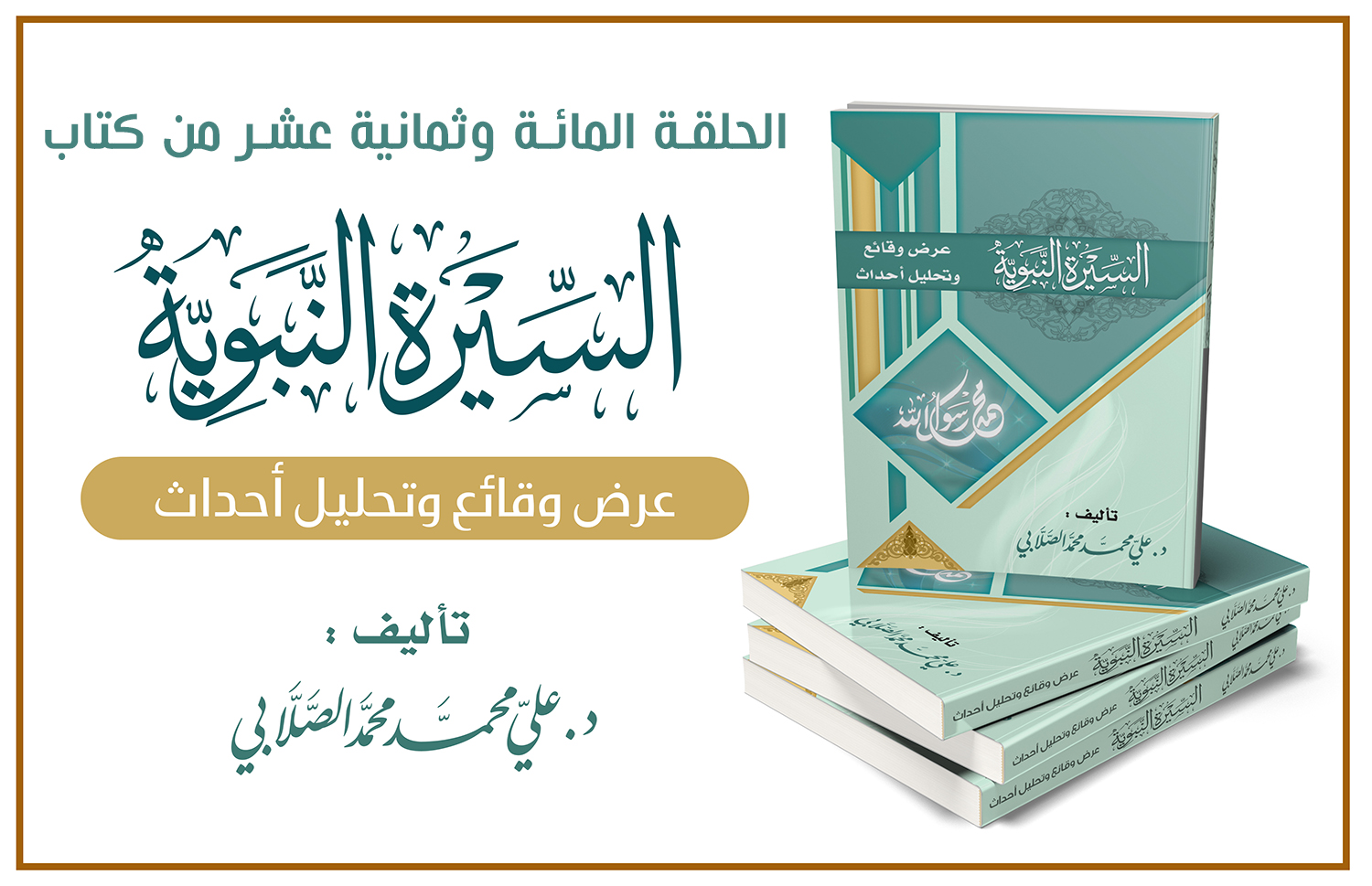
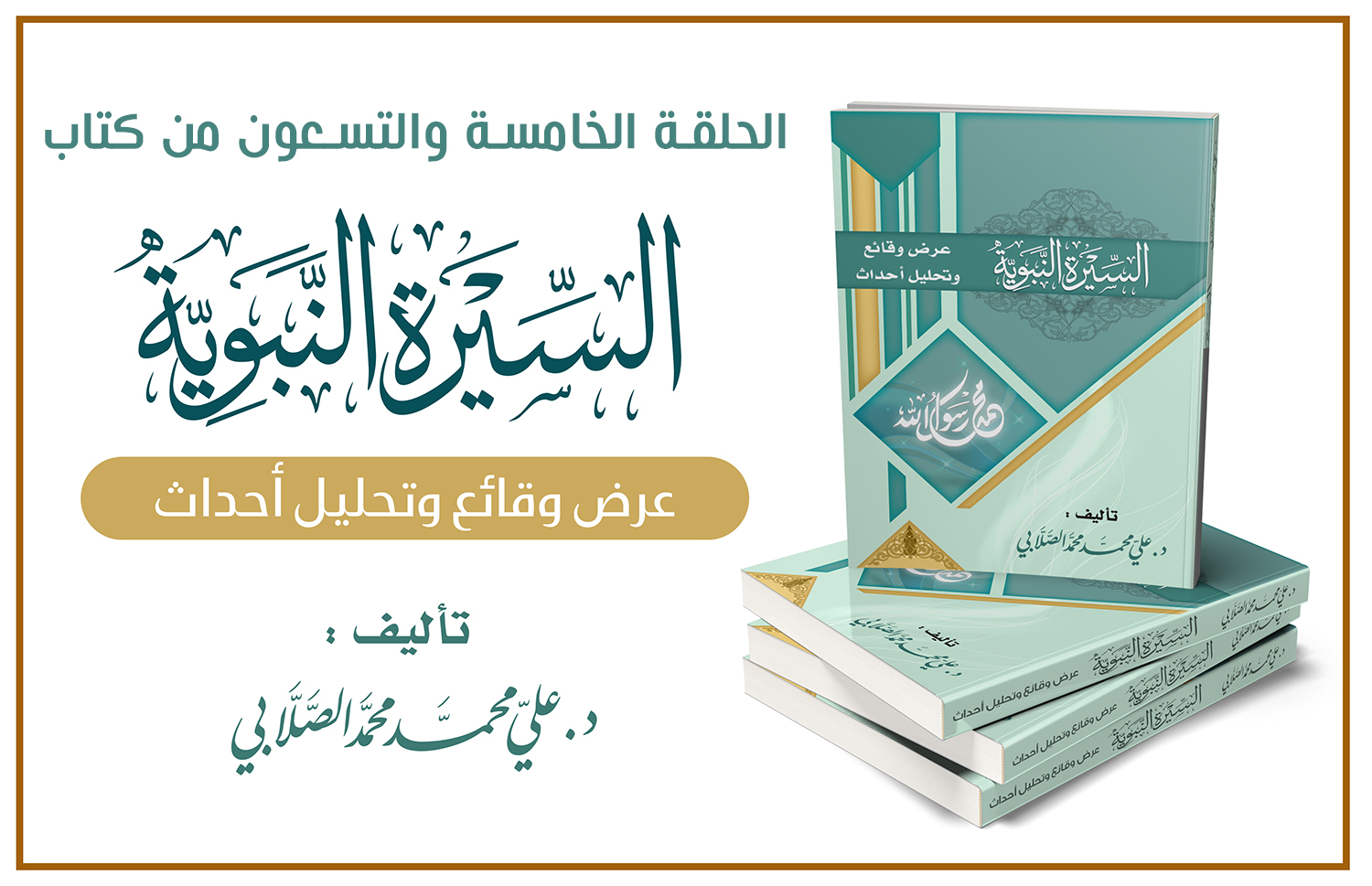
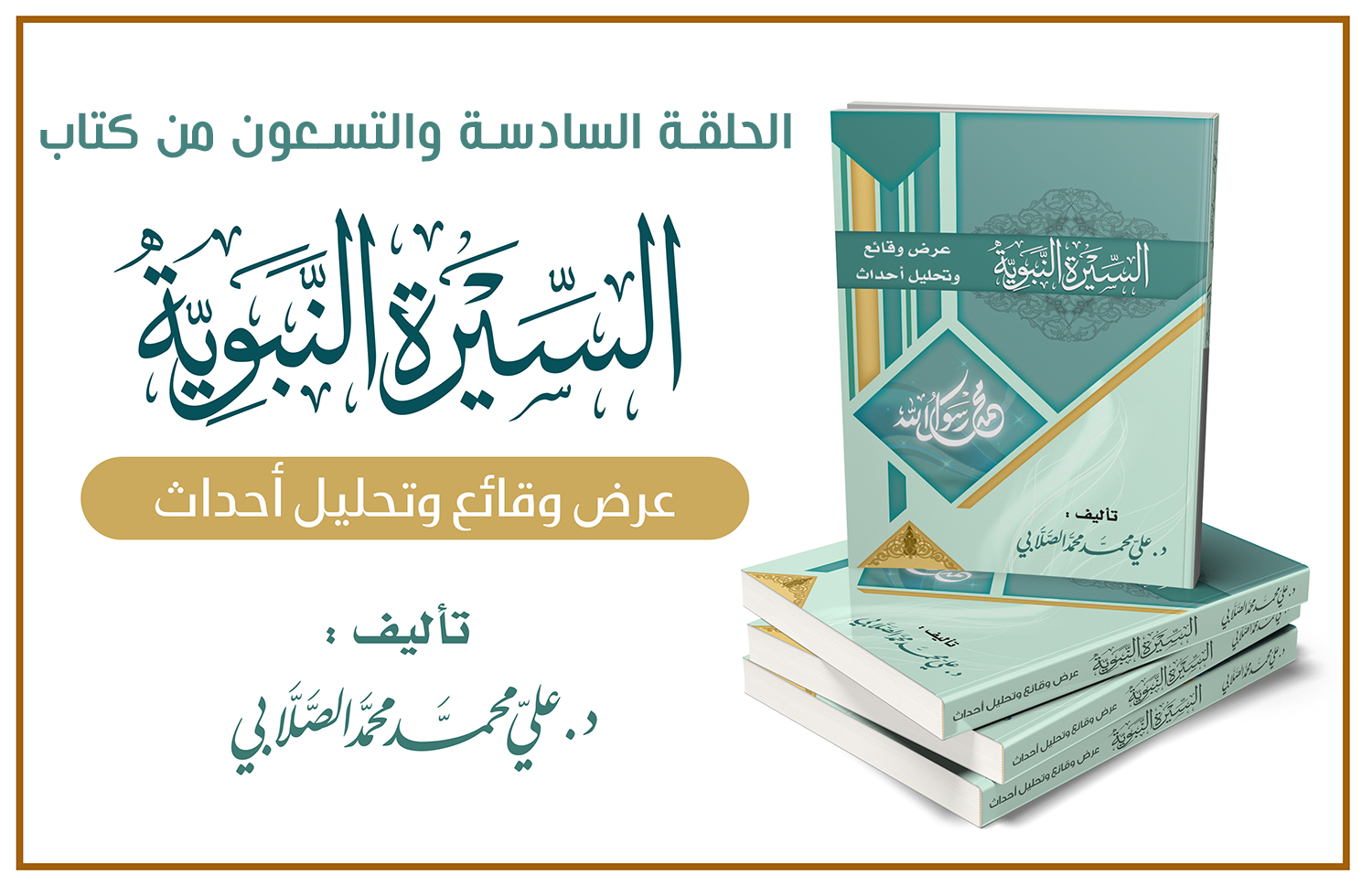
.jpg)