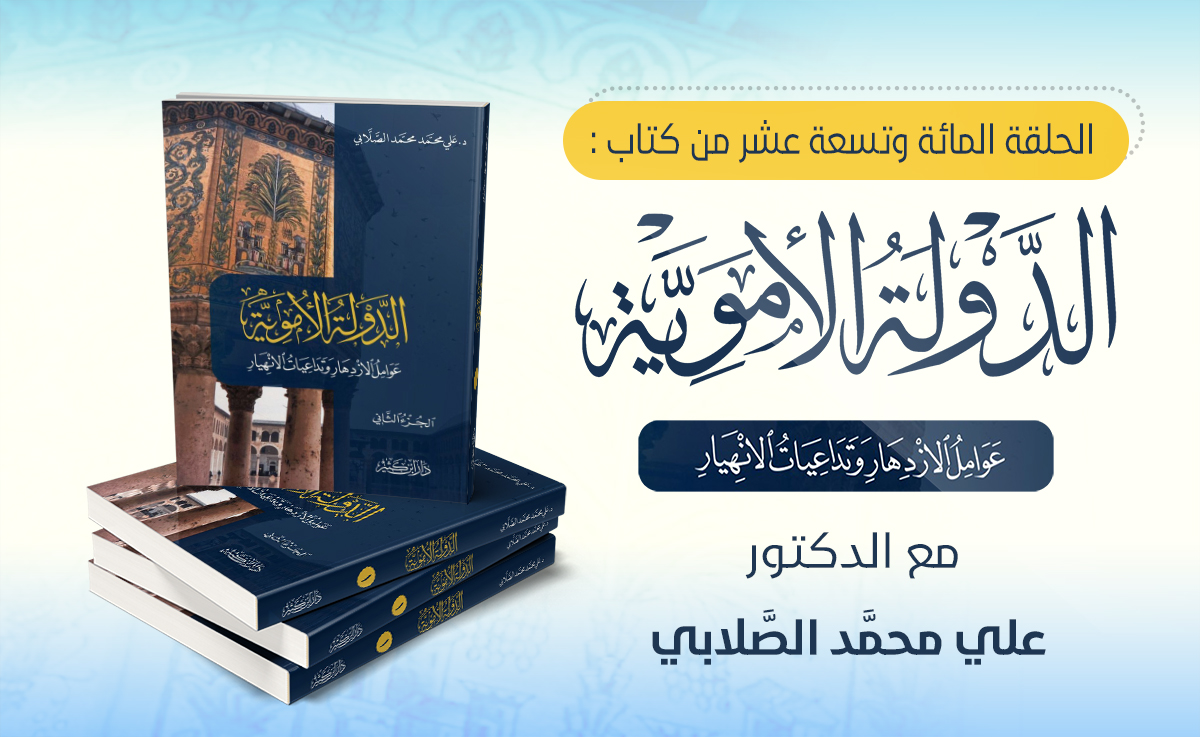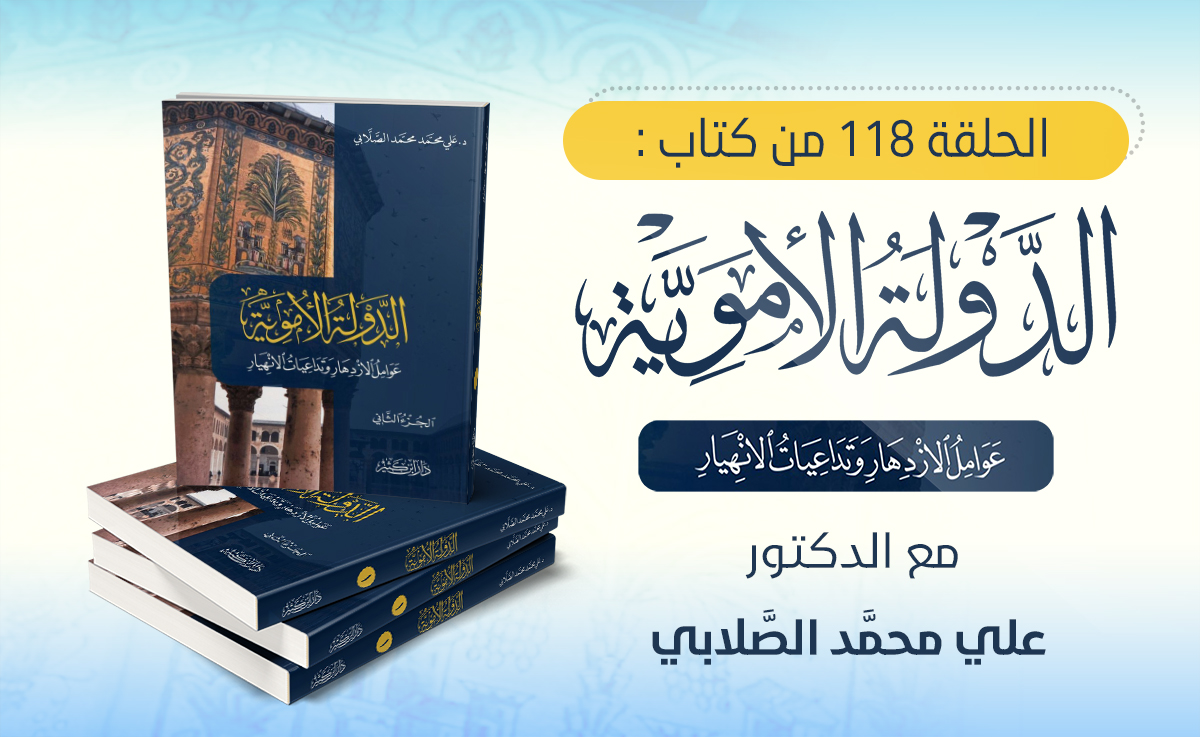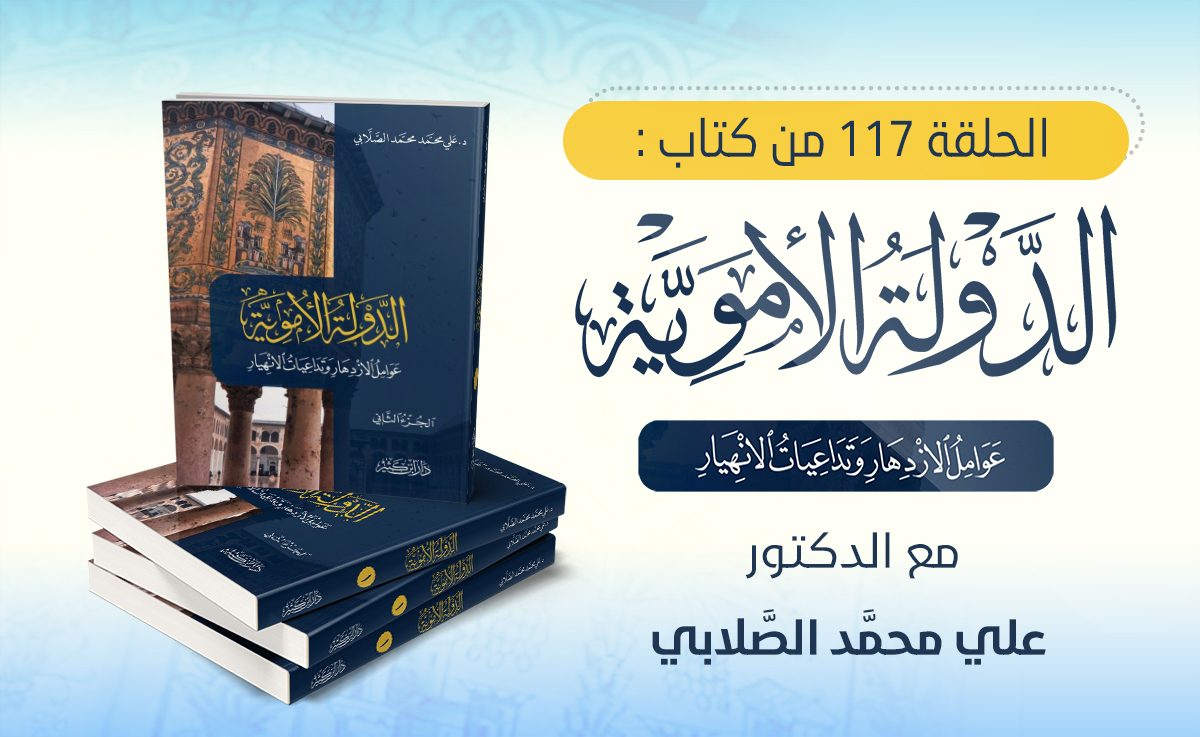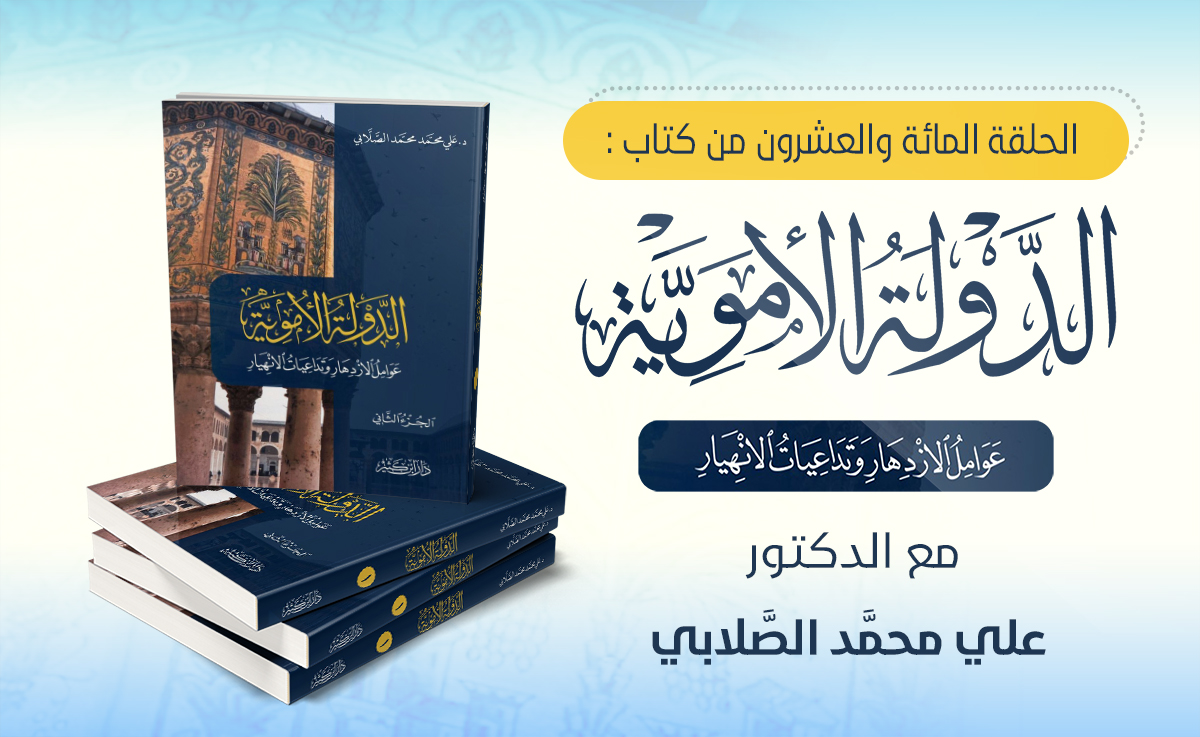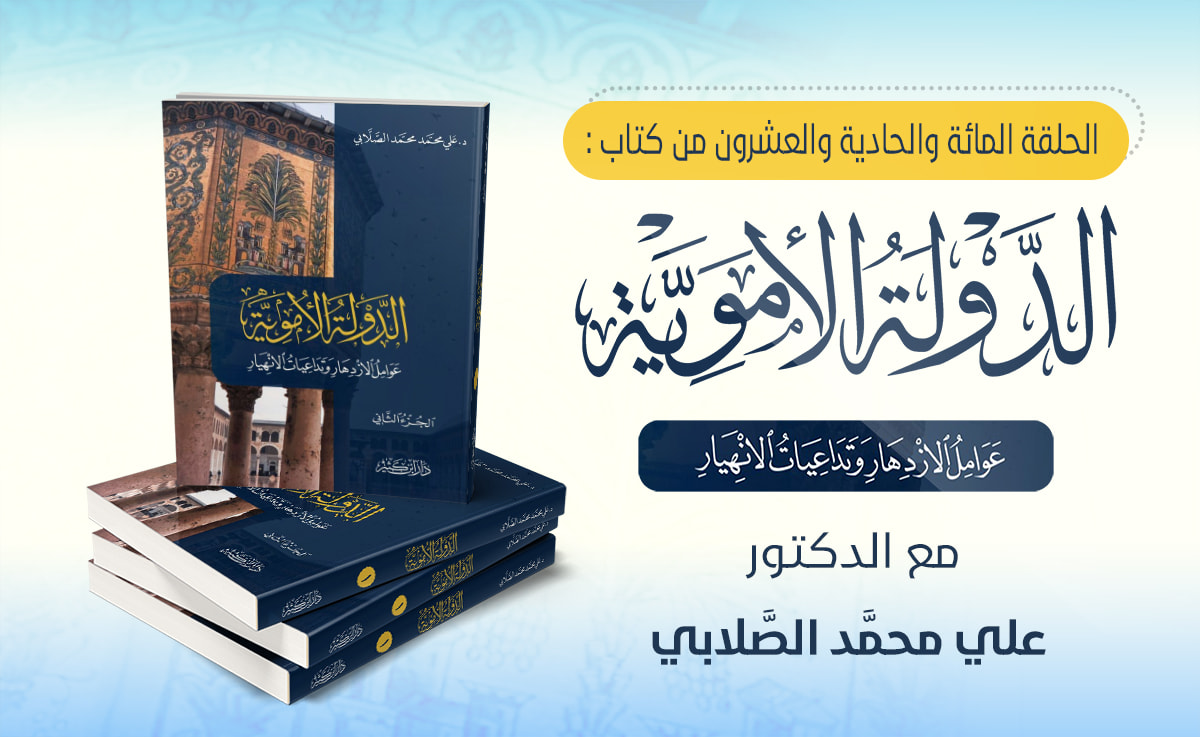من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2)
(القطاع الزراعي في عهد عبد الملك بن مروان)
الحلقة: 119
بقلم: د. علي محمد الصلابي
جمادى الأولى 1442 ه/ يناير 2021
كان تطور القطاع الزراعي للدولة الأموية في الجانب الغربي، وذلك بسبب عوامل عديدة؛ منها:
1 ـ الاستقرار السياسي لتلك المنطقة خلال معظم العصر الأموي.
2 ـ الاستقرار النقدي الذي كانت تتمتع به المنطقة حتى قبل سك النقود الإسلامية، ذلك أنها ورثت الدنانير البيزنطية، والتي ظلت عملة مستقرة لم تتعرض لما تعرضت له الدراهم الفارسية من غشٍّ.
3ـ أن المنطقة الغربية من الدولة الأموية لم تعانِ مما كانت تعاني منه المنطقة الشرقية من تركز في الثروة، ووجود عدد كبير نسبياً من أفراد المجتمع دخولهم منخفضة نسبياً، ويعود ذلك إلى أن مادة الجيش الأموي السياسية كانت من جند الشام، وقد تميز أهل هذه المنطقة بالعطاء مما جعل الدورة الاقتصادية في المنطقة الغربية تدور بسرعة أكبر،
وبالتالي ينشط القطاع الزراعي فيها بشكل أكبر، وينمو بشكل أسرع، بينما كان معظم سكان المنطقة الشرقية هم من أصحاب الدخول المنخفضة (الموالي).
4ـ استبدال الضرائب العينية في كل من الجزيرة والشام بضرائب نقدية خلال المسح الذي تمّ في عهد عبد الملك ء، وهذا أثر في العطاء، فزاد الطلب النقدي لساكني المدن على السلع الزراعية، ومنتجات الريف، وأحدث نوعاً من الاستقرار وأحدث زيادة في دخول المزارعين مكنتهم من تحقيق تنمية زراعية
وقد ظهرت دلائل التطور الزراعي بالمنطقة الغربية كثمرة لتلك العوامل وغيرها؛ وكان من أبرز تلك العوامل:
1ـ زيادة حصيلة خراج منطقتي الجزيرة والشام نتيجة المسح الذي تم لهما في عهد عبد الملك بن مروان.
2 ـ تطور نظام الري من خلال توزيع المياه بين الأنهار الفرعية ، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية؛ فهذه بعض الدلائل التي تشير إلى التطور الزراعي بالمنطقة الغربية من الدولة الأموية.
ـ التدهور الزراعي في القسم الشرقي من الدولة الأموية:
كان الطابع العام لقطاع الزراعة في هذا القسم السير نحو التدهور، ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية ما يلي:
1 ـ الاضطراب السياسي، وفقدان الأمن بالمنطقة، فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية الزراعية.
2 ـ تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة، حيث كانت معظم التركيبة السكانية من الموالي، مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة، فضعفت حركة تبادل السلع، أي حدوث كساد اقتصادي بالمنطقة .
3 ـ قرار بيع الأراضي الخراجية وجعل ثمنها في بيت المال، جاء ذلك لمواجهة النقص في إيرادات الدولة . فأدى إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للدولة على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل كانت له اثار عكسية على إيرادات بيت المال؛ فقد تحولت هذه الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية، وبينما لا تقل ضريبة الخراج عن (25%) ، وقد تصل إلى (50%) من حصيلة الإنتاج الزراعي سنوياً، أصبح الحد الأقصى بما تدره لبيت المال هو (10%) سنوياً فقط. وقد أدى انخفاض إيرادات الدولة على هذا النحو إلى إضعاف مقدرة الدولة في المدى الطويل على تمويل المشاريع العامة، والتي كان غالبها يدعم قطاع الزراعة.
إلى جانب ذلك كان لهذا القرار أثر مباشر على الإنتاجية الزراعية، فقد كان البائعون هم أصحاب الأرض الأصليين الذين عرفوا كيف يتعاملون معها، وأسلوب زراعتها، واكتسبوا الخبرة الزراعية من طول مكثهم فيها، بينما كان المشترون من العرب وهم ذوو خبرة قليلة بالزراعة، خاصة إذا ما قورنت بالنسبة لخبرة المزارعين الأصليين.
4 ـ إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية، فقد أدت محاربة الدولة لخصومها السياسيين إلى تخريب أو تحجيم مشاريعهم الزراعية، فانعكس ذلك بنتائج سلبية على اقتصاد الدولة ككل، ومن صور ذلك ما حدث في عهد الحجّاج من أن بثوقاً انبثقت على الأرض المحياة من أرض البطائح، فلم يعمل الحجّاج ـ بوصفه والي المنطقة ـ على سد تلك البثوق مضارة لأهلها؛ لاتهامهم بمساعدة ابن الأشعث في الخروج عليه، فغرقت أراضيهم الزراعية وتحولت إلى موات .
5 ـ حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي والدولة الأموية، وذلك حينما حاول والي العراق إعادتهم إلى أراضيهم بالقوة وإعادة فرض الجزية عليهم، وقد وافق ذلك خروج ابن الأشعث على الدولة الأموية، فانضموا تحت لوائه .
ونتيجة لتلك الأسباب وغيرها فقد بدت علامات تدهور القطاع الزراعي العام في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية، وكان أبرز تلك العلامات ما يلي:
1 ـ تدهور غلة الخراج، حيث أخذت في التناقص المستمر .
2 ـ هجرة الفلاحين للأراضي الزراعية والاتجاه نحو المدن، وذلك لزيادة حجم ضريبة الخراج ـ بالضرائب الإضافية ـ وعنف الجباية، فتركوا أراضيهم وهاجروا إلى المدن .
3 ـ حالة القلق التي انتابت المزارعين الذين بقوا في أراضيهم، مما دفعهم لتسجيل أراضيهم بأسماء الأمراء والأشراف؛ وهو ما يعرف بالإلجاء طلباً للحماية، ومن أمثلة ذلك: إلجاء كثير من المزارعين أراضيهم بمسلمة بن عبد الملك للتعزز به .
4 ـ حدوث نقص كبير في الإنتاج الحيواني، وبالذات حيوانات الحرث، مما دفع والي العراق إلى إصدار أمر يقضي بمنع ذبح الأبقار في أحد خطوات علاج الأزمة، كما قام بتوريد كمية من الجواميس من إقليم السند لسد العجز الحاصل في دواب التنمية الزراعية .
ومع ذلك فقد كانت خلال هذه الفترة مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي خففت من حدة التدهور الزراعي بالمنطقة خلال عهد عبد الملك، وكان من أبرزها ما يلي:
1 ـ عملية نقل الأيدي العاملة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى، بهدف إحداث تنمية زراعية من الجهة المنقول إليها،
ومن أمثلة ذلك: نقل الحجّاج بن يوسف عدداً من مزارعي بلاد السند بأهليهم وجواميسهم وإسكانهم في أرض موات فأحيوها .
2 ـ نقل رؤوس الأموال إلى مناطق فقيرة لتنميتها، ومثال ذلك: إسكان قتيبة بن مسلم لمجموعة من العرب في سمرقند ، ومعلوم أن العرب كانوا من أعلى الناس ثروة في العصر الأموي .
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
الجزء الثاني:
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: