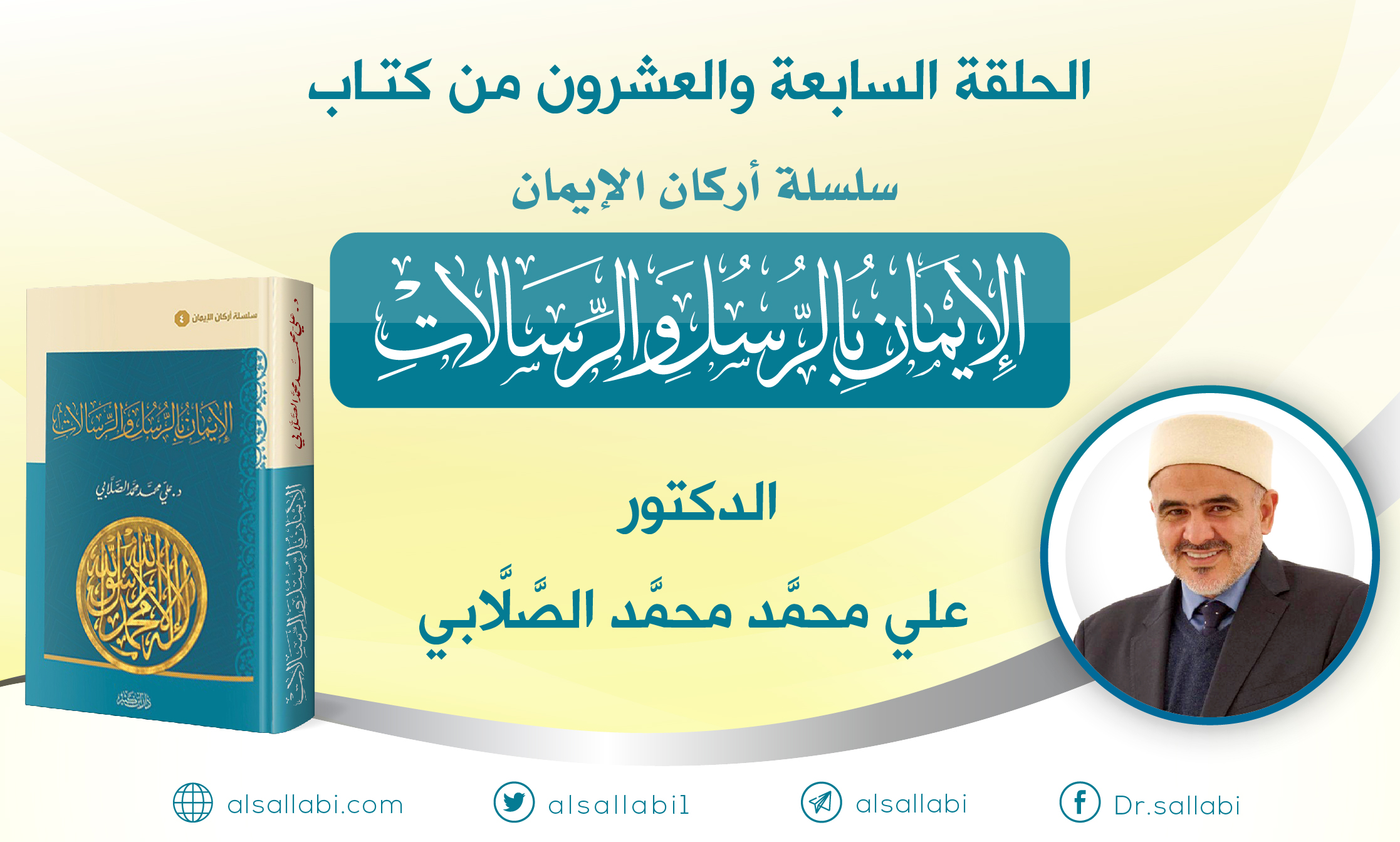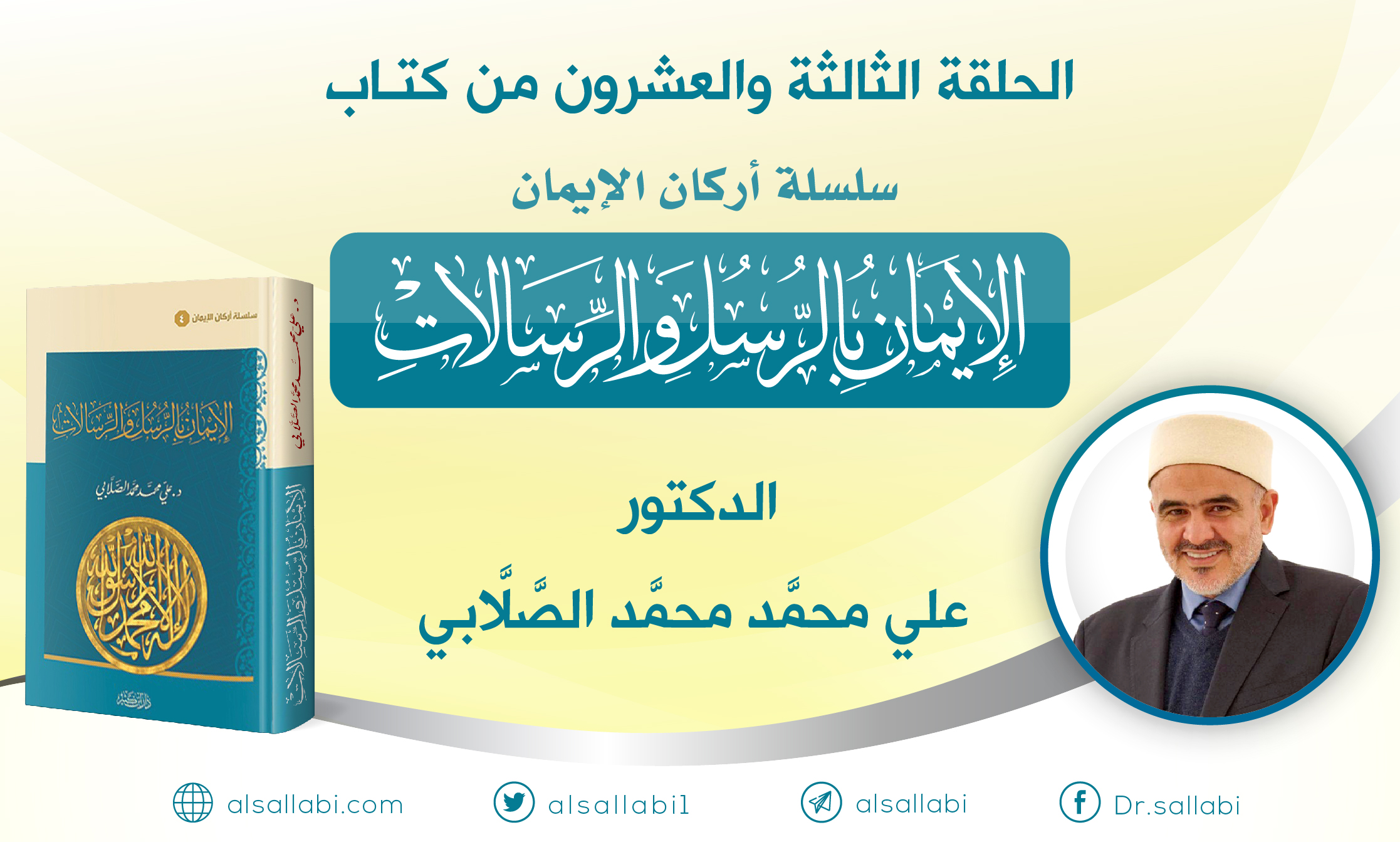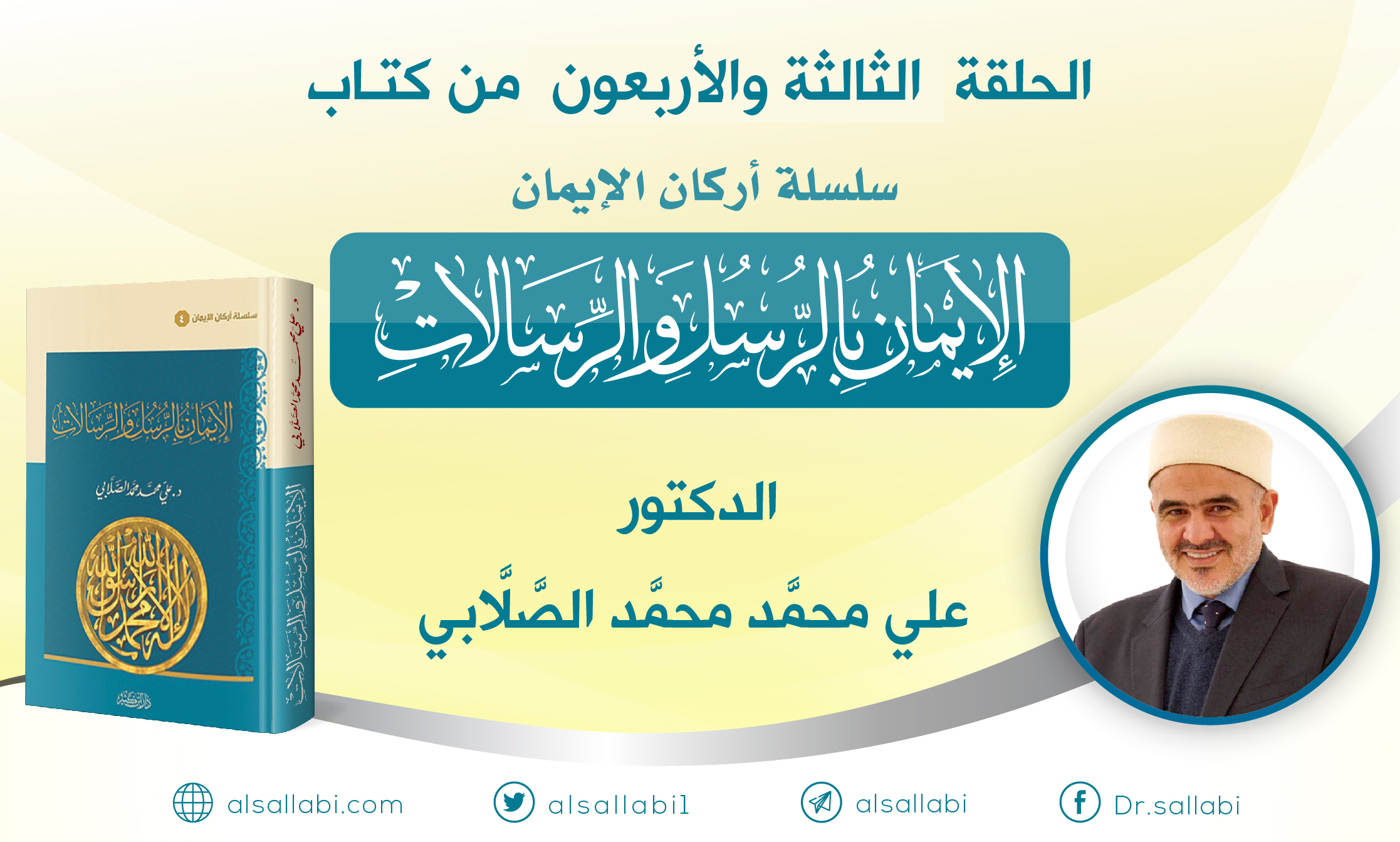هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السلوك والأخلاق
الحلقة: السابعة والعشرون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ذو القعدة 1441 ه/ يوليو 2020
لقد خصّ الله عزّ وجلّ أنبياءَه عليهم الصلاة والسلام بالكمال البشري في الأخلاق والسلوك ، فجاءوا قدوات لمن بعدهم ، يُهتدَى بأخلاقهم ، ويقتدى بسلوكهم ، كما كان الشأنُ في توحيدهم وإيمانهم ، ومعرفتهم بربهم ، ولا غرابة فيما وصلوا إليه من أخلاق عالية ، وصفات نبيلة ، فما هي إلا من اثار التصوّر الصحيح ، والإيمان العظيم ، فالارتباطُ بين المعتقَد والسلوك ارتباطٌ قوي ، وبينهما تناسَبٌ طردي ، تشهدُ له الأدلة والتجارب ، فكلّما صحَّ الاعتقاد وكان سليماً ، فإنّ الأخلاق تعلو وتنمو ، وتشرقُ ، والعكس بالعكس.
وحسبنا أن نستعرضَ بعض هذه الأخلاق الرفيعة ، لتدلُّنا على بقيتها ، لعلَّ القلوبَ ترقُّ ، والعزائمُ تستيقظ ، لتلحق بهذه الصفوة المباركة ، فتهتدي بأخلاقهم ، وتسير بسلوكهم ، وخاصة في مثل زماننا المعاصر ، الذي يشهد أزمةَ أخلاق ، وسوء ممارسات في التعامل بين الناس ، فإن كنّا محبين للأنبياء حقيقةً فهذه أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام ، وقد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم فيها وفي غيرها:
ومن هذه الأخلاق ما يلي:
1 ـ خلق الرحمة بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله عز وجل:
قال تعالى عن دعوة نوح عليه السلام لقومه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *} [الاعراف : 59].
فنوحٌ عليه السلام خوّفهم إنْ لم يطيعوه عذابَ الله ، فقال: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *} وهذا من نصحه عليه السلام لهم ، وشفقته عليهم ، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي ، والشقاء السرمدي ، كإخوانه من المرسلين ، الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة ابائهم وأمهاتهم.
وهذا التخوفُ على الناس من عذاب الله عز وجل كان عندَ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ومن ذلك قول الله تعالى عن شعيب عليه السلام يحذر قومه: {وَيَاقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ *} [هود : 89].
وقد وصف الله عزّ وجلّ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *} [التوبة : 128].
2 ـ النصح للناس:
قوله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: {قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ *} [الاعراف : 61 ـ 62].
وقوله تعالى عن نبيه هود عليه السلام: {قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ *} [الاعراف : 67 ـ 68].
وقوله تعالى عن نبيه صالح عليه السلام بعد هلاك قومه: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ} [الأعراف: 79].
وقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام بعد هلاك قومه: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَال ياقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ *} [الاعراف : 93].
ولقد بلغ النصحُ والشفقةُ على الناس من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كادَ هذا الأمرُ أن يهلكَه ، فخاطبه الله عز وجل قائلاً: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ *} [الشعراء: 3] ، فكان يحزن حزناً شديداً على عدم إيمانهم نصحاً لهم ، وشفقة عليهم.
ومن هذا الباب ، أيضاً تلك الدعوة التي وجهها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه ، والتي كانت كلّها نصحٌ وشفقةٌ ورحمةٌ مع أدبٍ جمٍّ ، وحلم وتلطف ، من الابن النبي إلى أبيه الكافر: قال تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا *إِذْ قَالَ لأِبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا *يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا *يَاأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا *يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا *قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي ياإِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا *قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا *} [مريم : 41 ـ 47].
ومع أنّ الأبَ الشقيَّ ردَّ نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وهدّده ، وتوعّده بالرجم ، وطالبه بالهجر والمقاطعة ، إلاّ أنّ الابن البار الخائف على أبيه من عذاب يمسّه من قبل الرحمن قال: فلما أيس من {قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا *} ، تبرأ منه ، واعتزله ، وترك الاستغفار له ، ومع ذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاوِلُ الشفاعة فيه يوم القيامة ، ولكن حقّت كلمةُ العذابِ على الكافرين.
ومن ذلك قوله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا *} [مريم : 55].
أي وكان مقيماً لأمر الله على أهله ، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة الإخلاص للمعبود ، وبالزكاة المتضمنة الإحسان إلى العبيد ، فكمّل نفسه ، وكمّل غيره ، وخصوصاً أخصّ الناس عنده ، وهم أهله ، لأنهم أحقّ بدعوته من غيرهم.
3 ـ الصبر:
الصبر من الأخلاق الأساسية في الإمامة في الدين:
قال تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ *} [الانعام : 34].
وقال تعالى: {وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ *} [إبراهيم: 12].
وقال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} [الأحقاف: 35].
وقال تعالى عن أيوب عليه السلام: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ *} [ص : 44].
وقال سبحانه عن نبيه يوسف عليه السلام بعد تلك الابتلاءات المتنوّعة، والتي ثبّته الله عز وجل فيها، وتجاوزها بنجاح: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *} [يوسف : 90].
والايات في وصف صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقواهم ، وخشيتهم من الله سبحانه كثيرةٌ لا يتّسع المقام لذكرها ، وممّا تجدرُ الإشارةُ إليه ، أنّ مِنْ أهمِّ أغراض قصص الأنبياء في القران الكريم أخذُ العبر من صبرهم وتضحيتهم ومعاناتهم في مواجهة الشرك ، وإرجاع الناس إلى عبادة الله عز وجل ، وذلك حتى يقتديَ بصبرهم مَنْ جاء بعدهم من الدعاة والمصلحين ، فيثبتوا ولا يضعفوا ، ويستبشروا ولا ييأسوا ، قال تعالى: {وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *} [هود : 120].
وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرّض لمحنٍ عظيمةٍ فصبر لها صبرَ الموحّدِ لربّه ، الموفي لوعده ، ذلك حين ألقي في النار ، وحين أُمِرَ بذبح ابنه ، وفلذة كبده ، وحين أُمِرَ بتركه بوادٍ غير ذي زرع ، وحين هاجر من موطنه وترك أباه وأقاربه.
وهذا موسى عليه السلام وما واجه من الأذى والتهديد من فرعون وملأه ، ثم ما واجه من الأذى والتعنت من قومه بني إسرائيل ، حتى إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن موسى عليه السلام: «يرحمُ اللهُ موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر».
وهذا عيسى عليه السلام جاءه من الأذى والتهم الباطلة من بني إسرائيل حتى تامروا على قتله وصلبه، فصبر على ذلك كله، ولكنّ الله عزّ وجل رفعه إليه.
والأنبياء والمرسلون يتفاوتون في الصبر ، فبالرغم من الصبر العظيم من يوسف عليه السلام لا يعني أنه فاق أولي العزم من الرسل في الصبر والتقوى ، فقصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أعظم ، والواقع فيها من الجانبين ، فما فعله الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه ، وإظهار اياته ، وأمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، ومجاهدة المكذّبين لهم ، والصبر على أذاهم ، هو أعظم عند الله ، ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسفُ عليه وعنه ، وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظمُ من طاعة يوسف وعبادته وتقواه ، أولئك أولو العزم الذين خَصّهم الله بالذكر في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *} [الاحزاب : 7] وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *} [الاحزاب : 7] وقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى : 13] ، وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة.
وفي قصة يوسف عليه السلام من جوانب الصبر العظيمة ما يدلنا على ما هو أعظمُ صبراً من يوسف عليه السلام ، ففي قول يوسف عليه السلام: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ *} [يوسف : 33]. عبرتان:
إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي.
والثانية: طلبُ سؤال الله ودعائه أن يثبّتَ القلبَ على دينه ، ويصرفه إلى طاعته ، وإلا فإذا لم يثبت القلبُ صبا إلى الامرينَ بالذنوبِ ، وصار من الجاهلين ، ففي هذا توكل على الله ، واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان به والطاعة.
وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه: {اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ *} [الاعراف : 128]. لما قال فرعون: {سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ *} [الاعراف : 127 ـ 128].
وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *} [النحل : 41 ـ 42].
فلا بدّ من التقوى بفعل المأمور ، والصبر على المقدور ، كما فعل يوسف عليه السلام: اتقى الله بالعفّة على الفاحشة ، وصبر على أذاهنّ له بالمراودة والحبس ، واستعان بالله ودعاه ، حتى يثبته على العفّة ، فتوكّل عليه أن يصرف عنه كيدهن ، وصبر على الحبس ، ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله ، كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الصالحين ، كانت العاقبة له في الدنيا والاخرة ، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيماً وسروراً ، كما أنّ ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعيم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً.
فيوسفُ خاف الله من الذنوب ، ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله ، بل اثرَ الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية ، فإنّه لو وافق امرأة العزيز لنال الشهوة وأكرمته بالمال والرئاسة ، فاختار يوسف الذلَّ والحبسَ وتركَ الشهوة والخروجَ من المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية ، بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق وإن اذاه بالحبس والكذب ، فإنّها كذبت عليه ، فزعمتْ أنّه راودها ، ثم حبسته.
كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء أخوته له في الجُبِّ وبيعه ، وتفريقهم بينه وبين أبيه ، فإنّ هذه أمورٌ جرت عليه بغير اختياره ، لا كسب له فيها ، وليس للعبد فيها حيلة غير الصبر ، وأمّا صبره عن المعصية ، فصبرُ اختيارٍ ورضًى ، ومحاربةٍ للنفس ، ولا سيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة ، فإنّه كان شاباً ، وداعية الشباب إليها قوية ، وعزباً ليس له ما يعوّضه ، ويردّ شهوته ، وغريباً ، والغريب لا يستحي في بلدِ غربته مما يستحي منه مَنْ هو بين أصحابه ومعارفه وأهله ، ومملوكاً ، والمملوك أيضاً ليس له وازعٌ كوازع الحرِّ ، والمرأة جميلةٌ ، وذاتُ منصب وجمالٍ ، وهي سيدته ، وقد غاب الرقيب ، وهي الداعية له إلى نفسها ، والحريصة على ذلك أشدَّ الحرص ، ومع ذلك توعّدته إن لم يفعل بالسجن والصَّغار ، ومع هذه الدواعي كلِّها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله ، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟!.
وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، على ما نالهم من الله ، باختيارهم وفعلهم ، ومقاومتهم قومهم ـ أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسبباً في فعله ، وكذلك صبر إسماعيل الذبيح ، وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على تنفيذ أمر الله أكملُ من صبر يعقوب على فقد يوسف.
هذا هو صبرُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه هي تضحياتهم. وإذا أردنا أن نقتدي بهم في هذا الخلق العظيم، وأن ننتفع به كما انتفعوا ، فلابدّ في هذا الصبر من شروطٍ ثلاثٍ:
أ ـ أن يكون الصبر بالله ، والمراد بذلك الاستعانة بالله سبحانه ورؤيته أنه هو المصبِّر ، وأنَّ صبرَ العبد بربه لا بنفسه ، كما قال تعالى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ} [النحل: 127]
ب ـ أن يكون لله ، وهو أن يكون الباعثُ له على الصبر محبة الله ، وإرادة وجهه ، والتقرب إليه ، لا لإظهار قوة النفس ، والاستحماد إلى الخلق ، وغير ذلك من الأغراض.
ج ـ أن يكون الصبر مع الله ، وهو دورانُ العبد مع مراد الله الديني منه ، ومع
أحكامه الدينية سائر بسيرها ، مقيماً بإقامتها ، أي يجعل نفسه وقفاً على أوامره ومحابه.
4 ـ الكرم:
من الأمثلة على صفة الكرمِ الكرمُ الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأضيافه من الملائكة ، قال تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ *إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ *فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *} [الذاريات : 24 ـ 26] ، وقوله تعالى: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ *} [الذاريات : 26 ـ 27] ، متضمنٌ وجوهاً من المدح واداب الضيافة ، وإكرام الضيف:
منها: قوله تعالى: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ} والروغان الذهابُ بسرعةٍ ، وهو يتضمّن المبادرة إلى إكرام الضيف ، والاختفاء يتضمّن ترك تخجيله ، وألاّ يعرِّضه للحياء ، وهذا بخلافِ مَنْ يتثاقل ، ويتبادَرُ على ضيفه ، ثم يبرز بمرأى منه ، ويحلّ صرةَ النفقة ، ويزنُ ما يأخذ ، ويتناول الإناء بمرأى منه ، ونحو ذلك ، مما يتضمّن تخجيلَ الضيف وحياءه فلفظة (راغ) تنفي هذين الأمرين.
وفي قوله تعالى: {إِلَى أَهْلِهِ} مدحٌ اخر لما فيه من الإشعار بأنَّ كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله ، وأنَّه لا يحتاجُ إلى أن يستقرِضَ من جيرانه ، ولا أن يذهبَ إلى غير أهله ، إذ قرَى الضيف حاصلٌ عندهم.
وقوله: {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *}يتضمّن ثلاثة أنواع من أحدها: خدمة ضيفه بنفسه ، فإنه لم يرسل به ، وإنما جاء به بنفسه.
الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام ، لم يأتهم ببعضه ، ليتخيّروا من أطيبِ لحمه ما شاءوا.
الثالث: أنه سمين ، ليس بمهزول ، وهذا من نفائس الأموال ، ولد البقر السمين ، فإنّهم يعجبون به ، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره.
وقوله: {فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ} متضمناً المدحَ واداباً أخر.
ثم عرض عليهم الأكل بقوله: {أَلاَ تَأْكُلُونَ *} وهذه الصيغة مؤذنةٌ ، بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام ، كلوا ، تقدموا ، ونحو هذا.
وهذا يوسف عليه السلام يقول الله عز وجل على لسانه وهو يخاطب إخوته: {أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ *} [يوسف : 59]. أي خير المضيفين ، لأنه أحسن ضيافتهم.
وأما إذا جئنا إلى كرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجوده، فهو الكرم الذي لا يضاهَى ، والجود الذي لا يبارى ، ويكفينا من ذلك قول الأعرابيِّ الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده من الكرم والسخاء ما يبهرُ العقولَ ، حتى قال مقولته المشهورة لمّا رجع إلى قومه ، وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فقال: يا قوم أسلموا ، فإنّ محمّداً يعطي عطاءَ مَنْ لا يخشى الفاقة.
5 ـ الوفاء:
أمّا صفة الوفاء فهي بارزةٌ في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، الذين بلّغوا الرسالة ، وأدّوا الأمانة ، وجاهدوا في الله حق جهاده.
فمنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربه تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى *} [النجم : 37] أي بلغ جميعَ ما أُمرَ به ، وقال ابن عباس {وَفَّى *} أُمِرَ به ، وقال قتادة طاعة {وَفَّى *} ، وأدَّى رسالته إلى خلقه ، وهذا القولُ هو اختيارُ ابن جرير ، وهو يشمل الذي قبله.
ومدحَ الله سبحانه نبيّه إسماعيل عليه السلام بقوله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا *} [مريم : 54].
وقد وفّى موسى عليه السلام لربّه سبحانه في تبليغ بني إسرائيل دعوةَ اللهِ عزّ وجلّ ، وصبره على أذاهم وتعنتهم وسوء أدبهم ، وقد كان له موقفُ وفاءٍ قبل بعثته ، ألا وهو موقفه عليه السلام مع شيخ مدين حينما أجر نفسه عشر سنين ، وهي أتمُّ الأجلين عند الشيخ والد البنتين حتى يتزوّج إحداهما ، وكان قد خيّره بين الثماني والعشر ، فاختار أكمل الأجلين.
عن سعيد بن جبير ، قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيُّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْرِ العرب فأسأله ، فقدمتُ فسألتُ ابنَ عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما ، إنّ رسول الله إذ قال فعل.
إنَّ العقل والقلم ليعجزان عن الإحاطةِ بأخلاق وسلوكيات هؤلاء الصفوة من عباد الله عزَّ وجلَّ، سواء من جهة الكم أو الكيف ، ولكننا استعرضنا بعض هذه الأخلاق الكريمة لترشدنا إلى غيرها.
يمكنكم تحميل -سلسلة أركان الإيمان- كتاب:
الإيمان بالرسل والرسالات
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/Book94(1).pdf