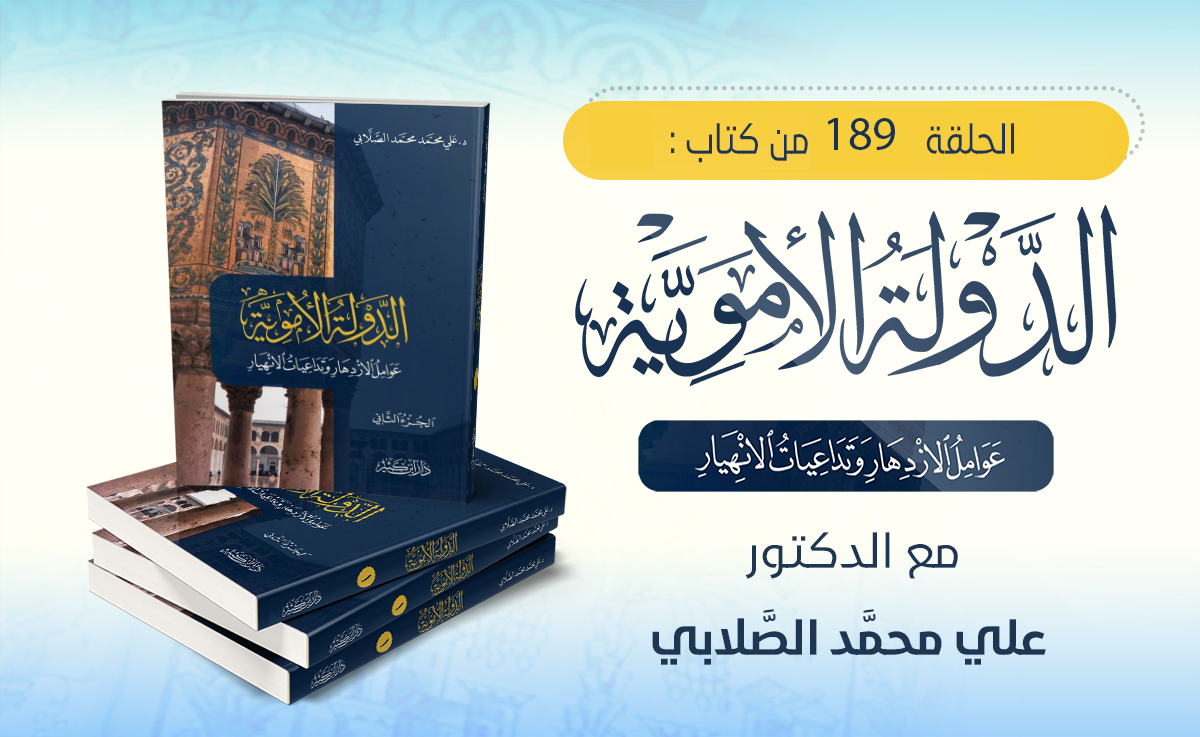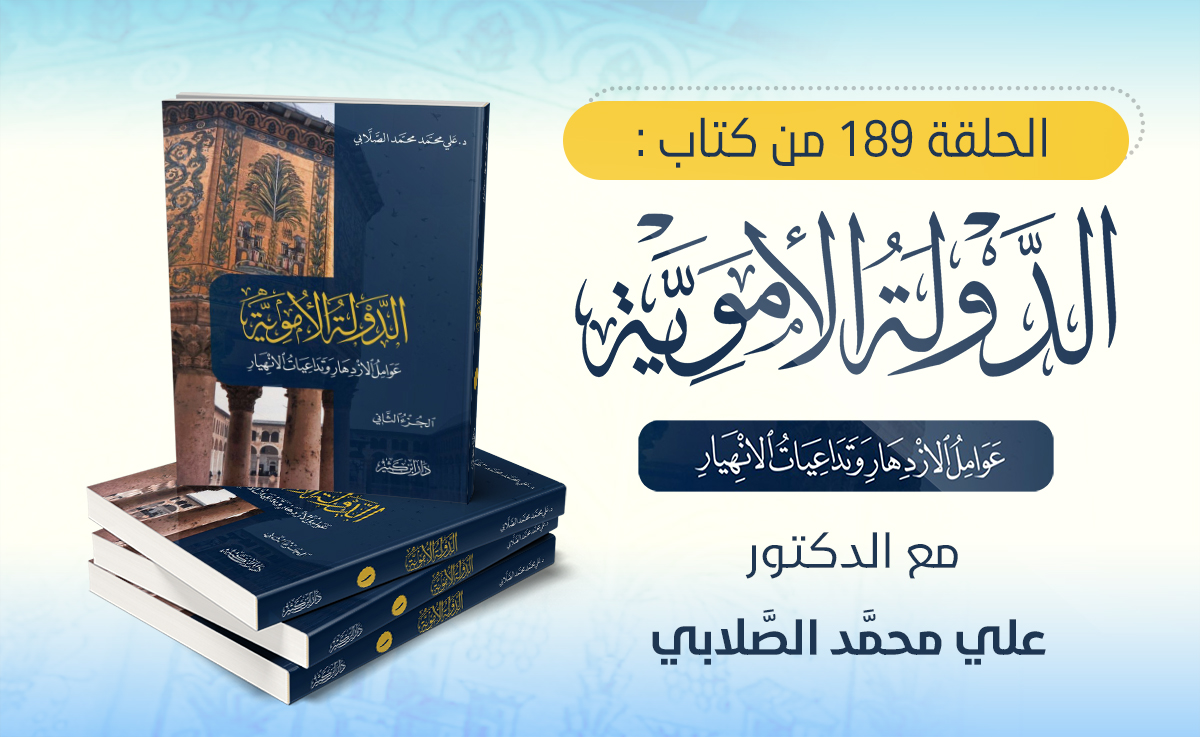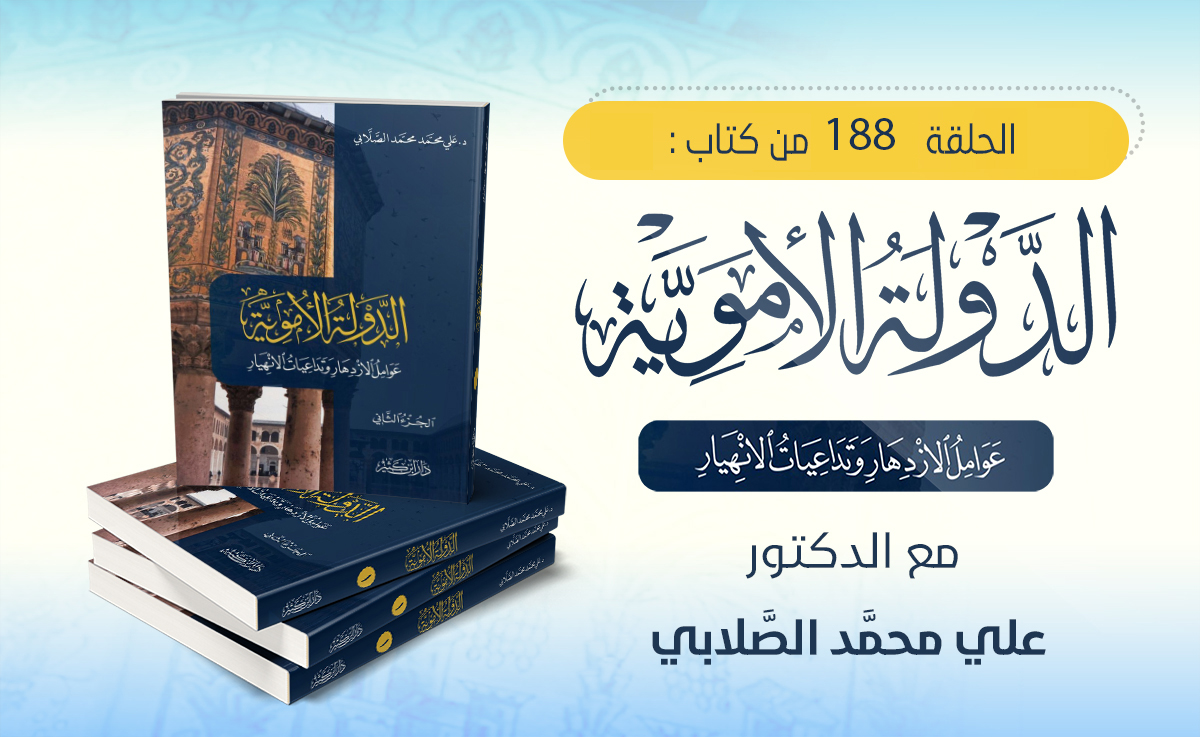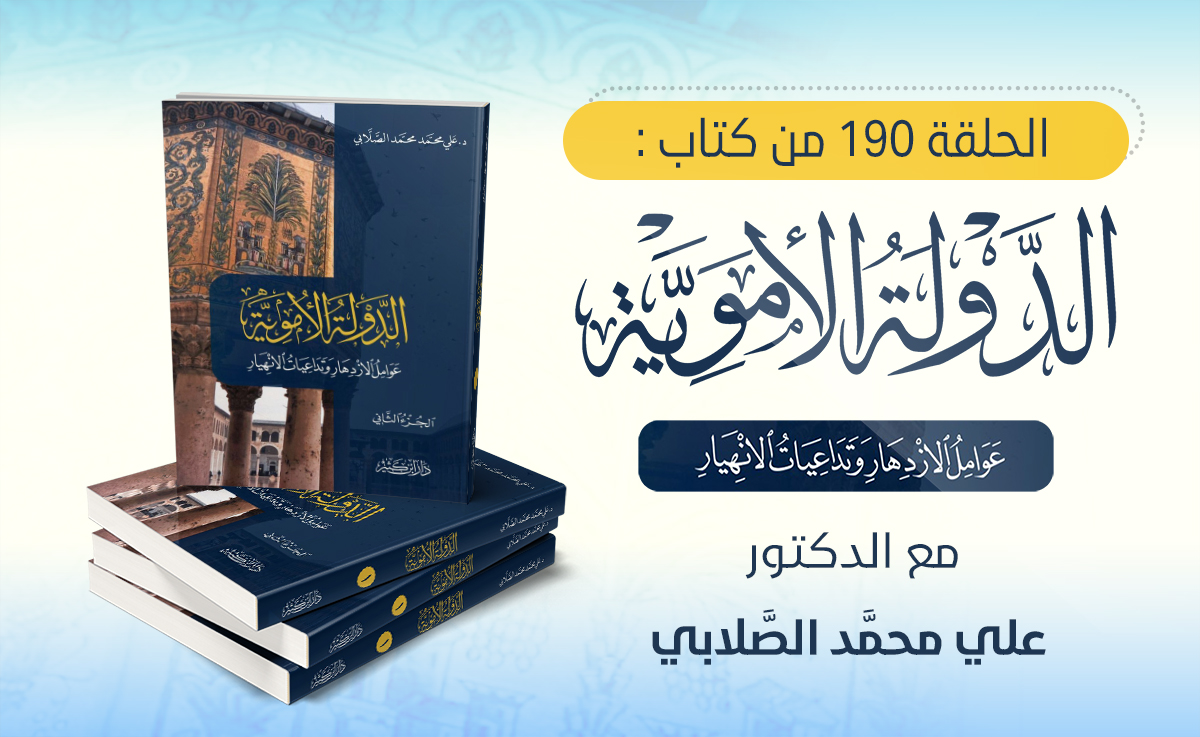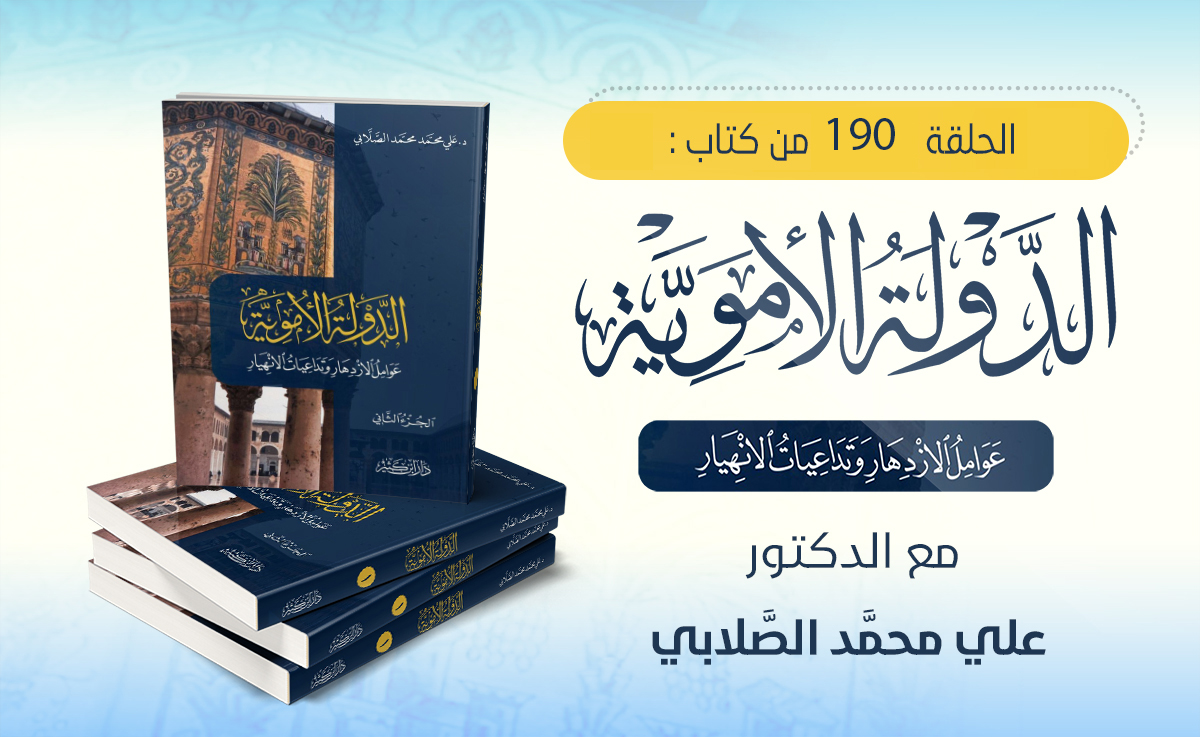من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):
(الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز)
الحلقة: 189
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شعبان 1442 ه/ مارس 2021
أولا: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح:
إن عمال الخليفة وأمراء البلدان بخاصة هم نواب الخليفة في أقاليمهم، والواسطة بينه وبين رعيته، ومهما كان الخليفة على درجة من الدراية في تصريف أمور السياسة إلا أنه لا يستطيع تحقيق النجاح إلا إذا اختار عماله بعناية تامة، لذا عني عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عناية فائقة باختياره عماله وولاته، وحين نتبع أخباره في هذا الصدد نجد أن له شروطاً لابد من تحققها فيمن يختار العمل عنده، ومن أهم هذه الشروط: التقوى، والأمانة، وحسن التدين، فلما عزل خالد بن الريان ـ الذي كان رئيساً للحرس في عهد الوليد بن سليمان ـ نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنصاري فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا الإسلام، ولكني سمعتك تكثر تلاوة القرآن، ورأيتك تصلي في موضع تظن أنه لا يراك أحد، فرأيتك تحسن الصلاة، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي.
وكان يكتب إلى عماله: إياكم أن تستعملوا على شيء من أعمالنا إلا أهل القرآن، فإنه إذا لم يكن عند أهل القرآن خير، فغيرهم أحرى بأن لا يكون عندهم خير.
وإذا شك في أمر من ينوي توليته لم يقدم على توليته حتى يتبين له حاله، فحين ولي الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت الخلافة ـ يا أمير المؤمنين ـ شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها، واستشهد بأبيات من الشعر في مدح عمر، فجزاه عمر خيراً، ولزم بلال المسجد يصلي، ويقرأ ليله ونهاره، فهم عمر أن يوليه العراق، ثم قال: هذا رجل له فضل، فدسَّ إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالاً جليلاً، فأخبر بذلك عمر، فنفاه وأخرجه.
وكان يكره أن يولي أحداً ممن غمس نفسه في الظلم أو عمل مع الظلمة لا سيما الحجاج، وإذا كان مَنْ قَبْلَ عمر يجعل للعصبية والقرابة من البيت الأموي وزناً في تولية العمل، فإنه لم يكن شيء من ذلك في ميزان عمر، فحدث الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية، فقال: أتحبون أن أولي كل رجل منكم جنداً من هذه الأجناد؟ فقال رجل منهم: تعرض علينا ما لا تفعله؟ قال: ترون بساطي هذا؟ إني لأعلم أنه يصير إلى بِلى، وإني أكره أن تدنسوا عليه بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني؟ وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟! هيهات هيهات.
وقد كـان لهذا النهج الذي تميزت به سياسة عمر بن عبد العزيز في اختيار الولاة والعمال أثر في الاستقرار السياسي في الأقاليم، حيث رضي الناس سير عماله وحمدوا فعالهم، إذ لم يكن في عماله من هو على شاكلة الحجاج يتعامل مع الناس بالشدة ويأخذهم بالتهمة، كما لم يكن منهم صاحب عصبية يرفع أناساً ويضع آخرين فيجدوا عليه في أنفسهم.
ثانيا: الإشراف المباشر على إدارة شؤون الدولة:
أشـرف عمر بن عبد العزيز بنفسـه على ما يتم في دولتـه من أعمال صغرت أو كبـرت، وكان يتابع عماله في أقاليمهم، وساعده على ذلك أجهزة الدولة التي طورها عبد الملك بن مروان، كالبريد، وجهاز الاستخبارات الكبير الممتد في أطراف الدولة، والذي كان الخلفاء يستخدمونه في جمع المعلومات.
وعلى الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز في اختيار الولاة، إلا أن هذا لم يمنعه من العمل على متابعة أمر الرعية وتصريف شؤون الدولة، وقد اشتهر عنه الدأب والجد في العمل حتى أصبح شعاره: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فقد قيل له: يا أمير المؤمنين! لو ركبت فتروحت، قال: فمن يجزي عني عمل ذلك اليوم؟ قيل: تجزيه من الغد، قال: فدعني من عمل يوم واحد، فكيف إذ اجتمع علي عمل يومين. وقال ميمون بن مهران: كنت ليلة في سمر عمر بن عبد العزيز، فقلت: يا أمير المؤمنين! ما بقاؤك على ما أرى؟ أنت بالنهار في حوائج الناس وأمورهم، وأنت معنا الآن ثم الله أعلم ما تخلو عليه، فقد كان ـ رحمه الله ـ يمضي الكثير من وقته لرسم سياسته الإصلاحية التي شملت مختلف الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية، وغيرها.. حتى خلف رحمه الله كمّاً هائلاً من تلك السياسات التي تمثل مواد نظام حكمه الإصلاحي الشامل، وقد بعث بهذه السياسات إلى عماله لتنفيذها في مختلف الأقاليم، وكثيراً ما يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها عماله بعظم الأمانة الملقاة على عواتقهم، ويخوفهم بالله ويأمرهم بمراقبته وتقواه فيما يعملون ويذرون.
وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر في نفوس عماله أشد من وقع السياط، وأبلغ من أوامر العزل والإعفاء، فكتب مرة إلى أحدهم: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب، طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى الله تعالى.
ولم يكتفِ عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إلى عماله، بل كان يحرص على متابعة تنفيذها، وتحقق آثارها على رعيته. فلا يفتأ يسأل القادمين عن ذلك، فقال زياد بن أبي زياد المدني حين قدم على عمر من المدينة: فسألني عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم... وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فأخبرته.
وخرج عمر بن عبد العزيز يوماً فركب هو ومزاحم، وكان كثيراً ما يركب فيلقى الركبان ويتحسس الأخبار عن القرى، فلقيهما راكب من أهل المدينة وسألاه عن الناس وما وراءه، فقال لهما: إن شئتما جمعت لكما خبري وإن شئتما بعضته تبعيضاً، فقالا: بل اجمعه، فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور، فسُرَّ عمر بذلك وقال: والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
وحين قدم عليه رجل من خراسان وأراد العودة إلى بلاده؛ طلب من عمر أن يحمله على البريد، فقال له عمر وقد اطمأن لسيرته: هل لك أن تعمل لنا عملاً وأحملك؟ فقال الرجل: نعم. فقال عمر: لا تأتِ على عامل لنا إلا نظرت في سيرته، فإن كانت حسنة لم تكتب بها، وإن كانت قبيحة كتبت بها. قال مزاحم: فما زال كتاب منه يجيئنا في عامل فنعزله حتى قدم خراسان.
ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم بمصادر متنوعة بجمع المعلومات، لعلمه أن المعرفة الدقيقة بأمور الرعية والولاة تحتاج لجمع المعلومات الصحيحة التي يبني عليها التوجيهات والأوامر والنواهي النافعة للأمة والدولة. لقد أتت هذه المتابعة الدقيقة من عمر لعماله والتوجيهات التفصيلية لهم ثمارها في استقرار أحوال الأقاليم، كما أن هذه التوجيهات والمتابعة من عمر جعلت العمال والولاة في حالة تحفز دائمة للعمل؛ حيث كانت تلك التوجيهات تقع في نفوسهم بمكان، فحدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رأيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يعمل بالليل كله وبالنهار لاستحثاث عمر إياه.
وكان رحمه الله يرسل المفتشين في الأقاليم ليأتوه بالأخبار: فقد بعث إلى خراسان ثلاثة مفتشين، يبحثون في ظلامات الناس من نظام خراجها، الذي قرره عدي بن أرطأة على الأهالي، وأرسل مفتشاً إلى العراق، ليأتيه بأخبار الولاة والناس فيها. ولقد أعلن عمر في إطار متابعته لشؤون الدولة ما يمكن تسميته بالرقابة العامة، إذ كتب لأهل الموسم في يوم الحج الأكبر:...إني بريء من ظلم من ظلمكم... ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني، وأنا معوِّل كل مظلوم، ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق، ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم...ألا وأيما وارد في أمر يصلح الله به، خاصة أو عامة، فله ما بين مئة دينار إلى ثلاثمئة دينار، على قدر ما نوى من الحسبة. فقد أعلن في أكبر تجمع إسلامي، بل شجع مادياً ومعنوياً على مراقبته، ومراقبة عماله، والإفصاح عن كل ما لا يوافق الكتاب والسنة، وبطبيعة الحال فالأمة الإسلامية لا تحتاج إلى غير تعاليم الكتاب والسنة، إذا كان الالتزام بها هدفاً منشوداً.
ثالثا: التخطيط في إدارة عمر بن عبد العزيز:
يعرف التخطيط في معناه العام بأنه: العملية التي تتخذ لتلبية احتياجات المستقبل، وتحديد وسائل تحقيقها، كما عرف التخطيط بأنه: الجسر بين الحاضر والمستقبل، ومن هذا التعريف العام يمكن أن نقول: إن التخطيط في الإسلام هو الاستعداد في الحاضر لما يواجهه الإنسان في عمله، أو حياته في المستقبل.
وعمر بن عبد العزيز لم يكن ليتخذ قراراً دونما تخطيط، وتوخٍّ لعواقب الأمور، وأخذها بعين الاعتبار، ولعل من أهم المؤشرات على إدراك عمر لأهمية التخطيط والتفكير في الأمور قوله لرجاء: يا رجاء! إني لي عقلاً أخاف أن يعذبني الله عليه.
وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على الله ثم جمع المعلومات والقدرة على حسن قراءتها، واستشراف المستقبل وتحقيق الأهداف المطلوبـة، ففي ذلك يقول عمر: من عمل على غير علـم كان يفسد أكثر مما يصلح، وقد كان عمر بن عبد العزيز في تخطيطه يضع الأهداف ويختار السياسات، ويحدد الإجراءات ويبلور العمل في خططه؛ ففي إطار بلورة الأهداف كان هناك هدف رئيسي يسعى عمر لتحقيقه؛ ألا وهو الإصلاح والتجديد الراشدي على منهاج النبوة والخلافة الراشدة، والقيام بكل مقومات هذا المشروع الإصلاحي من إقامة العدل والحق وإزالة الظلم، وإعادة الانسجام بين الإنسان وبين الكون والحياة وخالقهما في إطار الفهم الشمولي للإسلام، وأما اختيار السياسات كأحد مقومات التخطيط، فإنه قد تجلى ذلك في تطبيقات عمر للتخطيط الإداري، ولا أدل على ذلك من عزم عمر على الاكتفـاء بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع، والدين، على أساس أنه حاكم منفذ، وأن الشرع من جانبه على نفسه وعلى رعيته، كما ألزم الرعية بالتمسك بذلك الشرع القويم. هذا في إطار تحديد واختيار السياسة العامة.
أما تحديد الإجراءات كأحد مقومات التخطيط أيضاً، فإن ذلك يتضح من خلال الإجراءات التي حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء الأول مع الأمة عند وضعه شروطاً لصحبته، والتي قد بينتها فيما مضى، وأما بلورة طريقة العمل، فإنه قد وضح بأنه منفذ وليس مبتدع ـ أي منفذ لتعاليم الدين وأن الطاعة لمن أطاع الله ـ وأن يكون أساس العمل إقامة العدل والإصلاح والإحسان بدلاً من الظلم والفجور والعدوان.
وقد مارس عمر التخطيط من حيث الشمول، وشمل تخطيطه كافة المجالات، فلم يترك مجالاً إلا طرق بابه، في أمور السياسة والحكم، والقضاء والاقتصاد، والتربية والتعليم، والنواحي الاجتماعية فضلاً عن التخطيط للأمور العامة، كما اهتم ببعض الأقاليم بشكل منفصل؛ مثل: خراسان والعراق، واهتم بمؤسسات تنظيمية أخرى مثل القضاء، وبيت المال، وولاة الخراج، وغير ذلك.
رابعا: التنظيم في إدارة عمر بن عبد العزيز:
إن التنظيم يأتي مكملاً للتخطيط لبناء المتطلبات الإجرائية لتنفيذ الخطط، وقد جعل عمر بن عبد العزيز التنظيم أهم أولويات العمل الإداري، ورسخ مفهوم التنظيم في سلوكه الإداري.
فمن حيث التنظيم الهيكلي للعمل، نجده قد جزَّأ أعمال الدولة إلى أربعة أجزاء رئيسية، تأتي تحت مسؤولية أربعة أركان؛ هم: الوالي والقاضي وصاحب بيت المال والخليفة؛ بالإضافة إلى تنظيمات أخرى؛ مثل: الخراج والجند والكتاب والشرطة والحرس وصاحب الخاتم والحاجب وغير ذلك، وفيما يلي اللائحة التنظيمية لمسؤوليات العمل في عهد عمر بن عبد العزيز.
وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة والعمال، وتحديد أوجه العمل وأساليب التنفيذ؛ فإنه يمكننا القول: إن الكثير من كتب عمر لعماله تسعى لتحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا الجانب التنظيمي من العملية الإدارية، فعلى سبيل المثال: أوضح أسلوب التعامل بينه وبين المظلومين، وكيفية الاتصال بينه وبينهم، إذ أباح دخول المظلومين عليه من غير إذن.
ومن صور التنظيم إعادة الكثير من الأمور والقضايا إلى ما كانت عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء الراشدين، ومثال ذلك: أمره بإرجاع مزرعته في خيبر إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الشيء نفسه بشأن (فدك)؛ إذ كتب إلى أبي بكر بن حزم واليه على المدينة يقول: إني نظرت في أمر فدك، فإذا هو لا يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فاقْبِضها وولِّها رجلاً يقوم فيها بالحق، وسلام عليك.
كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية والصدقات والضرائب والأخماس والزكاة في الأموال والممتلكات، وتنظيم العمالة التجارية، ومن ليس له الحق في ممارسة التجارة وغير ذلك.
كما اهتم عمر بتنظيم أمور القضاء باعتباره السبيل الرئيسي للفصل بين الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم، فكان لكل مصر أو ولاية قاضٍ يقضي بما في الكتاب والسنة، وكان قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك المصر، كعامر بن شرحبيل الشعبي بالكوفة، والحارث بن يمجد الأشعري بحمص، وعمر بن سليمان بن خبيب المحاربي بدمشق وغيرهم، كما كان عمر يمارس القضاء بنفسه.
وكان الاعتبار الأساسي في التنظيم القضائي في نظر عمر هو مراجعة الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وعندما اشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم، عين لهم قاضياً ليحكم في هذه القضية، وقد مرت معنا، وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد العزيز مبدأ الفصل بين السلطات على أتم وجه، ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يبتَّ هو بها، مع أنه كان يسعه ذلك، وهو خليفة المسلمين، ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان بن أبي السري، مخافة أن يجمح به الهوى، أو أن تأخذه العزة بالإثم، ولأنه عامل باسم الخليفة الذي أبى هو نفسه أن يبتَّ بالخلاف، ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري، بل أمر بأن يجلس لهم القاضي؛ لأن القاضي لا يتأثر بالاعتبارات العسكرية أو السياسية، ولا يأبه إلا لحكم الله، يطبق أوامر الشريعة كما وردت، وهكذا تحقق ظن عمر بن عبد العزيز، وحكم القاضي بأن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم، أي أنه أمرهم بالجلاء، لأن الاحتلال وقع بصورة غير مشروعة.
كما شملت تطبيقات عمر لتنظيم بيت الخلافة، أنه أعاد تنظيمه بما يتوافق مع نظرته في أنه واحد من عامة المسلمين، وأنه ليس في حاجة إلى أبهة الملك، فانصرف عن كل مظاهر الخلافة التي سادت قبله، وألغى بعض الوظائف، كصاحب الشرطة الذي يسير بين يدي الخليفة بالحربة، كعادته مع الخلفاء السابقين له، وقال له عمر: تنحَّ عني ما لي ولك؟ إنما أنا رجل من المسلمين، ثم سار وسار معه الناس.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf
الجزء الثاني:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC139.pdf
كما يمكنكم الاطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com