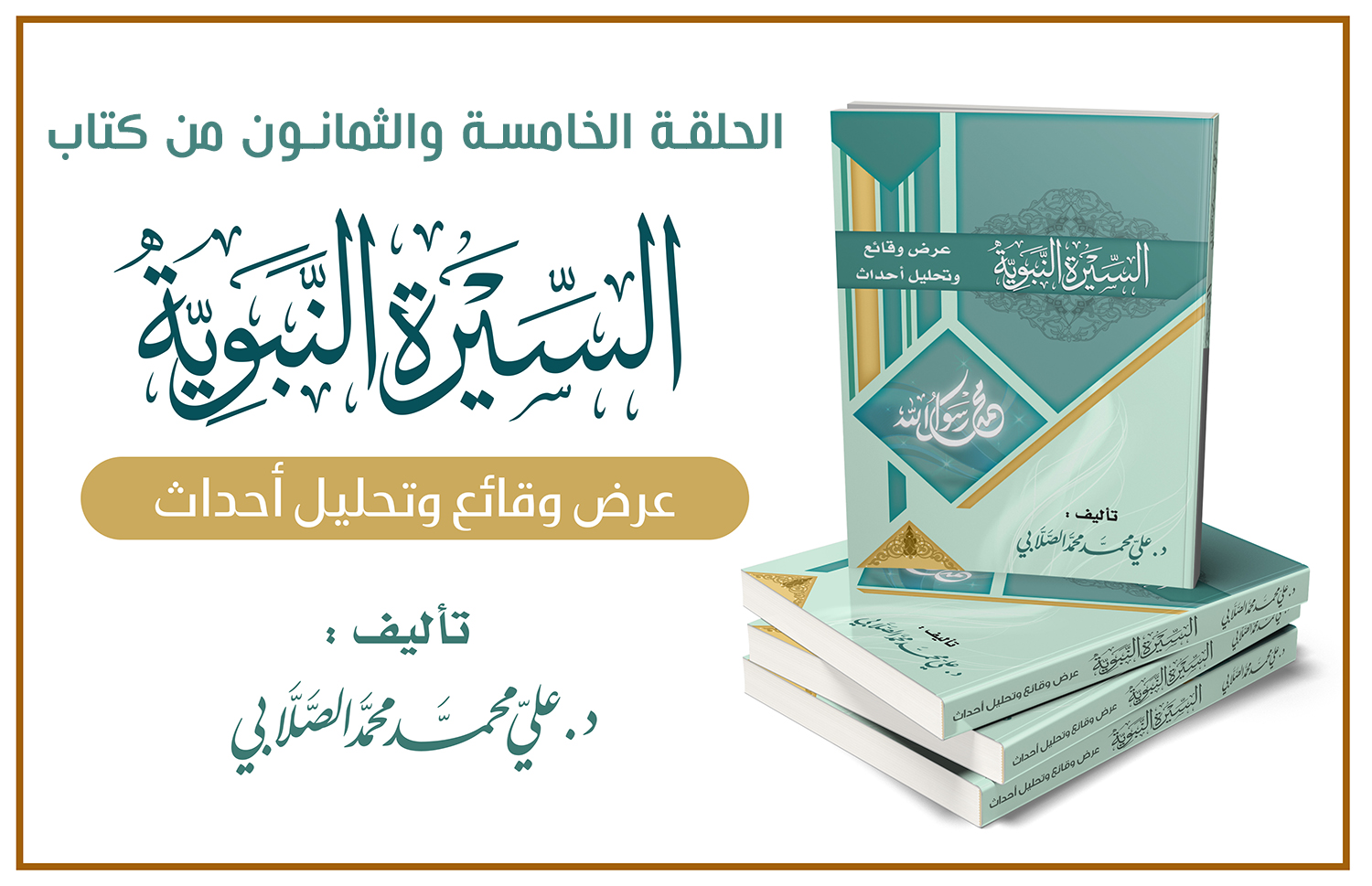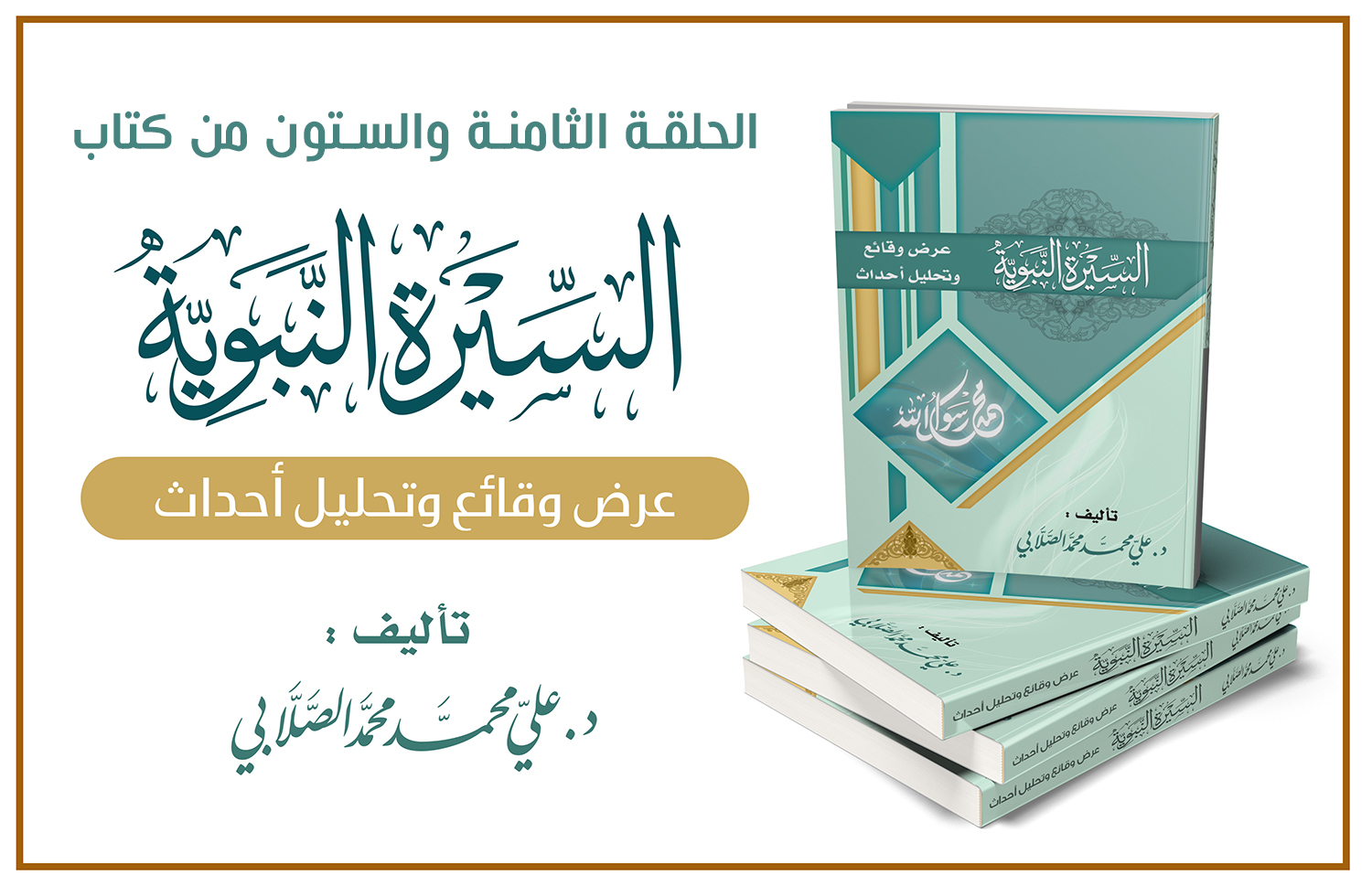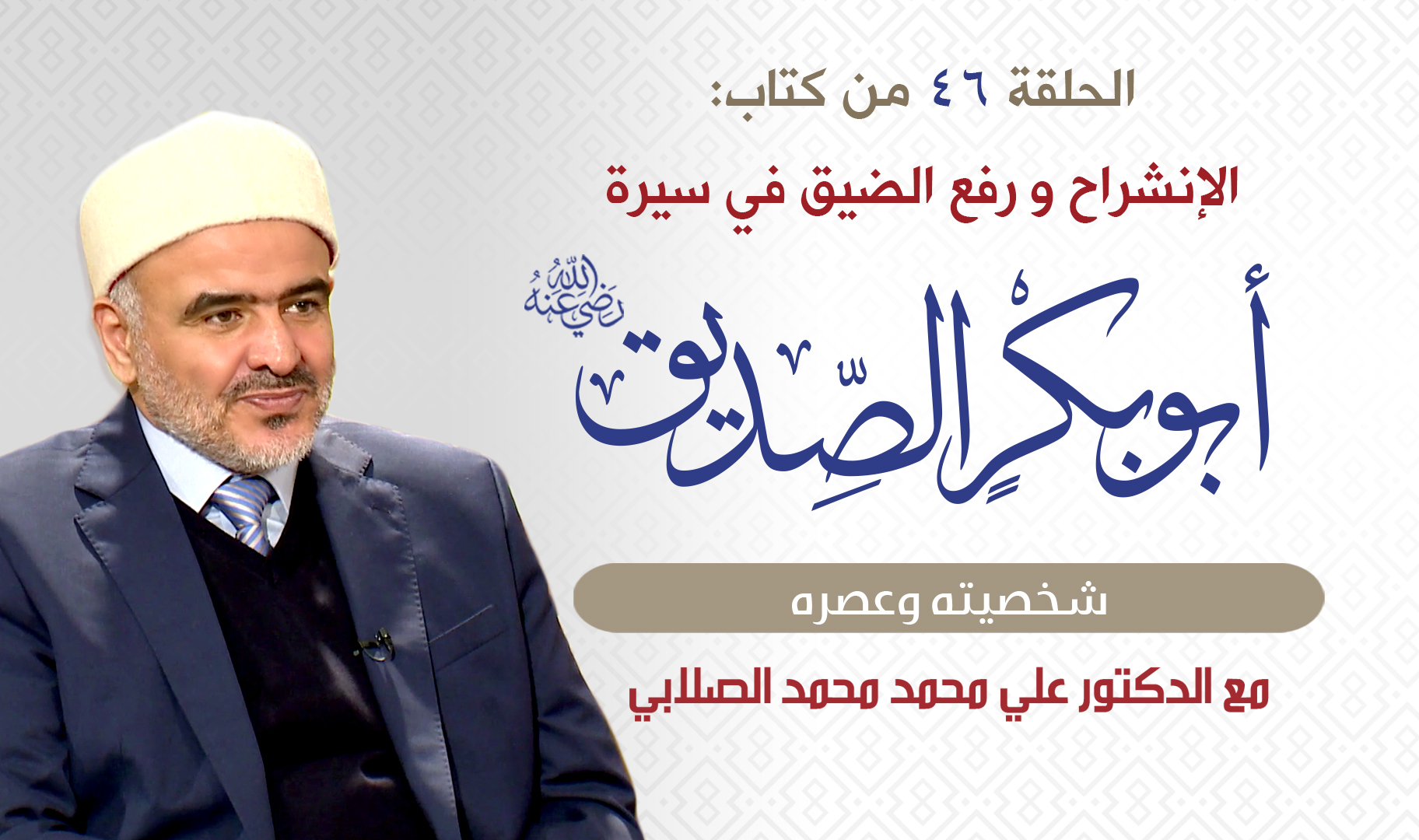الحلقة الخامسة والثمانون (85)
غزوة أحد (أحداث ما بعد المعركة)
أولاً: حوار أبي سفيان مع الرَّسول (ص) وأصحابه:
قال البَراءُ رضي الله عنه: وأشرفَ أبو سفيان، فقال: أفي القوم محمَّدٌ؟ فقال رسولُ الله (ص): «لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابنُ أبي قُحَافَةَ؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابنُ الخطَّاب؟ فقال: إنَّ هؤلاء القوم قُتلوا، فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرُ رضي الله عنه نفسَه، فقال: كذبتَ يا عدوَّ الله! أبقى اللهُ عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: اعْلُ هُبَلُ! فقال النَّبيُّ (ص) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلُّ». قال أبو سفيان: لنا العُزَّى. ولا عُزَّى لكم. فقال النَّبيُّ (ص) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللهُ مولانا، ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يومُ بيوم بدر، والحرب سِجَالٌ، وتجدون مُثلةً لم امُرْ بها، ولم تَسُؤْني. [البخاري (4043)، والبيهقي في الدلائل (3/268)] وفي روايةٍ: قال عمر: لا سواء! قتلانا في الجنَّة، وقتلاكم في النَّار». [أحمد (1/463)، ومجمع الزوائد (6/110)].
كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله (ص) ، وأبي بكرٍ، وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ واضحةٌ على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم؛ لأنَّه في علمهم أنَّهم أهل الإسلام، وبهم قام صَرْحُهُ، وأركان دولته، وأعمدة نظامه، ففي موتهم يعتقد المشركون: أنَّه لا يقوم الإسلام بعدهم.
وكان السُّكوت عن إجابة أبي سفيان أوَّلاً؛ تصغيراً له، حتَّى إذا انتشى، وملأه الكِبْر؛ أخبروه بحقيقة الأمر، وردُّوا عليه بشجاعةٍ.
وفي هذا يقول ابن القيِّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته، وبشركه؛ تعظيماً للتَّوحيد، وإعلاماً بعزَّة من عَبَدَهُ المسلمون، وقوَّة جانبه، وأنَّه لا يُغْلَبُ، ونحن حزبُه، وجندُه، ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمَّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل روي: أنَّه نهاهم عن إجابته، وقال: «لا تجيبوه»؛ لأنَّ كلْمَهم لم يكن برد في طلب القوم، ونارُ غيظهم بعدُ متوقِّدةٌ، فلـمَّا قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتُموهم؛ حمي عمر بن الخطَّاب، واشتد غضبه، وقال: كذبت يا عدوَّ الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال، والشَّجاعة، وعدم الجبن، والتَّعرُّف إلى العدوِّ في تلك الحال ما يؤذنهم بقوَّة القوم، وبسالتهم، وأنَّهم لم يهِنوا، ولم يَضْعُفُوا، وأنَّه، وقومَه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم، وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثَّلاثة وهلةٌ بعد ظنِّه، وظنِّ قومه: أنَّهم قد أُصيبوا من المصلحة، وغيظ العدوِّ، وحزبه، والفتِّ في عَضُده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً، واحداً، فكان سؤاله عنهم، ونعيُهم لقومه آخر سهام العدوِّ، وكيده، فصبر له النَّبيُّ (ص) حتَّى استوفي كيده، ثمَّ انتدب له عمر، فردَّ بسهام كيده عليه، وكان ترك الجواب عليه أحسن، وذكره ثانياً أحسن، وأيضاً: فإنَّ في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانةً له، وتصغيراً لشأنه، فلـمَّا مَنَّتْهُ نفسهُ موتهم، وظنَّ: أنهم قد قُتلوا، وحصل له بذلك من الكبر، والأشرما حصل، كان في جوابه إهانةٌ له، وتحقيرٌ، وإذلالٌ، ولم يكن هذا مخالفاً لقول النَّبيِّ (ص) : «لا تجيبوه» فإنَّه إنَّما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمَّد؟ أفيكم فلان؟ ولم يَنْهَ عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قُتلوا، وبكلِّ حالٍ، فلا أحسنَ مِنْ ترك إجابته أولاً، ولا أحسنَ مِنْ إجابته ثانياً.
ثانياً: تفقد الرَّسول (ص) الشُّهداء:
بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة، ذهب الرَّسول (ص) ليتفقَّد أصحابه رضي الله عنهم، فمرَّ على بعضهم، ومنهم حمزةُ بن عبد المطَّلب، ومُصْعَب بن عُمَيرٍ، وحنظلةُ بن أبي عامرٍ، وسعد بن الرَّبيع، والأُصَيْرِمُ، وبقيَّة الصحابة رضي الله عنهم، فلـمَّا أشرف عليهم رسول الله (ص) قال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء، إنَّه ما من جَرِيح يُجْرَح في الله، إلا والله يبعثه يوم القيامة يَدْمَى جُرْحُهُ؛ اللَّونُ لونُ دمٍ، والرِّيح ريح المسك، انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» [سبق تخريجه].
وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريِّ: إنَّ النَّبيَّ (ص) كان يجمع بين الرَّجلين من قَتْلَى أُحدٍ في ثوبٍ واحد، ثمَّ يقول: «أيُّهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟» فإذا أُشِيرَ له إلى أَحدٍ؛ قدَّمه في اللَّحْدِ، وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» ، وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلُوا . [البخاري (4079) ، وأبو داود (3138)، والترمذي (1036)، والنسائي (4/62)، وابن ماجه (1514)].
وأمر رسولُ الله (ص) أن يدفنوا حيثُ صُرِعوا، وأُعيد مَنْ أُخذ؛ ليدفن داخل المدينة. [النسائي (4/79)].
ولـمَّا رأى رسولُ الله (ص) حمزةَ بن عبد المطلب وقد مُثِّل به؛ حزن حزناً شديداً، وبكى حتَّى نشغ من البُكاء وقال (ص) : «لولا أن تحزن صفيَّة، ويكون سنةً من بعدي؛ لتركتُه حتَّى يكون في بطون السِّباع، وحواصل الطَّيـر، ولئن أظهرني الله على قريشٍ في موطن من المواطن؛ لأمثلنَّ بثلاثين رجلاً منهم» فلـمَّا رأى المسلمون حُزْنَ رسول الله (ص) وغيظه على مَنْ فعل بعمِّه ما فعل، قالوا: والله! لئن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدَّهر، لنمثلنَّ بهم مُثلَةً لم يُمَثِّلْهَا أحدٌ من العرب. [أحمد (3/128)، وأبو داود (3136)، والترمذي (1016)، والحاكم (3/196)، وابن أبي شيبة (14/391 - 392)]، فنزل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126].
لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشيَّة، حيث قاموا بالتَّمثيل بقتلى المسلمين، فبقروا بطون كثيرٍ من القتلى، وجَدَعُوا أنوفَهم، وقطعوا الاذان، ومذاكير بعضهم؛ ومع ذلك صَبَرَ رسولُ الله (ص) وأصحابه، واستجابوا لتوجيه المولى - عزَّ وجلَّ - فعفا، وصبر، وكَفَّر عن يمينه، ونهى عن المُثْلَةِ. روى ابن إسحاق بسنده عن سَمُرة بن جُنْدب، قال: ما قام رسولُ الله (ص) في مقامٍ قطُّ ففارقه، حتَّى يأمرنا بالصَّدقة، وينهانا عن المُثْلَة. [ابن هشام (3/102)].
ثالثاً: دعاء الرَّسول (ص) يوم أُحدٍ:
صلّى رسولُ الله (ص) بأصحابه الظُّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه، وصلَّى وراءه المسلمون قعوداً، وتوجَّه النَّبيُّ (ص) بعد الصَّلاة إلى الله بالدُّعاء، والثَّناء على ما نالهم من الجَهْد، والبلاء، فقال لأصحابه: «استووا حتَّى أُثني على ربِّي - عزَّ وجلَّ»، فصاروا خلفه صفوفاً، ثمَّ دعا بهذه الكلمات الدَّالة على عمق الإيمان، فقال (ص) : «اللَّهمَّ! لك الحمدُ كلُّه، اللَّهُمَّ لا قابضَ لِمَا بَسطتَ، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضلَلْتَ، ولا مُضِلَّ لمَنْ هديت، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا مانع لما أعطيتَ، ولا مُقَرِّب لما باعدْتَ، ولا مُبْعِد لما قرَّبْتَ.
اللَّهُمَّ! ابسطْ علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك. اللّهُمَّ! إنِّي أسألك النَّعيم المُقيم؛ الَّذي لا يَحُول، ولا يزول. اللَّهُمَّ! إنِّي أسألك النَّعيم يوم الغلبة، والأمنَ يوم الخوف. اللَّهُمَّ! عائذٌ بك من شرِّ ما أعطيتنا، وشرِّ ما منعتنا. اللَّهُمَّ! حَبِّبْ إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق، والعصيان، واجعلنا من الرَّاشدين. اللَّهُمَّ توفَّنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصَّالحين غيرَ خزايا، ولا نادمين، ولا مفتونين. اللَّهُمَّ! قاتل الكفرة الَّذين يكذِّبون رُسُلَكَ، ويصدُّون عن سبيلك، واجعلْ عليهم رجزكَ، وعذابك. اللَّهُمَّ قاتل الكفرة الَّذين أوتوا الكتاب، إله الخَلْق» [أحمد (3/424)، والبزار (1800)، والطبراني في المعجم (4549)، والبخاري في الأدب المفرد (699)، ومجمع الزوائد (6/121 - 122)] ثمَّ ركب فرسه، ورجع إلى المدينة.
وهذا أمرٌ عظيم، شرعه رسول الله (ص) لأمَّته، لكي يطلبوا النَّصر، والتَّوفيق من ربِّ العالمين، وبيَّن لأمَّته: أنَّ الدُّعاء مطلوبٌ في ساعة النَّصر، والفتح، وفي ساعة الهزيمة؛ لأنَّ الدُّعاء مُخُّ العبادة، كما أنَّه من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، ويجعل القلوب متعلِّقة بخالقها، فينزل عليها السَّكينة، والثَّبات، والاطمئنان، ويمدُّها بقوَّةٍ رُوحيَّةٍ عظيمةٍ، فترتفع المعنويات نحو المعالي، وتتطلَّع إلى ما عند الله تعالى.
في أعقاب المعركة، يتَّخذ النَّبيُّ (ص) أُهْبَتَهُ، وينظِّم المسلمين صفوفاً، لكي يُثْنِيَ على ربِّه - عزَّ وجلَّ - إنَّه لموقفٌ عظيمٌ، يُجَلِّي إيماناً عميقاً، ويكشف عن العبودية المطلقة لربِّ العالمين الفعَّال لما يريد، فهو القابض، والباسط، والمعطي، والمانع، لا رادَّ، ولا مُعَقِّب لحُكْمِه.
إنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديَّة الَّتي تسمو بالعابدين، وتجلُّ المعبود كأعظم ما يكون الإجلال، والإكبار، وأبرز ما يكون الحَمْدُ والثَّناء.
رابعاً: معرفة وِجْهَةِ العدو:
بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسولُ الله (ص) عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة، وذلك لمعرفة اتِّجاه العدوِّ، فقال له: «اخرج في آثار القوم، وانظر ماذا يصنعون، وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَنَّبُوا الخيلَ، وامتطوا الإبل [الواقدي في المغازي (1/298)، والطبري في تاريخه (2/527) ، والبيهقي في الدلائل (3/282)]؛ فإنَّهم يريدون مكَّة ، وإن ركبوا الخيل ، وساقوا الإبل ، فهم يريدون المدينة، والَّذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسيرنَّ إليهم فيها، ثمَّ لأناجزنَّهم». قال عليٌّ: فخرجت في أثرهم أنظرُ ماذا يصنعون، فجَنَّبوا الخيل، وامتطوا الإبل، ووجَّهوا إلى مكَّة، فرجع عليٌّ رضي الله عنه، وأخبر رسول الله (ص) بخبر القوم.
وفي هذا الخبر عدَّة دروسٍ، وعبرٍ؛ منها: يقظة الرَّسول (ص) ، ومراقبتُه الدَّقيقة لتحرُّكات العدوِّ، وقدرته (ص) على تقدير الأمور، وظهور قوَّته المعنويَّة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة، وفيه ثقة النَّبيِّ (ص) بعليٍّ رضي الله عنه، ومعرفته بمعادن الرِّجال، وفيه شجاعة عليٍّ رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورَّع عن محاولة قتله.
ونلحظ: أنَّ النَّبيَّ (ص) أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت؛ تفقَّد خلالها الجرحى، والشُّهداء، وأمر بدفنهم، ودعا ربَّه، وأثنى عليه سبحانه، وأرسل عليّاً ليتتبَّع خبر القوم؛ كلُّ ذلك من أجل أن يحافظ على النَّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أُحُدٍ، وهذا من فقه سنن الله تعالى في الحروب والمعارك، فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنَّصر أسباباً، وللهزيمة أسباباً، فمن أخذ بأسباب النَّصر، وصدق التَّوكُّل على الله - سبحانه وتعالى - حقيقة التوكُّل؛ نال النَّصر بإذن الله - عزَّ وجل -، كما قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ [الفتح: 23].ويتجلَّى فقه النَّبيِّ (ص) في ممارسة سنَّة الأخذ بالأسباب، في غزوة حمراء الأسد.
خامساً: غزوة حمراء الأسد:
نجد في بعض الرِّوايات: أنَّ النَّبيَّ (ص) تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه، حتَّى بعد رجوعهم إلى مكَّة، وبلغه مقالـة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمَّد، وجنده، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لـمَّا انصرف أبو سفيان والمشركون من أُحدٍ، وبلغوا الرَّوْحاء، قال أبو سفيان: لا محمَّداً قتلتُم، ولا الكواعب أردفتُم، شرٌّ ما صنعتم! فبلغ ذلك رسول الله (ص) [الطبراني في المعجم الكبير (11632)، ومجمع الزوائد (6/121)]. وتفيد هذه الرِّواية خبر استطلاع الرَّسول (ص) أعداءه حتَّى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنَّ على عدم مباغتتهم له.
وعندما سمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة، خرج بمن حضره يوم أُحُدٍ من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد.
قال ابن إسحاق: كان يوم أُحُد يوم السَّبت للنِّصف مِنْ شوَّال، فلـمَّا كان الغدُ من يوم الأحد لستَّ عشرة ليلةً مضت من شوَّال؛ أذَّن مؤذنُ رسولِ الله (ص) في النَّاس بطلب العدوِّ، وأذَّن مؤذِّنه ألاَّ يخرجنَّ معنا أحَدٌ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه، فأذن له، وإنَّما خرج مُرْهِباً للعدوِّ، وليظنُّوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوِّهم. [ابن هشام (3/107)، والبيهقي في الدلائل (3/314)]. وقد استجاب أصحاب النَّبيِّ (ص) لنـداء الجهاد، حتَّى الَّذين أُصيبوا بالجروح؛ فهذا رجلٌ من بني عبد الأشهل يقول: شهدت أُحُداً أنا، وأخٌ لي، فرجعنا جريحَين، فلما أذَّن مؤذِّن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدوِّ؛ قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتُنا غزوةٌ مع رسول الله (ص) ؟ والله ما لنا من دابةٍ نَرْكَبُها، وما منا إلا جريحٌ ثقيلٌ، فخرجنا مع رسول الله (ص) ، وكنت أيسرَ جُرْحاً منه، فكان إذا غُلب؛ حملته عُقبةً ومشى عُقبةً (فترةً)، حتَّى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون.
وسار رسول الله (ص) إلى حمراء الأسد، واقترب بجنوده من جيش المشركين، فأقام فيه ثلاثة أيام يتحدَّى المشركين، فلم يتشجَّعوا على لقائه، ونزاله، وكان رسول الله (ص) قد أمرَ بإشعال النِّيران، فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خمسمئة نار.
وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعيُّ إلى رسول الله (ص) فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان، فيخذِّله، فلحقه بالرَّوحاء - ولم يعلم بإسلامه - فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمَّدٌ وأصحابه، فقد تحرَّقوا عليكم، وخرجوا في جمعٍ لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلَّف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حتَّى يطلع أوَّل الجيش من وراء هذه الأكمة، فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فإنِّي أنهاك عن ذلك، ووالله! لقد حملني ما رأيتُ على أن قلتُ فيه أبياتاً من شعرٍ:
|
|
كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الأصْوَاتِ رَاحِلَتي |
|
إِذْ سَالَتِ الأرْضُ بالجُرْدِ الأَبابيْلِ |
|
|
|
تَرْدِي بأُسْدٍ كِرَامٍ لاَ تَنَابِلَةٍ |
|
عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلاَ مِيْلٍ مَعَازِيلِ |
|
|
|
فَظَلْتُ أَعْدُو أَظُنُّ الأَرْضَ مَائِلَةً |
|
لـمَّا سَمَوْا بِرَئِيْسٍ غَيْرِ مَخْذُوْلِ |
|
|
|
فَقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمُ |
|
إِذَا تَغَطْمَطَتِ البَطْحَاءُ بِالجِيْلِ |
|
|
|
إنِّي نَذِيْرٌ لأَهْلِ البَسْلِ ضَاحِيَةً |
|
لِكُلِّ ذِيْ إِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُوْلِ |
|
|
|
مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لاَ وَخْشٍ تَـنَـابِلَةٌ |
|
وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالقِيْلِ |
|
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وحاول أبو سفيان أن يغطِّي انسحابه هذا بشنِّ حربٍ نفسيَّة على المسلمين، لعلَّه يُرهبهم، فأرسل مع رَكْبِ عبد القيس - وكانوا يريدون المدينة للْمِيْرَةِ - [البيهقي في الدلائل (3/315 - 317)، وابن هشام (3/108 - 110)] رسالةً إلى رسول الله (ص) ، مفادها: أنَّ أبا سفيان وجيشـه قد أجمعوا على السَّير إليه، وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود، وواعد أبو سفيان الرَّكبَ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونـه في سوق عُكَاظ، ومرَّ الرَّكبُ برسول الله (ص) وهو بحمراء الأسـد، فأخبروه بالَّذي قاله أبو سفيان، فقال هو والمسلمون: حسبنا اللهُ، ونِعْمَ الوكيلُ.
واستمرَّ المسلمون في معسكرهم، واثرت قريش السَّلامة، والأوبةَ، فرجعوا إلى مكَّة، وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروحٍ قويَّةٍ متوثِّبةٍ، غسلت عَارَ الهزيمة، ومسحت مغبَّةَالفشل، فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب، عبثوا بانتصار المشركين، وهزُّوا أعصابهم، وأحبطوا شماتة المنافقين، واليهود في المدينة، وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة، وسجَّل ظواهرها بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران 172 - 175] ووقع في أسر النَّبيِّ (ص) قبل رجوعه إلى المدينة، أبو عزَّة الجُمَحِيُّ الشَّاعر، فقُتِل صبراً؛ لأنَّه أخلف وعده للرَّسول (ص) بألاَّ يقاتل ضدَّه عندما منَّ عليه ببدرٍ، وأطلقه، فعاد فقاتل في أُحدٍ، وقد حاول أبو عزَّة أن يتخلَّص من القتل، وقال: يا رسول الله! أقِلْني، فقال رسول الله (ص) : «لا والله! لا تمسح عارضيك بمكَّة بعدها، وتقول: خدعتُ محمَّداً مرَّتين، اضرب عنقه يا زُبيرُ!» [ابن سعد (2/43)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/65)، وفي دلائل النبوة (3/280 - 281)]. فضرب عُنقَه، فقال النَّبيُّ (ص) حينئذٍ: «لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحدٍ مرَّتين» [البخاري (6133)، ومسلم (2998)]، فصار هذا الحديث مثلاً، ولم يسمع قبل ذلك.
ويعد هذا العمل من قبيل السِّياسة الشَّرعية؛ لأنَّ هذا الشَّاعر من المفسدين في الأرض، الدَّاعين إلى الفتنة، ولأنَّ في المنِّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين. ولم يُـؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عزَّةَ الجُمَحيِّ.
وأمَّا عدد القتلى من المسلمين في أُحدٍ؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيداً من المسلمين، ويؤيِّد هذا تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلـمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 165] أنَّها نزلت تسليةً للمؤمنين عمَّن أُصيب منهم يوم أُحدٍ. قال ابن عطيَّة - رحمه الله -: وكان المشركون قد قتلوا منهم سبعين نفراً، وكان المسلمون قد قتلوا من المشركين ببدرٍ سبعين، وأسروا سبعين.أمَّا عدد الَّذين قُتلوا يوم أُحدٍ من المشركين، فكان اثنين وعشرين قتيلاً.
كان خروج رسول الله (ص) لملاحقة المشركين في غزوة حمراء الأسد، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المقاصد المهمَّة؛ منها:
1 - ألاَّ يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذين خرجوا يوم أُحدٍ هو الشُّعور بالهزيمة.
2 - إعلامهم: أنَّ لهم الكرَّة على أعدائهم متَى نفضوا عنهم الضَّعف، والفشل، واستجابوا لدعوة الله، ورسوله (ص) .
3 - تجرئة الصَّحابة على قتال أعدائهم.
4 - إعلامُهم: أنَّ ما أصابهم في ذلك اليوم، إنَّما هو منحةٌ، وابتلاءٌ اقتضتها إرادة الله، وحكمتُه، وأنَّهم أقوياء، وأنَّ خصومهم الغالبين في الظَّاهر ضعفاء.
كما أنَّ في خروج النَّبيِّ (ص) إلى حمراء الأسد إشارةً نبويَّـةً إلى أهمِّيَّة استعمال الحرب النَّفسيَّة للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج (ص) بجنوده إلى حمراء الأسد، ومكث فيها ثلاثة أيَّامٍ، وأمر بإيقاد النِّيران، فكانت تُشاهدُ من مكانٍ بعيدٍ، وملأت الأرجاء بأنوارها، حتَّى خُيِّل لقريش: أنَّ جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به، فانصرفوا؛ وقد ملأ الرُّعب أفئدتهم.
قال ابن سعد: «ومضى رسولُ الله (ص) بأصحابه حتَّى عسكروا بحمراء الأسد، وكان المسلمون يوقِدون تلك اللَّيالي خمسمئة نارٍ حتَّى تُرى من المكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم، نيرانهم في كلِّ وجهٍ؛ فكبَتَ اللهُ تعالى بذلك عدوَّهم».
سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أُحدٍ:
كانت غزوة أحدٍ أوَّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءُ المسلمين، وقد ظهرت بطولاتُ الـنِّساء، وصدق إيمانهنَّ في هذه المعركـة، فقد خرجن لكي يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، ومنهنَّ مَنْ قامت بردِّ ضربات المشركين المُوَجَّهة للرَّسول (ص) ، وممَّن شاركن في غزوة أحدٍ: أمُّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصِّدِّيق، وأمُّ عمارة، وحَمْنَة بنت جَحْشٍ الأسديَّة، وأمُّ سَلِيط، وأمُّ سُلَيْم، ونسوةٌ من الأنصار. [مسلم (1809 و1810 و1811)].
قال ثعلبة بن أبي مالكٍ رضي الله عنه: إنَّ عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من نساء أهل المدينة، فبقي منها مِرطٌ جيِّدٌ، فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين! أعطِ هذا بنت رسول الله الَّتي عندك - يريدون أمَّ كلثوم بنتَ عليٍّ - فقال عمر رضي الله عنه: أم سَليط أحقُّ به. وأمُّ سليط من نساء الأنصار مِمَّن بايع رسولَ الله (ص) . قال عمر: فإنها كانت تُزْفِرُ لنا القِرَبَ يوم أُحدٍ. [البخاري (2881، 4071)].
أ - سقي العطشى من المجاهدين:
عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «لـمَّا كان يوم أُحدٍ، انهزمَ النَّاسُ عن النَّبيِّ (ص) ، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرٍ، وأمَّ سُلَيم، وإنَّهما لمشمِّرتان، أرى خَدَمَ سُوقِهنَّ تَنْقُزَانِ القِرَبَ - وقال غيره: تنقلان القربَ - على متونهما، ثمَّ تُفْرغَانِهِ في أفواه القوم، ثمَّ ترجعان، فتملانها، ثمَّ تجيئان، فتُفرغَانه في أفواه القوم» [البخاري (2880)].
وقال كعب بن مالكٍ رضي الله عنه: «رأيتُ أمَّ سُلَيم بنت ملحان، وعائشة، على ظهورهما القِرَبُ، يحملانها يوم أُحدٍ، وكانت حَمْنَةُ بنت جحشٍ تسقي العطشى، وتداوي الجرحى، وكانت أمُّ أيمن تسقي الجرحى».
ب - مداواة الجرحى، ومواساة المصابين:
عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله (ص) يغزو بأمِّ سُلَيم، ونسوةٍ من الأنصار معه؛ إذا غزا، فيسقين الماءَ، ويداوين الجرحى. [مسلم (1810)].
وأخرج عبد الرَّزاق عن الزُّهريِّ: كان النِّساء يشهدن مع النَّبيِّ (ص) المشاهد، ويسقين المقاتلة، ويداوين الجرحى. وعن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذٍ، قالت: كنَّا مع النَّبيِّ (ص) نسقي القوم، ونداوي الجرحى، ونردُّ القتلى إلى المدينة. [البخاري (2882)]. وفي روايةٍ: كنَّا نغزو مع النَّبيِّ (ص) ، فنسقي القوم، ونخدمُهم، ونردُّ الجرحى، والقتلى إلى المدينة. [البخاري (2883)].
وعن أبي حازمٍ: أنَّه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله (ص) ، فقال: أما والله! إنِّي لأعرفُ مَنْ كان يغسلُ جُرحَ رسول الله (ص) ، ومن كان يسكب الماء، وبما دُوويَ. قال: كانت فاطمةُ رضي الله عنها بنتُ رسول الله (ص) تغسلُه، وعليٌّ يسكب الماء بالمجنِّ، فلـمَّا رأت فاطمة: أنَّ الماء لا يزيدُ الدَّم إلا كثرةً؛ أخذت قطعةً من حصيرٍ، فأحرقتها، وألصقتها، فاستمسك الدَّم. [البخاري (4075)، ومسلم (1790)].
ج - الدِّفاع عن الإسلام ورسوله (ص) بالسَّيف:
لم تقاتل المشركين يوم أُحدٍ إلا أمُّ عُمارة نُسَيبة المازنيَّة رضي الله عنها، وهذا ضَمْرَةُ بن سعيدٍ يحدث عن جدَّته، وكانت قد شهدت أُحداً تسقي الماء، قالت: سمعت النَّبيَّ (ص) يقول: لَمُقَامُ نُسَيْبة بنتِ كعبٍ اليوم خيرٌ من مُقام فلانٍ، وفلان، وكان يراها تُقاتل يومئذٍ أشدَّ القتال، وإنَّها لحاجزةٌ ثوبها على وسطها، حتَّى جُرِحَتْ ثلاثة عشرَ جرحاً، فلـمَّا حضرتها الوفاة كنت فيمن غسَّلها، فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً، فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إنِّي لأنظرُ إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها - وكان أعظم جراحها، لقد داوته سنةً - ثم نَادَى منادي النَّبيِّ (ص) : إلى حمراء الأسد! فشدَّت عليها ثيابها، فما استطاعت من نزف الدَّم، ولقد مكثنا ليلنا نكمِّد الجراح حتَّى أصبحنا، فلـمَّا رجع رسول الله (ص) من الحمراء، ما وصل إلى بيته حتَّى أرسل إليها عبدَ الله بن كعبٍ المازني - أخا أمِّ عُمارة - يسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها، فسُرَّ النَّبيُّ (ص) بذلك.
وقد علَّق الأستاذ حسين الباكريُّ على مشاركة نُسَيبة بنت كعب في القتال، فقال: «وخروج المرأة للقتال مع الرِّجال لم يثبت في ذلك منه شيءٌ غيرُ قصَّة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إنَّما كان اضطراريّـاً؛ حين رأت: أنَّ رسول الله (ص) أصبح في خطرٍ حين انكشف عنه النَّاس، فأمُّ عُمارة إذاً كانت في موقفٍ أصبح حَمْلُ السِّلاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حمله؛ رجلاً كان، أو امرأةً».
وعلَّق الدُّكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدَّالة على مشاركة النِّساء في أحدٍ بقوله: «وهذه الآثار تدلُّ على جواز الانتفاع بالنِّساء عند الضَّرورة، لمداوة الجرحى، وخدمتهم؛ إذا أُمِنَتْ فتنتهُنَّ مع لزومهنَّ السِّتر، والصِّيانة، ولهنَّ أن يُدافعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرَّض لهنَّ الأعداء، مع أنَّ الجهاد فرضٌ على الرِّجال وحدهم، إلا إذا داهم العدوُّ ديار المسلمين، فيجب قتاله من الجميع رجالاً، ونساء».
وأمَّا الأستاذ محمَّد أحمد باشميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة أُحدٍ أوَّل معركةٍ في الإسلام قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين، ومن الثَّابت: أنَّ امرأةً واحدةً فقط اشتركت في هذه المعركة، وهي تدافع عن رسول الله (ص) ، كما أنَّه من الثَّابت أيضاً: أنَّ المرأة الَّتي اشتركت في معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال، فهي لم تكن مجنَّدةً فيها كالرِّجال؛ وإنَّما خرجت لتنظر ما يصنع النَّاس لتقوم بأيَّة مساعدةٍ يمكنها القيام بها للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء، وما شابه ذلك، يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الَّتي خاضت معركة أُحدٍ، هي امرأةٌ قد تخطَّت سِنَّ الشَّباب، كما أنَّها لم تخرج إلى المعركة إلاَّ مع زوجها، وابنيها، الَّذين كانوا من الجند الَّذين قاتلوا في المعركة، يضاف إلى هذا الرَّصيد الهائل؛ الَّذي لديها من المناعة الخُلقيَّة والتَّربية الدِّينيَّة، فلا يقاس على هذه الصَّحابية الجليلة، مجنَّدات هذا الزَّمان، الَّلائي يرتدين لباس الميدان، وعنصر الإغراء، والفتنة هو أهمُّ عنصرٍ يتميَّزن به، ويحرصن على إظهاره للرِّجال؛ فأين الثَّرَى مِنَ الثُّرَيَّا؟!
كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا الزَّمان، من ناحية الشَّهامة، والاستقامة، والعفَّة والرُّجولة، فكلُّ المحاربين الَّذين اشتركت معهم المرأة في معركة أُحدٍ، كانوا صفوة الأمَّة الإسلاميَّة، ورمز نبلها، وشهامتها، وعنوان رجولتها، واستقامتها، فلا يصحُّ مطلقاً جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أُحدٍ قاعدةً تقاس عليها (من النَّاحية الشَّرعيَّة) إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر، لتقاتل بجانب الرَّجل (كعنصر أساسٍ من عناصر الجيش) فالقياس في هذه الحالة قياسٌ مع الفارق، وهو قياسٌ باطلٌ قطعاً».
سابعاً: دروس في الصَّبر تقدِّمها صحابيَّاتٌ للأمَّة:
أ - صفية بنت عبد المطَّلب رضي الله عنها:
لـمَّا استُشهد أخوها حمزةُ بن عبد المطَّلب رضي الله عنه في أُحدٍ، وجاءت لتنظر إليه؛ وقد مَثَّلَ به المشركون، فجدعوا أنفه، وبقروا بطنه، وقطعوا أذنيه، ومذاكيره، فقال رسول الله (ص) لابنها الزُّبير بن العوَّام: «الْقَها، فأَرْجعها؛ لا ترى ما بأخيها» فقال لها: يا أُمَّه! إنَّ رسول الله (ص) يأمرك أن ترجعي، قالت: ولِمَ؟ وقد بلغني: أنَّه قد مُثِّلَ بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبنَّ، ولأصبرنَّ إن شاء الله.
فلـمَّا جاء الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك، قال: «خَلِّ سبيلها» فأتته، فنظرت إليه، فصلَّت عليه، واسترجعت، واستغفرت له. [سبق تخريجه].
ب - حَمْنَةُ بنت جحش رضي الله عنها:
لـمَّا فرغ رسول الله (ص) من دفن أصحابه رضي الله عنهم، ركب فرسه، وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة، فلقيته حَمْنَةُ بنت جحشٍ، فقال لها رسول الله (ص) : يا حمنةُ! احتسبي! قالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: أخاك عبدَ الله بن جحشٍ، فاسترجعت، واستغفرت له، ثمَّ قال لها رسولُ الله (ص) : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن عبد المطَّلب، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئاً له الشهادة. ثمَّ قال لها: احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجُك مصعب بـن عُمَيْرٍ، قالت: واحزنـاه !
وصاحت، ووَلْوَلَتْ. فقال رسول الله (ص) : «إنَّ زوج المرأة منها لبمكانٍ»؛ لمَا رأى من تَثَبُّتِها عند أخيها، وخالها، وصياحها على زوجها. [ابن ماجه (1590)، والطبري في تاريخه (2/532)، والبيهقي في الدلائل (3/301)، وابن هشام (3/104)]. ثمَّ قال لها: ولِمَ قلتِ هذا؟ قالت: يا رسول الله! ذكرت يُتْمَ بنيه، فراعني، فدعا لها رسول الله (ص) ، ولوَلدِها أن يحسن الله تعالى عليهم من الخَلَفِ، فتزوَّجت طلحةَ بن عبيد الله، فولدت منه محمَّداً، وعمران، وكان محمَّد بن طلحة أوصل النَّاس لولدها.
ج - المرأة الدِّينارية رضي الله عنها:
قال سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: مرَّ رسول الله (ص) بامرأةٍ من بني دينار، وقد أُصيب زوجُها، وأخوها، وأبوها مع رسول الله (ص) بأُحدٍ، فلـمَّا نُعُوا لها؛ قالت: فما فعل رسولُ الله (ص) ؟ قالوا: خيراً يا أمَّ فلان! هو بحمد الله كما تحبِّين، قالت: أَرُونيه حتَّى أنظرَ إليه، فأُشير لها إليه، حتَّى إذا رأته؛ قالت: كلُّ مصيبةٍ بعدَك جَلَلٌ. [الواقدي في المغازي (1/292)، والطبري في تاريخه (2/533)، والبيهقي في الدلائل (2/302)، وابن هشام (3/105)].
ـ تريد: صغيرةٌ -. وهكذا يفعل الإيمان في نفوس المسلمين!
د - أمُّ سعد بن مُعاذٍ، وهي كبشةُ بنت عبيد الخزرجيَّة رضي الله عنها:
خرجت أمُّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسولِ الله (ص) ، ورسولُ الله (ص) واقفٌ على فرسه، وسعد بن معاذ اخذٌ بعنَانِ فرسه، فقال سعد: يا رسول الله! أمِّي! فقال رسول الله (ص) : مرحباً بها، فدنت حتَّى تأمَّلت رسولَ الله، فقالت: أما إذ رأيتك سالماً؛ فقد أشوت المصيبة، فعزَّاها رسول الله (ص) بعمرو بن معاذٍ ابنها، ثمَّ قال: يا أمَّ سعد! أبشري، وبشِّري أهليهم: أنَّ قتلاهم قد ترافقوا في الجنَّة جميعاً - وهم اثنا عشر رجلاً - وقد شُفِّعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثمَّ قالت: ادعُ يا رسولَ الله! لمن خُلِّفوا. فقال رسول الله (ص) : « اللّهُمَّ أذهب حُـزن قلوبهم، واجْبُـرْ مصيبتهم، وأحسن الخَلَفَ على من خُلِّفُوا». [مغازي الواقدي (1/315 - 316)].
يمكن النظر في كتاب السِّيرة النَّبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث
على الموقع الرسمي للدكتور علي محمّد الصّلابيّ