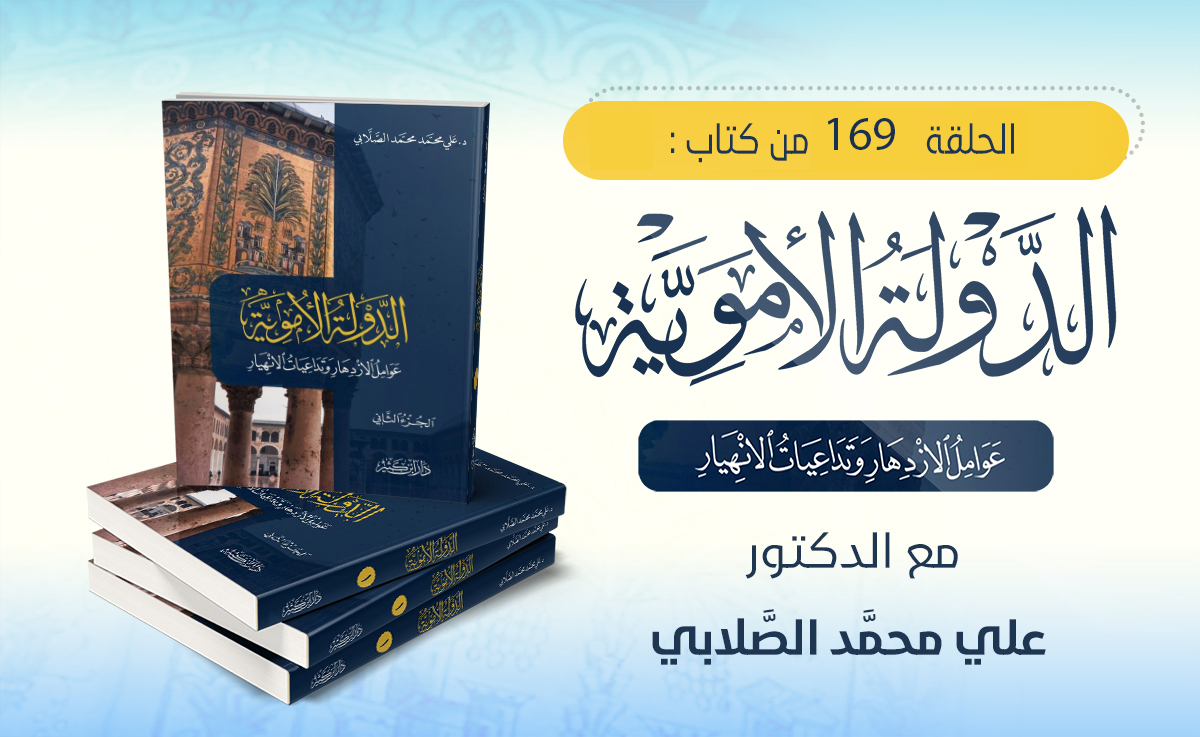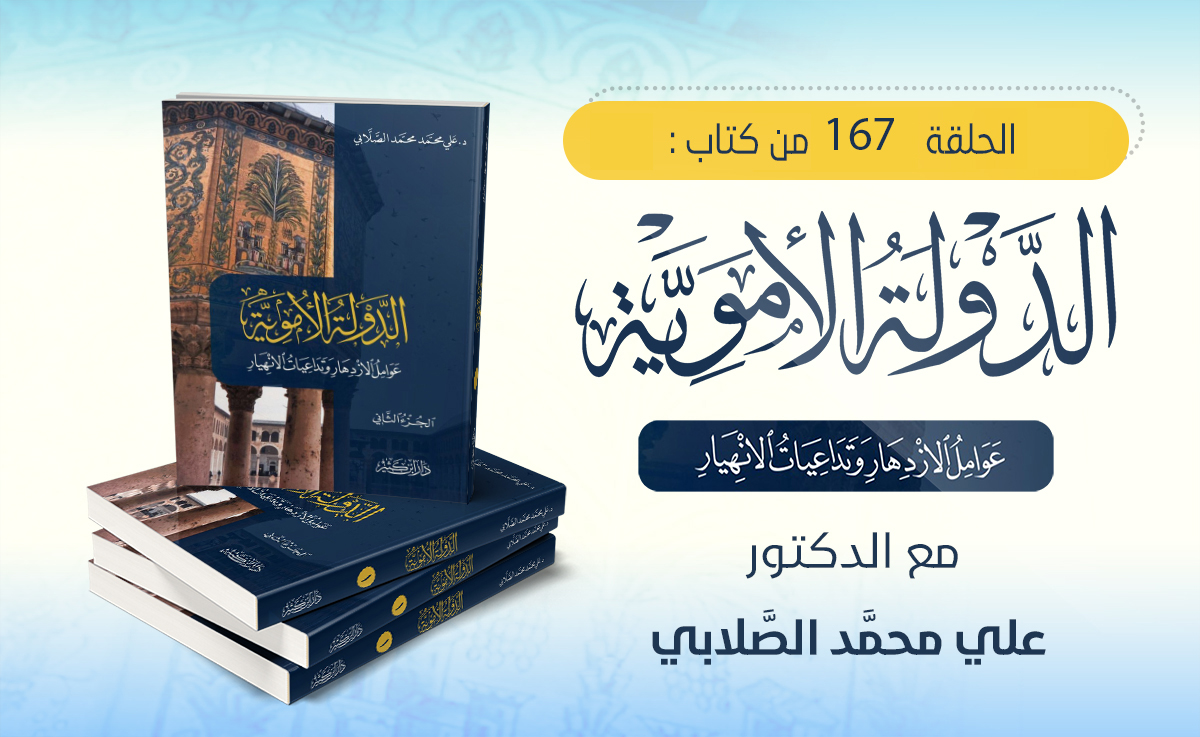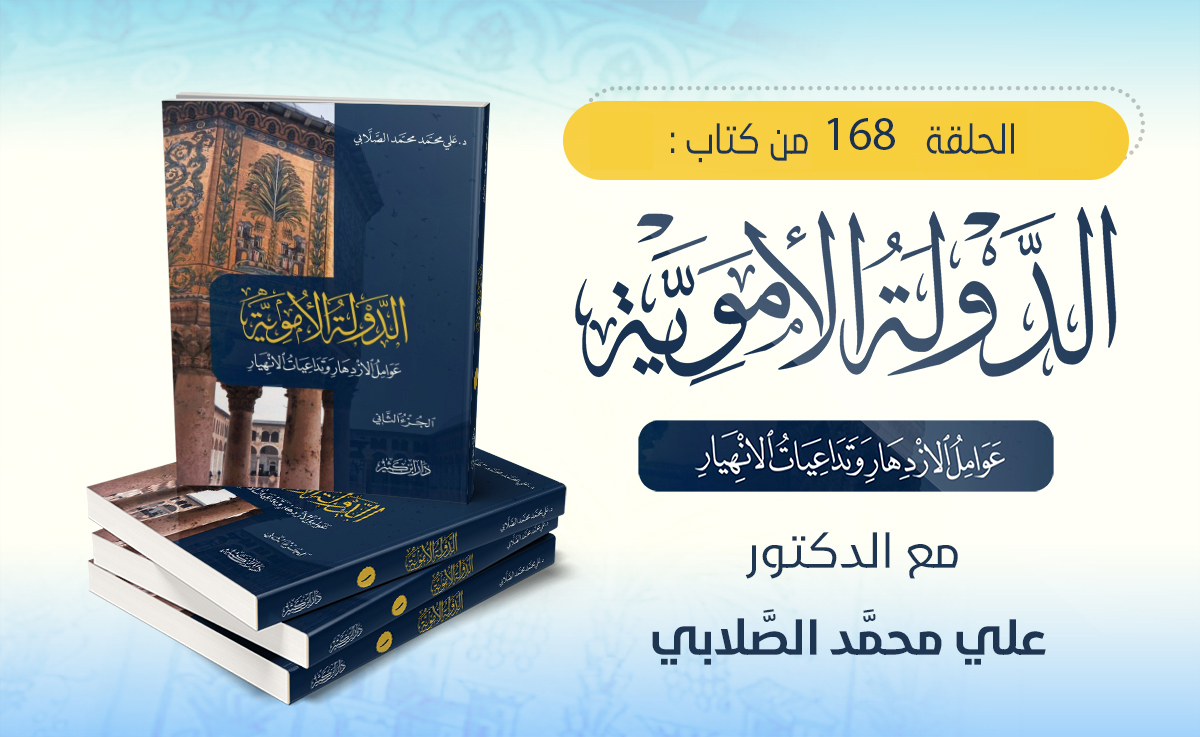منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم:
من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):
الحلقة: 169
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
رجب 1442 ه/ مارس 2021
سلك التابعون منهاجاً واضحاً في تفسير القران الكريم، فكانوا يفسرون القران بالقران، والقران بالسنة، والقران بأقوال الصحابة، واللغة العربية، والاجتهاد وقوة الاستنباط.
1 ـ تفسير القران بالقران:
تعددت طرق التابعين في تفسير القران بالقران؛ ومن هذه الطرق:
أ ـ نظائر القران الكريم:
كتفسير الآية بآيـة أخرى تحمل الموضوع نفسـه وإن اختلف اللفظ، وقـد أكثر التابعون من ذلك، ومن ذلك: ما ورد عن مجاهد في تفسير الكلمات في قوله تعالى :{فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ } [سورة البقرة:37] قال: قوله: {قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا} [الأعراف: 23]. حتى فرغ منها .
وجاء عن عكرمة، والحسن في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً *} [الإسراء: 110]. قال: وكان رسول الله ﷺ إذا صلى يجهر بصلاته، فآذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه، فلذلك قال: : {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً *} .
وقال في الأعراف: : {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ *} [الأعراف: 205]. وفي تفسير قوله تعالى: { * قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الْدَّارُ الآخرة عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * } [البقرة: 94].قال قتادة: وذلك أنهم قالوا: { لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى }[البقرة: 111]. وقالوا: { َحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ } [المائدة: 18]. فقيل لهم:{فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *}[البقرة: 94].
ب ـ الأشباه:
والمراد بالأشباه تفسير الاية بما يشبهها من الايات؛ كتفسير الاية بالايات التي تحمل بعض معناها مع تقارب اللفظ ، فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس بالغير، فإنه قال في تفسير قوله تعالى: {لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا} [النور: 12]. قالوا لهم خيراً ، ألا ترى أنه يقول: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] ؟ يقول: بعضكم بعضاً، و {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61]. قال: يسلم بعضكم على بعض. ففسر مجاهد هنا النفس بالغير ، واستدل بورود ذلك في ايات متشابهة في القران تدل على هذا الجزء من المعنى .
جـ الدلالة على التفسير بالسياق:
وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم سياق الاية فيربطها بما قبلها، أو بما بعدها سواء كان ذلك في الاية نفسها، أو في مجموعة من الايات، مثل تفسير قوله تعالى: هي {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ} [الأنعام: 83]. قال مجاهد في تفسيرها: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]
هـ بيان المجمل:
وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في ايات القران التي فيها إجمال، وينظر في الايات الأخرى التي يمكن أن تكون بياناً لهذا الإجمال، كحمل المجمل على المبين، ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: {خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا*} [نوح: 41]: قال: من تراب ، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم ما ذكر حتى يتم خلقه . فأشار بقوله إلى الايات التي فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ *}[المؤمنون: 12 ـ 14].
و ـ تفسير العام بالخاص:
وفي هذا يعمد المفسر منهم إلى اية ظاهرها العموم فيحملها على معنى اخر ذكرت فرداً من أفراد العموم ، كقوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]. قال الحسن البصري: الكافر ، ثم قرأ: {وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ*} قال: من الكفار.
وفي رواية عنه قال: {وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ *} يعني الفار، لا يعني بذلك أهل الصلاة . فالاية الأولى جاء فيها العموم في لفظة (من) ليعم المؤمن والكافر، فجاء الحسن فبين أنها خاصة بالكافر مستدلاً بأسلوب الحصر في الآية الثانية . وأصرح من ذلك ما جاء عنه في تفسير الاية نفسها أنه قال: [النساء: 123] إنما ذلك لمن أراد الله ، فأما من أراد كرامته، فإنه من أهل الجنة [الأحقاف: 16]
ز ـ التفسير باللازم:
المراد بالتفسير باللازم أن المفسر لا يذكر صراحة تفسيراً للاية التي هو بصددها، بل يذكر شيئاً من لوازم ذلك، ويربطه باية أخرى، فمن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى :{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } [البقرة: 156]، فقد قال: لو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب، ألم تسمع: { يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ } [سورةيوسف:84]. أنه لم يكن يعرف { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *}، وإلا لقالها، بدلاً من تأسُّفه على ذهاب يوسف.
ح ـ توضيح المبهم:
ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون ـ أيضاً ـ: إيضاح مبهم اية باية أخرى لإزالة الإبهام ، ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع في لفظة (الحين) استدل بالاية التي تبين أن المراد منه سنة؛ فعنه أنه قال: أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباس: إني حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناً، فما الحين الذي تعرف به؟ قلت: إن من الحين حيناً لا يدرك، ومن الحين حيناً يدرك، وأما الحين الذي لا يدرك فقول الله: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا *} [الإنسان: 1]. واللهِ يدري الإنسان كم أتى له إلى أن خلق، وأما الذي يدرك فقوله: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25] ؛ فهو بين العام إلى العام المقبل، فقال: أصبت يا مولى ابن عباس، ما أحسن ما قلت .
ط ـ بيان معنى (لفظ)، أو إيضاح مشكلة:
وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين، فصاروا يتناولون ايات القران بالتفسير بايات أخرى تبين هـذا المعنـى، وتلكم الألفـاظ ، ومثـال ذلك كتفسير الحـسن البصري {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ *تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ *} [النازعات: 6 ـ 7]. قال: النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانيـة فتحيي الموتـى، ثم تلا الحسن: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } [الزمر: 68]. والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقران بالقران، ومن أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين.
2 ـ تفسير القران بالسنة:
لا شك أن السنة مبينة للقران موضحة له، قال الشاطبي: وهي راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله، وبسط مختصره ، وذلك لأن النبي ﷺ هو أعلم بكلام الله وأكثر قدرة على فهم نصوص الايات من غيره مع ما أوحاه الله تعالى إليه من المعاني، فهو ﷺ:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[النجم: 3 ـ 4]، وقال ﷺ: «ألا إني أوتيت القران ومثله معه».
يقول ابن تيمية: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القران بالقران... إلى أن يقول: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقران وموضحة له، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه من القران، قال تعالى: {إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥} [سورة النساء:105] . وقال تعالى: {وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤} [سورة النحل:44] . وقال تعالى: {وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤}
[سورة النحل:64]
وقد اتفق العلماء على أن الأخذ بالسنة واجب، والعمل بها حتم، وتحكيمها فرض، بل جاء عن مكحول التابعي أنه قال: القران أحوج إلى السنة، من السنة إلى القران.
وقد كثر عن التابعين النقول التي تدل على شدة متابعتهم للسنة، قال ربيعة للزهري: إذا سُئلت عن مسألة فكيف تصنع ؟ قال: أحدِّث فيها بما جاء عن النبي ﷺ؛ فإن لم يكن عند النبي ﷺ فعن أصحابه، فإن لم يكن عند أصحابه اجتهدت رأيي .
ومما يدل على عظيم احتفائهم وعنايتهم بالمروي عنه ﷺ: أنه قل أن نجدهم يخالفون ما صح عنه ﷺ من تفسيره، وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة على ذلك:
أ ـ فمن هذا ما جاء عنه ﷺ في تفسير قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *} [الفاتحة: 7]. قال ﷺ: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال» . وبذلك فسرها: مجاهدٌ ، وسعيد بن جبير وغيرهما. قال ابن حاتم: لا أعلم خلافاً بين المفسرين في تفسير { المغضوب عليهم } باليهود، و {ولا الضالين } بالنصارى
ب ـ ومنه أيضاً ما صح عنه ﷺ في بيان قوله تعالى: [البقرة: 187]. {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ﷺ: «هو سواد الليل وبياض النهار»، ولم يخالف في ذلك أحد من التابعين، وبه قال الحسن ، وقتادة .
جـ من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي ورد في قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ } [سورة الأنعام:82] . قال ﷺ حين شق ذلك على أصحابه فقالوا: أيُّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلك، ألم تسمعوا قول لقمان : {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ *} [لقمان: 13] ». وهذا هو المنقول عن التابعين قال به إبراهيم النخعي، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير .
د ـ ومنه ما جاء عنه ﷺ في تفسيره للسبع المثاني في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ*} [الحجر: 87]. قال ﷺ لأبي سعيد بن المعلى: «ألا أعلمك أعظم سورة في القران قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي ﷺ ليخرج، فذكرته، فقال: «الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقران العظيم الذي أوتيته» . وهذا التفسير هو المروي عن سعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة .
هـ ومن ذلك: بيانه ﷺ لمعنى: الأمة الوسط، التي وردت في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]. ففي الحديث عن ﷺ في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } قال: «عدُولاً» وبهذا التفسير قال مجاهد ، وعطاء وقتادة ، هذه بعض الأمثلة التي اعتمدها التابعون في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية .
3 ـ تفسير القران بأقوال الصحابة:
إن التابعين ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة، وكذلك الاجتهاد، ونحو ذلك إلا بسبب تربيتهم على أيدي الصحابة وخبرتهم بمناهجهم الاستدلالية، وتعلمهم لطرق الاستنباط وتلقيهم الرواية النبوية، ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله، ولقد استوعب التابعون رسالة الصحابة وعرفوا فضلهم، فها هو مجاهد يقول: العلماء أصحاب محمد ﷺ ، وكان التابعون يقدمون قول الصحابي على قولهم؛ يقول الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شيئاً حتى يشاور، فقال أشعث ـ راوي الأثر ـ: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره . وكان منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة يدور حول:
أ ـ إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي ﷺ، فهذا هو المطلب الرئيس، والغاية القصوى، وليس بعده قول، وكذلك ما كان من تفسير الصحابي، وهو وارد في سبب النزول بالصيغة الصريحة، وكذلك فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا يقفون عنده لا يجاوزونه، لأن الصحابي شاهد التنزيل، ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ *} [الأنعام: 61]. فقد قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: إن لملك الموت أعواناً من الملائكة. رواه عنه إبراهيم . ولذا جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن عباس، ولم يزد عليه شيئاً، فقال: أعوان ملك الموت ، وكذا جاء عن قتادة، ومجاهد، والربيع .
ب ـ وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابي من باب الاجتهاد، وجارياً على مقتضى اللغة، فإنهم في الغالب لا يخالفونه، فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم، ولأجل ذلك اعتمد مجاهد تفسير ابن عباس دون غيره عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} [الأنعام: 98]. فقد قال ابن عباس: المستقر بالأرض، والمستودع عند الرحمن. وجاءت رواية عن ابن عباس: أن المستقر في الرحم، والمستودع في الصلب ، موافقة للرواية الثانية لشخصية أخرى، وهكذا كان حال ابن جبير في تفسير الاية .
جـ إذا تعارضت الأقوال المنقولة عن الصحابة، فإن التابعين يسلكون مسلك الترجيح بينها، والترجيح قد يكون باللغة، أو بالحديث، أو بقول صحابي اخر يجمع بين الأقوال، فمن الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ } [سورة الإسراء:78] . جاء عن ابن عباس في تفسيرها أن دلوكها غروبها وجاء عنه أن دلوكها : زيغها بعد نصف النهار وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها , وجاء عنه أيضا أن دلوكها ميلها يعني : الزوال . فاختار قتادة أن دلوكها زوالها ، ففسرها به ، مع انه نقل القول بغروبها عن ابن مسعود ، ولعل سبب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل ، فيكون المراد صلاة الظهر، ورجحه ابن جرير ، وناقش الأول .
وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع، ومنه ما جاء عن قتادة وهو يحدث عن سعيد بن المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه ، فرجح الحسن أنها صلاة العصر ، متابعاً في ذلك عدداً من الصحابة رضي الله عنهم، والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذي رواه الحسن عن سمرة: أن النبي ﷺ قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» .
وقد يكون الترجيح بقول صحابي اخر يقدَّم به عموم الاية على ما ورد في خصوصها، ويجمع به بين الأقوال، فمن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: {إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١}[سورة الكوثر:1] . فقد جاء تفسير الكوثر عن جمع من الصحابة أنه نهر في الجنة ، وعن ابن عباس : أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ، وتابعه على ذلك سعيد بن جبير ، فقال أبو بشر لسعيد : إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه ، فهنا رجح ابن جبير العموم في الآية مستندا لقول ابن عباس ، ولم يذهب إلى الخصوص في الأثر الوارد في ذلك ، أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في ذلك ، فعندئذ يدخل منهم من يدخل في باب الاجتهاد .
وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في التفسير إلى ظهور نتائج واثار ترتبت على ذلك؛ منها: حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحوالهم والتمييز بينهم، والالتزام بمناهجهم والإفادة منها، وتبني أقوالهم .
4 ـ اللغة العربية:
لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدراً من مصادر التفسير؛ وذلك لعدة أسباب؛ منها: معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم، والإلمام بأشعار العرب، ومعرفة فقه اللغة من الاشتقاق، والإيجاز والحذف، والتقديم والتأخير، وغير ذلك من الأسباب .
5 ـ الاجتهاد:
ظهرت اجتهادات التابعين في التفسير، حتى إبان عهد الصحابة، وشملت اجتهاداتهم مواطن كثيرة، غالبها مما سكت عنه الصحابة؛ ومن أهمها:
أ ـ بيان المراد من النص، وذلك إذا كان النص خفيَّ الدلالة بسبب إجمال في اللفظ أو التركيب.
ب ـ استنباط بعض الأحكام من النصوص القرانية.
جـ بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات، والمعاني، والتفسير بين النظائر.
د ـ العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز، كمباحث عد الايات، والكلمات في القران الكريموغيرها.
وقد كان لاجتهاد التابعين في تفسير الايات مميزات منها:
ـ تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها.
ـ الإيجاز غير المخلِّ.
ـ عمق التأمل ودقة التفسير.
ـ قوة الاستنباط.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf
الجزء الثاني:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC139.pdf
كما يمكنكم الاطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com