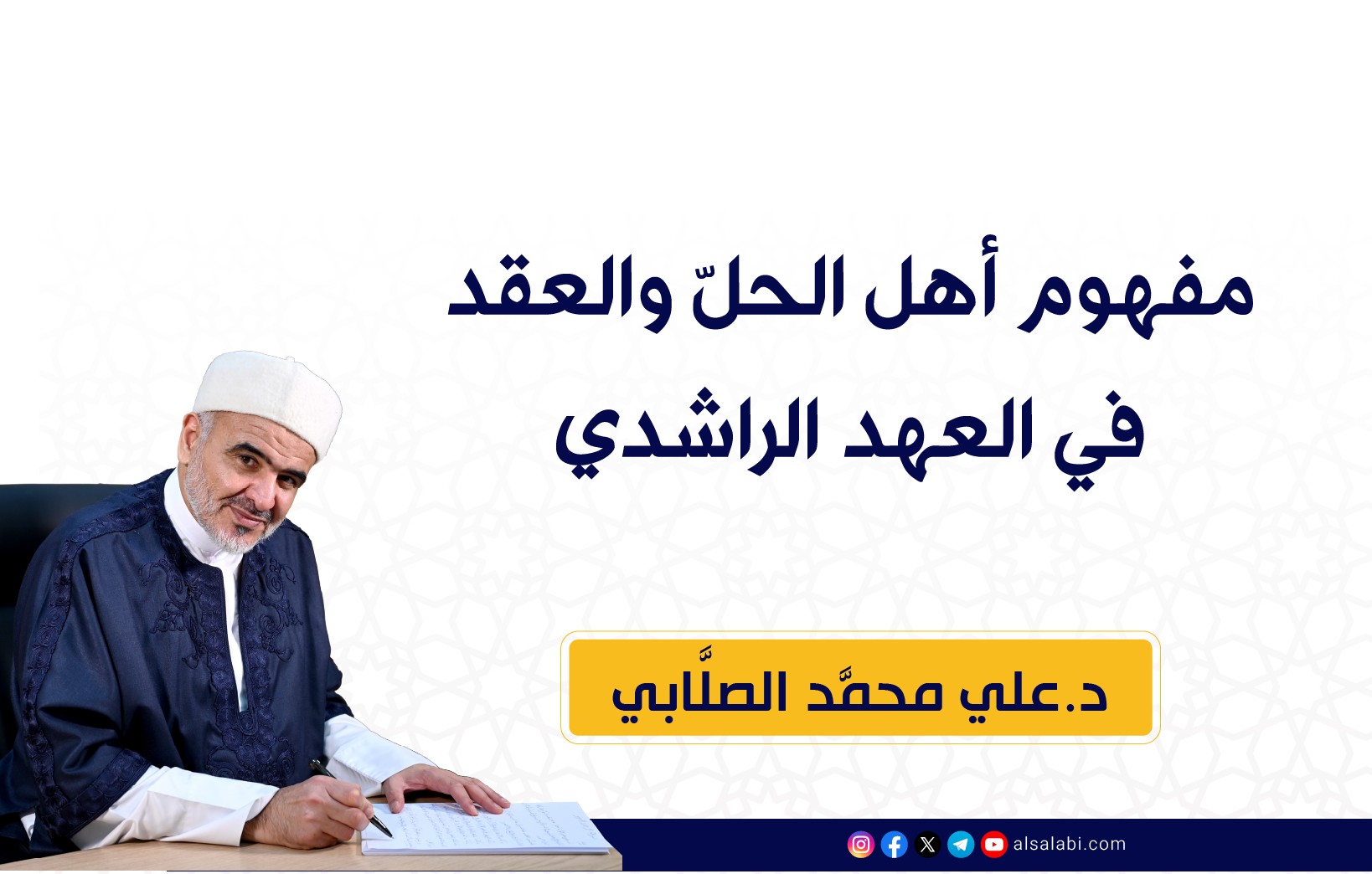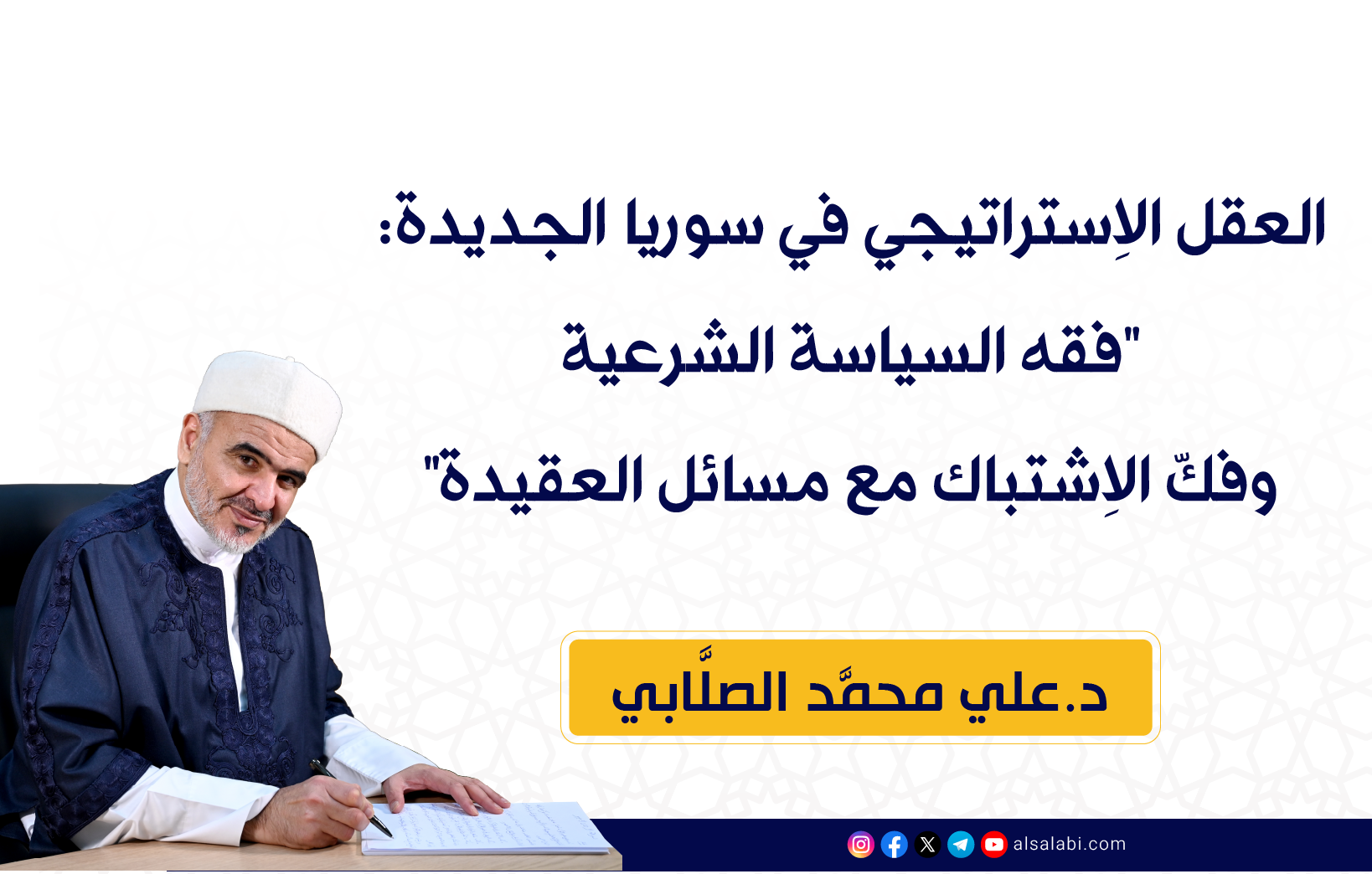مفهوم أهل الحلّ والعقد في العهد الراشدي
بقلم: د. علي محمد الصلابي
يشكّل مفهوم أهل الحلّ والعقد إحدى أهمّ القضايا في الفكر السياسي الإسلامي، إذ يجمع بين الجذور الشرعية في التجربة الراشدة وبين الإشكالات التاريخية التي رافقت تطوره وعدم تفعيله عمليًّا. ولا بدّ من تسليط الضوء على أبعاد هذا المفهوم، وواقع حضوره في نظم الحكم التقليدية والمعاصرة، وكيفية مواءمته لحقوق الأمة وشرعية السلطة وضمان العدل، بما يخدم بناء دولة حديثة تستلهم قيم الإسلام ومقاصده.
ومصطلح أهل الحل والعقد هو مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، وتاريخي من جهة أخرى، فالفكرة لا تعدم أصولاً شرعية يمكن تأسيسها عليها، وتسويغها بها، خاصة من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك ما يمنع شرعاً، فهي تمثل إحدى الصيغ التنظيمية الناجعة في مجال الحكم والسياسة، ولكنها على كل حال ليست منصوصة لا باسمها، ولا بهيئتها.
والمشكل في فكرة أهل الحل والعقد يكمن في أمرين:
الأول: هو أنها لم تؤخذ مأخذ الجد، ولم توضع موضع التنفيذ، ولم توضع لها صيغة تنظيمية ملزمة، فبقيت محصورة في أذهان الفقهاء ومؤلفاتهم وتمنِّياتهم، وفي أحسن الأحوال قد يوجد نوع من أهل الحل والعقد، ولكن أمرهم كله إلى الحاكم نفسه بما في ذلك اختياره لهم، واختياره بين استشارتهم وعدمها، واختياره بين اتباع مشورتهم وعدمها، بمعنى أن الحل والعقد كله بيد السلطان، لا بيد أهل الحل والعقد.
الثاني: هو أن فكرة أهل الحل والعقد اتخذها بعض الحكام وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها، واستبعاد أي أثر لها في تدبير شؤونها، فبدل أن تطبق الفكرة، وتكون هي التعبير المنظم عن إرادة الأمة، أصبحت مجرد حجة نظرية تلغي بمقتضاها الأمة، بدعوى أن أهل الحل والعقد يقومون مقامها، بينما الحاكم بأمره هو الذي يقوم مقام الجميع، وهنا لابد من التذكير والتأكيد بأن اختيار الخليفة أو الإمام هو في الأصل من حق الأمة قاطبة، وهي تمارس هذا الحق بحسب الاستطاعة والإمكان لكل زمان ومكان، وعلى هذا مضت سُنَّةُ الخلفاء الراشدين.
فعند اختيار الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، كان اجتماع السقيفة مفتوحاً لكل من حضر من المسلمين، ولم يقل أحد: إن الاجتماع خاص بفلان وفلان، أو خاص بهؤلاء، بل حضره من شاء، وتكلم فيه من شاء، ومن ذلك وجد من الناس من اعتبر بيعة أبي بكر فلتة، نظراً للفجائية والسرعة التي تمت بها، فرد عليهم عمر رضي الله عليهم بقوله الحاسم: «فلا يَفْترنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» ثم أعلن قراره الدستوري التاريخي بقوله: من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا[(1)].
وعندما مرض أبو بكر أخذ يشاور، حتى اطمأن إلى تطلع الناس جميعاً إلى عمر، ورغبتهم فيه، ورضاهم، فعهد إليه، ثم بايعه الناس.
وفي تولية الخليفة الثالث، وما جرى فيها من الموازنة والترجيح بين المرشَّحين: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، قال ابن كثير: ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم، جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى ومجتمعين، سراً وجهراً، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرِد من الركبان والأعراب إلى المدينة، في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب، ثم بايعا مع الناس[(2)].
وأهل الحل والعقد لابد منهم، ولا غنى عنهم، وهم إما أن يكونوا من علماء الشريعة المبينين لمقتضياتها، الأمناء على حكامها، أو من أهل المعارف والخبرات التي لا غنى عنها، وإما أن يختارهم الناس ليكونوا نواباً عنهم إن كانوا من أهل الزعامة والمكانة في المجتمع، وفي جميع أحوالهم، فهم ليسوا مجرد أصداء أبواق أو عيون للحكام، وهذا يقتضي أن لا يكون له يد عليهم، لا في اختيارهم، ولا في رواتبهم، ولا في عملهم، وحتى إذا كان أهل الحل والعقد على هذا النحو، فإن وجودهم لا يلغي الأمة، ولا يلغي دورها وحقها في تقرير ما تريده من اختياراتها ومصالحها، متى أمكنها ذلك[(3)].
فالحق للأمة، فهي الأصل، وهي أحد طرفي العقد، والحاكم هو الوكيل والنائب عنها، وليس الحكم تفويضاً إلهياً، والبيعة عقد تراضٍ لا إذعان فيه باتفاق السلف المتقدمين، وليست الوكالة نسخاً للحق الأصلي، ولا عقداً مؤبداً لا يعترضه فسخ؛ ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». وقال عمر: «الخلافة شورى». وقال علي: «إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين». ولذا كان من حق الأمة أن تبايع بيعة مشروطة بوقت أو بفعل، كما اشترط الصحابة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إقامة القصاص، وكما اشترط عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعلي أن يعملا بالكتاب والسنة وسيرة الخليفتين، وفي الحديث المشهور: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلَّ حراماً»[(4)].
ولأصحاب الحق الأصلي أن يحدّدوا العقد بمدة معينة، كما يقع في بعض الدساتير بأربع أو خمس أو ست سنوات، وبابه المصلحة المرسلة والمشارطة، ومدار ذلك على تحقيق العدل[(5)].
ومن التعاريف الجامعة المانعة لأهل الحل والعقد: هم نخبة المجتمع الإسلامي من النواحي الإيمانية والجهادية والعلمية ؛ الذين أبلوا البلاء الحسن في نصرة الدين ونشره، وتطوير المجتمع من جهة تدينه وعلمه، وشهد لهم بذلك المجتمع فبوأهم موقعاً طليعياً ليقرروا بحكمتهم ووعيهم في مختلف الشؤون العامة، وعلى رأسها اختيار الحكام، وشكل أهل الحل والعقد مجلس الشورى الإسلامي، وقد يصح أن يجري انتخابهم بطريقة الانتخاب الحر المباشر من قبل أفراد الشعب كافة[(6)].
المصادر والمراجع:
ـ[1] البخاري، نقلاً عن فقه الثورة، أحمد الريسوني، ص 28.
ـ[2] البداية والنهاية، ابن كثير، (7 / 146).
ـ[3] فقه الثورة، أحمد الريسوني، ص 31.
ـ[4] مسند أحمد، رقم 8784.
ـ[5] أسئلة الثورة، سلمان العودة، ص 84.
ـ[6] مدخل إلى الفلسفة السياسية، محمد وقيع الله أحمد، ص 339.