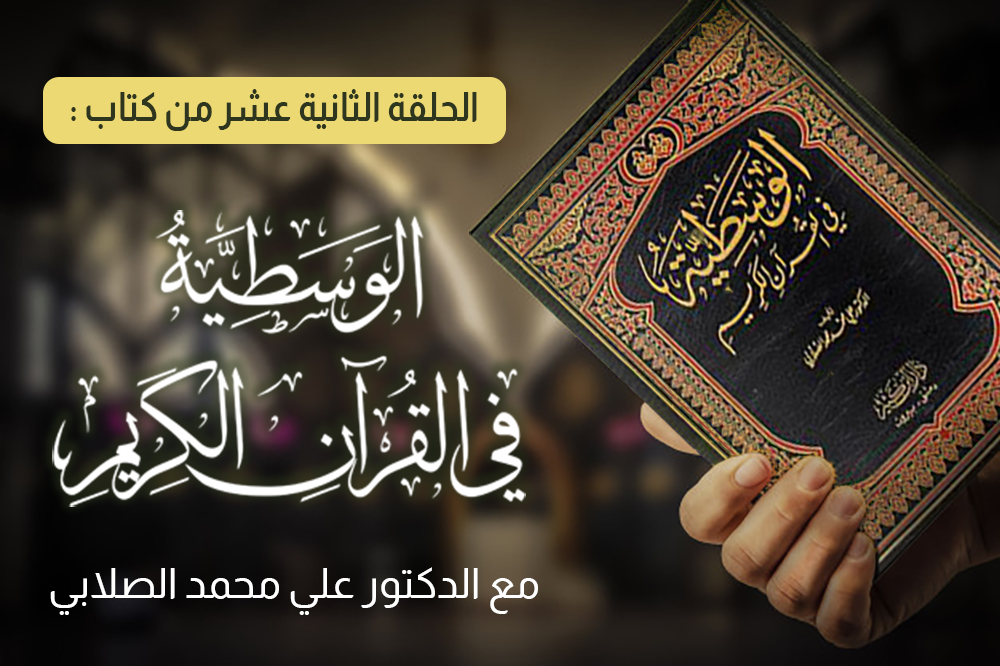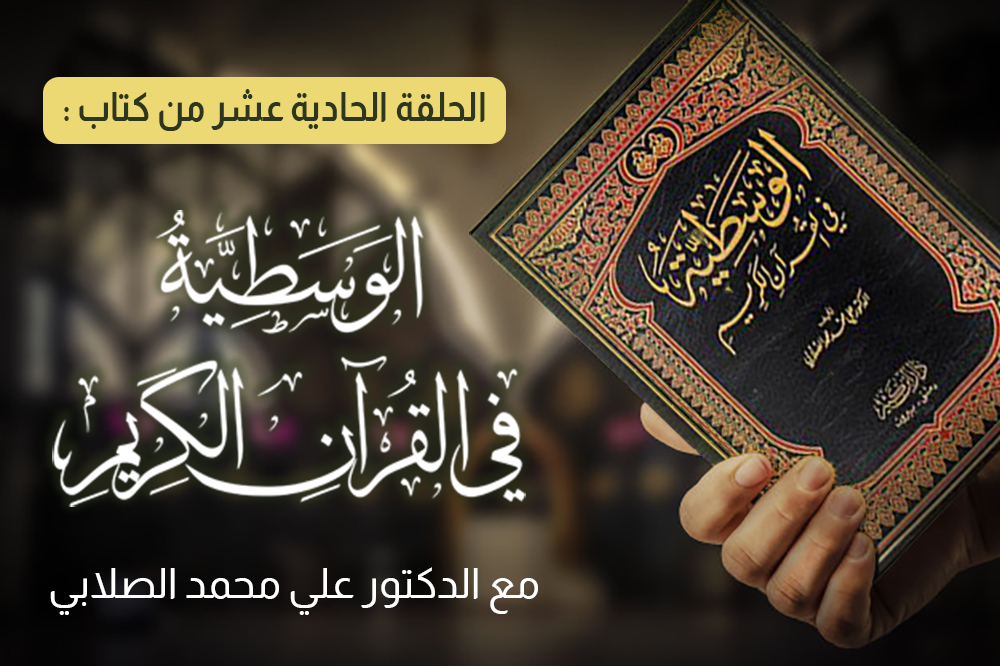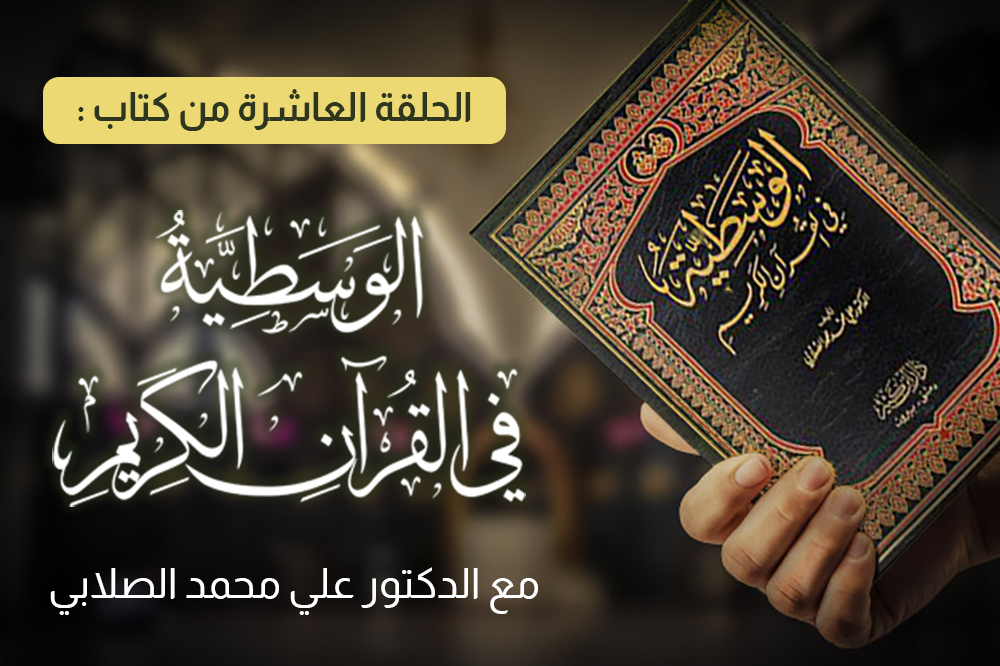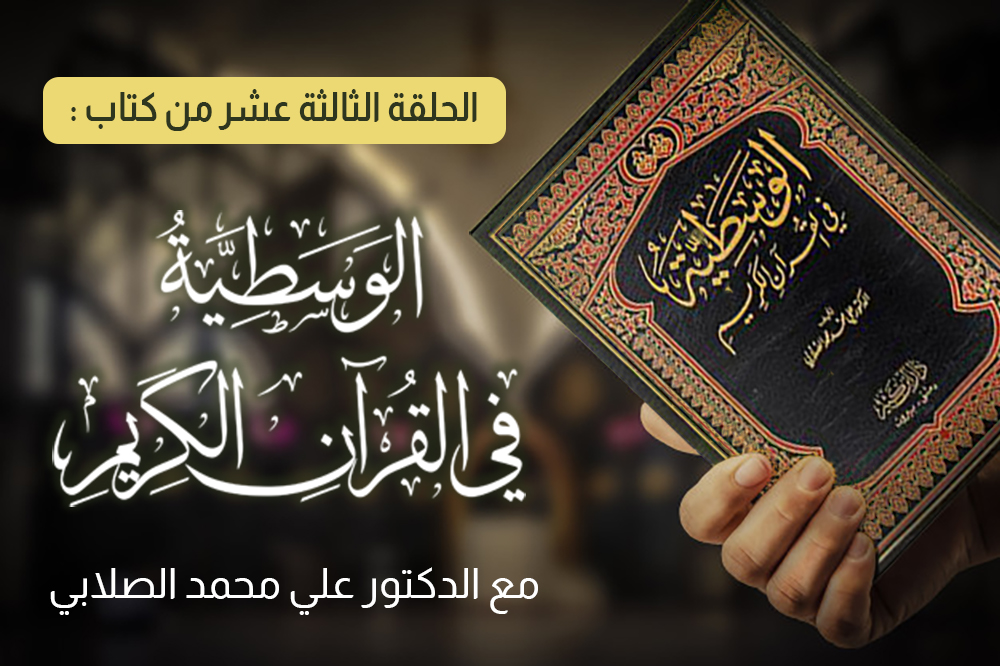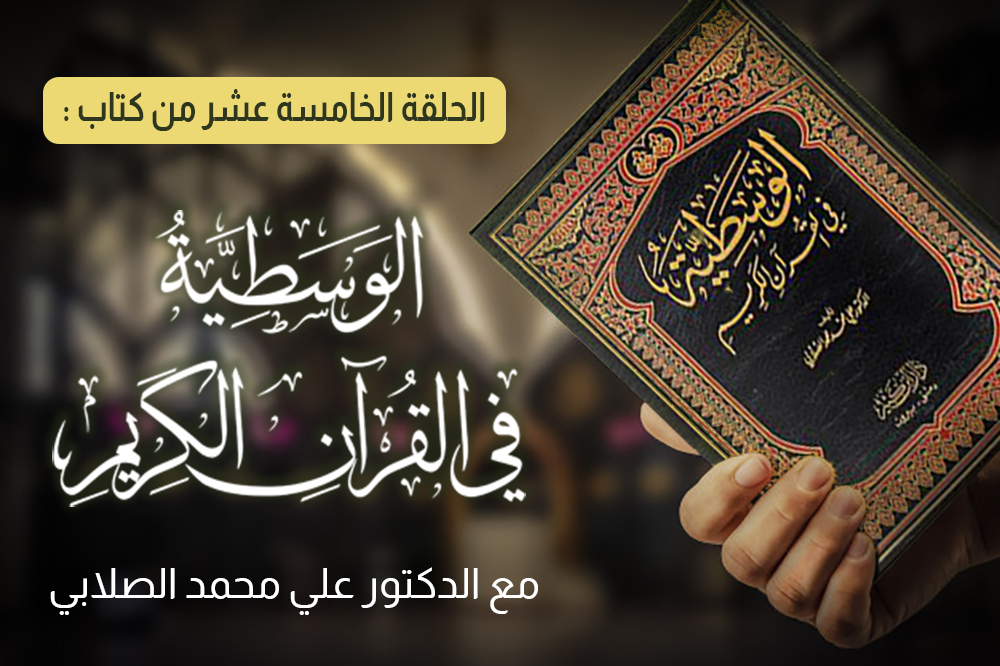من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
(أدلة التيسير والوسع ورفع الحرج من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين)
الحلقة: الثانية عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
وردت آيات كثيرة جدّاً تبين: أن هذا الدين دين يسر، وأنَّ الله قد رفع الحرج عن هذه الأمة فيما يَشُقُّ عليها ؛ حيث لم يكلفها إلا وسعها. وسأبين أدلة التيسير، ثم أدلة رفع الحرج، ثم أدلة عدم التكليف بغير الوسع والطاقة.
1 ـ أدلة التيسير والتخفيف:
قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185] وقال سبحانه: { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا *}[النساء: 28] وقال عزوجل: {وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى} [الأعلى: 8] وقال في سورة الشرح: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } [الشرح: 5 ـ 6] وفي سورة الطلاق: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } [الطلاق: 4] وقال جل من قائل: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا *} [الطلاق:7 ] .
هذه بعض الآيات التي تفيد التيسير على هذه الأمة. قال القاسمي في تفسير آية البقرة : قال الشعبي: (إذا اختلف عليك أمران؛ فإنَّ أيسرهما أقربهما إلى الحق لهذه الأمة).
وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم لهذه الايات: أنَّ الله أراد لهذه الأمة اليسر، ولم يرد لها العسر.
2 ـ أدلة رفع الحرج:
من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:78] .
قال الطبري في تفسير هذه الآية: (جعل الدين واسعاً، ولم يجعله ضيقاً). قال ابن كثير: (أي: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يَشُقُّ عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً، ومخرجاً).
وقال سبحانه: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * [المائدة: 6] وفي سورة التوبة: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}[التوبة:91].
وقال في سورة الأحزاب: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ [الأحزاب: 38] وفي سورة النور:{ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور:61].
وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج عن هذه الأمة، وأنَّ الله لم يجعل في التشريع حرجاً، وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصة في أحكام معينة لكننا نجد التعليل عامّاً، فكأن التخفيف، ورفع الحرج في هذه الأحكام والفروض بإعادة الشيء إلى أصله وهو رفع الحرج عن هذه الأمة، فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص، أو عام فهو معفو عنه رجوعاً إلى الأصل والقاعدة.
3 ـ أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة:
قال سبحانه في سورة البقرة: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} وقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: «قد فعلت»، وكذلك قوله: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}[البقرة:286].
قال الدكتور صالح بن حميد: (والوسع ما يسع الإنسان فلا يعجز عنه، ولا يضيق عليه، ولا يحرج فيه، فقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} أي: لا يحملها إلا ما تسعه، وتطيقه، ولا تعجز عنه، أو يحرجها دون مدى غاية الطاقة، فلا يكلفها بما يتوقف حصوله على تمام صرف القدرة، فإن عامة أحكام الإسلام تقع في هذه الحدود، ففي طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر من خمس صلوات، وصيام أكثر من شهر، ولكن الله جلَّت قدرته، ووسعت رحمته أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بها العسر).
ومن الأدلة على أنَّ التكليف بحدود الوسع والطاقة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *}[الأعراف: 42] ويقول سبحانه في سورة المؤمنون: .{وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}
قال القاسمي: (فسنة الله جارية على أنه لا يكلف النفوس إلا وسعها) وجاء التأكيد على هذه القاعدة عند ذكر بعض الأحكام الفرعية، فقال سبحانه: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة: 233].
وكذلك في سورة الطلاق: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا [الطلاق: 7] وكذلك أيضاً في سورة الأنعام: { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[الأنعام: 152].
هذه هي الآيات التي وردت مبينة: أنَّ التكليف بحسب الوسع والطاقة، لاشك أن الأحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ الطاقة؛ ففي ذلك الدلالة الظاهرة على أن الحرج مرفوع، وأن اليسر سمة هذا الدين، والتوسعة على العباد خاصية من خصائصها، فهي الحنيفية السمحة، والوسطيَّة التي لا عنت فيها، ولا مشقة.
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:
نعت الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بأمته، يعز عليه كلُّ ما فيه مشقة عليهم، قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *} [التوبة: 128] وظهرت شفقته، ورحمته بأمته في السنة النبوية في أقواله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأفعاله، وجميع سيرته، بل كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون قد أمر أمته، أو سلك فيهم طريقاً فيه مشقة، أو إعنات، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن سلوك طريق التعمُّق، والتشدد، وسأبيِّن أحاديث وردت في يسر هذا الدين وسماحته، ورفع الحرج عنه، وأحاديث توضح لنا خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد شقَّ على أمته، وأحاديث في أمر الصحابة بالتخفيف عن التعمُّق، والتشديد، وإنكار ذلك عليهم.
وما سأذكره من أحاديث يبيِّن: أن الدين كله يسر، لا عسر فيه، ولا حرج، وفيه ما يتعرض لقضايا جزئية كبعض أحكام الصلاة، والصيام، ونوافل العبادات، ولاشك: أن كل ذلك يدل بمجموعه دلالةٌ قاطعة على رفع الحرج عن هذا الدين، وبعده عن العسر والمشقة.
أ ـ أحاديث في بيان يسر هذا الدين وسماحته ورفع الحرج عنه:
1 ـ أخرج البخاري في صحيحه تعليقاً: قيل يا رسول الله: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة».
2 ـ أخرج البخاري في صحيحه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ قال لهما: «يسِّرا، ولا تعسِّرا، وبشِّرا، ولا تنفِّرا».
3 ـ وأخرج البخاري في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسدِّدوا، وقاربوا، وأبشروا».
4 ـ روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لم يبعثني معنتاً، ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسِّراً».
5 ـ وفي مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: «إن خير دينكم أيسره! إن خير دينكم أيسره!».
وأهل الكتاب يعلمون: أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث بالتخفيف، واليسر، ولهذا لما زنى رجل منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه بعث بالتخفيف... إلى آخر القصة التي أنكروا فيها الرجم في شريعتهم.
ب ـ أحاديث تدل على خشيته صلى الله عليه وسلم أن يكون قد شقَّ على أمته:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث تدلُّ على شفقته التامة على أمته، وخشيته أن يكون قد جلب عليها ما يعنتها، أو يشق عليها، وتجنبه كل طريق يؤدي إلى ذلك. وإليك بعضاً منها:
1 ـ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح؛ قال: «قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم». وفي الرواية الأخرى: «فتعجزوا عنها».
2 ـ قال صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشقَّ على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك» بل إنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة، ويتجوز فيها ـ وهي قرة عينه وفيها الراحة التي ينشدها ـ رفقاً بحال المؤمنين ومراعاة لضعفهم، وانشغال بالهم، ودفعاً لكل ما يدخل المشقة عليهم.
3 ـ قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم إلى الصلاة؛ وأنا أريد أن أطوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبيِّ، فأتجوز كراهية أن أشقَّ على أمِّه».
والأحاديث في هذا الشأن من باب المثال لا من باب الحصر.
ج ـ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتخفيف، ونهيهم عن التعمق والتشديد، وإنكار ذلك عليهم:
بل كان صلى الله عليه وسلم يتتبع أحوال بعض الصحابة الذين ينسب إليهم ذلك، فينكر عليهم، ويوجههم إلى طريق اليسر والاعتدال، وهذه مجموعة من الأحاديث التي توضح هذا، وتبينه:
1 ـ كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى قومه فأمَّهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل، فسلم ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟! قال: لا والله! ولاتينّ رسول الله فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح ـ وهي الإبل التي يستقى عليها ـ نعمل بالنهار، وإن معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة! فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: «يا معاذ! أفتان أنت؟! اقرأ بكذا»، وفي الرواية الأخرى: «سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والضحى».
2 ـ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ممَّا يطيل بنا. يقول راوي الحديث ـ وهو أبو مسعود الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قطُّ أشدَّ مما غضب يومئذٍ، فقال: «أيها الناس! إنَّ منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس؛ فليوجز، فإن من ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة».
بل قد بلغ الحال ببعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أن أرادوا الأخذ بعزائم الأمور، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان يترخَّص فيه ـ ظنّاً منهم: أنه طريق التقوى والخشية ـ وأن ترخُّصات النبي صلى الله عليه وسلم خاصةٌ به ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.
وكأن هؤلاء القوم فهموا: أنَّ الأخذ بالأشد هو الأتقى، وهو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لهم: أن الطريق الصحيح هو في الاتباع والاقتداء، وأن اتباع اليسر والسهولة، والأخذ برخص الله هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بشرعه، وأشدُّهم له خشية.
3 ـ يوضح ذلك: ما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون؛ قالوا: «إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله! إنَّ الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب؛ حتى يعرف الغضبُ في وجهه، ثم يقول: «إنَّ أتقاكم، وأعلمكم بالله أنا». فهو صلى الله عليه وسلم الجامع للقوَّتين العلمية، والعملية، وعمله ومنهجه هو المنهج المستقيم. وفي هذا الحديث بيان: أن الطريق الصحيح والمنهج السليم هو الوقوف عند ما حدَّده الشارع من عزيمة، أو رخصة، واعتقاد: أنَّ الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له، كما أعلمهم صلى الله عليه وسلم: أنه وإن كان الله قد غفر له؛ لكنه مع ذلك أخشى الناس لله، وأتقاهم فما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة، أو رخصة فهو في غاية التقوى، والخشية، ومن هنا ندرك غضبه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين حاولوا سلوك منهج التعمق، والتشدد ظنّاً منهم: أن ذلك طريق النجاة، وإذاً فلا غرابة أن رأيناه صلى الله عليه وسلم يتعقب الذين يلتزمون التشديد، والأخذ بالأشق.
4 ـ ودخل صلى الله عليه وسلم مرة المسجد؛ فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: «ما هذا الحبل؟» فقالوا: حبل لزينب، فإذا فترت؛ تعلقت به.. فقال صلى الله عليه وسلم: «حلُّوه! ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر؛ فليرقد».
5 ـ وفي السنن عن عقبة بن عامر: أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب». وفي رواية: «إن الله لغني عن مشيها، مروها، فلتركب».
هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته: سلوك الطريق الوسط، واتباع اليسير، وسلوك غير ذلك رغبة في سنة رسول الله ـ فيه الخطر الشديد، والوعيد العظيم المؤدِّي إلى منهج التنطُّع، والإفراط، بل لقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عن التشديد، والتكلف ممَّن التزموا هذا الجانب ما يؤدي بهم إلى الانقطاع، وعدم التمكن من المواصلة، وإهمال حقوق وواجبات للنفس، والأهل، وكل من له به تعلق.
6 ـ فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله! قال: «فلا تفعل، صم، وأفطر، وقم، ونم؛ فإن لجسدك عليك حقّاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقّاً، وإن لزورك عليك حقّاً، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة، أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله»، فشدَّدتُ فَشُدِّدَ عليَّ، قلت: يا رسول الله إنِّي أجد قوة، قال: «فصم صيام نبي الله داود، عليه السلام، ولا تزد عليه». قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: «نصف الدهر»، فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
7 ـ وحينما نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصيام؛ فقال له رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: «وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي، ويسقين»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر؛ لزدتكم! كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي الرواية الأخرى: قيل: إنك تواصل! قال: «إني أبيت يطعمني ربي، ويسقين، فاكلَفوا من العمل ما تُطيقون».
وتوجيهات رسول الله في هذا مما يَجِلُّ عن الحصر في مثل هذا المقام، فالسهولة، والرفق، والأخذ بالأيسر، ومراعاة الأحوال ديدنه صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: فهم الصحابة والتابعين لرفع الحرج في الشريعة:
أ ـ الصحابة:
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفئة الذين اختارهم الله؛ ليشاهدوا تنزُّل الوحي، ويسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله، ويشاهدوا أفعاله، ويأتمروا بأوامره مباشرة، ويسترشدوا بتوجيهاته، ويقتدوا بتطبيقاته، فهم الذين عاشوا عصر النبوة، كما عاشوا الإسلام خالصاً نقيّاً؛ لذا فإن أفعالهم، وأقوالهم نماذج عملية لإرادة تطبيق الإسلام النقي الصافي، وفي هذا المقام سأورد بعضاً مما أُثِرَ عنهم مما يوضح جوانب عملية في التطبيق، والفتوى في العصر الإسلامي الأول بكل ما يتمتع به من سهولة، ويسر.
1 ـ يقول عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في وصف منهج إخوانه من الصحابة، والاقتداء بهم: «من كان منكم مستنّاً فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»، «أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».
ويقول أيضاً: «إياكم والتنطُّع! وإياكم والتعمُّق! وعليكم بالعتيق».
هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو منهجهم: رسوخٌ في العلم، وبُعدٌ عن التكلف، وصلاحٌ في القلوب، ومقاومة للتنطع والتشدد، لقد كانوا على الهدي المستقيم، والطريق الواضح.
2 ـ عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: (كنا عند عمر ـ رضي الله عنه ـ فسمعته يقول: «نُهِينَا عن التكلُّف».
قال الدكتور صالح بن حميد: (هذه الصيغة وإن كان لها حكم المرفوع، غير أنها تدلُّ على أنَّ البعد عن التكلف هو منهج عمر، وغيره من الصحابة) وقد مرَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ في طريق، فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: (يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر، أو نجس؟ فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا. ومضى).
ب ـ التابعون:
نَهَجَ التابعون ـ رضي الله عنهم ـ نَهْجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علماً، وعملاً، وتوجيهاً، وإرشاداً، واقتداءً، ولقد كان من طريقهم البعد عن الشدة والتكلف، والأخذ باليسير من الأمر. وإليك أمثلة من أقوالهم:
1 ـ قال الإمام الشعبي ـ رحمه الله ـ: (إذا اختلف عليك أمران؛ فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق) لقوله تعالى: { يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }[البقرة: 185]
2 ـ وقال معمر، وسفيان الثوري: (إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كلُّ أحد).
3 ـ وقال إبراهيم النخعي: (إذا تخالجك أمران؛ فظنَّ: أن أحبهما إلى الله أيسرهما).
فإن المتأمل لهذه الاثار من الكتاب، والسنة، وأقوال سلف الأمة يلحظ: أن هذا المعنى غائبٌ عن واقع، وفهم كثير من المسلمين، وقليل منهم من يدرك هذه الحقيقة، ويتعامل معها، حيث إنه يوجد هناك من لو سئل عن هذا الأمر لأجاب الإجابة الصحيحة، ولكن عند التأمل في واقعه، وتعامله، والتزامه، ومنهجه؛ لا نجد إلا الإفراط، أو التفريط.
والعجب: أن بعض هؤلاء كأنه أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الله ـ جل وعلا ـ الذي يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }[الحج:78] ويقول تعالى: { يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }[البقرة: 185]ويقول: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا}[النساء:28].
وهذا لا يعني ـ أيضاً ـ التفريط، والتساهل، والتهاون بحجة: أن هذا الدين يسر، والتوسعة إلى الشارع لا إلى أهواء الناس ورغباتهم، وما ألفوه، ودرجوا عليه، فلا إفراط، ولا تفريط، ولا غلو، ولا جفاء (كِلاَ طرفي قصد الأمور ذميم) ثمَّ إنَّ قضية التيسير، والتوسعة قضية منهج متكامل، وليست تتعلق بجزئية، أو جزئيات كما يتصور بعض الناس.
وبهذا التعريف، والشمول ندرك: أن هذا الأمر يندرج في منهج الوسطيَّة، التي هي سمةٌ من سمات هذه الأمة، وخاصية من خصائصها، فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطيَّة إلا إذا فهمنا سمة اليسر، والتوسعة، ورفع الحرج، وإلا؛ تصبح الوسطيَّة معنىً مفرغاً من حقيقته، وقولاً نظريّاً لا وجود له في الواقع، وبذلك يفقد هذا الدين خاصية لها أثرها في حياة الناس، ومالهم.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/29.pdf