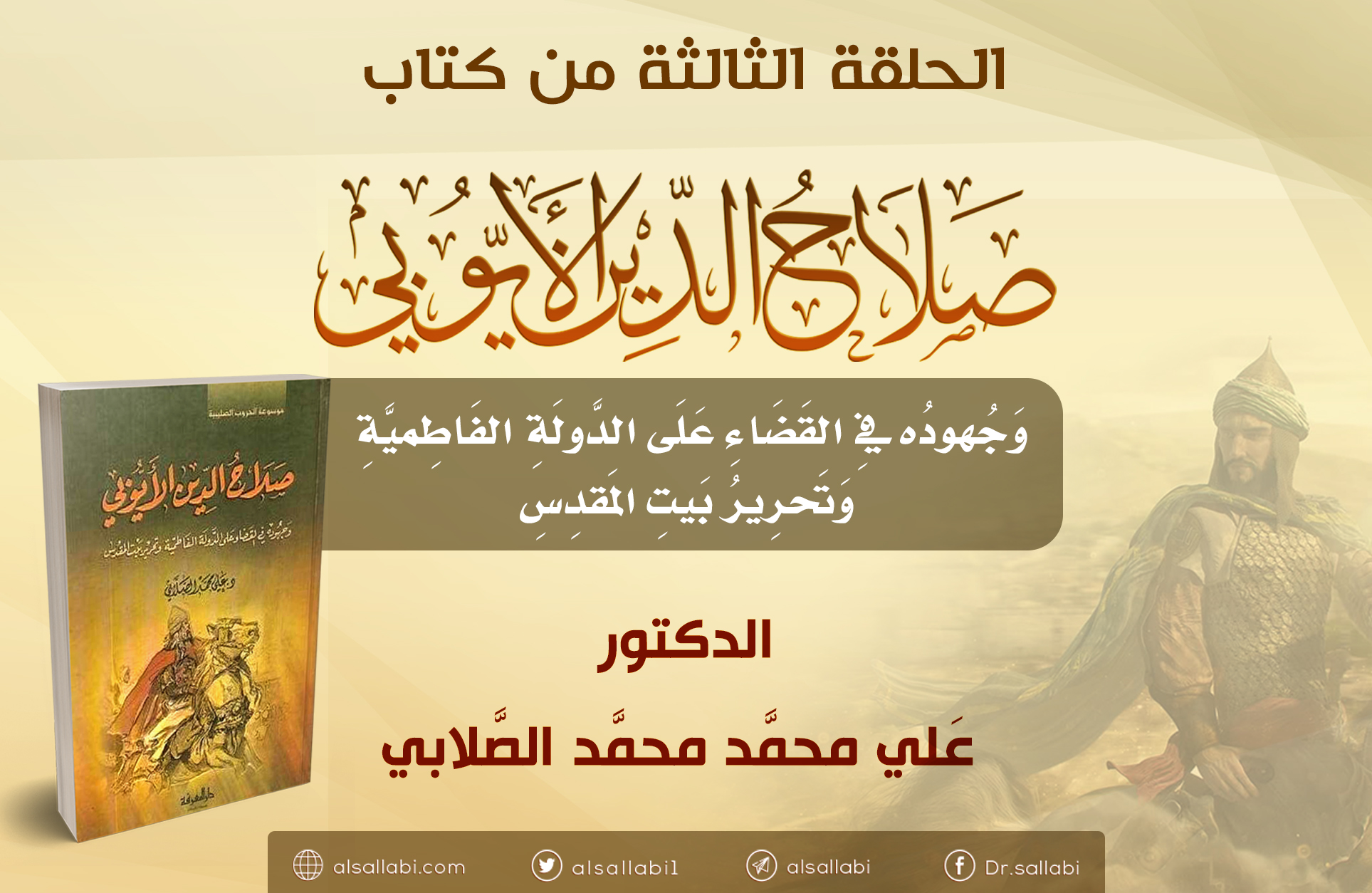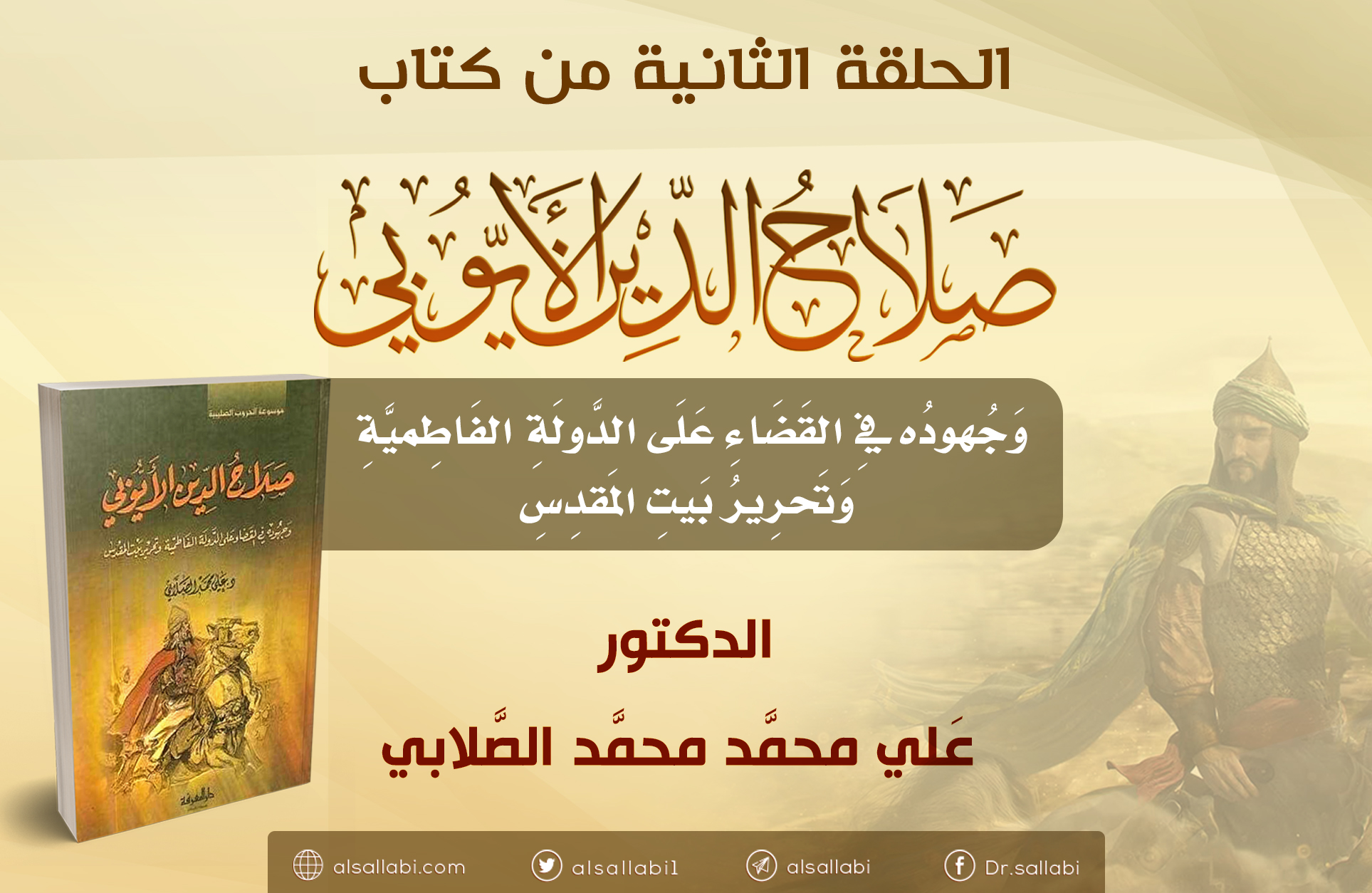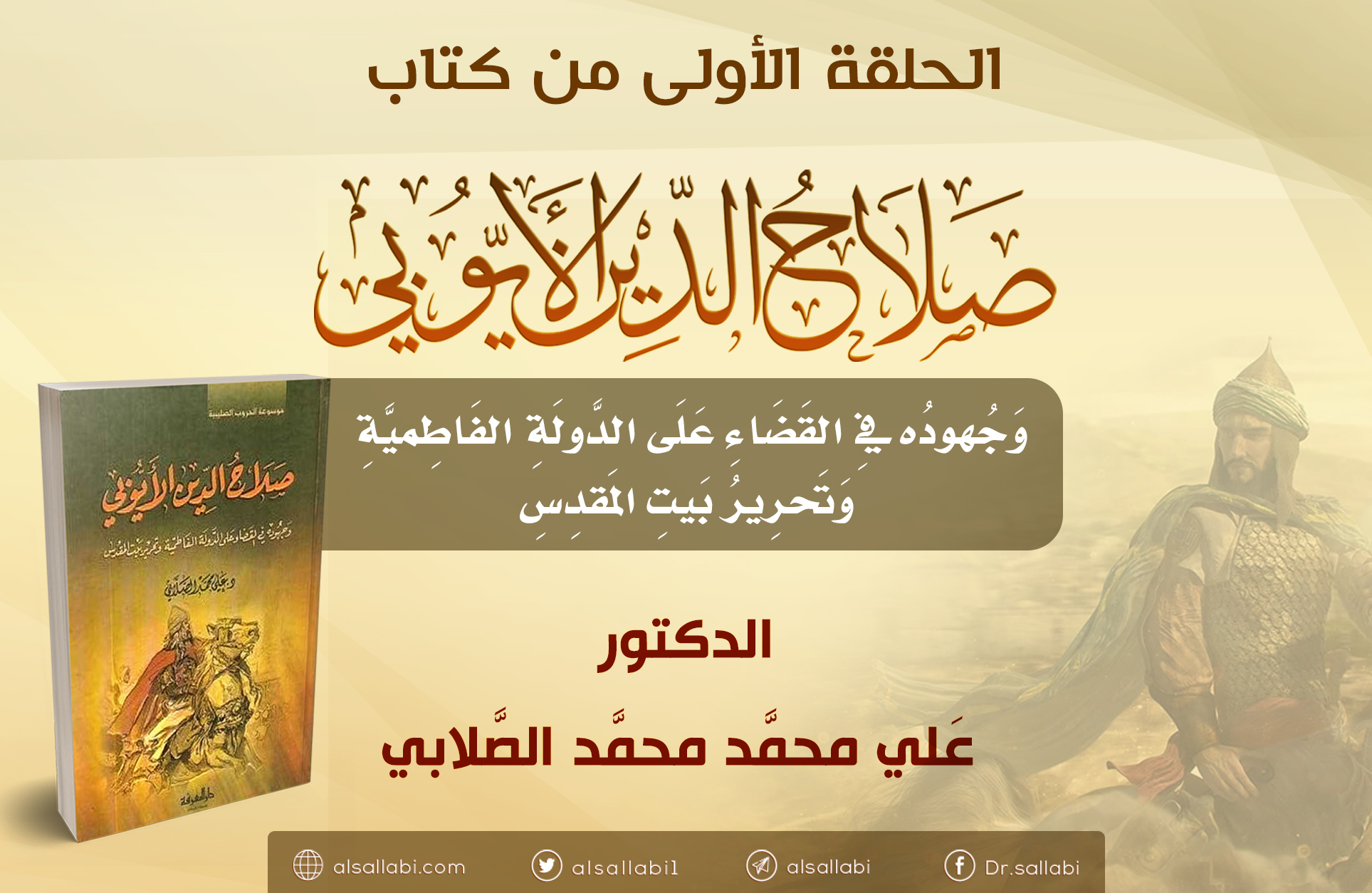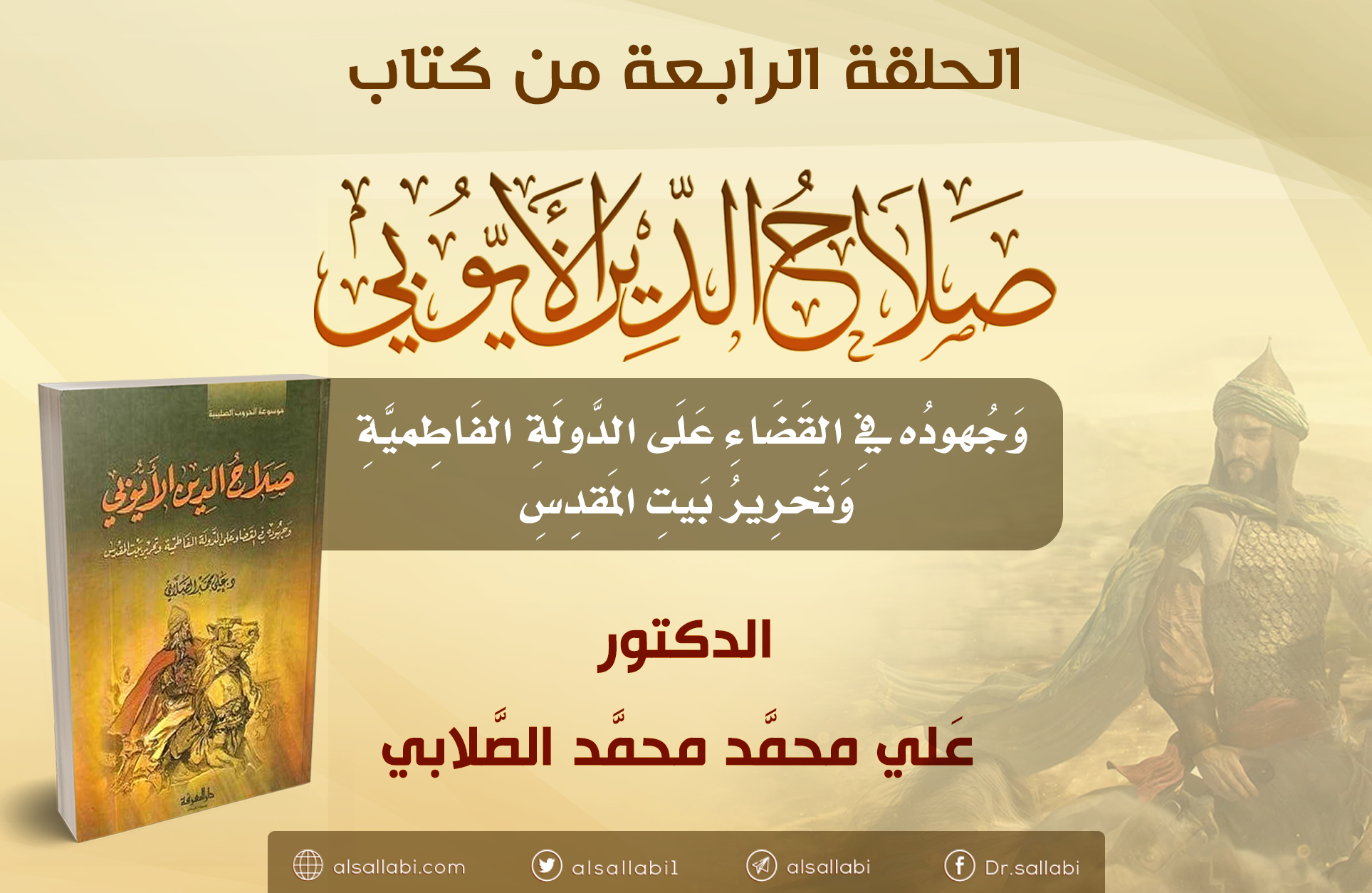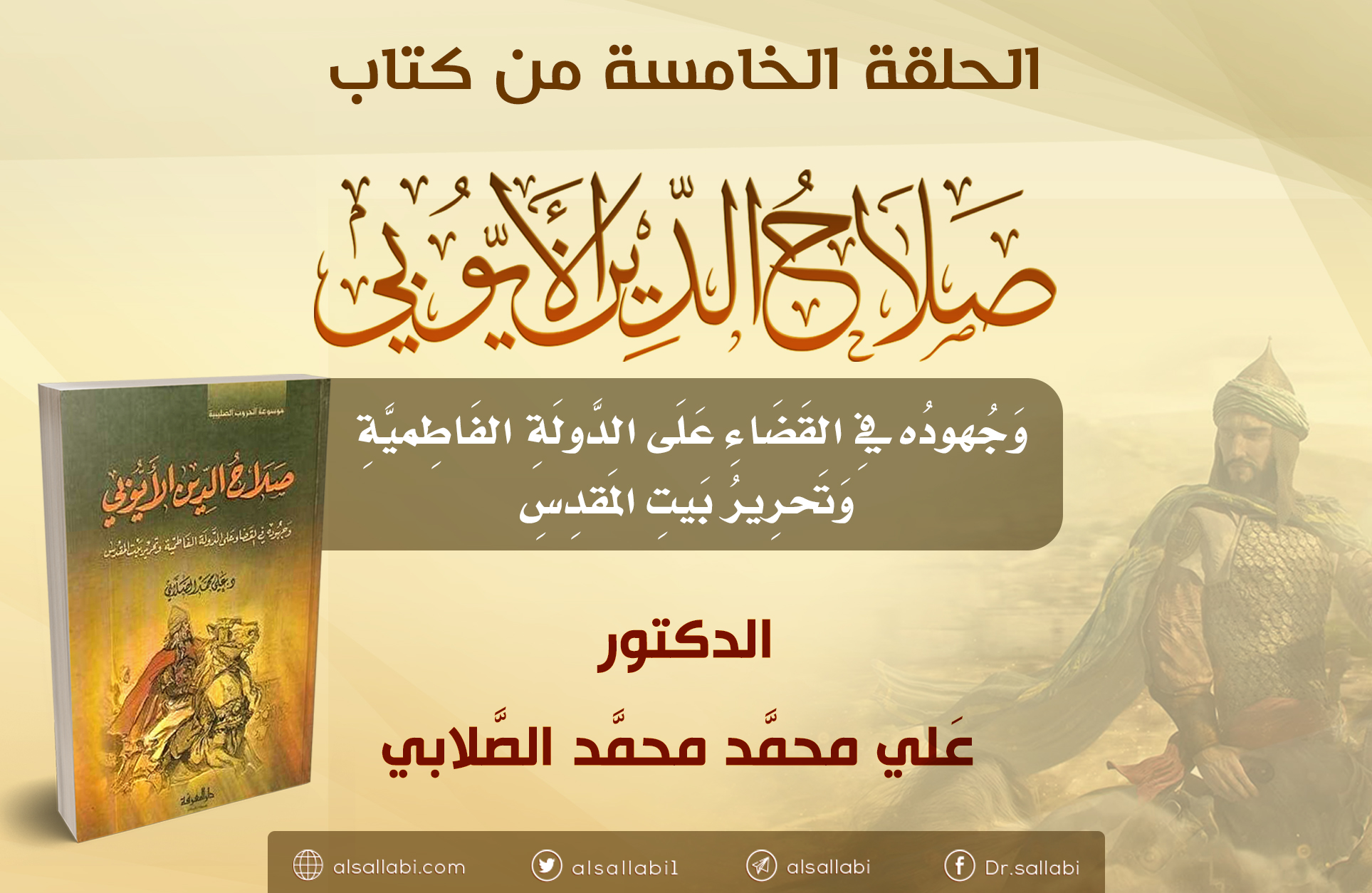في سيرة صلاح الدين الأيوبي
الدوافع السياسية والإجتماعية والإقتصادية للحروب الصليبية
الحلقة: الثالثة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
رمضان 1441 ه/ مايو 2020
أولا: الدافع السياسي:
كان الملوك ، والأمراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء أطماع سياسة، لم يستطيعوا إخفاءها؛ سواء قبل وصولهم إلى الشام ، وفلسطين ، أو بعد استقرارهم فيهما ، والمعروف: أنَّ النظام الإقطاعي ارتبط دائماً بالأرض ، وبقدر ما يكون الإقطاع كبيراً ، والأرض واسعة ، بقدر ما تكون مكانة الأمير ساميةً في المجتمع ، وفي ظل هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الأمير ، والفارس هي عدم وجود إقطاع ، أو أرض له، مما يجعله عديم الأهمية مسلوب النفوذ ، وأدى هذا إلى بقاء عدد كبير من الفرسان ، والأمراء بدون أرض؛ لأن من القواعد الأساسية في هذا النظام أن الابن الأكبر وحده هو الذي يرث الإقطاع ، فإذا مات صاحب الإقطاع؛ انتقل الإقطاع بأكمله إلى أكبر أبنائه ، وهذا يعني بقاء بقية الأبناء دون أرض ، وهو وضع ممقوت في المجتمع الإقطاعي ، الأمر الذي جعل الفرسان ، والأمراء المحرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه العقبة عن طريق الزواج من وريثه إقطاع ، أو الالتجاء إلى العدوان ، والحرب للحصول على إقطاع ، وكان أن ظهرت الحركة الصليبية؛ لتفتح باباً جديداً أمام ذلك النفر من الأمراء ، والفرسان ، فلبُّوا نداء البابوية ، وأسرعوا إلى الإسهام في تلك الحركة لعلَّهم ينجحون في تأسيس إمارات لأنفسهم في الشرق ، تعوضهم ما فاتهم في الغرب. أما الأمراء ، والفرسان الذين كانوا يمتلكون إقطاعات؛ فقد وجدوا في المشاركة في الحركة الصليبية فرصةً طيبة لتحقيق مجدٍ أكبر، والحصول على جاهٍ أعظم.
وبدراستنا لمراجع الحروب الصليبية نرى: أن أطماع أمراء الحملة الأولى تجلَّت في عدَّة مظاهر سياسية ، فقد أخذوا يقسمون الغنيمة؛ وهم في الطريق؛ أي: قبل أن يستولوا على الغنيمة فعلاً ، وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغبة كل واحد منهم في الفوز بها ، وكيف أنَّ من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسباً في الطريق قنع به ، وتخلَّى عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف على البيت المقدس ، وهو الهدف الأساسي للحملة. وكثيراً ما دبَّ الخلاف بينهم ـ بعد استقرارهم ـ حول حكم إمارة ، أو الفوز بمدينة ، وعبثاً حاولت البابوية أن تتدخل لفضِّ المنازعات بين الأمراء ، وتحذرهم بأنَّ المسلمين يحيطون بهم ، وأنَّ الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن أنفسهم ، ولكن تلك الصيحات ذهبت أدراج الرياح؛ لأنَّ هدف الأمراء كان ذاتياً سياسياً ، ولم يكن يهمهم كثيراً رضا البابا ، أو سخطه ، بل إنَّ بعض الأمراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين، ممَّا يدلُّ على أن الوازع الديني كثيراً ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام مصالحهم السياسية.
أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطي (الكسيوس) فإنه لم يعترض على أهداف أمراء الحملة؛ لأنه إذا تسنى للدولة البيزنطية استرداد ما كان لها من أملاك قبل غارات الأتراك عليها؛ جاز أن تقوم في تخومها إمارات مسيحية حاجزة، لها حق السايدة عليها ، ولضمان الحصول على ذلك حرص الإمبراطور على الحصول على يمين الولاء من أمراء الغرب ، وبذلك توافقت مصالح كلا الجانبين المسيحيين في القيام بالحرب ، والعدوان على الأرض الإسلامية.
والواقع: أنه من العسير الفصل بين العوامل المادية ، والعوامل المعنوية التي دفعت المسحيين إلى الحروب الصليبية، فالفقر ، والرغبة في الكسب ، وروح المغامرة كانت عوامل هيَّأت الجو المناسب للحروب ، غير أن هذه العوامل لم تظهر إلا بما نجم عن فكرة الحرب »المقدسة» وتخليص الأرض من حماس ديني.
والواضح: أنَّ فكرة الحرب نبعت من السياسة البابوية ، وسياسة الدولة البيزنطية ، والحروب الإسبانية الإسلامية ، فمما سهل أمر إعلان الحرب على المشرق الإسلامي ما درج عليه الإسبان ، والفرنسيون في قتال المسلمين في بلاد الأندلس ، حيث اتخذ هذا القتال صفة الحرب المقدَّسة ، سواء من جهة المسلمين ، حيث أثار «المرابطون» في المغرب الإسلامي الجهاد الديني ، أو من جهة المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية إلى الشرق ، حتى أنَّ المؤرخ الكبير «ابن الأثير» نظر إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية ، واعتبر أيَّ عدوان على طرف من أطراف العالم الإسلامي ـ سواء في الشرق والغرب ـ رافد يصبُّ في النهر الأكبر ، وهو الغزو الأجنبي المنظم على أكبر قوة حضارية في العصور الوسطى ، وهو الدولة الإسلامية .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كشف المؤرخ المذكور بوضوح عن أسباب نجاح هذا الغزو ، ذي الشعب (الأندلس ، صقلية ، الشام ـ فلسطين) والتي تكمن في الفرقة ، والأطماع الذاتية ، وفقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام ، والمسلمون الأوائل بناة الدولة الإسلامية ، وقد كان واضحاً للعيان: أنَّ الكنيسة الغربية كانت محمومةً لتوسيع رقعتها الإقطاعية، والسيطرة على الكنائس الشرقية، إضافةً إلى رغبتها في حرب المسلمين.
ومن حقائق التعصب الديني وجود الجماعات الدينية التي كانت ترتبط بالكنيسة مباشرةً ، وكانت ذات أثر فعال في تلك الحروب ، منها فرسان الإسبتارية؛ الذين كانوا ملتزمين بالدفاع عن ممتلكات الصليبيين في المشرق ، وحماية الأماكن المقدسة ، وكانوا يرتبطون بالبابا مباشرة ، وكانت كنائس بيت المقدس قد خصَّصت عُشْرَ دخلها لمساعدتهم في أداء رسالتهم الدينية المزعومة، وهناك هيئة الفرسان الداوية ، التي اتخذت مقرها في جزء من هيكل سليمان ـ عليه السلام ـ في المسجد الأقصى، وسميت باسم: فرسان المعبد، ثم حُرِّفت إلى اسم: الداوية . هذا وقد كانت للبابوية ،ورجال الكنيسة القدرة على التأثير ، والضغط ، والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإصدار قرارات الحرمان؛ التي تقضي بالحرمان من النعيم في الآخرة ، ونبذ طاعته في الدنيا على حدِّ زعمهم.
ثانيا: الدافع الاجتماعي:
ساد المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى تمايز طبقي كبير، فقد سادت فيه طبقة رجال الدين، وطبقة المحاربين من النبلاء ، والفرسان ، وكانت طبقة الفلاحين تمثل الأكثرية المغلوبة على أمرها، والتي كان أفرادها يكدحون؛ ليسدوا حاجة الطبقتين الأوليين. كان الفلاح الأوروبي مغلوباً على أمره، وكان مطالباً بالتزامات عديدة لأصحاب الإقطاع، وكان البابا على دراية بأحوال الفلاحين ، فوعدهم بإلغاء التزاماتهم نحو أسيادهم، وأغراهم بخيرات الشرق الإسلامي ، كان الاف الفلاحين يعيشون عيشة منحطة في نظام الإقطاع، حيث شيَّدوا لأنفسهم أكواخاً من جذوع الأشجار، وفروعها ، وغطيت سقوفها بالطين، والقش، دون أن يكون لها نوافذ، ولا يوجد داخلها أثاث بل كان ما يجمعه الفلاح ، يعتبر ملكاً خاصاً للسيد الإقطاعي، كما يعتبر محروماً من الملكية الشخصية . وكانوا مثقلين بالالتزامات الخدمية لأسيادهم الإقطاعيين في شتى المجالات إلى جانب حرمانهم من منتجاتهم ، وبذلك يظهر مدى التعاسة ، والبؤس الذي كان يعيشه غالبية شعب أوروبا في القرن الحادي عشر الميلادي.
وهكذا لما ظهرت الدعوة للغزو الصليبي؛ وجدت هذه الغالبية العظمى فرصتها للخلاص من حياتها الشاقة المليئة بالذل ، والهوان ، ونظروا إلى أخطار الاشتراك في هذا الغزو نظرةً هينةً أمام ما كانوا يعيشون فيه ، فإن ماتوا في هذه الحرب ؛ كان لهم الخلاص ، وإن نجوا؛ كانت لهم حياة جديدة أفضل ممَّا كانوا عليه .
ولقد عرفت الكنيسة كيف تلعب بعقول هؤلاء ، وتوغر صدورهم ضدَّ السلام وأهله ، وخدعتهم بأنهم سيحررون بيت المقدس ، والقبر المقدس ، يباركهم الرب ، والبابا ، لذلك لم يردعهم رادع عن الذبح ، والقتل ، بل كان قتل المسلم مرضاةً ينال عليها الصليبيُّ ثواباً يوم الدينونة .
ثالثاً: الدافع الاقتصادي:
يعتبر التطلُّع إلى خيرات المشرق الإسلامي من أقوى دوافع الحروب الصليبية بعد الدوافع الدينية ، وقد عبَّر البابا (أوربان) نفسه في خطابه عن أهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع أوروبا آنذاك، فقال: لا تدعوا شيئاً يقعد بكم... ذلك أنَّ الأرض التي تسكنونها الآن، والتي تحيط بها البحار ، وقلل الجبال ضيقةٌ على سكانها الكثيرين، وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً ، ويلتهم بعضكم بعضاً.. إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها، بل هي فردوس المباهج . وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غرب أوروبا في أواخر القرن الحادي عشر، وكانت فرنسا بالذات تعاني من مجاعة شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى، ولذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة الاخرين ، فقد كانت الأزمة طاحنةً؛ حيث ألجأت الناس إلى أكل الحشائش، والأعشاب، وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك الجائعين باباً جديداً للخلاص من أوضاعهم الصعبة، وهذا ما يفسر أعمال السلب، والنهب للحملة ضد الشعوب النصرانية؛ التي مرُّوا في أراضيها.
كذلك اشترك عدد كبير من تجار المدن الإيطالية ، والفرنسية ، والإسبانية في الحروب الصليبية بغرض استغلالي بحت من أجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية؛ التي أصبحت مصدر ثراء للمشتغلين بها ، لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال في الاستيلاء على المراكز الرئيسية في الشام ، فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلاء على أنطاكية سنة 490هـ 1097م، وأسهم البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على بيت المقدس ، وكان هدف هذه الجاليات الأول ، والأخير هو الربح ، والكسب المادي ولم يكن يعنيها الباعث الديني إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها، ويكفي أن نعرف: أن شعار البنادقة الذين عرفوا به وقتذاك كان: لنكن أولاً بنادقة ، ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين، ولذلك قامت جمهوريات إيطاليا: (جنوا ـ بيزا ـ البندقية) بعقد معاهدات مع أمراء الصليبيين بالمشرق، حصلت بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة .
رابعا: تبدل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط:
منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) تبدَّل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط لصالح الغرب الأوروبي مركز الحركة الصليبية ، فَضَعْفُ الدولة البيزنطية ، وترنُّحها تحت ضربات السلاجقة القوية جعلها تسارع إلى الاستنجاد بأوروبا الغربية من ناحية ، ثم اختلال أوضاع المسلمين في الجناح الغربي من العالم الإسلامي خاصة في الأندلس ، وصقلية ، وما قابل ذلك من تيسير أسباب القوة ، والظهور لدى أعدائهم ، مما جعل الغرب الأوروبي يرفد النصارى الإسبان بشتى صنوف الدَّعم ، والمساندة في صراعهم مع مسلمي الأندلس على الاستنجاد بالمرابطين ، ومسلمي صقلية على الاستنجاد بإفريقية من ناحيةٍ ثانية. كلُّ ذلك أدَّى إلى دخول الحركة الصليبية في طورها الجديد؛ الذي اتخذ صفة العالمية . وكانت البابوية تدعم هذه الحرب بالموافقة ، والتوجيه ، والدعاية ، والدعم المعنوي ، فهذه حروب صليبية متقدِّمة على إعلان البابا أوربان الثاني بدء الزحف الصليبي إلى المشرق سنة 488هـ 1095م.
وتعتبر إفريقية بمدلوها التاريخي أحد هذه الميادين في الصراع الصليبي ، فقد كانت الجبهة الإفريقية ميداناً نشطت فيه قوى العدوان الصليبي لعدَّة قرون ، يتمثل ذلك في حملات عديدة ، وجهت إليها ، الواحدة تلو الأخرى ، ولم تفتر للصليبيين في ذلك همة ، ولم يوهن الفشل لهم عزيمة ، فكما أنَّ بلدان المغرب الإسلامي كانت أول من أكتوى من البلاد الإسلامية بنار الاستعمار الأوروبي الحديث؛ كانت بلدان الجناح الغربي من العالم الإسلامي ـ ومن ضمنها إفريقية ـ هي التي تلقَّت الضربات الأولى للصليبيين.
والسبب في ذلك يعود إلى عدَّة اعتبارات جغرافية، وتاريخية، من أهمها: قربها الشديد من غرب أوروبا مركز الحركة الصليبية، ومعرفة الأوروبيين الواسعة نسبياً لأوضاع المسلمين في هذه المنطقة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين ، ثم الحقد الشديد الذي كان يكنُّه الأوروبيون للمسلمين المغاربة ، وبالذات لكونهم هم الذين تولوا عبء الجهاد في أوروبا أكثر من غيرهم من المسلمين، وما كان يشعر به الأوروبيون من خطر هؤلاء؛ إذ تهيَّأت لهم الوحدة، والقيادة المخلصة. لكل ذلك كانت أوروبا تتربص بمسلمي هذه المنطقة الدوائر، وتتحفَّز للوثوب عليهم منتظرة الفرصة المناسبة، وأخذت هذه الفرصة التي طالما انتظرها محركو قوى العدوان الصليبي تتهيأ منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) إذ أصاب الجناح الغربي من العالم الإسلامي من التمزق ما جعله يسير بخطىً حثيثةٍ نحو التردِّي إلى الهاوية ، ولم يكن وضع إخوانهم في المشرق بأحسن حال منهم ، فكان هذا التمزُّق ، وافتراق الكلمة هو السبب الأهم في البلاء الذي نزل بالمسلمين في المشرق ، والمغرب على حدٍّ سواء ، وما أشبه اليوم بالأمس، لقد كان، ولا يزال تفرُّق العرب، والمسلمين هو الباب الواسع الذي يدخل إليهم أعداؤهم منه لضربهم في عقر ديارهم. فكان أن انطلقت القوى الصليبية في موجة عاتية تضرب المسلمين في ثلاث جبهات في انٍ واحدٍ: في الأندلس، وصقلية، وإفريقية
1 ـ الأندلس:
فقد شهدت الجبهة الأندلسية منذ أواسط ذلك القرن نشاطاً ملحوظاً تمثَّل في شنِّ هجومٍ قويٍّ مستمرٍّ من قِبَل النصارى الإسبان بزعامة مملكة قشتالة على مسلمي الأندلس ، حيث أخذت المدن ، والمعاقل الإسلامية تسقط في أيديهم تباعاً ، وأحرزوا النصر على المسلمين في معاركَ عديدةٍ ، وتوجت تلك الانتصارات بسقوط مدينة طليطلة سنة 478هـ في يد الفونسو السادس ملك قشتالة. تلك الكارثة التي روَّعت العالم الإسلامي بأسره. وحيال هذا الضغط المتواصل من النصارى الإسبان اضطر مسلمو الأندلس إلى الاستنجاد بالمرابطين من العدوة المغربية ، فكانوا يرسلون الاستغاثة تلو الأخرى لهذه القوة الفتية، حتى إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين على جيوب المقاومة لدولته في المغرب؛ عبر البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة؛ حيث التقى بألفونسو السادس في معركة الزلاقة سنة 479هـ التي سطَّر المرابطون، ومن ساعدهم من الأندلسيين بانتصارهم الرائع فيها صفحةً مشرقةً في تاريخ الجهاد الإسلامي. وبانتصار المسلمين في تلك المعركة أوقف المدُّ المسيحي الإسباني؛ حتى تهيأت له ظروف أخرى فيما بعد.
2 ـ صقلية:
وأما الجبهة الصقلية؛ فقد أدى ظهور النورمان كقوةٍ جديدةٍ في ميدان السياسة الدولية إلى تغيُّر ميزان القوى في غرب المتوسط لصالح القوى النصرانية؛ إذ ما كاد هؤلاء القادمون الجدد أن يكون لهم موطىء قدم لهم في جنوب إيطاليا؛ حتى حصل جيسكارد أكبر زعمائهم على اعتراف البابا نقولا الثاني به في مؤتمر ملقى سنة 1059م، وأعلن عن مشروعه في توجيه قواه ضدَّ مسلمي صقلية إرضاءً للبابوية؛ التي كانت ترى في ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليبية من ناحية، وإبعاداً للخطر النورماني عن ممتلكاتها من ناحيةٍ أخرى، فشجَّعت هذا المشروع، وكدليل على موافقتها، وتشجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد رايةً مقدَّسةً؛ لينال هو وجنده ببركتها النصر على المسلمين، وأصرَّ على أن الفتوحات المرتقبة من أجل المسيح عليه السلام هي أكثر أهمية من إرسال الهدايا إلى روما . وتَّم الاستيلاء على الجزيرة في سنة 484هـ في عهد رجار الأول، ثم وثبت قواته على مالطة في العام التالي، واحتلتها، وأخذ يتحيَّن الفرصة للانقضاض على إفريقية.
3 ـ إفريقية:
وأما الجبهة الإفريقية؛ فقد نالت حظها هي الأخرى من العدوان الصليبي في تلك الآونة بفعل قوة ناشئة ، هي المدن البحرية الإيطالية ، فقد استغلَّت هذه المدن غياب القوى البحرية القديمة المتمثلة في الأسطولين: الإسلامي، والبيزنطي عن مياه البحر الأبيض المتوسط منذ أوائل ذلك القرن لانشغال كلا الطرفين بمشاكله الداخلية ، وأخذت أساطيلها تمخر مياه ذلك البحر القريبة من الشواطئ الأوروبية ، أولاً خوفاً من أسطول مجاهد العامري صاحب دانية الذي استطاع تجميد نشاطها لفترةٍ من الوقت؛ حتى إذا ما تمكَّنت من إزالة ذلك الخطر؛ بدأت منذ أواسط القرن المذكور تجوب مياه البحر الأبيض المتوسط شرقاً ، وغرباً ، وقد وضعت هذه المدن قوَّتها البحرية في خدمة الأهداف الصليبية منذ البداية لتحقيق مكاسب خاصة لها ، فبتشجيع البابا لاون التاسع استولى تحالف من جنوة، وبيزا على جزيرة سردينيا الإسلامية سنة 442 هـ 1063م حيث خرب أرباضها ، وميناءها ، وغنم غنائم كبيرة.
كما اشتركت هذه الأساطيل في حروب الجبهة الصقلية؛ اشتركت في حروب الجبهة الأندلسية ، فأسهمت في مطاردات المسلمين الأندلسيين عن طريق البحر ، وأخذت نصيبها من الغنيمة ، وفرضت حصاراً بحرياً على المرية؛ حتى دفعت تلك المدينة فدية ضخمة تقدر بمبلغ 113ألف دينار ذهبي ، كما أجبرت بلنسية على دفع أتاوة مماثلة تقدر بمبلغ 20ألف دينار ذهبي؛ لتفتدي نفسها بذلك من النهب ، والسَّلب ، وهاجمت الجزائر الشرقية (جزر البليار) عدَّة مرات. ونتيجة لتلك اصبحت القوة البحرية الإيطالية هي المتحكمة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، ممَّا دفعها إلى مزيد من المغامرة ، فوجهت نشاطها إلى إفريقية؛ التي كانت لا تزال تحتفظ بقوة بحريَّة تمدُّ يد المساعدة لإخوانهم في صقلية ، أو غيرها من ناحية ثانية.
ثم لتحقيق أهداف الحركة الصليبية في إفريقية من ناحية ثالثة قامت قوة بحرية ضخمة مكونة من أسطولي جنوة، وبيزا مدعومة بفريق من مدينة أمالفي ، وقوة عسكرية أخرى أمدهما بهما البابا لمهاجمة مدينة المهدية سنة 480هـ/1087م أي: بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين ، وقبيل الاستيلاء الكامل على صقلية ، واستولت عليها باستثناء قلعتها ، وظلت في يدها إلى أن دفع صاحبها تميم بن المعز للقوى المتحالفة فديةً ماليةً ضخمةً ، وعقد مع الغزاة معاهدةً ، نصَّ أحدُ بنودها على تعهّد تميم بعدم التعرض للسفن الإيطالية في المياه الإفريقية ، ومنحهم امتيازات تجارية في بلاده ، كما سيذكر في موضعه.
ومما تقدَّم يتَّضح: أنَّ هذا الهجوم الصليبي على القسم الغربي من العالم الإسلامي منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) والذي كانت تدبر دفته البابوية قد احتدم في ثلاث جبهات ، كانت إفريقية إحداها ، ولا شك: أنَّ هذا الهجوم كان وجهاً من أوجه الحركة الصليبية ، وهذا يؤكد: أنَّ الحروب الصليبية بدأت في إفريقية قبل الزحف الصليبي إلى المشرق ، ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 491هـ ؛ إذ يفهم من النصِّ الذي أورده: أنَّ تلك الحوادث كانت مترابطةً ، يحركها محركٌ واحد ، وأنها كانت بداية لموجه الحروب الصليبية في ذلك الطور من أطوار الحركة الصليبية؛ إذ يقول: كان ابتداء ظهور دولة الفرنج ، واشتداد أمرهم، وخروجهم إلى بلاد الإسلام ، واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة ، فملكوا طليطلة ، وغيرها من بلاد الأندلس... ثم قصدوا سنة أربعة وثمانين وأربعمئة جزيرة صقلية، وملكوها.. وتطرقوا إلى إفريقية فملكوا منها شيئاً ، وأخذ منهم ـ ثم ملكوا غيره وغيره على ما تراه ـ فلما كان سنة تسعين وأربعمئة خرجوا إلى بلاد الشام.
وعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الحركة الصليبية إلى المشرق؛ إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء فكرة احتلال إفريقية ماثلةً في أذهان ذوي الأفكار الصليبية ، وبقي تطلع النورمان للاستيلاء عليها قائماً؛ حتى تم لهم ذلك عهد رجار الثاني؛ حيث استولى على معظم سواحلها من طرابلس شرقاً إلى مدينة تونس غرباً في سنة 543هـ/1148م ، فكانت الحرب الصليبية مشتعلةً في الجبهة الإفريقية أثناء احتدامها في جبهة المشرق ، وبقي الوجود النورماني ماثلاً فيها؛ حتى قام عبد المؤمن بن علي زعيم دولة الموحدين بطردهم من المهدية اخر معاقلهم فيها سنة 555هـ/1160م ، وعندما حدث نوع من تبدل ميزان القوى في المغرب الإسلامي؛ نجد ذلك ساهم في جبهة المقاومة الإسلامية في المشرق في عهد نور الدين محمود زنكي ، وصلاح الدين الأيوبي ، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
خامساً: استنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني:
استنجد الإمبراطور الكسيوس كومنين (1081 ـ 1118م) بالبابا أوربان الثاني ضد السلاجقة ، ولم يكن هذا الاستنجاد في الحقيقة الأول من نوعه ، بل سبقه استنجاد الإمبراطور (ميخائيل السابع) بالبابا (جريجوري السابع) عقب موقعة ملاذ كرد 463هـ السالفة الذكر ، فالمعروف: أنَّ شن الحرب على الترك كان من الأغراض التي تنطوي عليها الدعوى البيزنطية ، فالأناضول يعتبر أكثر أهمية من بيت المقدس عند الدولة البيزنطية ، ولذلك لما أصبحت عاصمة البيزنطيين مهددةً من قبل السلاجقة؛ كان لزاما على الإمبراطور أن يستنجد بالغرب في مقابل اتحاد الكنيستين الشرقية ، والغربية ، وقد أرسل البابا جريجوري السابع إلى الإمبراطور ميخائيل السابع رداً مرضياً بدافع العاطفة المسيحية من جهة ، وبدافع سياسي من جهة أخرى ، فما يحشده من جيش سوف يقضي على الانشقاق بين الكنيستين ، ويزيد من نفوذ البابوية في الشرق مثلما زاد في الغرب ، غير أنَّ الحرب التي نشبت بين جريجوري السابع ، والإمبراطور (هنري الرابع) منعته من المضي في مشروعه ، ولما خلف الإمبراطور (الكسيوس كومنين) الإمبراطور ميخائيل السابع؛ بعث برسالة إلى البابا أوربان الثاني ، وإلى كبار رجال الإقطاع سنة 478هـ يدعوهم لإرسال المساعدات لنجدة إخوانهم في الشرق ، وحماية القسطنطينية ضدَّ الخطر السلجوقي .
ولقد كان (الكسيوس) يرغب في أن يبعث له الغرب ببعض الجند المرتزقة ، ولكن البابا أوربان لم يشأ أن يجعل نفسه في خدمة الدولة البيزنطية ، بل أراد أن تتولى البابوية تقديم المساعدة للمسيحين في الشرق ، وهذا التغيير في الفكرة يؤدي إلى أن يحشد العالم المسيحي اللاتيني جيشاً ضخماً ، لا أن يبعث بجنود مرتزقة تخضع لأهواء الأمراء في تصرف البابا مقابل الإمبراطور ميخائيل السابع ، ويبرز أهمية الإبداع ، والتفكير ، واقتناص الفرص ، وتسخير الوسائل في خدمة مشروعهم ، وعلينا أن نستفيد مِنْ هذه الدروسَ الكثيرة لخدمة المشروع الإسلامي. وأثار هذا الاختلاف في التفكير من المتاعب منذ البداية ما أساء العلاقات بين البيزنطيين ، والصليبيين.
والثابت تاريخياً: أنَّ المسؤول الأول عن قيام الحركة الصليبية هو البابا أوربان الثاني ، فهو الذي أنذر بقيام تلك الحروب ، يؤيده في دعواه الجهاز الكنسي في الغرب، وينسب إليه جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين له الدور الرئيسي في تحقيق هذه الفكرة .
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/66.pdf
الدوافع السياسية والإجتماعية والإقتصادية للحروب الصليبية
الحلقة: الثالثة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
رمضان 1441 ه/ مايو 2020
أولا: الدافع السياسي:
كان الملوك ، والأمراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء أطماع سياسة، لم يستطيعوا إخفاءها؛ سواء قبل وصولهم إلى الشام ، وفلسطين ، أو بعد استقرارهم فيهما ، والمعروف: أنَّ النظام الإقطاعي ارتبط دائماً بالأرض ، وبقدر ما يكون الإقطاع كبيراً ، والأرض واسعة ، بقدر ما تكون مكانة الأمير ساميةً في المجتمع ، وفي ظل هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الأمير ، والفارس هي عدم وجود إقطاع ، أو أرض له، مما يجعله عديم الأهمية مسلوب النفوذ ، وأدى هذا إلى بقاء عدد كبير من الفرسان ، والأمراء بدون أرض؛ لأن من القواعد الأساسية في هذا النظام أن الابن الأكبر وحده هو الذي يرث الإقطاع ، فإذا مات صاحب الإقطاع؛ انتقل الإقطاع بأكمله إلى أكبر أبنائه ، وهذا يعني بقاء بقية الأبناء دون أرض ، وهو وضع ممقوت في المجتمع الإقطاعي ، الأمر الذي جعل الفرسان ، والأمراء المحرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه العقبة عن طريق الزواج من وريثه إقطاع ، أو الالتجاء إلى العدوان ، والحرب للحصول على إقطاع ، وكان أن ظهرت الحركة الصليبية؛ لتفتح باباً جديداً أمام ذلك النفر من الأمراء ، والفرسان ، فلبُّوا نداء البابوية ، وأسرعوا إلى الإسهام في تلك الحركة لعلَّهم ينجحون في تأسيس إمارات لأنفسهم في الشرق ، تعوضهم ما فاتهم في الغرب. أما الأمراء ، والفرسان الذين كانوا يمتلكون إقطاعات؛ فقد وجدوا في المشاركة في الحركة الصليبية فرصةً طيبة لتحقيق مجدٍ أكبر، والحصول على جاهٍ أعظم.
وبدراستنا لمراجع الحروب الصليبية نرى: أن أطماع أمراء الحملة الأولى تجلَّت في عدَّة مظاهر سياسية ، فقد أخذوا يقسمون الغنيمة؛ وهم في الطريق؛ أي: قبل أن يستولوا على الغنيمة فعلاً ، وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغبة كل واحد منهم في الفوز بها ، وكيف أنَّ من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسباً في الطريق قنع به ، وتخلَّى عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف على البيت المقدس ، وهو الهدف الأساسي للحملة. وكثيراً ما دبَّ الخلاف بينهم ـ بعد استقرارهم ـ حول حكم إمارة ، أو الفوز بمدينة ، وعبثاً حاولت البابوية أن تتدخل لفضِّ المنازعات بين الأمراء ، وتحذرهم بأنَّ المسلمين يحيطون بهم ، وأنَّ الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن أنفسهم ، ولكن تلك الصيحات ذهبت أدراج الرياح؛ لأنَّ هدف الأمراء كان ذاتياً سياسياً ، ولم يكن يهمهم كثيراً رضا البابا ، أو سخطه ، بل إنَّ بعض الأمراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين، ممَّا يدلُّ على أن الوازع الديني كثيراً ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام مصالحهم السياسية.
أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطي (الكسيوس) فإنه لم يعترض على أهداف أمراء الحملة؛ لأنه إذا تسنى للدولة البيزنطية استرداد ما كان لها من أملاك قبل غارات الأتراك عليها؛ جاز أن تقوم في تخومها إمارات مسيحية حاجزة، لها حق السايدة عليها ، ولضمان الحصول على ذلك حرص الإمبراطور على الحصول على يمين الولاء من أمراء الغرب ، وبذلك توافقت مصالح كلا الجانبين المسيحيين في القيام بالحرب ، والعدوان على الأرض الإسلامية.
والواقع: أنه من العسير الفصل بين العوامل المادية ، والعوامل المعنوية التي دفعت المسحيين إلى الحروب الصليبية، فالفقر ، والرغبة في الكسب ، وروح المغامرة كانت عوامل هيَّأت الجو المناسب للحروب ، غير أن هذه العوامل لم تظهر إلا بما نجم عن فكرة الحرب »المقدسة» وتخليص الأرض من حماس ديني.
والواضح: أنَّ فكرة الحرب نبعت من السياسة البابوية ، وسياسة الدولة البيزنطية ، والحروب الإسبانية الإسلامية ، فمما سهل أمر إعلان الحرب على المشرق الإسلامي ما درج عليه الإسبان ، والفرنسيون في قتال المسلمين في بلاد الأندلس ، حيث اتخذ هذا القتال صفة الحرب المقدَّسة ، سواء من جهة المسلمين ، حيث أثار «المرابطون» في المغرب الإسلامي الجهاد الديني ، أو من جهة المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية إلى الشرق ، حتى أنَّ المؤرخ الكبير «ابن الأثير» نظر إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية ، واعتبر أيَّ عدوان على طرف من أطراف العالم الإسلامي ـ سواء في الشرق والغرب ـ رافد يصبُّ في النهر الأكبر ، وهو الغزو الأجنبي المنظم على أكبر قوة حضارية في العصور الوسطى ، وهو الدولة الإسلامية .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كشف المؤرخ المذكور بوضوح عن أسباب نجاح هذا الغزو ، ذي الشعب (الأندلس ، صقلية ، الشام ـ فلسطين) والتي تكمن في الفرقة ، والأطماع الذاتية ، وفقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام ، والمسلمون الأوائل بناة الدولة الإسلامية ، وقد كان واضحاً للعيان: أنَّ الكنيسة الغربية كانت محمومةً لتوسيع رقعتها الإقطاعية، والسيطرة على الكنائس الشرقية، إضافةً إلى رغبتها في حرب المسلمين.
ومن حقائق التعصب الديني وجود الجماعات الدينية التي كانت ترتبط بالكنيسة مباشرةً ، وكانت ذات أثر فعال في تلك الحروب ، منها فرسان الإسبتارية؛ الذين كانوا ملتزمين بالدفاع عن ممتلكات الصليبيين في المشرق ، وحماية الأماكن المقدسة ، وكانوا يرتبطون بالبابا مباشرة ، وكانت كنائس بيت المقدس قد خصَّصت عُشْرَ دخلها لمساعدتهم في أداء رسالتهم الدينية المزعومة، وهناك هيئة الفرسان الداوية ، التي اتخذت مقرها في جزء من هيكل سليمان ـ عليه السلام ـ في المسجد الأقصى، وسميت باسم: فرسان المعبد، ثم حُرِّفت إلى اسم: الداوية . هذا وقد كانت للبابوية ،ورجال الكنيسة القدرة على التأثير ، والضغط ، والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإصدار قرارات الحرمان؛ التي تقضي بالحرمان من النعيم في الآخرة ، ونبذ طاعته في الدنيا على حدِّ زعمهم.
ثانيا: الدافع الاجتماعي:
ساد المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى تمايز طبقي كبير، فقد سادت فيه طبقة رجال الدين، وطبقة المحاربين من النبلاء ، والفرسان ، وكانت طبقة الفلاحين تمثل الأكثرية المغلوبة على أمرها، والتي كان أفرادها يكدحون؛ ليسدوا حاجة الطبقتين الأوليين. كان الفلاح الأوروبي مغلوباً على أمره، وكان مطالباً بالتزامات عديدة لأصحاب الإقطاع، وكان البابا على دراية بأحوال الفلاحين ، فوعدهم بإلغاء التزاماتهم نحو أسيادهم، وأغراهم بخيرات الشرق الإسلامي ، كان الاف الفلاحين يعيشون عيشة منحطة في نظام الإقطاع، حيث شيَّدوا لأنفسهم أكواخاً من جذوع الأشجار، وفروعها ، وغطيت سقوفها بالطين، والقش، دون أن يكون لها نوافذ، ولا يوجد داخلها أثاث بل كان ما يجمعه الفلاح ، يعتبر ملكاً خاصاً للسيد الإقطاعي، كما يعتبر محروماً من الملكية الشخصية . وكانوا مثقلين بالالتزامات الخدمية لأسيادهم الإقطاعيين في شتى المجالات إلى جانب حرمانهم من منتجاتهم ، وبذلك يظهر مدى التعاسة ، والبؤس الذي كان يعيشه غالبية شعب أوروبا في القرن الحادي عشر الميلادي.
وهكذا لما ظهرت الدعوة للغزو الصليبي؛ وجدت هذه الغالبية العظمى فرصتها للخلاص من حياتها الشاقة المليئة بالذل ، والهوان ، ونظروا إلى أخطار الاشتراك في هذا الغزو نظرةً هينةً أمام ما كانوا يعيشون فيه ، فإن ماتوا في هذه الحرب ؛ كان لهم الخلاص ، وإن نجوا؛ كانت لهم حياة جديدة أفضل ممَّا كانوا عليه .
ولقد عرفت الكنيسة كيف تلعب بعقول هؤلاء ، وتوغر صدورهم ضدَّ السلام وأهله ، وخدعتهم بأنهم سيحررون بيت المقدس ، والقبر المقدس ، يباركهم الرب ، والبابا ، لذلك لم يردعهم رادع عن الذبح ، والقتل ، بل كان قتل المسلم مرضاةً ينال عليها الصليبيُّ ثواباً يوم الدينونة .
ثالثاً: الدافع الاقتصادي:
يعتبر التطلُّع إلى خيرات المشرق الإسلامي من أقوى دوافع الحروب الصليبية بعد الدوافع الدينية ، وقد عبَّر البابا (أوربان) نفسه في خطابه عن أهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع أوروبا آنذاك، فقال: لا تدعوا شيئاً يقعد بكم... ذلك أنَّ الأرض التي تسكنونها الآن، والتي تحيط بها البحار ، وقلل الجبال ضيقةٌ على سكانها الكثيرين، وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً ، ويلتهم بعضكم بعضاً.. إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها، بل هي فردوس المباهج . وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غرب أوروبا في أواخر القرن الحادي عشر، وكانت فرنسا بالذات تعاني من مجاعة شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى، ولذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة الاخرين ، فقد كانت الأزمة طاحنةً؛ حيث ألجأت الناس إلى أكل الحشائش، والأعشاب، وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك الجائعين باباً جديداً للخلاص من أوضاعهم الصعبة، وهذا ما يفسر أعمال السلب، والنهب للحملة ضد الشعوب النصرانية؛ التي مرُّوا في أراضيها.
كذلك اشترك عدد كبير من تجار المدن الإيطالية ، والفرنسية ، والإسبانية في الحروب الصليبية بغرض استغلالي بحت من أجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية؛ التي أصبحت مصدر ثراء للمشتغلين بها ، لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال في الاستيلاء على المراكز الرئيسية في الشام ، فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلاء على أنطاكية سنة 490هـ 1097م، وأسهم البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على بيت المقدس ، وكان هدف هذه الجاليات الأول ، والأخير هو الربح ، والكسب المادي ولم يكن يعنيها الباعث الديني إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها، ويكفي أن نعرف: أن شعار البنادقة الذين عرفوا به وقتذاك كان: لنكن أولاً بنادقة ، ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين، ولذلك قامت جمهوريات إيطاليا: (جنوا ـ بيزا ـ البندقية) بعقد معاهدات مع أمراء الصليبيين بالمشرق، حصلت بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة .
رابعا: تبدل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط:
منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) تبدَّل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط لصالح الغرب الأوروبي مركز الحركة الصليبية ، فَضَعْفُ الدولة البيزنطية ، وترنُّحها تحت ضربات السلاجقة القوية جعلها تسارع إلى الاستنجاد بأوروبا الغربية من ناحية ، ثم اختلال أوضاع المسلمين في الجناح الغربي من العالم الإسلامي خاصة في الأندلس ، وصقلية ، وما قابل ذلك من تيسير أسباب القوة ، والظهور لدى أعدائهم ، مما جعل الغرب الأوروبي يرفد النصارى الإسبان بشتى صنوف الدَّعم ، والمساندة في صراعهم مع مسلمي الأندلس على الاستنجاد بالمرابطين ، ومسلمي صقلية على الاستنجاد بإفريقية من ناحيةٍ ثانية. كلُّ ذلك أدَّى إلى دخول الحركة الصليبية في طورها الجديد؛ الذي اتخذ صفة العالمية . وكانت البابوية تدعم هذه الحرب بالموافقة ، والتوجيه ، والدعاية ، والدعم المعنوي ، فهذه حروب صليبية متقدِّمة على إعلان البابا أوربان الثاني بدء الزحف الصليبي إلى المشرق سنة 488هـ 1095م.
وتعتبر إفريقية بمدلوها التاريخي أحد هذه الميادين في الصراع الصليبي ، فقد كانت الجبهة الإفريقية ميداناً نشطت فيه قوى العدوان الصليبي لعدَّة قرون ، يتمثل ذلك في حملات عديدة ، وجهت إليها ، الواحدة تلو الأخرى ، ولم تفتر للصليبيين في ذلك همة ، ولم يوهن الفشل لهم عزيمة ، فكما أنَّ بلدان المغرب الإسلامي كانت أول من أكتوى من البلاد الإسلامية بنار الاستعمار الأوروبي الحديث؛ كانت بلدان الجناح الغربي من العالم الإسلامي ـ ومن ضمنها إفريقية ـ هي التي تلقَّت الضربات الأولى للصليبيين.
والسبب في ذلك يعود إلى عدَّة اعتبارات جغرافية، وتاريخية، من أهمها: قربها الشديد من غرب أوروبا مركز الحركة الصليبية، ومعرفة الأوروبيين الواسعة نسبياً لأوضاع المسلمين في هذه المنطقة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين ، ثم الحقد الشديد الذي كان يكنُّه الأوروبيون للمسلمين المغاربة ، وبالذات لكونهم هم الذين تولوا عبء الجهاد في أوروبا أكثر من غيرهم من المسلمين، وما كان يشعر به الأوروبيون من خطر هؤلاء؛ إذ تهيَّأت لهم الوحدة، والقيادة المخلصة. لكل ذلك كانت أوروبا تتربص بمسلمي هذه المنطقة الدوائر، وتتحفَّز للوثوب عليهم منتظرة الفرصة المناسبة، وأخذت هذه الفرصة التي طالما انتظرها محركو قوى العدوان الصليبي تتهيأ منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) إذ أصاب الجناح الغربي من العالم الإسلامي من التمزق ما جعله يسير بخطىً حثيثةٍ نحو التردِّي إلى الهاوية ، ولم يكن وضع إخوانهم في المشرق بأحسن حال منهم ، فكان هذا التمزُّق ، وافتراق الكلمة هو السبب الأهم في البلاء الذي نزل بالمسلمين في المشرق ، والمغرب على حدٍّ سواء ، وما أشبه اليوم بالأمس، لقد كان، ولا يزال تفرُّق العرب، والمسلمين هو الباب الواسع الذي يدخل إليهم أعداؤهم منه لضربهم في عقر ديارهم. فكان أن انطلقت القوى الصليبية في موجة عاتية تضرب المسلمين في ثلاث جبهات في انٍ واحدٍ: في الأندلس، وصقلية، وإفريقية
1 ـ الأندلس:
فقد شهدت الجبهة الأندلسية منذ أواسط ذلك القرن نشاطاً ملحوظاً تمثَّل في شنِّ هجومٍ قويٍّ مستمرٍّ من قِبَل النصارى الإسبان بزعامة مملكة قشتالة على مسلمي الأندلس ، حيث أخذت المدن ، والمعاقل الإسلامية تسقط في أيديهم تباعاً ، وأحرزوا النصر على المسلمين في معاركَ عديدةٍ ، وتوجت تلك الانتصارات بسقوط مدينة طليطلة سنة 478هـ في يد الفونسو السادس ملك قشتالة. تلك الكارثة التي روَّعت العالم الإسلامي بأسره. وحيال هذا الضغط المتواصل من النصارى الإسبان اضطر مسلمو الأندلس إلى الاستنجاد بالمرابطين من العدوة المغربية ، فكانوا يرسلون الاستغاثة تلو الأخرى لهذه القوة الفتية، حتى إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين على جيوب المقاومة لدولته في المغرب؛ عبر البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة؛ حيث التقى بألفونسو السادس في معركة الزلاقة سنة 479هـ التي سطَّر المرابطون، ومن ساعدهم من الأندلسيين بانتصارهم الرائع فيها صفحةً مشرقةً في تاريخ الجهاد الإسلامي. وبانتصار المسلمين في تلك المعركة أوقف المدُّ المسيحي الإسباني؛ حتى تهيأت له ظروف أخرى فيما بعد.
2 ـ صقلية:
وأما الجبهة الصقلية؛ فقد أدى ظهور النورمان كقوةٍ جديدةٍ في ميدان السياسة الدولية إلى تغيُّر ميزان القوى في غرب المتوسط لصالح القوى النصرانية؛ إذ ما كاد هؤلاء القادمون الجدد أن يكون لهم موطىء قدم لهم في جنوب إيطاليا؛ حتى حصل جيسكارد أكبر زعمائهم على اعتراف البابا نقولا الثاني به في مؤتمر ملقى سنة 1059م، وأعلن عن مشروعه في توجيه قواه ضدَّ مسلمي صقلية إرضاءً للبابوية؛ التي كانت ترى في ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليبية من ناحية، وإبعاداً للخطر النورماني عن ممتلكاتها من ناحيةٍ أخرى، فشجَّعت هذا المشروع، وكدليل على موافقتها، وتشجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد رايةً مقدَّسةً؛ لينال هو وجنده ببركتها النصر على المسلمين، وأصرَّ على أن الفتوحات المرتقبة من أجل المسيح عليه السلام هي أكثر أهمية من إرسال الهدايا إلى روما . وتَّم الاستيلاء على الجزيرة في سنة 484هـ في عهد رجار الأول، ثم وثبت قواته على مالطة في العام التالي، واحتلتها، وأخذ يتحيَّن الفرصة للانقضاض على إفريقية.
3 ـ إفريقية:
وأما الجبهة الإفريقية؛ فقد نالت حظها هي الأخرى من العدوان الصليبي في تلك الآونة بفعل قوة ناشئة ، هي المدن البحرية الإيطالية ، فقد استغلَّت هذه المدن غياب القوى البحرية القديمة المتمثلة في الأسطولين: الإسلامي، والبيزنطي عن مياه البحر الأبيض المتوسط منذ أوائل ذلك القرن لانشغال كلا الطرفين بمشاكله الداخلية ، وأخذت أساطيلها تمخر مياه ذلك البحر القريبة من الشواطئ الأوروبية ، أولاً خوفاً من أسطول مجاهد العامري صاحب دانية الذي استطاع تجميد نشاطها لفترةٍ من الوقت؛ حتى إذا ما تمكَّنت من إزالة ذلك الخطر؛ بدأت منذ أواسط القرن المذكور تجوب مياه البحر الأبيض المتوسط شرقاً ، وغرباً ، وقد وضعت هذه المدن قوَّتها البحرية في خدمة الأهداف الصليبية منذ البداية لتحقيق مكاسب خاصة لها ، فبتشجيع البابا لاون التاسع استولى تحالف من جنوة، وبيزا على جزيرة سردينيا الإسلامية سنة 442 هـ 1063م حيث خرب أرباضها ، وميناءها ، وغنم غنائم كبيرة.
كما اشتركت هذه الأساطيل في حروب الجبهة الصقلية؛ اشتركت في حروب الجبهة الأندلسية ، فأسهمت في مطاردات المسلمين الأندلسيين عن طريق البحر ، وأخذت نصيبها من الغنيمة ، وفرضت حصاراً بحرياً على المرية؛ حتى دفعت تلك المدينة فدية ضخمة تقدر بمبلغ 113ألف دينار ذهبي ، كما أجبرت بلنسية على دفع أتاوة مماثلة تقدر بمبلغ 20ألف دينار ذهبي؛ لتفتدي نفسها بذلك من النهب ، والسَّلب ، وهاجمت الجزائر الشرقية (جزر البليار) عدَّة مرات. ونتيجة لتلك اصبحت القوة البحرية الإيطالية هي المتحكمة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، ممَّا دفعها إلى مزيد من المغامرة ، فوجهت نشاطها إلى إفريقية؛ التي كانت لا تزال تحتفظ بقوة بحريَّة تمدُّ يد المساعدة لإخوانهم في صقلية ، أو غيرها من ناحية ثانية.
ثم لتحقيق أهداف الحركة الصليبية في إفريقية من ناحية ثالثة قامت قوة بحرية ضخمة مكونة من أسطولي جنوة، وبيزا مدعومة بفريق من مدينة أمالفي ، وقوة عسكرية أخرى أمدهما بهما البابا لمهاجمة مدينة المهدية سنة 480هـ/1087م أي: بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين ، وقبيل الاستيلاء الكامل على صقلية ، واستولت عليها باستثناء قلعتها ، وظلت في يدها إلى أن دفع صاحبها تميم بن المعز للقوى المتحالفة فديةً ماليةً ضخمةً ، وعقد مع الغزاة معاهدةً ، نصَّ أحدُ بنودها على تعهّد تميم بعدم التعرض للسفن الإيطالية في المياه الإفريقية ، ومنحهم امتيازات تجارية في بلاده ، كما سيذكر في موضعه.
ومما تقدَّم يتَّضح: أنَّ هذا الهجوم الصليبي على القسم الغربي من العالم الإسلامي منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) والذي كانت تدبر دفته البابوية قد احتدم في ثلاث جبهات ، كانت إفريقية إحداها ، ولا شك: أنَّ هذا الهجوم كان وجهاً من أوجه الحركة الصليبية ، وهذا يؤكد: أنَّ الحروب الصليبية بدأت في إفريقية قبل الزحف الصليبي إلى المشرق ، ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 491هـ ؛ إذ يفهم من النصِّ الذي أورده: أنَّ تلك الحوادث كانت مترابطةً ، يحركها محركٌ واحد ، وأنها كانت بداية لموجه الحروب الصليبية في ذلك الطور من أطوار الحركة الصليبية؛ إذ يقول: كان ابتداء ظهور دولة الفرنج ، واشتداد أمرهم، وخروجهم إلى بلاد الإسلام ، واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة ، فملكوا طليطلة ، وغيرها من بلاد الأندلس... ثم قصدوا سنة أربعة وثمانين وأربعمئة جزيرة صقلية، وملكوها.. وتطرقوا إلى إفريقية فملكوا منها شيئاً ، وأخذ منهم ـ ثم ملكوا غيره وغيره على ما تراه ـ فلما كان سنة تسعين وأربعمئة خرجوا إلى بلاد الشام.
وعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الحركة الصليبية إلى المشرق؛ إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء فكرة احتلال إفريقية ماثلةً في أذهان ذوي الأفكار الصليبية ، وبقي تطلع النورمان للاستيلاء عليها قائماً؛ حتى تم لهم ذلك عهد رجار الثاني؛ حيث استولى على معظم سواحلها من طرابلس شرقاً إلى مدينة تونس غرباً في سنة 543هـ/1148م ، فكانت الحرب الصليبية مشتعلةً في الجبهة الإفريقية أثناء احتدامها في جبهة المشرق ، وبقي الوجود النورماني ماثلاً فيها؛ حتى قام عبد المؤمن بن علي زعيم دولة الموحدين بطردهم من المهدية اخر معاقلهم فيها سنة 555هـ/1160م ، وعندما حدث نوع من تبدل ميزان القوى في المغرب الإسلامي؛ نجد ذلك ساهم في جبهة المقاومة الإسلامية في المشرق في عهد نور الدين محمود زنكي ، وصلاح الدين الأيوبي ، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
خامساً: استنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني:
استنجد الإمبراطور الكسيوس كومنين (1081 ـ 1118م) بالبابا أوربان الثاني ضد السلاجقة ، ولم يكن هذا الاستنجاد في الحقيقة الأول من نوعه ، بل سبقه استنجاد الإمبراطور (ميخائيل السابع) بالبابا (جريجوري السابع) عقب موقعة ملاذ كرد 463هـ السالفة الذكر ، فالمعروف: أنَّ شن الحرب على الترك كان من الأغراض التي تنطوي عليها الدعوى البيزنطية ، فالأناضول يعتبر أكثر أهمية من بيت المقدس عند الدولة البيزنطية ، ولذلك لما أصبحت عاصمة البيزنطيين مهددةً من قبل السلاجقة؛ كان لزاما على الإمبراطور أن يستنجد بالغرب في مقابل اتحاد الكنيستين الشرقية ، والغربية ، وقد أرسل البابا جريجوري السابع إلى الإمبراطور ميخائيل السابع رداً مرضياً بدافع العاطفة المسيحية من جهة ، وبدافع سياسي من جهة أخرى ، فما يحشده من جيش سوف يقضي على الانشقاق بين الكنيستين ، ويزيد من نفوذ البابوية في الشرق مثلما زاد في الغرب ، غير أنَّ الحرب التي نشبت بين جريجوري السابع ، والإمبراطور (هنري الرابع) منعته من المضي في مشروعه ، ولما خلف الإمبراطور (الكسيوس كومنين) الإمبراطور ميخائيل السابع؛ بعث برسالة إلى البابا أوربان الثاني ، وإلى كبار رجال الإقطاع سنة 478هـ يدعوهم لإرسال المساعدات لنجدة إخوانهم في الشرق ، وحماية القسطنطينية ضدَّ الخطر السلجوقي .
ولقد كان (الكسيوس) يرغب في أن يبعث له الغرب ببعض الجند المرتزقة ، ولكن البابا أوربان لم يشأ أن يجعل نفسه في خدمة الدولة البيزنطية ، بل أراد أن تتولى البابوية تقديم المساعدة للمسيحين في الشرق ، وهذا التغيير في الفكرة يؤدي إلى أن يحشد العالم المسيحي اللاتيني جيشاً ضخماً ، لا أن يبعث بجنود مرتزقة تخضع لأهواء الأمراء في تصرف البابا مقابل الإمبراطور ميخائيل السابع ، ويبرز أهمية الإبداع ، والتفكير ، واقتناص الفرص ، وتسخير الوسائل في خدمة مشروعهم ، وعلينا أن نستفيد مِنْ هذه الدروسَ الكثيرة لخدمة المشروع الإسلامي. وأثار هذا الاختلاف في التفكير من المتاعب منذ البداية ما أساء العلاقات بين البيزنطيين ، والصليبيين.
والثابت تاريخياً: أنَّ المسؤول الأول عن قيام الحركة الصليبية هو البابا أوربان الثاني ، فهو الذي أنذر بقيام تلك الحروب ، يؤيده في دعواه الجهاز الكنسي في الغرب، وينسب إليه جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين له الدور الرئيسي في تحقيق هذه الفكرة .
يمكنكم تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
http://alsallabi.com/s2/_lib/file/doc/66.pdf