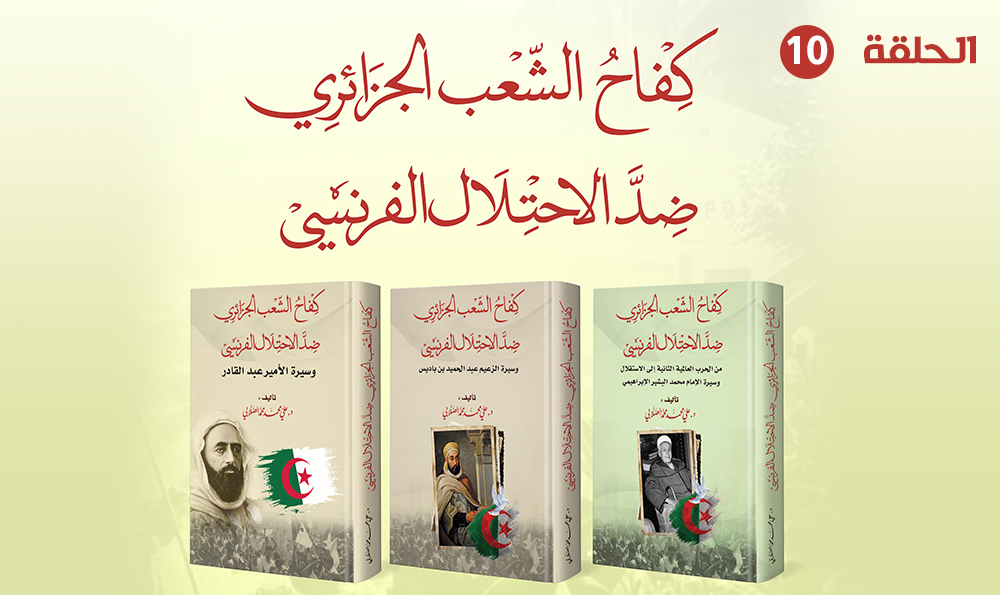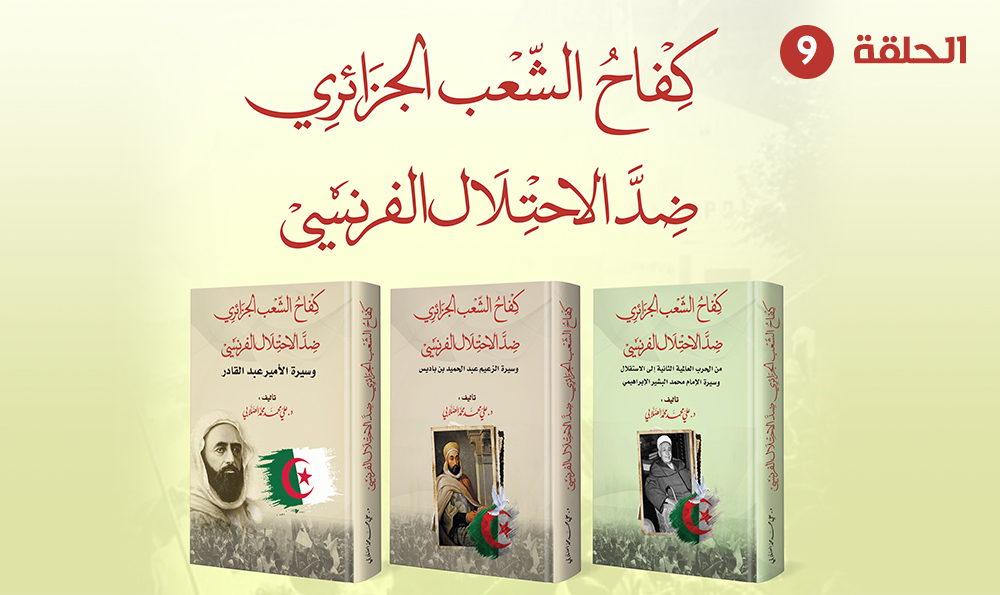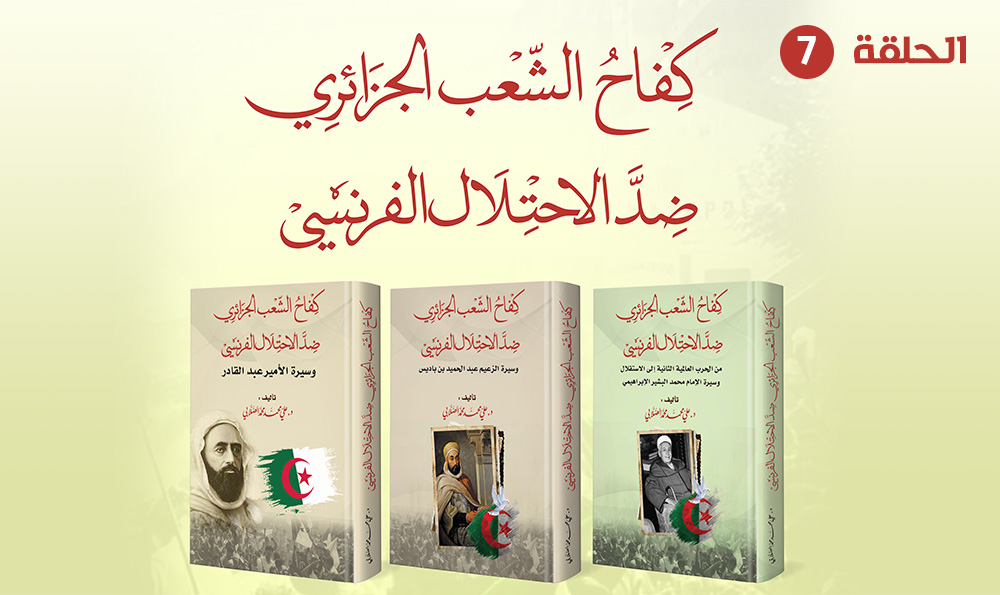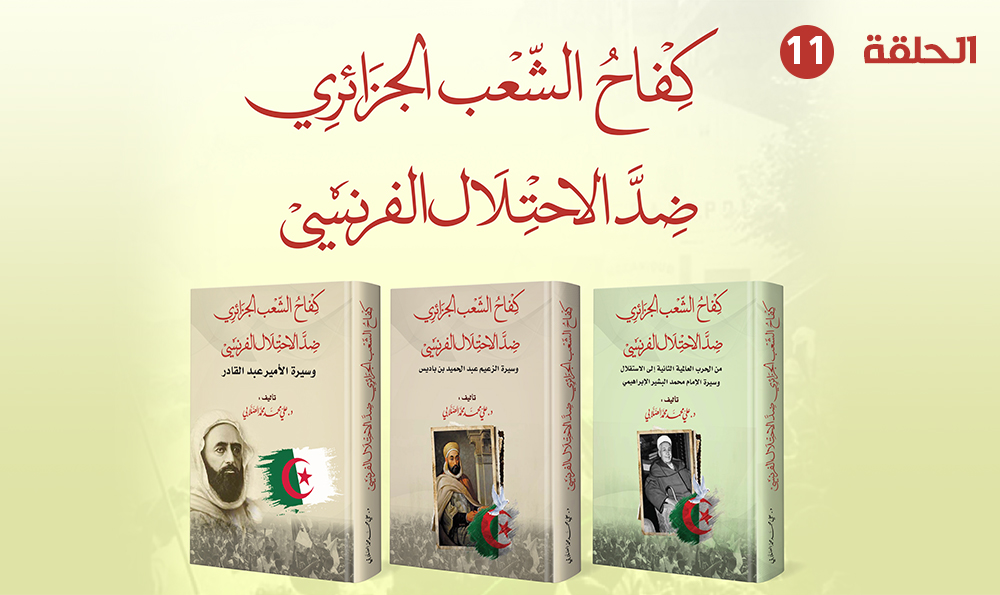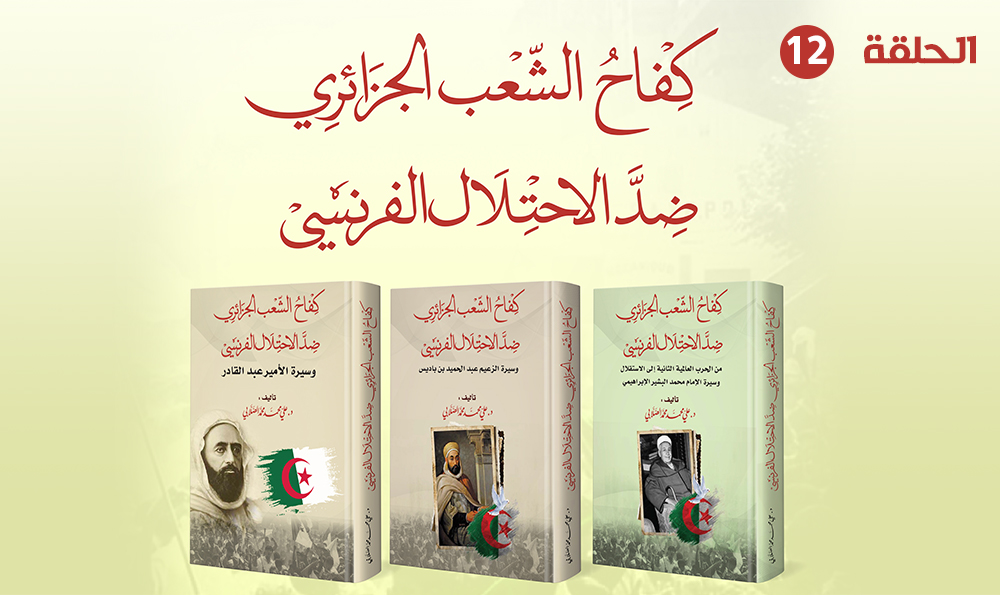من كتاب كفاح الشعب الجزائري، بعنوان:
(العثمانيون في الجزائر)
الحلقة: العاشرة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ سبتمبر 2020
أولاً: قيام الدولة العثمانية:
ينتسب العثمانيون إلى قبيلة تركمانية كانت بداية القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي تعيش في كردستان وتزاول حرفة الرعي. ونتيجة للغزو المغولي بقيادة جنكيز خان على العراق ومناطق شرق اسيا الصغرى، فإن سليمان جد عثمان هاجر في عام (617ه ـ 1220م) مع قبيلته من كردستان إلى بلاد الأناضول فاستقر في مدينة أخلاط، ثم بعد وفاته في عام (628ه ـ 1230م) خلفه ابنه الأوسط أرطغرل، والذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول، وكان معه حوالي مئة أسرة وأكثر من أربعمئة فارس، وحين كان أرطغرل والد عثمان فارّاً بعشيرته التي لم يتجاوز تعدادها أربعمئة عىء لة، من ويلات الهجمة المغولية، فإذا به يسمع عن بُعد جلبة وضوضاء، فلما دنا منها وجد قتالاً حامياً بين مسلمين ونصارى، وكانت كفة الغلبة للجيش البيزنطي، فما كان من أرطغرل إلا أن تقدم بكل حماس وثبات لنجدة إخوانه في الدين والعقيدة، فكان ذلك التقدم سبباً في نصر المسلمين على النصارى.
وبعد انتهاء المعركة قدَّر قىء د الجيش الإسلامي السجلوقي هذا الموقف لأرطغرل ومجموعته، فأقطعهم أرضاً في الحدود الغربية للأناضول بجوار الثغور في الروم، وأتاحوا لهم بذلك فرصة توسيعها على حساب الروم، وحقق السلاجقة بذلك حليفاً قوياً ومشاركاً في الجهاد ضد الروم، وقد قامت بين هذه الدولة الناشئة وبين سلاجقة الروم علاقة حميمية نتيجة وجود عدو مشترك لهم في العقيدة والدين، وقد استمرت هذه العلاقة طيلة حياة أرطغرل، حتى إذا توفي سنة (699هـ/1299م) خلفه من بعده في الحكم ابنه عثمان ؛ الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوسع في أراضي الروم.
ثانياً: عثمان مؤسس الدولة العثمانية:
في عام (656هـ 1258م) ولد لأرطغرل ابنه عثمان الذي تنتسب إليه الدولة العثمانية، وهي السنة التي غزا فيها المغول بقيادة هولاكو بغداد عاصمة الخلافة العثمانية، وكانت الأحداث عظيمة، والمصىء ب جسيمة، يقول ابن كثير: ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الابار وأماكن الحشوش، وقنيّ الوسخ، وكمنوا الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم.
لقد كان الخطب عظيماً، والحدث جلل، والأمة ضعفت ووهنت بسبب ذنوبها ومعاصيها، ولذلك سلط عليها المغول، فهتكوا الأعراض، وسفكوا الدماء وقتلوا الأنفس، ونهبوا الأموال، وخربوا الديار، في تلك الظروف الصعبة والوهن المستشري في مفاصل الأمة ولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وهنا معنى لطيف ألا وهو: بداية الأمة في التمكين هي أقصى نقطة من الضعف والانحطاط. تلك هي بداية الصعود نحو العزة والنصر والتمكين، إنها حكمة الله وإرادته ومشيئته النافذة.
قال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ *} [القصص :4].
وقال تعالى: {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ىء مَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ *وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ *} [القصص :5 ـ 6].
ولا شك أن الله تعالى قادر على أن يمكن لعباده المستضعفين في عشية أو ضحاها، بل في طرفة عين قال تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ *} [النحل :40].
فلا يستعجل أهل الحق وعد الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين، فلابد من مراعاة السنن الشرعية، والسنن الكونية، ولابد من الصبر على دين الله عز وجل: {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد :4].
والله إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه، وأتى به شيئاً فشيئاً، بالتدرج أو دفعة واحدة.
وبدأت قصة التمكين للدولة العثمانية مع ظهور القىء د عثمان الذي ولد في عام سقوط الخلافة العباسية في بغداد.وعندما نتأمل في سيرة عثمان الأول تبرز لنا بعض الصفات المتأصلة في شخصه، كقىء د عسكري، ورجل سياسي، ومن أهم هذه الصفات:
الشجاعة، والحكمة، والإخلاص، والصبر، والجاذبية الإيمانية، وعدله، والوفاء، والتجرد لله في فتوحاته، ولقد كانت شخصية عثمان متزنة وخلابة، بسبب إيمانه العظيم بالله تعالى واليوم الاخر، ولذلك لم تطغ قوته على عدالته، ولا سلطانه على رحمته، ولا غناه على تواضعه، وأصبح مستحقاً لتأييد الله وعونه، ولذلك أكرمه الله تعالى بالأخذ بأسباب التمكين والغلبة، وهو تفضل من الله تعالى على عبده عثمان، فجعل له مكانة وقدرة على التصرف في اسيا الصغرى من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة والوقار. لقد كانت رعاية الله له عظيمة، ولذلك فتح الله له باب التوفيق، وحقق له ما تطلع إليه من أهداف وغاية سامية، لقد كانت أعماله عظيمة بسبب حبه للدعوة إلى الله ؛ فقد فتح الفتوحات العظيمة بحد السيف، وفتوحات القلوب بالإيمان والإحسان، فكان إذا ظفر بقوم دعاهم إلى الحق، والإيمان بالله تعالى، وكان حريصاً على الأعمال الإصلاحية في كافة الأقاليم والبلدان التي فتحها، فسعى في بسط سلطان الحق والعدالة، وكان صاحب ولاء ومحبة لأهل الإيمان، مثلما كان معادياً لأهل الكفران.
ثالثاً: الدستور الذي عليه العثمانيون:
كانت حياة الأمير عثمان مؤسس الدولة العثمانية، جهاداً ودعوة في سبيل الله، وكان علماء الدين يحيطون بالأمير، ويشرفون على التخطيط الإداري والتنفيذ الشرعي في الإمارة، ولقد حفظ لنا التاريخ وصية عثمان لابنه أورخان وهو على فراش الموت، وكانت تلك الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية، سارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد، يقول عثمان في وصيته لابنه:
أ ـ يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين.
ب ـ إذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلاً.
ج ـ يا بني أوصيك بعلماء الأمة أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم.
د ـ اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك الله عنها.
هـ يا بني أحط من أطاعك بالإعزاز، وأنعم على الجنود.
و ـ ولا يغرنك الشيطان بجندك ومالك.
ز ـ وإن بالجهاد يعم نور ديننا كل الافاق فتحدث مرضاة الله عز وجل.
ح ـ من انحرف من سلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر.
ط ـ يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وبالإسلام نموت.
هذه الوصية الخالدة هي التي سار عليها الحكام العثمانيون في زمن قوتهم ومجدهم وعزتهم وتمكينهم.
وترك عثمان الأول الدولة العثمانية، وكانت مساحتها (16000) كيلومتر مربع، واستطاع أن يجد لدولته الناشئة منفذاً على بحر مرمرة، واستطاع بجيشه أن يهدد أهم مدينتين بيزنطيتين في ذلك الزمان وهي: أزنيق وبورصة.
رابعاً: سلاطين العثمانين بعد مؤسس الدولة:
أ ـ تولى السلطان أورخان الحكم بعد وفاة والده عام (726هـ) وسار على سياسة والده نفسها في الحكم والفتوحات، وحرص على تحقيق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، ووضع خطة استراتيجية تستهدف محاصرة العاصمة البيزنطية من الغرب والشرق في ان واحد.
ومن أهم الأعمال التي ترتبط بحياة السلطان أورخان تأسيسه للجيش الإسلامي، وحرصه على إدخال نظام خاص للجيش، فقام بتقسيم الجيش إلى وحدات تتكون كل وحدة من عشرة أشخاص أو مئة شخص أو ألف شخص، وخصص خمس الغنىء م للإنفاق منها على الجيش، وجعله جيشاً دىء ماً بعد أن كان لا يجتمع إلا وقت الحرب، وأنشأ له مراكز خاصة.
ـ واهتم أورخان بتوطيد أركان دولته، وبالأعمال الإصلاحية والعمرانية، ونظم شؤون الإدارة وقوى الجيش، وبنى المساجد، وأنشأ المعاهد العلمية، وأشرف عليها خيرة العلماء والمعلمون، وكانوا يحتفظون بقدر كبير من الاحترام في الدولة.
ب ـ وتولى الحكم بعد السلطان أورخان السلطان مراد الأول عام (761هـ)، وكان مراد الأول شجاعاً مجاهداً كريماً متديناً، وكان محباً للنظام متمسكاً به، عادلاً مع رعاياه وجنوده، شغوفاً بالغزوات وبناء المساجد والمدارس والملاجىء، وكان بجانبه مجموعة من خيرة القادة والخبراء والعسكريين شكل منهم مجلساً لشوراه، وتوسع في اسيا الصغرى وأوروبا في وقت واحد.
واستطاع مراد الأول أن يفتح أدرنة في عام (762هـ)، واتخذ من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية من عام (762هـ)، وبذلك انتقلت العاصمة إلى أوروبا، وأصبحت أدنة عاصمة إسلامية، وكان السلطان مراد الأول يعلم أنه يقاتل في سبيل الله، وأن النصر من عنده، ولذلك كان كثير الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه والتوكل عليه، ومن دعىء ه الخاشع نستدل على معرفة السلطان مراد لربه وتحقيقه لمعاني العبودية، واستشهد في معركة قوصوه ضد الصرب، وقاد السلطان مراد الشعب العثماني ثلاثين سنة بكل حكمة ومهارة، لا يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره.
ج ـ وتولى بايزيد الحكم بعد أبيه مراد عام (791هـ) وكان شجاعاً شهماً كريماً متحمساً للفتوحات الإسلامية، ولذلك اهتم اهتماماً كبيراً بالشؤون العسكرية، واستهدف الإمارات المسيحية في الأناضول، وخلال عام أصبحت تابعة للدولة العثمانية، وكان بايزيد مثل البرق في تحركاته بين الجبهتين البلقانية والأناضولية، ولذلك أطلق عليه لقب «الصاعقة». وانهزم بايزيد أمام جيوش تيمورلنك بسبب اندفاعه وعجلته وعدم إحسانه لاختيار المكان الذي نزل به جيشه. وتعرضت الدولة العثمانية لخطر داخلي، ونشبت الحرب الأهلية في الدولة بين أبناء بايزيد على العرش، واستمرت هذه الحرب عشر سنوات، وكانت هذه المرحلة في تاريخ الدولة العثمانية مرحلة اختبار وابتلاء سبقت التمكين الفعلي المتمثل في فتح القسطنطينية.
د ـ واستطاع السلطان محمد جلبي أن يقضي على الحرب الأهلية بسبب ما أوتي من الحزم والكياسة وبُعْد النظر، وتغلب على إخوته واحداً واحداً حتى خلص له الأمر، وتفرد بالسلطان وقضى سنيّ حكمه في إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها. ويعتبره بعض المؤرخين المؤسس الثاني للدولة العثمانية، واستطاع السلطان محمد جلبي أن يقضي على حركة الشيخ بدر الدين الذي كان يدعو إلى المساواة في الأموال والأمتعة والأديان، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم في العقيدة، وكان السلطان محمد جلبي محباً للشعر والأدب والفنون، وقيل هو أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة.
ه ـ تولى أمر السلطنة مراد الثاني عام (824هـ) بعد وفاة أبيه محمد جلبي، وكان محبّاً للجهاد والدعوة إلى الإسلام، وكان شاعراً ومحباً للعلماء والشعراء.
و ـ تولى محمد الفاتح حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده مراد الثاني عام (855هـ) وكان عمره آنذاك (22) سنة، وقد تميز بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل، كما فاق أقرانه منذ حداثته في كثير من العلوم التي كان يتلقاها في مدرسة الأمراء، وخاصة معرفته لكثير من لغات عصره، وميله الشديد لدراسة التاريخ.
وكانت من أهم أعمال السلطان محمد الثاني فتحه للقسطنطينية، وكان لذلك الفتح أعظم الأثر على العالم الإسلامي والأوروبي. وكان لفتح القسطنطينية أسباب مادية ومعنوية وشروط أخذ بها، وتحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفتح العظيم عندما قال: «لتفتحن القسطنطينية على يد رجل، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» وكان ذلك الفتح في عام (857هـ/1453م).
لقد حرص العثمانيون الأوىء ل على تحكيم شرع الله، وظهرت اثاره الدنيوية والأخروية على المجتمع العثماني، ومنها: الاستخلاف والتمكين، الأمن والاستقرار، النصر والفتح، العز والشرف، انتشار الفضىء ل وانزواء الرذىء ل، وغير ذلك من الآثار.
وكانت من أهم الصفات القيادية في شخصية محمد الفاتح، الحزم والشجاعة والذكاء والعزيمة والإصرار والعدالة، وعدم الاغترار لقوة النفس وكثرة الجند وسعة السلطان، والإخلاص والعلم.
ومن أعمال السلطان محمد الفاتح الحضارية: بناؤه للمدارس والمعاهد، وتكريمه العلماء والشعراء والأدباء والمترجمين، والعمران والبناء والمستشفيات، واهتمامه بالتجارة والصناعة والتنظيمات الإدارية والجيش والبحرية والعدل.
وترك محمد الفاتح وصية عبرت أصدق التعبير عن منهجه في الحياة، وقيمه ومبادئه التي آمن بها، وهذه الوصية جاء فيها:
ـ خذ مني هذه العبرة: حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة، فالزم مسلكي واحذُ حذوي، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله.
ـ كن صالحاً رحيماً.
ـ وابسط على رعيتك حمايتك دون تمييز.
ـ واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض.
ـ قدّم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفتر في المواظبه عليه.
ـ ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين، ولا يجتنبون الكبىء ر، وينغمسون في الفحش.
ـ جانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك عليها.
ـ وسع رقعة البلاد بالجهاد.
ـ واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد.
ـ وإياك أن تمد يدك إلى أموال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام.
ـ واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين.
ـ وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة ؛ فعظّم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال.
ـ حذار حذار لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن مجلسك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا.
ـ واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله.
ـ ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهو أو أكثر من قدر اللزوم، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك.
ز ـ بعد وفاة السلطان محمد الفاتح تولى ابنه بايزيد الثاني (886هـ)، وكان سلطانا وديعاً، نشأ محباً للأدب، متفقهاً في علوم الشريعة الإسلامية، شغوفاً بعلم الفلك. ودخل بايزيد الثاني في صراع مع أخيه جم، واشتبك مع المماليك في معارك على الحدود الشامية وحاول أن يساعد مسلمي الأندلس في محنتهم الشديدة.
ل ـ تولى الحكم السلطان سليم الأول بعد بايزيد الثاني، وكان يحب الأدب والشعر الفارسي والتاريخ، ورغم قسوته فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلم، وكان يصحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتال ليسجلوا تطورات المعارك وينشدوا القصىء د التي تحكي أمجاد الماضي.
وكان للسلطان سليم الأول دور في إضعاف النفوذ الشيعي في العراق وبلاد فارس وحقق انتصاراً عظيماً على الصفويين الشيعة في معركة جالديران.
وكانت نتيجة الصراع بين الدولة العثمانية والصفوية ضم شمال العراق، وديار بكر إلى الدولة العثمانية، وأمَّن العثمانيون حدود دولتهم الشرقية، وسيطر المذهب السني في اسيا الصغرى، بعد أن قضى على أتباع وأعوان إسماعيل الصفوي، واستفاد البرتغاليون من صراع الصفويين مع الدولة العثمانية وحاولوا أن يفرضوا على البحار الشرقية حصاراً عاما على كل الطرق القديمة بين الشرق والغرب.
ودخل السرور على الأوروبيين بسبب الحروب بين العثمانيين والصفويين، وعمل الأوروبيون على الوقوف مع الشيعة الصفوية ضد الدولة العثمانية ؛ لإرباكها حتى لا تستطيع أن تستمر في زحفها نحو أوروبا.
واستطاع العثمانيون أن يحققوا انتصاراً ساحقاً على المماليك في معركة غزة ثم معركة الريدانية وأزاحوا دولة المماليك بعد ذلك من الوجود.
ـ وبعد مقتل السلطان الغوري ونىء به طومان باي ؛ بادر شريف مكة «بركات بن محمد» إلى تقديم السمع والطاعة إلى السلطان سليم الأول، وسلمه مفاتيح الكعبة، وبذلك أصبح السلطان سليم خادماً للحرمين الشريفين.
ـ ودخلت اليمن تحت النفوذ العثماني بعد سقوط دولة المماليك، وكانت تمثل بعداً استراتيجياً، وتعتبر مفتاح البحر الأحمر. وفي سلامتها سلامة للأماكن المقدسة في الحجاز. واستفاد العثمانيون من وجودهم في اليمن فقاموا بحملات بحرية إلى الخليج بقصد تخليصه من الضغط البرتغالي.
ـ وبعد أن ضم العثمانيون بلاد مصر والشام ودخلت البلاد العربية تحت نطاق الحكم العثماني ؛ واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة نادرة، فتمكنت من استرداد بعض الموانىء الإسلامية في البحر الأحمر مثل: مصوع وزيلع، كما تمكنت من إرسال قوة بحرية بقيادة مير علي بك على الساحل الإفريقي، فتم تحرير مقديشو وممبسة، ومُنيت الجيوش البرتغالية بخسىء ر عظيمة. وقد تمكن العثمانيون من صد البرتغال وإيقافهم بعيداً عن الممالك الإسلامية والحدّ من نشاطهم. ونجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر وحماية الأماكن المقدسة من التوسع البرتغالي المبني على أهداف استعمارية وغايات دنيئة ومحاولات للتأثير على الإسلام والمسلمين بطرق مختلفة.
وكانت نتيجة الصراع العثماني البرتغالي: أن احتفظ العثمانيون بالأماكن المقدسة وطريق الحج، وحماية الحدود البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن السادس عشر، واستمرار الطرق التجارية التي تربط الهند وإندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر.
واهتمت الدولة العثمانية بالشمال الإفريقي ووقفت مع حركة الجهاد البحري وقدمت لهم كافة المساعدات المالية والمعنوية.
ودخلت الجزائر تحت نفوذ الدولة العثمانية منذ السلطان سليم الأول. وظهر في ساحة الجهاد في الشمال الإفريقي قىء دان عظيمان هما الأخوان عروج، وخير الدين بربروسا.
خامساً: الأخوان عروج وخير الدين بربروسا:
كان من اثار التهجير الجماعي للمسلمين من الأندلس، ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى الشمال الإفريقي ؛ حدوث العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في ولايات الشمال الإفريقي، ولما كان بين المسلمين النازحين إلى هذه المناطق أعداد وفيرة من البحارة، فكان من الضروري أن تبحث عن الوسىء ل الملىء مة لاستقرارها، إلا أن بعض العوامل قد توافرت لتدفع بأعداد من هؤلاء البحارة إلى طريق الجهاد ضد القوى المسيحية في البحر المتوسط. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب الدافع الديني بسبب الصراع بين الإسلام والنصرانية، وإخراج المسلمين من الأندلس، ومتابعة الإسبان والبرتغال للمسلمين في الشمال الإفريقي.
وقد ظلت حركات الجهاد الإسلامي ضد الإسبان والبرتغاليين غير منظمة حتى ظهور الأخوين خير الدين وعروج بربروسه، اللذين استطاعا تجميع القوات الإسلامية في الجزائر، وتوجيهها نحو الهدف المشترك لصدّ أعداء الإسلام عن التوسع في موانىء ومدن الشمال الإفريقي، وقد اعتمدت هذه القوى الإسلامية الجديدة
في جهادها أسلوب الكرّ والفرّ في البحر، بسبب عدم قدرتها على الدخول في حرب نظامية ضد القوى المسيحية من الإسبان والبرتغاليين وفرسان القديس يوحنا. وقد حقق المجاهدون نجاحا أثار قلق القوى المعادية، ثم رأى المجاهدون بنظرهم الثاقب أن يدخلوا تحت سيادة الدولة العثمانية لتوحيد جهود المسلمين ضد البرتغال والإسبان وحلفىء هم.
وقد حاول المؤرخون الأوربيون التشكيك في طبيعة الحركة الجهادية في البحر المتوسط، ووصفوا دورها بالقرصنة، وكذلك شككوا في أصل قادتها وهما خير الدين وأخوه عروج ؛ الأمر الذي يفرض ضرورة إلقاء الضوء على دور الأخوين وأصلهما وأثر هذه الحركة على الدور الصليبي في البحر المتوسط في زمن السلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني:
أ ـ أصل الأخوين عروج وخير الدين:
يرجع أصل الأخوين المجاهدين إلى الأتراك المسلمين. وكان والدهما يعقوب بن يوسف من بقايا الفاتحين المسلمين الأتراك الذين استقروا في جزيرة مدللي إحدى جزر الأرخيبل، وأمهم سيدة مسلمة أندلسية كان لها أعظم الأثر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد الأندلس، التي كانت تئن في ذلك الوقت من بطش الإسبان والبرتغاليين.
وكان لعروج وخير الدين أخوان مجاهدان، هما إسحاق ومحمد إلياس، ولقد استند المؤرخون المسلمون في أصلهم الإسلامي إلى الحجج التالية:
ـ ما ذكره المؤرخ الجزائري «أحمد توفيق مدني» مستنداً على أثرين ما زالا موجودين في الجزائر: أولهما رخامة منقوشة كانت موضوعة على باب حصن شرشال، وثانيهما رخامة كانت على باب مسجد الشواس بالعاصمة الجزائرية، وقد نقش على الرخامة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله، هذا برج شرشال أنشأه القىء د محمود بن فارس التركي في خلافة الأمير الحاكم بأمر الله المجاهد في سبيل الله «أوروج بن يعقوب» بإذنه بتاريخ أربعة وعشرين، بعد تسعمئة 1518م. ونقش على الرخامة الثانية اسم «أوروج بن أبي يوسف يعقوب التركي»، وهناك ثالثة مسجل عليها بعض ما شيده خير الدين في الجزائر سنة (1520).
ـ إن اسم «عروج» ـ «أوروج» مأخوذ من حادثة الإسراء والمعراج التي يرجح أنه ولد ليلتها، وأن الترك ينطقونه «أوروج» ثم عُرب إلى «عروج».
ـ إن ما ذكر عن الدور الذي لعبه الأخوان يؤكد حرصهما على الجهاد في سبيل الله ومقاومة أطماع إسبانيا والبرتغال في الممالك الإسلامية في شمال إفريقيا، ولقد أبدع الأخوان في الجهاد البحري ضد النصارى، وأصبح لحركة الجهاد البحري في القرن السادس عشر مراكز مهمة في شرشال ووهران والجزائر ودلي وبجاية وغيرها في أعقاب طرد المسلمين من الأندلس، وقد قويت بفعل انضمام المسلمين الفارين من الأندلس والعارفين بالملاحة وفنونها والمدربين على صناعة السفن إليها.
ب ـ دور الأخوين في الجهاد ضد الغزو الصليبي:
اتجه الأخوان عروج وخير الدين إلى الجهاد البحري منذ الصغر، ووجها نشاطهما في البداية إلى بحر الأرخبيل المحيط بمسقط رأسهما حوالي سنة (1510م)، لكن ضراوة الصراع بين المسيحية في بلاد الأندلس وفي شمال إفريقيا وبين المسلمين هناك، والذي اشتد ضراوة في مطلع القرن السادس عشر، قد استقطب الأخوين لينقلا نشاطهما إلى هذه المناطق، وبخاصة بعد أن تمكن الإسبان والبرتغاليون من الاستيلاء على العديد من المراكز والموانىء البحرية في شمال إفريقيا.
وقد حقق الأخوان العديد من الانتصارات على القراصنة المسيحيين ؛ الأمر الذي أثار إعجاب القوى الإسلامية الضعيفة في هذه المناطق، ويبدو ذلك من خلال منح السلطان (الحفصي) لهم حق الاستقرار في جزيرة جربة التونسية، وهو أمر عرّضه لهجوم إسباني متواصل، اضطره لقبول الحماية الإسبانية بالضغط والقوة، كما يبدو من خلال استنجاد هذه البلاد بهما، وتأثيرهما داخل بلادهم، مما أسهم في وجود قاعدة شعبية لهما تمكنهما من حكم الجزائر وبعض المناطق المجاورة.
ويرى بعض المؤرخين أن دخول (عروج) وأخيه الجزائر وحكمهما لها ؛ لم يكن بناءً على رغبة السكان، ويستند هؤلاء إلى وجود بعض القوى التي ظلت تتحيّن الفرص لطرد الأخوين والأتراك المؤيدين لهما، لكن البعض الاخر يرون أن وصول (عروج) وأخيه كان بناء على استدعاء من ساكنيها لنجدتهم من الهجوم الإسباني الشرس ؛ وأن القوى البسيطة التي قاومت وجودهما كانت تتمثل في بعض الحكام الذين أبعدوا عن الحكم أمام محاولات الأخوين الجادة في توحيد البلاد، حيث كانت قبل وصولهما أشبه بدولة ملوك الطوىء ف في الأندلس، وقد ساند أغلب أهل البلاد محاولات الأخوين، واشتركت أعداد كبيرة منهم في هذه الحملات، كما ساندهما العديد من الحكام المحليين الذين شعروا بخطورة الغزو الصليبي الإسباني. ويظهر دور الأخوين المجاهدين في محاولة تحرير بجاية من الحكم الإسباني سنة (1512م)، وقد نقلا لهذا الغرض قاعدة عملياتهما ضد القوات الإسبانية إلى ميناء جيجل شرقي الجزائر بعد أن تمكنا من دخولها وقتل حماتها الجنويين سنة (1514م)، لكي تكون محطة تقوية لتحرير بجاية من جهة، ولمحاولة مساعدة مسلمي الأندلس من جهة أخرى، ويبدو أن الأخوين قد واجها تحالفاً قوياً نتج عنه العديد من المعارك النظامية، وهو أمر لم يتعودوه ؛ ولكن أجبروا عليه بفعل الاستقرار في حكم الجزائر، وزاد من حرج الموقف قتل عروج في إحدى المعارك.
ج ـ محاولة تحرير تلمسان واستشهاد عروج:
جاء وفد من تلمسان يخبر عروج بالفوضى التي تسودها، بسبب النزاع الذي دبَّ بين أمراء العرش الزيني، الذي فقد كل مقاومات البقاء الصالح، وصارت تلمسان مهددة بغزو إسباني ؛ طالبين منه نجدة تلمسان وتخليصها من أبي حمو الثالث الذي هو تحت حماية الإسبان، بعد أن أعلن الطاعة لملك إسبانيا في مدينة برغوس، وأطاح بالملك الزياني الشرعي أبي زيان وسجنه، وانطلق نتيجة لهذا صراع بين الأمراء الزيانيين.
واستجاب الأخوان فوراً لنداء تلمسان لأن هدفهما من السيطرة على جزىء ر بني مرغنة هو تحرير ساحل المغرب الأوسط من الاحتلال الإسباني، والشواطىء الغريبة أكثر عجلة في التحرير لقربها من إسبانيا، وقرر عروج التحرك سالكاً طريق الهضاب الداخلية حتى لا يواجه القواعد الإسبانية بوهران، واتخذ من قلعة بني راشد التي تتوسط بين معسكر ومستغانم مقراً، أقام فيه موقعاً وضع فيه (600) جندي تحت قيادة أخيه الثالث إسحاق بن يعقوب، لحماية طريق مواصلاته، وأمرهم بمناوشة الإسبان حتى يصرف انتباههم عن اكتشاف هدف الحملة نحو تلمسان، ثم تقدم على رأس جيشه ولما وصل سهل أربال وجد أبا حمو على رأس جيش كبير من (6000) فارس و(3000) من المشاة فهاجمه، ونظراً لعدم تمتع جيش حمو بمعنويات عالية بسبب أهدافه المشبوهة وطنياً، فلم يستطيع الصمود أمام عروج، وواصل عروج تقدمه في سرعة نحو تلمسان، التي فتحت له أبوابها واستقبله سكانها كمنقذ من السلطان الخائن.
وقام عروج بإخراج السلطان أبي زيان من السجن وأجلسه على العرش، وأما عمه الخىء ن أبو حمو الثالث ؛ فقد هرب إلى فاس، ومنها توجه إلى وهران ملتجئاً إلى حاكمها الإسباني.
لكن ما إن استقرت الأوضاع قليلاً حتى عادت الفتن بين أمراء بني زيان يغذيها الإسبان وأبو حمو، فقرر عروج مغادرة تلمسان والعودة إليها بخطة بعد أن قتل أبا زيان ورؤوس الفتنة. وأمر ملك إسبانيا شارل كوينتو كارلوس الخامس حاكم وهران أن يعيد أبا حمو إلى عرش تلمسان، وأرسل له عشرة الاف جندي، وخرج أبو حمو من وهران على رأس جنود بدو معه فرقة إسبانية فهاجموا قلعة بني راشد، فدافع عنها إسحاق بن يعقوب وجنده دفاع الأبطال لكنه سقط شهيداً، وذلك في شهر (يناير 1518م)، وتقدم أبو حمو من الشرق، وقام حاكم وهران بإنزال قوة إسبانية ثانية في بلدة رشقون الساحلية وتوجهت مسرعة نحو تلمسان، وحاصرت القوتان تلمسان، وبالرغم من كثرة القوتين إلا أن عروج قاوم مع سكان المدينة، وصمد للحصار ستة أشهر، استطاع الإسبان بعدها فتح ثغرة في السور بالمدفعية، وتحولت المقاومة إلى حرب شوارع، وانسحب عروج إلى قلعة المشوار منتظراً النجدة من سلطان فاس التي لم تصل. وقاوم عروج مع جنوده الأتراك الخمسمئة عازمين على الاستشهاد بدل الاستسلام، وتمكن مع عشرة من رجاله مغادرة القلعة عنوة وفتح طريق نحو البحر، وكسر الطوق وتوجه ناحية الغرب، لكن فرقة من الفرسان الإسبان تعقبته وحاصرته في زاوية سيدي موسى، وقاوم إلى أن استشهد مع الرجال الذين كانوا معه. كان شاهراً سيفه وجهاً لوجه مع قىء د الفرقة الإسبانية، ودخلا في مبارزة، وبالرغم من الإعياء الذي سيطر على قوة عروج إلا أن المبارزة انتهت بغرز كل واحد سيفه في جسد الاخر، وسقط عروج شهيداً عن عمر خمسين سنة.
وهكذا استشهد هذا المجاهد العظيم والسيف في يده يقاتل دفاعاً عن الإسلام في مواجهة الصليبية الإسبانية وعملاءِهم، وكما يقول ش أ جوليان: استطاع أن يضع الأسس لدولة إسلامية قوية وسط محيط من المنافسات القبلية والإمارات المغربية، دون أن تتمكن أوروبا من النيل منها.
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي: