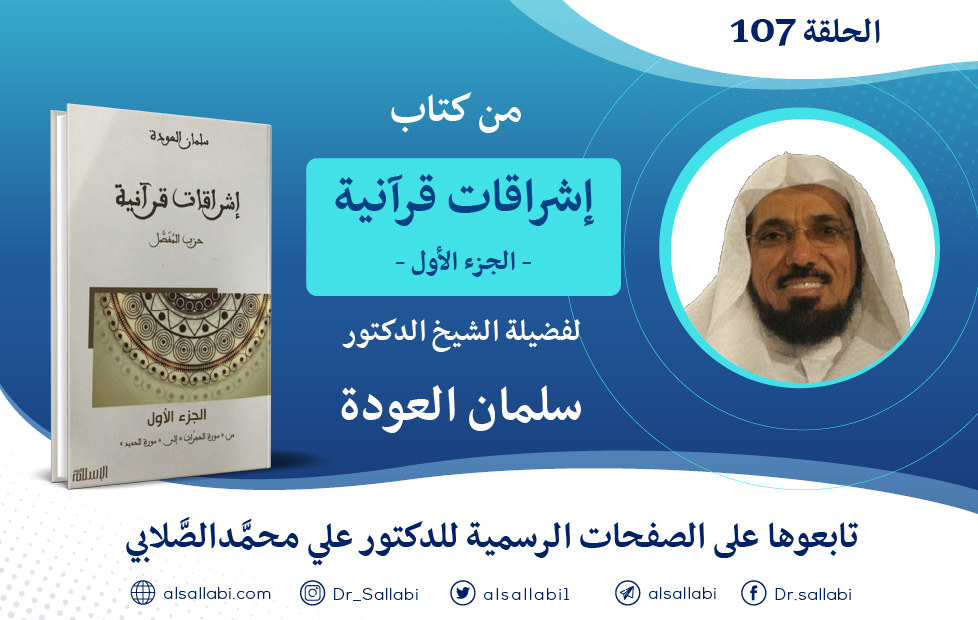من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الفجر)
الحلقة المئة وسبعة
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
شعبان 1442 هــ/ مارس 2021
* {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا }:
والحُب معنًى قلبيٌّ، وهذا يعني: أن قلوبهم معلَّقة بالمال وتملكه بكل سبيل، وأحسن ما قيل في الزهد: أن يكون المال في يدك، وليس في قلبك.
وقد يملك الإنسان المال، ولكن ليس عنده الحب الشديد له، ولذلك لا يبخل به، بل ينفقه ويتصدَّق منه.
والجمُّ: الكثير، كما يقال: جمَّ الماء يجمُّ، إذا كَثُر في عين أو بئر، وبدأ الماء يتجمع شيئًا فشيئًا في أسفلها، والمعنى: تحبونه حبًّا كثيرًا ينمو ويزيد.
* {كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا }:
{ﮪﮫ} الأولى إشارة إلى واقعهم في الدنيا، أي: أن ادعاءهم أن ربهم أكرمهم، أو أهانهم، بناءً على ما أعطاهم في الدنيا ليس صحيحًا.
ثم جاءت {كَلاَّ } الثانية لتنقلَهم إلى عالم الآخرة، أي: أن الدنيا ليست نهاية المطاف، وهب أنك بَقِيْتَ في الدنيا سالمًا غانمًا معافًى إلى وقت الموت، فماذا ينفعك هذا عند الحساب؟
و«الدَّك» ورد في مواضع أخرى؛ كما في «سورة الحاقة»:{وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} ، وهنا قال: {دَكًّا دَكًّا }، وليس المقصود التعدد أو التثنية، بل التوكيد أو التفصيل، كما أقول: إنني أخذت الكتاب فقرأته حرفًا حرفًا. وهذا معناه: أنني استوعبته تمامًا، وليس معناه أنني قرأته مرتين، وكما أقول: عرضت الحساب على فلان رقمًا رقمًا وبابًا بابًا، وهذا معناه: أنني انتقلت معه بالتدريج إلى المسائل كلها، والله أعلم.
وكثير من النصوص تُبيِّن دكَّ هذه الأرض التي فيها الجبال والعمران والمنخفضات، والتي أقمنا عليها العماد، وتحركنا فيها، والتي يمشي الإنسان فيها متبخترًا متكبرًا بخُيَلاءَ وفخرٍ، وهو يظن أنه لا يموت ولا يزول، ولا ينطوي ملكُه، وينسى مَن قبله، وينسى ما بعده، فهذه الأرض كلها سوف تُدَكُّ وتكسَّر وتفتَّت، فكيف بما عليها؟
* {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا }:
مشهد مهيب، ومن المتكلمين مَن يقول: إن هذا محمول على المجاز؛ لأن المجيء في حقيقته انتقال، والانتقال لا يكون إلا للأجساد؛ والله تعالى منزَّه عن التجسيم.
والأولى باللَّبيب أن يتدبَّر الآية، ويتذكر ذلك الموقف المهيب، ولا يشغل نفسه في تأويلها، وكيف يصرفها عما تدل عليه؟!
ولو أننا أبقينا القرآن على جماله ورونقه، ووضوحه وظاهره، لكان هذا الأجدر بالهداية الربانية، ولذلك كان من طريقة السلف: «أمِرُّوا النصوص كما جاءت».
ومن مذهبهم أن كل ما يخطر في الذهن عند قراءة هذه الآية ونحوها خيال بعيد عن الواقع؛ والله منزه عنه، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك.
فإذا قرأت: {وَجَاء رَبُّكَ }، وتخيلت كرسيًّا يُنْصَب، ومَلِكًا يقعد عليه، فإن هذا الخيال الذي في ذهنك مخلوق وجدير بالمخلوقين، ويجب أن يُنـزَّهَ الله عنه.
ولذلك نقول: مَن قال: إن الظاهر غير مراد. فإن قصد بالظاهر هذه الصورة الخيالية التمثيلية التي ارتسمت في أذهاننا ونحن نقرأ السورة، فهو صحيح، ولكننا نقول ببقاء النص على ظاهره، والله سبحانه يجيء من غير تكييف؛ لأننا لا نعلم كيف هو، فلا نعلم كيف أفعاله، ولا كيف صفاته، ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه، والموقف مهيب؛ لأنه إذا كان مجيء ملوك الدنيا من المواقف المهابة، فكيف بمجيء الرب العظيم الكامل في أسمائه وصفاته، وعظمته ومجده، وقدرته وسلطانه؟!!
والمقصود أن الله يجيء لفصل القضاء بينهم، ونصر المظلوم من الظالم، وإعادة الحق إلى أصحابه، وثواب المطيعين المؤمنين الصابرين، وعقاب الكافرين المعاندين!!
فهذا المشهد مشهد عظيم مَهِيب تَوْجَلُ له القلوب، وجلال النص أن يبقى على طلاقته، مع نفي أي صورة متخيَّلة يقترحها الذهن البشري الكليل العاجز.
ثم الملائكة يُصَفُّون صفوفًا بعضهم خلف بعض، وورد أنهم يُصَفُّون سبعة صفوف، وهم محيطون بالبشر، ولهذا: {يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَر * كَلاَّ لاَ وَزَر * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر } [القيامة: 10- 12]، وهذا من معاني المِرصاد!
* {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى }:
جهنَّم: من أسماء النار، وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «يُؤْتَى بجهنَّمَ يومئذٍ لها سبعونَ ألفَ زمام، مع كل زمام سبعونَ ألفَ مَلَك يجرُّونها».
والحديث ورد موقوفًا ومرفوعًا، وكأن الموقوف أشبه، فقد رجَّحه غير واحد، واستدرك الدارقطني على مسلم رفعه.
ويُؤتى بالجنة، كما في قوله سبحانه: {وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَت } [التكوير: 13]، يعني: قُرِّبت من أهلها، وإنما ذكر جهنَّم فقط؛ لأن المقام مقام تهديد ووعيد.
{يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى }: هذا الإنسان الذي كان يقول:
{رَبِّي أَهَانَن } إن مُنع المال والدنيا، ويقول: {رَبِّي أَكْرَمَن } إن أُعطي المال والدنيا، في ذلك الموقف يستعيد ذكرياته، {وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى }: لفظ استفهام، معناه الإنكار أو الاستبعاد، يعني: أَنَّى له أن ينتفع بالذكرى؟! وإلا فهو قد تذكَّر فعلًا، ولكنه لا يستفيد من الذِّكْرى؛ لأن وقت العمل قد ذهب، وجاء وقت الحساب.
* {يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي }:
يقولها بلسانه أو يقولها بقلبه، وهما سِيان، يعني أن الذي مُتِّع في الدنيا، وأُعطي ونُعِّم حتى أسرف على نفسه، واشتغل بملذاتها عن فعل الفرائض والقيام بحق الله، وشك في اليوم الآخر، يأتي يوم القيامة متحسِّرًا على التفريط في جنب الله قائلاً بلسانه أو بقلبه: {يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي } موقنًا أن الحياة الحقة هي الآخرة، {وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ } [العنكبوت: 64].
* {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد * وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد }:
{ﭘ} بكسر الذال، و{يُوثِقُ } بكسر الثاء، وفي قراءة بفتحهما، أي: أن عذاب الله في الدار الآخرة لا يشبهه عذاب أحد من الناس، وكل ما تعرفونه من ألوان العذاب فهو مختلف.
والوَثاق هو: القيد، كما في قوله سبحانه: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ } [محمد: 4]، ولا أحد يوثِق مثل وثاق القيد الذي يجعله الله تعالى للكافرين، كما قال تعالى: {خُذُوهُ فَغُلُّوه * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوه } [الحاقة: 30- 32]، ومَن قرأ هذه الآيات يتخيل سلاسل الحديد الموجودة في الدنيا، ودوائرها الضيقة، ومن ثَمَّ يقع عند الإنسان شيء من التشبيه، ولهذا قال هنا: {لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد * وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد }، فما عند الله من العذاب ومن النعيم لا يخطر على بال، ولا يلحقه خيال.
أو المعنى: لا يعذِّب اللهُ تعالى عذابَ هذا الكافر أحدًا غيره، أي: لا يتحمل أحد عن أحد عذابه ولا وثاقه، فعذاب كل إنسان يتحمله هو، ولا يعذَّبه أحد غيره.
وقد ذكر تعالى في هذه السورة القوة والشدة والوعيد والتهديد والعقوبات الدنيوية للأمم الكافرة، وأما العذاب الحقيقي فهو في الآخرة، ولا يقارن عذاب الآخرة ونكالها بما وقع لهم في الدنيا.
وذِكْر العذاب والوَثاق مناسب مع ما يذكر عن فرعون وغيره من أنهم كانوا يوثِقون ويقيِّدون، ويعذبون مَن لا يوافقهم.
* ثم ختم تعالى السورة بهذا الختام اللَّطيف الدال على رحمته وفضله وكرمه وعطائه ولطفه: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة }:
والسورة فيها مقامان:
1- مقام التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم على فضل الله عليه ومنَّتِه.
2- مقام الإشارة إلى أعدائه وما سيصنع الله بهم.
فالختام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه المطمئنة، وهو خطاب لكل الصالحين، فالنفس هنا هي كلُّ النفوس المطمئنة.
المطمئنة بذكر الله عز وجل؛ فإن ذكر الله طُمأنينة للقلب، كما في قوله تعالى:
{أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب } [الرعد: 28].
المطمئنة بالنظر وإعمال العقل والفكر في ملكوت السماوات والأرض، وفي آيات الله الكونية المخلوقة، وفي آيات الله الشرعية المنزَّلة، كما قال إبراهيم عليه السلام: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﭡ ﭢﭣ} [البقرة: 260]، يعني: أنه كان يريد مزيدًا من الطُّمأنينة، وهي تكون برؤية الملكوت، وتكون برؤية الله عز وجل في الآخرة، وتكون بمحض الفضل من الله، كما في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون } [فصلت: 30]، فهذه النفس المطمئنة تنال الأمن والبشارة.
ومن معاني المطمئنة: المنخفضة، كقولنا: هذه أرض مطمئنة، يعني: غير مرتفعة؛ فمن معانيها: التواضع، فهي متواضعة لعظمة ربها تبارك وتعالى.
ومن معاني المطمئنة: استواء المشاعر من حيث التسليم والرضا بالمقدور في كل حال.
وسبق أن ذكر مَن كانوا إذا أصابهم المال والغنى قالوا: ربُّنا أكرَمَنا. وإذا أصابهم الفقر والجوع والمرض قالوا: ربُّنا أهانَنا. وهذا يدل على أن نفوسهم لم تكن مطمئنة.
وهنا نلحظ التوافق والتناسب بين أولئك الذين قال الله فيهم:{فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ}، وبين الخاتمة هنا في قوله: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة }، وهذا استثناء للنفوس المؤمنة بربها المطمئنة إلى وعده تعالى، فهي مطمئنة بمواقفها ومشاعرها في حال الخوف والأمن، والشدة والرَّخاء، والسَّعة والضيق، والغنى والفقر، والمرض والعافية، والكثرة والقلة، والعزة والذلة، وهي راضية بقضاء الله، ذاكرة له، ممتلئة من الإيمان والتدبر والتأمل في كتابه المشهود «الكون»، وفي كتابه المنزَّل «القرآن».
وقد قسَّم بعض العلماء النفوس إلى ثلاثة أقسام:
1- النفس المطمئنة.
2- النفس اللَّوَّامة.
3- النفس الأمَّارة بالسوء.
وهذه الأقسام يشبه أن تكون أحوالًا للنفس؛ فإن الإنسان يكون في حال مطمئنًّا، وفي حال أخرى لائمًا لنفسه، وفي حال أخرى تكون نفسه أمَّارة بالسوء، ثم قد تستقر النفس في نهاية أمرها على واحدة من الحالات.
* {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة }:
المعنى فيه على قولين:
{ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ } أي: ارجعي إلى الله تعالى، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، وهو الصحيح.
وعن بعض السلف أنه سُئل: كيف القدوم على الله؟ فقال: «أما المحسن، فكالغائب يقدم على أهله مسرورًا، وأما المسيء، فكالآبق يقدم على مولاه محزونًا».
والرجوع هنا كأنه اختياري لها وبطوعها، وقد جاء في «الصحيحين»: «مَن أحبَّ لقاءَ الله أحبَّ اللهُ لقاءَهُ، ومَن كره لقاءَ الله كره اللهُ لقاءَهُ».
فالكافر يُساق سوقًا، كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل في قصة النَّزْع والاحتضار، أن نفسَ الكافرِ وروحَه تتفرَّق في جسده، فتنتزعها الملائكة كما تنتزع السَّفُّود من الصوف المبلول، وأما المؤمن؛ فتخرج روحه كما تخرج القطرة من فيِّ السِّقاء، يعني: بسهولة ولين، وكما في الحديث الآخر: «المؤمنُ يموتُ بعَرَق الجَبين».
أو أن المقصود بقوله: {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ } أي: صاحبك؛ أي: إلى الجسد الذي كنت تعمرينه في الدنيا، وهذا ضعيف.
* {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي }:
أي: فادخلي في عبادي الصالحين، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِين } [العنكبوت: 9]، أي: ضمن عباد الله الصالحين.
{وَادْخُلِي جَنَّتِي }، فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وإلى هذا العطاء الجزيل، وهذا الختام الجميل؛ الذي لن يناله مَن داخله في الدنيا غرور بمال أو سلطان أو جاه، بل مَن اطمأنت نفسه إلى الله، وتواضع لعظمته، واختاره ورضي به.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: