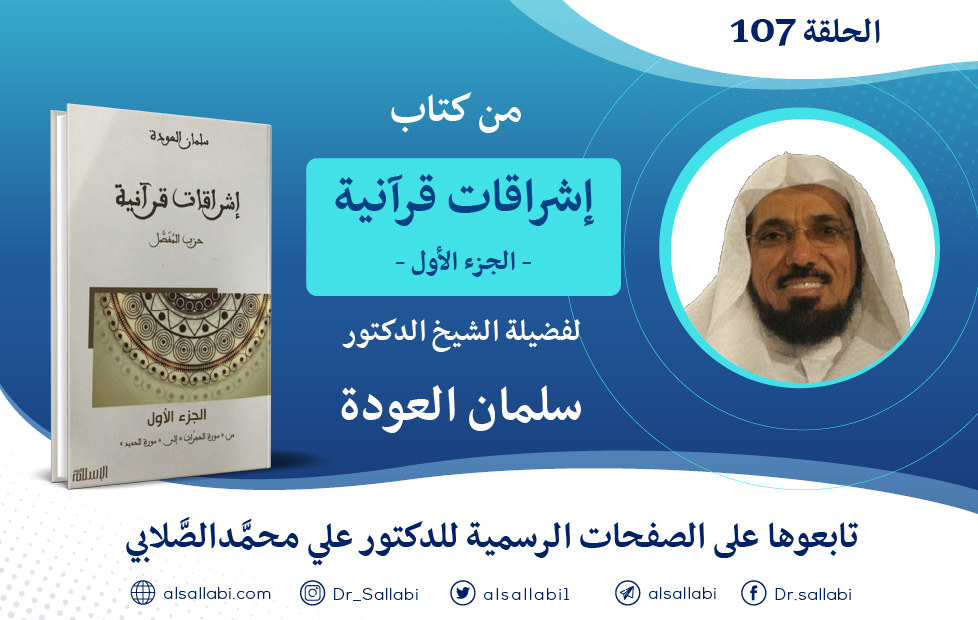من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
(سورة الضُّحى)
الحلقة المئة وأربعة عشر
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
شعبان 1442 هــ/ مارس 2021
* تسمية السورة:
اسمها: «سورة الضُّحى»، أو: «سورة {وَالضُّحَى }»، كما في «صحيح البخاري»، و«جامع الترمذي»، وكتب السنة والتفسير، ولم يُذكر اختلاف في التسمية.
* عدد آياتها: إحدى عشرة آية.
* وهي السورة الحادية عشرة تقريبًا في ترتيب النزول، فهي مكية بإجماع المفسرين، كما ذكر القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي والطاهر ابن عاشور وغيرهم، فقد اتفقوا على مكيتها وتقدُّم نزولها.
ولنزولها سبب مروي في «الصحيحين»، وكتب التفسير، وهو أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أصابه مرض، فترك القيامَ ليلتين أو ثلاثًا، فقال له بعض المشركين: ما نرى ربك إلا قد قَلَاك، أو جفاك. فحزن لذلك صلى الله عليه وسلم، فنزلت.
وفيها الثناء البالغ على النبي صلى الله عليه وسلم، والبُشرى بالوعد الحق له، مما يظهر منزلته عند ربه، وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك أَذيَّة المشركين، لما قالوا له: إن ربك قد جفاك أو قَلَاك.
والله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في الدنيا والآخرة بسبب أعدائه وخصومه، ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة ورِفعة المنزلة، وثقل الميزان في الدار الآخرة، ما لا يحصل عليه إلا بفضله تعالى، ثم بسبب العدو الذي يريد المضرَّة.
وعليه؛ فالسورة نزلت بعد فترة الوحي، أي: فتوره وتأخره، وهذا قال به كثير من المفسرين وأهل السير.
والذي يظهر- والله أعلم- أن الوحي فَتَر في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أولها بعد نزول «سورة {اقْرَأْ }»، ثم أنزل تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّر }، وبضع سور، ثم حصلت فترة ظلت أيامًا معدودة، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت «سورة الضُّحَى».
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيَّأ لنزول «سورة الضُّحى»، كانت قد تَروَّضت نفسُه، واستعدت لتلقِّي الوحي، وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث، فكان بداية ذلك أن يمهِّد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة.
* {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى }:
القَسَم يكون بأمور جليلة عظيمة، والضُّحى هو: أول النهار، وقد يكون ذلك قَسَمًا بالنهار كله، والأقرب أنه بجزء من النهار، وهو بداية حرارة الشمس، قبل وقت القَيْلولة.
يُقسم تعالى ببداية النهار وما فيه من الحياة والإشراق والعمل، كما يُقسم بالليل {إِذَا سَجَى } أي: غطَّى، فالليل لباس يُغَطِّي الكون، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا } [النبأ: 10]، وتقول: هذا رجل مُسجَّى، أي: مُغَطَّى، والمعنى: إذا عمَّ الكونَ وغطَّى بظلامه.
ومن معاني {سَجَى }: هدأ، تقول: البحر الساجي، أي: الذي هدأت عواصفه وأمواجه، وهَدْأَة الليل: آخره، تقول: ائتني هَدْأة الليل؛ أي: إذا سكن الناس، ولم يعد في الطريق ذاهب ولا آيب.
ومن مقاصد هدوء الليل: قلة الناس، وهو الوقت الذي كان يتعبَّد فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وقد ترك صلى الله عليه وسلم قيام الليل ليلة أو ليلتين، بسبب مرض أصابه.
ومن معاني: {سَجَى }: طال، فيكون قَسَمًا بالليل وطوله، وطوله ظرف لتلذذ العُبَّاد الذين يفرحون بالليل كلما طال؛ ويناجون ربهم ذا الجلال، ويتلذذون بقراءة كتابه.
وأطول ما يكون الليل على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنهم لا ينامون بسبب الاشتياق أو الهم أو الحزن، ولا يدرون عمَّ ينجلي، وكثيرًا ما كان الشعراء يشتكون طول الليل، قال أحدهم:
أَرِقْتُ فَباتَ ليلي لا يَزُولُ * وليلُ أخي المصيبةِ فيهِ طولُ
وقال الآخر:
لكلِّ ما يُؤذِي وإِنْ قَلَّ أَلَمْ * ما أطولَ الليلَ على مَن لم يَنَمْ
وقد تكون إشارة إلى معاناة النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الوحي، أو معاناته من الصعوبات التي تعترض دعوته.
وللقَسَم مناسبة لسبب النزول، وارتباطٌ لصيقٌ بالمقسَم عليه، وفيه الجمع بين معنيين مهمين:
1- العمل والنشاط، فالضحى أول النهار الذي هو أول وقت النشاط، وفي الحديث: «اللهمَّ بارك لأمتي في بُكُورها». وإذا سجى الليل فذلك وقت العبادة ووقت العلم والسَّهر على ما فيه من خير، ومصلحة وإنجاز، فهذا يكرِّس الإقبال على الجد والعمل.
2- الهدوء والاستقرار والطمأنينة، فإن بعض الناس قد يغلبه الجد فيتحول إلى أزمة في نفسه، حتى لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يستريح ولا يهنأ بعيش.
وآخرون على النقيض، حياتهم عبث ولهو ولعب، فنهارهم وليلهم ضائع في غير طائل، ولذلك جاء في الحديث: «لا سَمَرَ بعد الصلاة- يعني: العشاء- إلَّا لأحد رجلين: مُصَلٍّ، أو مسافر».
وعُدَّ من السهر المحمود: مداعبة الرجل أهله، ومحادثة ضيفه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء.
ومن معاني القَسَم: ذكر التنوع في خلق الله سبحانه، وما قدَّره من قوة وضعف، وعز وذُل، وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظيم: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن } [الرحمن: 29].
فلا يدوم إنسان على حال، ودوام الحال من المحال، وما يعانيه يتغير كما يتغير النهار والليل.
وكما امتنَّ الله تعالى على البشرية بالليل وما فيه من الهدوء والسكون للكائنات حتى النباتات، امتنَّ عليهم بالنهار وما فيه من الحركة والنشاط.
وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل المظلم، فامتن الله عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة.
وعند ما تقرأ كلام المفسرين حول آية من القرآن، تشعر أن الوقوف عند آية واحدة يمكن أن يمتد كثيرًا في توليد لطائف جديدة.
* {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى }:
هذا المُقْسَم عليه، وهذه الحقيقة التي أراد الله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بها، بعدما قال المشركون: إن ربك ترككَ وقَلَاكَ.
والفرق بين «وَدَّعَ» و«قَلَى»: أن الوَدْع هو: الترك والهجر، والقِلَى هو: البغض، فيكون المعنى: إن الله لم يترك نبيَّه ولم يبغضه.
وفي قراءة: (مَا وَدَعَكَ) بالتخفيف، والمعنى واحد.
ولم يقل: «وما قلاك»؛ رعاية لفواصل السورة؛ لأنها ألف مقصورة؛ ولأن المقصود نفي القَلَى، وهو البغض، فمن محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ضميره لا يجتمع مع لفظ القَلَى، مبالغة في تأكيد الرد على ما ادَّعاه الكفار من ذلك.
وهذه الآية وإن جاءت بصيغة النفي، إلا أن المقصود منها إثبات الحب والوصل، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحيَ مستَمِرٌّ، وأنه رسول الله ونبيه ومصطفاه، وأن الله يحبه ولن يتخلَّى عنه.
* {وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى }:
أي: إن الدار الآخرة خير لك من الدار الدنيا، وكلاهما لك خير.
وثَمَّ معنًى أعمُّ وأشملُ وأعظمُ، وهو أن الحال الآخرة خير لك من الحال الأولى، وكنتُ ذكرته مرة لبعض الإخوة فاستغربوه، ثم وجدتُ نص العلماء عليه، وممن نص عليه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي.
وحاصله أن كل حال لك يا محمد فما بعدها خير منها، وهذا يعني ترقِّي النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل حال آتية فهي أفضل مما قبلها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وهو في أكمل أحواله صلى الله عليه وسلم تقوى وإيمانًا، وعلمًا وعملًا، وكذلك الوحي الذي أرسل به.
وفيه دعوة للمؤمن إلى الترقِّي في مراقي مرضاة الله، وأَلَّا يكتفي بما هو عليه، بل كلما وصل إلى درجة، تطلَّع إلى ما هو خير وأفضل منها.
والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصل، فالحالة الثالثة- التي نزلت فيها هذه السورة- أكمل وأفضل من الحال التي قبلها، ويكفي ما في هذه السورة من البشائر والوعود مما لم يكن من قبل.
وحال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ لما في ذلك من اكتمال الشريعة ونصرة أصحابه، وقوة الدعوة، ومن هذا المعنى أن حاله في الآخرة خير وأفضل من حاله في الدنيا.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: «عُرضَ عليَّ ما هو مفتوحٌ لأمتي بعدي، فسرَّني، فأنزل اللهُ تعالى: {وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى...}». فيكون هذا من معاني الآية.
* {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }:
هذه الآية وما قبلها، كلها في سياق واحد متدِّرج: نفى الله ما زعمه المشركون من تركه أو قَلَاه، وهذا متضمِّن الرضى والمحبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم انتقل إلى بيان أن كل حالٍ له أكمل من التي قبلها، فما ينتقل إليه خير مما انتقل عنه.
ثم جاء الوعد بالعطاء السمح، وهو وعد أُكِّد باللام، وبـ«سوف»، ولم يذكر ماذا يعطيه، فيعم كل عطاء؛ فيعطيه الرسالة، والذكر الطيب، والأصحاب الأفاضل، والعلم الغزير، والمجد والدولة والسلطان، والشفاعة والكَوثر والجنة، والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل، ولا يدركه خيال، ولهذا لم يذكر المفعول الثاني لـ«يُعطِي»، ولم يحدِّد العطاء؛ سيعطيك حتى يرضيك!
إذًا فهو معنيٌّ بإرضائك، وإن كان صلى الله عليه وسلم راضٍ بكل حال، كما قال الشاعر:
رَضِيْتُ في حُبِّكَ الأيامَ جائرةً * فعلقَمُ الدَّهْرِ إن أرضَاك كالعَذْبِ
فهو صلى الله عليه وسلم يرضى عن الله وهو محروم من المال، أو من الأصحاب، أو حين ينزل الموت ببعض أحبابه، أو يؤذيه المشركون، فيحتسب ذلك كله في ذات الله، ويقول: «إِنْ لم يَكُنْ بك غضبٌ عليَّ فلا أُبالي».
وهنا جمع الله له بين الأمرين، بأن يمنحه كمال الرضا وكمال العطاء، وجَعْل العطاء منه، والغاية إليه، فهو سبحانه يحدِّد العطاء ويعلم الرضى، ولا يعني أن للعطاء أمدًا يتوقف عنده؛ لأن ما بعده خير منه؛ كما قضت الآية قبلها!
ويلاحظ أن القَسَم كان بـ{وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى }، وهما أمران، فجاء السياق في بقية الآيات مشابهًا له، فقال أولًا: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } عدم الترك وعدم البغض.
ثم قال: {وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى } وهما أيضًا اثنتان: الآخرة والأولى، وكلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم خير، لكن إحداهما خير من الأخرى.
ثم قال: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } وهما اثنتان: العطاء والرضا، وهذا العطاء له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأمته في الدنيا وفي الآخرة.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: