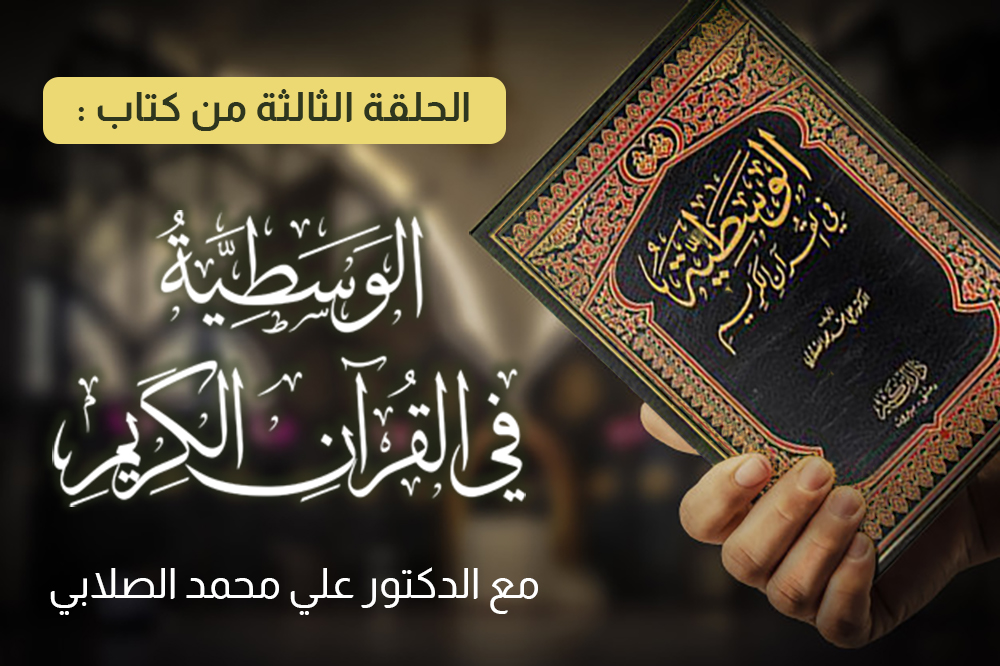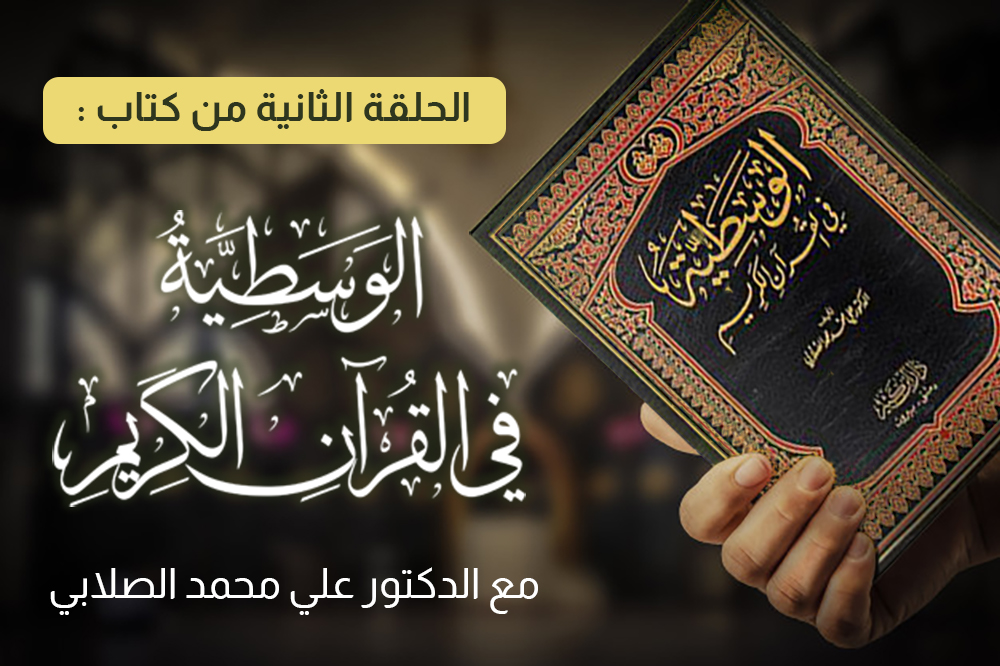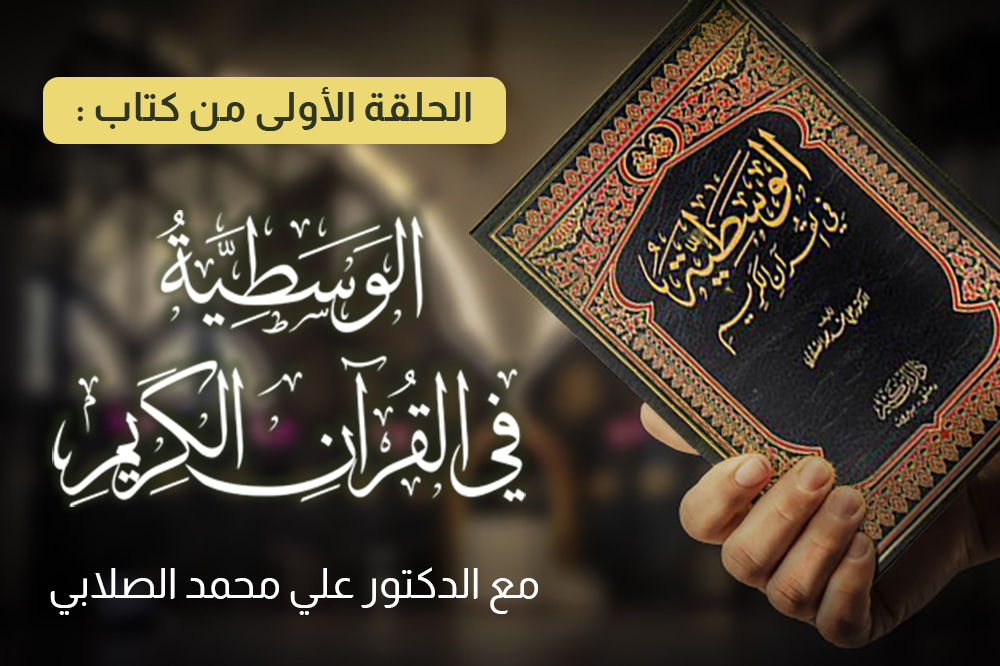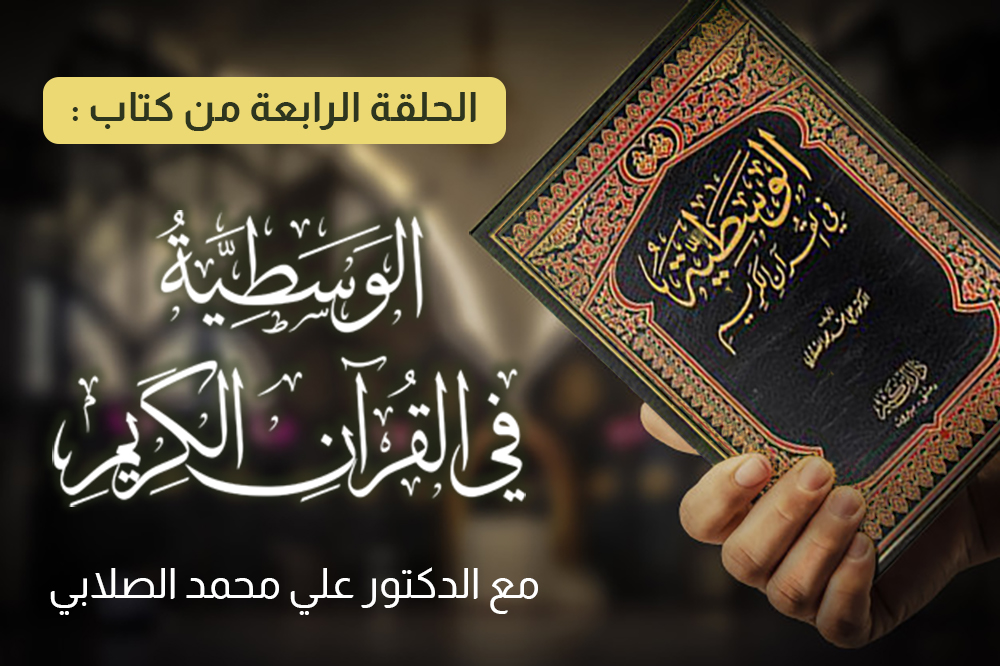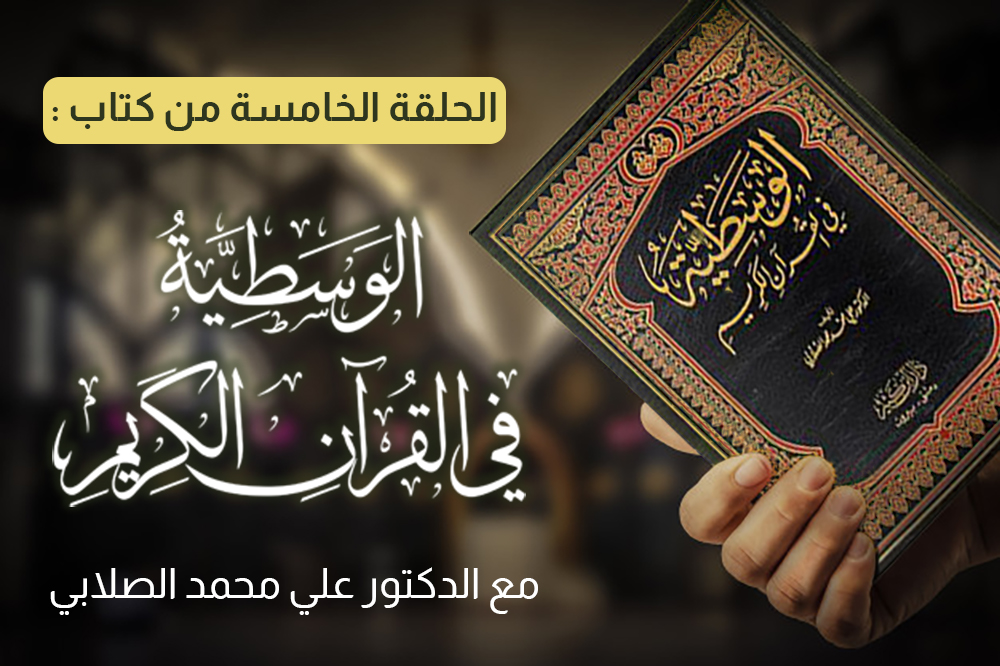من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
(الغلوُّ والإفراط)
الحلقة: الثالثة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
أولاً: الغلو: أما الغلو فقد عرّفه أهل اللغة بأنه مجاوزة الحد، فقال ابن فارس: غلو: الغين، واللام، والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على ارتفاع، ومجاوزة قدر، يقال: غلا السعر، يغلو غلاءً، وذلك ارتفاعه، وغلا الرَّجل في الأمر غلواً: إذا جاوز حدَّه، وغلا بسهمه غلواً: إذا رمى به سهماً أقصى غايته».
وقال الجوهري: وغلا في الأمر، يغلو غلواً؛ أي جاوز فيه الحدَّ وقال صاحب لسان العرب: وغلا في الدِّين، والأمر، والأمر يغلو: جاوز حدّه، وفي التنزيل:{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171]
وقال بعضهم: غلوت في الأمر غلواً، وغلانية، وغلياناً: إذا جاوزت فيه الحدَّ، وأفرطت فيه. وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدِّين..» أي: التشدُّد فيه، ومجاوزة الحدِّ، كالحديث الاخر: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق».
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه، وجاوز المدى، وكله من الارتفاع، والتجاوز. ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا، وغلا النبت: ارتفع، وعظم. هذا معنى الغلو في اللغة، وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي عن الغلوِّ بلفظه الصريح، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} [النساء: 171].
قال الإمام الطبري، رضي الله عنه:
لا تجاوزوا الحقَّ في دينكم، فتفرطوا فيه. وأصل الغلوِّ في كل شيء مجاوزة حدِّه الذي هو حدُّه، يقال منه في الدِّين: قد غلا، فهو يغلو غلوّاً .
وقال ابن الجوزي ـ رضي الله عنه ـ في تفسير هذه الآية: والغلو: الإفراط، ومجاوزة الحدِّ، ومنه غلا السعر. وقال: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم.
وغلوُّ النصارى في عيسى قول بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو ابن الله، وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن: غلوُّ اليهود فيه قولهم: إنه لغير رَشْدَةٍ، وقال بعض العلماء: لا تغلو في دينكم بالزيادة في التشدُّد فيه.
وقال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوِّ، والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا
الحدَّ في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إيَّاه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل غلوا في أتباعه، وأشياعه ممَّن زعم: أنه على دينه، فادَّعوا فيهم العصمة، واتَّبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقّاً، أو باطلاً، أو ضلالاً، أو رشاداً، أو صحيحاً، أو كذباً، ولهذا قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ } [التوبة: 31].
أما الآية الثانية؛ فجاءت في سورة المائدة، قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ *}[المائدة:77].
قال الطبري ـ رضي الله عنه ـ: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحقَّ إلى الباطل، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه).
قال ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ: والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات، والأعمال من سائر الطوائف، وإيَّاهم نهى الله عن الغلوِّ في القرآن.
ومن غلوِّ النصارى ما ذكره الله في سورة الحديد: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}[الحديد:27]
قال ابن كثير ـ رضي الله عنه ـ في تفسير آية المائدة: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ} [المائدة: 77] أي: لا تجاوزوا الحدَّ في اتِّباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه، فتبالغوا فيه؛ حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلـهية، كما صنعتم في المسيح، وهو نبيٌّ من الأنبياء، فجعلتموه إلـهاً من دون الله.
وقد وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن الغلوِّ، وذكر بعضها يساعد على فهم معناه وحده:
1 ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جَمْعٍ: «هَلُمَّ القُطْ لي الحصى»، فلقطت له حصياتٍ هنَّ حصى الخذف، فلما وضعتُهُنَّ في يده؛ قال: «نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغُلُوَّ في الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين».
قال ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ: وهذا عامٌّ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات، والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علَّله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي: هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به: أن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
2 ـ عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطِّعون». قالها ثلاثا.
قال النووي: هلك المتنطعون: أي المتعمِّقون، المغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم، وأفعالهم.
3 ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقول:
«لا تشدِّدوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوماً شدَّدوا على أنفسهم، فشدَّد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، والديار» {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: 27] .
4 ـ وعن أبي هريرةـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ هذا الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسدِّدوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيءٍ من الدُّلجة».
قال ابن حجر رضي الله عنه: والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية، ويترك الرفق إلا عجز، وانقطع فيغلب.
قال ابن رجبـ رضي الله عنه ـ: والتسديد: العمل بالسداد، وهو القصد، والتوسط في العبادة، فلا يقصِّر فيما أمر به، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه.
5 ـ وروى الإمام أحمدـ رضي الله عنه ـ في مسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه».
6 ـ وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
والأحاديث السابقة ترشدنا إلى أنَّ الغلو خروج عن المنهج، وتعدٍّ للحد، وعمل ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي تنهى عن الغلوِّ كثيرة، وليس هدفي في هذا البحث حصرها، وإنما اكتفيت ببعض الأحاديث التي لها دلالة على ما نحن بصدده، وهو تحديد معنى الغلو، ومفهومه، وحكمه، ومن ثم علاقته بالوسطيَّة، ولعلماء المسلمين تعريفات كثيرة لمعنى الغلو، واخترت منها في بحثي هذا تعريفين:
أولاً: تعريف ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ: الغلو مجاوزة الحد: مجاوزة بأن يزاد في الشيء في حمده، أو ذمِّه على ما يستحقُّ، ونحو ذلك.
ثانياً: تعريف ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ إذ يقول: الغلو: المبالغة في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحدِّ.
وضابط الغلو: هو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى عنه في قوله تعالى: {وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81]. سبق من التعريف اللغوي وما ورد فيه من آيات وأحاديث وكذلك من تعريف العلماء يتضح لنا: أن الغلو هو: مجاوزة الحد في الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه، أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده، وقصده الشارع العليم، الخبير، الحكيم.
وقد أفاد، وأجاد الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق في إيضاح حقيقة الغلو، وكشف حدوده، ومعالمه في رسالته العلمية: الغلو في الدين.
وقسَّم الغلو إلى أقسام:
أولاً: إن منشأ الغلو بحسب متعلقه ينقسم إلى ما يلي:
أ ـ إلزام النفس، أو الاخرين بما لم يوجبه الله عز وجل عبادةً، وترهباً، ومقياس ذلك الطاقة الذاتية؛ حيث إن تجاوز الطاقة في أمر مشروع يعتبر غلوّاً. والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
ما رواه أنس بن مالكـ رضي الله عنه ـ قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: «ما هذا الحبل؟» فقالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت؛ تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حلُّوه! ليصلِّ أحدُكم نشاطه، فإذا فتر؛ فليرقد».
قال ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ في شرحه لهذا الحديث: وفيه الحثُّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها.
ب ـ تحريم الطيبات التي أباحها الله على وجه التعبُّد، أو ترك الضرورات، أو بعضها ومن أدلة ذلك قصة النفر الثلاثة، حيث روى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته، فلما أخبروا؛ كأنهم تقالُّوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا؛ فأصلي الليل أبداً! وقال اخر: أنا أصوم الدهر، ولا أفطر! وقال اخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً!
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني! ».
وكذلك لو اضطر مسلم إلى شيء محرم، كأكل حيوان محرم، أو ميتة، وترك ذلك لأنّه محرَّم في الأصل، فإن ذلك يؤدي به إلى الهلكة، وإنَّ ذلك من التشدد. وبيان ذلك: أن الله هو الذي حرم هذا الشيء في حالة اليسر، وهو سبحانه الذي أباح أكله في حالة الاضطرار، قال سبحانه: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *}[البقرة:173].
3 ـ أن يكون الغلو متعلقاً بالحكم على الاخرين، حيث يقف من بعض الناس موقف المادح الغالي، ويقف من اخرين موقف الذامِّ الجافي ، ويصفهم بما لا يلزمهم شرعاً كالفسق، أو المروق من الدين، ونحــو ذلك، وفي كلا الحالين يترتب على ذلك أعمال هي من الغلو، كالحب والبغض، والولاء، والهجر، وغير ذلك.
ثانياً: أن الغلو في حقيقته حركة في اتجاه الأحكام الشرعية، والأوامر الإلهية، ولكنها حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدَّها الشارع، فهو مبالغة في الالتزام بالدين، وليس مروقاً عنه في الحقيقة، بل هو نابع من القصد في الالتزام به.
ثالثاً: إن الغلو ليس هو الفعل فقط، بل قد يكون تركاً، فترك الحلال كالنوم، والأكل، ونحوه من أنواع الغلو، إذا كان هذا الترك على سبيل العبادة، والتقرب إلى الله كما يفعل بعض الصوفية، والنباتيين.
رابعاً: الغلو على نوعين: اعتقاديٌّ، وعمليٌّ.
الاعتقادي على قسمين:
اعتقادي كلي، واعتقادي فقط.
والمراد بالغلو الكلي الاعتقادي ما كان متعلقاً بكليات الشريعة، وأمهات مسائلها.
أما الاعتقادي فقط فهو ما كان متعلقاً بباب العقائد دون غيرها، كالغلو في الأئمة، وادعاء العصمة لهم، أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي، أو تكفير أفراده، واعتزالهم.
ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي الغلو في فروع كثيرة؛ إذ إن المعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي .
أما الغلو الجزئي العملي، فهو ما كان غلواً في جزئية من جزئيات الشريعة، ومتعلقاً بباب الأعمال دون الاعتقاد، فهو محصور في جانب الفعل، سواء أكان قولاً باللسان، أم عملاً بالجوارح.
والغلو الكلي الاعتقادي أشد خطراً، وأعظم ضرراً من الغلو العملي؛ إذ إن الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الشقاق، والانشقاق، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم، وذلك كغلو الخوارج، والشيعة.
خامساً: إنَّه ليس من الغلو طلب الأكمل في كمية العبادة، بل يدخل في تحديد الأكمل أمور عدة تتعلق بالعمل، وبمن قام بالعمل، وكذلك من له صلة بهذا العمل.
فالصدقة ـ مثلاً ـ يراعى فيها: المتصدِّق، والمتصدَّق عليه، والمال المتصدَّق به، ولا يسمى كمالاً كليّاً بالنظر للكمال الجزئي. وذكر ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيد هذا المعنى، ونسبه إلى ابن المنير، فقال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملل، أو المبالغة في التطوُّع المفضي إلى ترك الأفضل.
سادساً: إنَّ الحكم على العمل بأنه غلو، أو أن هذا المرء من الغلاة باب خطير لا يقدر عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل، وتبحروا في علوم العقائد وفروعها ؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فقد يكون الأمر مشروعاً ويوصف صاحبه بالغلو، وها نحن نرى اليوم: أن الملتزمين بشرع الله، المتمسكين بالكتاب والسنة يوصفون بالغلو، والتطرف، والتزمُّت ونحوها، ولذلك فإن المعيار في الحكم على الأعمال، والأفراد، والجماعات هو الكتاب، والسنة، وليست الأهواء، والتقاليد، والأعراف، والعقول، وما تعارف عليه الناس، فقد ضل في هذا الباب أمم، وأفراد، وجماعات.
وبعد أن اتضح لنا معنى (الغلو) لغة وشرعاً، وما يتعلق به من معانٍ، وأقسام، أوضح معنى (الإفراط) بإيجاز، حيث ستتضح صلته بالغلو.
ثانياً: الإفراط:
لغة هو: التقدم، ومجاوزة الحد.
قال ابن فارس: يقال: أفرط: إذا تجاوز الحدَّ في الأمر. ويقولون: إياك والفرط؛ أي لا تجاوز القدر، وهذا هو القياس ؛ لأنه إذا جاوز القدر؛ فقد أزال الشيء عن وجهته.
وقال الجوهري: وأفرط في الأمر؛ أي جاوز فيه الحدَّ.
والفُرطة ـ بالضم ـ اسم للخروج والتقدُّم، ومنه قول أم سلمة لعائشةـ رضي الله عنهما ـ: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن الفُرطة في البلاد». وفي رواية: نهاك عن الفرطة في الدين، يعني: السبق، والتقدم، ومجاوزة الحد.
والإفراط: الإعجال، والتقدم، وأفرط في الأمر: أسرف، وتقدَّم، وكل شيء جاوز قدره فهو مفرط .
قال تعالى: {قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى *}[طه: 45 ]
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: وأما الإفراط؛ فهو الإسراف، والإشطاط، والتعدي، يقال منه: أفرطت في قولك: إذا أسرف فيه، وتعدَّى، وأما التفريط؛ فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر؛ حتى فات: إذا توانى فيه.
ونخلص مما سبق إلى أن معنى الإفراط: تجاوز الحد، والتقدُّم عن القدر المطلوب، وهو عكس التفريط، وسيأتي.
وقد تبيَّن مما سبق من تعريفي الغلو، والإفراط: أنَّ كلاً منهما يصدق عليه تجاوز الحد، وقد فسر الغلو بالإفراط كما سبق، وأن كل واحد منهما يحمل معنى أبلغ من الثاني في بعض ما يستعمل فيه، فالذي يشدد على نفسه بتحريم بعض الطيبات، أو بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من الإفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبةً يتعدَّى بها حدود مثل تلك العقوبة، الإفراط ألصق به من الغلو، وهكذا.
والذي يهمنا في هذا المبحث: أن كلاً من الغلو والإفراط خروج عن الوسطيَّة، فكل أمر يستحق وصف الغلو، أو الإفراط فليس من الوسطيَّة في شيء.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/29.pdf