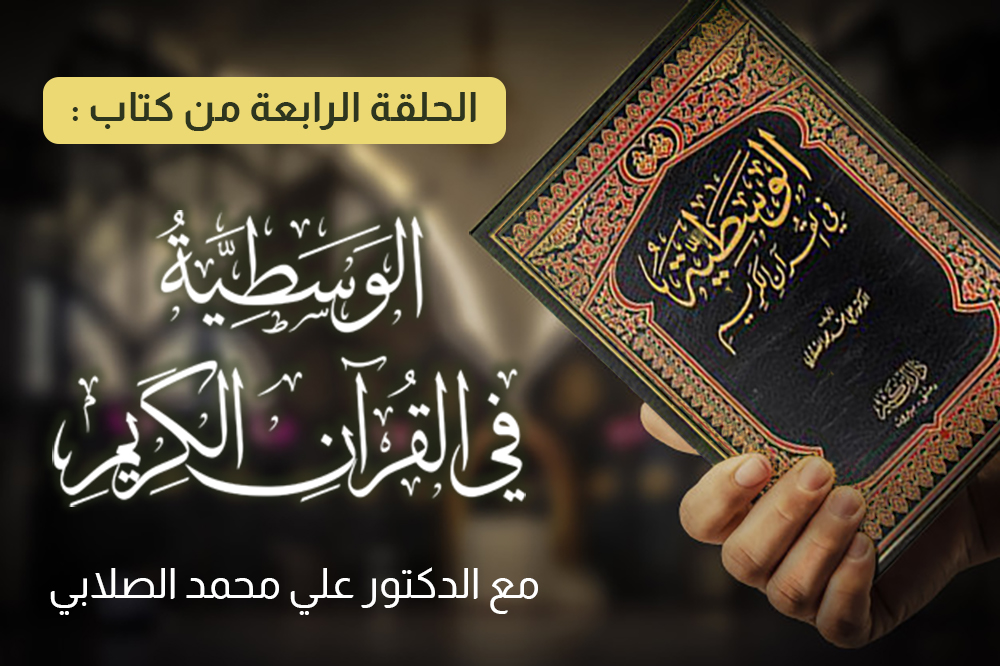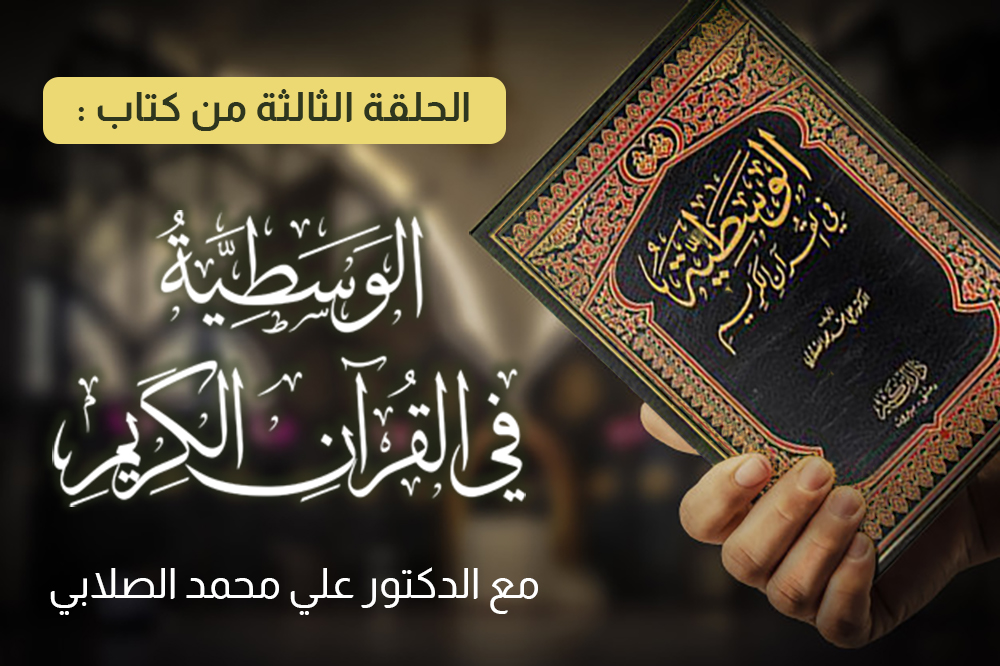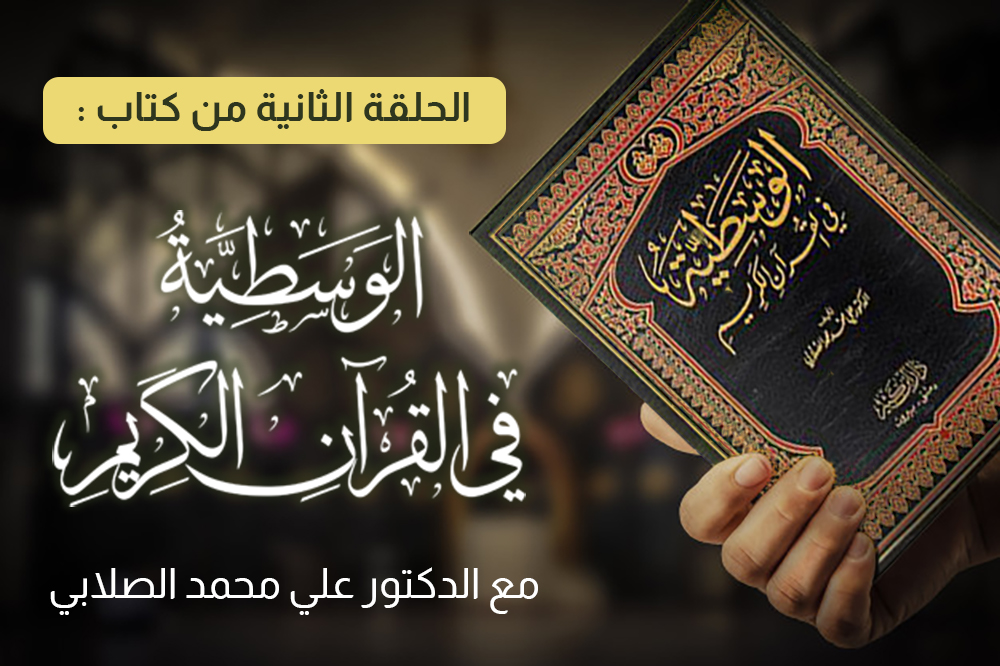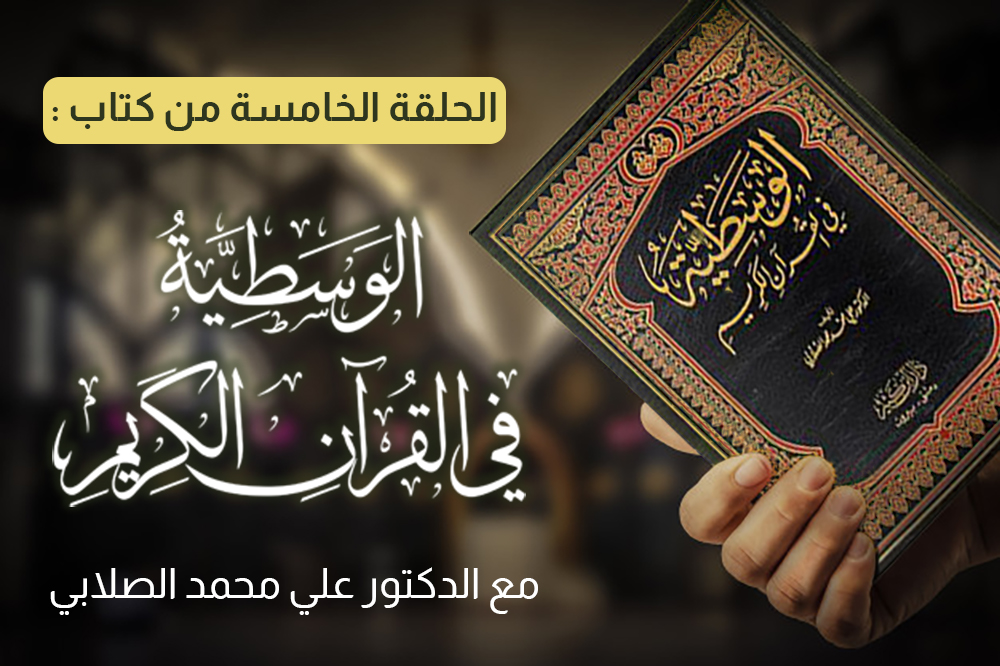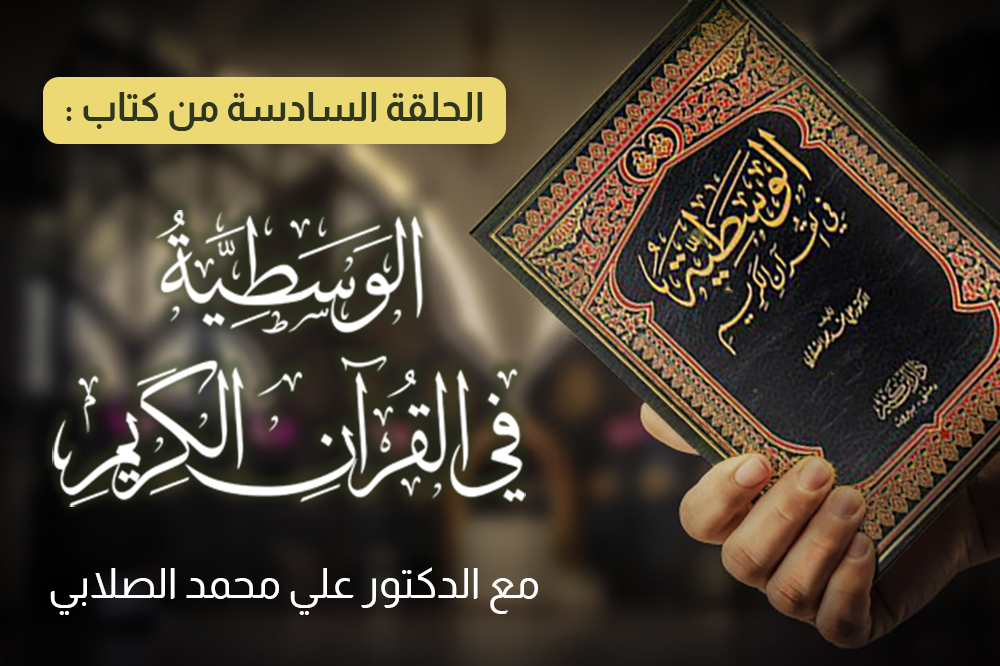من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
(التفريط والجفاء)
الحلقة: الرابعة
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
أولاً: التفريط: وبعد أن اتَّضح لنا معنى الغلو، والإفراط، وما يدلُّ عليه كل منهما نقف الآن مع ما يقابلهما، وهو التفريط، والجفاء. والتفريط في اللغة هو التضييع كما في لسان العرب.
وفي حديث عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ: (لا يُرى الجاهل إلا مفرِّطاً أو مُفْرِطاً)، وهو بالتخفيف المسرف في العمل، وبالتشديد المقصِّر فيه، وفرط في الأمر يفرط فرطاً، أي: قصر فيه، وضيعه؛ حتى فات، وكذلك التفريط.
ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أما إنه ليس في النوم تفريط» وإذاً فالتفريط هو التقصير، والتضييع، والترك.
قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: وكذلك التفريط، وهو التقصير ؛ لأنه إذا قصر فيه؛ فقد قعد عن رتبته التي هي له.
وقال الجوهري ـ رحمه الله ـ: فرط في الأمر فرطاً، أي: قصر فيه، وضيعه؛ حتى فات، وكذلك التفريط.
وقد وردت مادة (فرط) في القرآن في عدة مواضع.
قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا}[الأنعام:31].
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها!
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ: وفرطنا معناه: ضيعنا، وأصله التقدُّم، فقولهم: فرطنا، أي: قدمنا العجز.
وقيل: (فرطنا) أي جعلنا غير الفارط السابق لنا إلى طاعة الله، وتخلفنا.
وقال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام:38].
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: ما ضيعنا إثبات شيء منه.
وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أم الكتاب.
وقال تعالى:
{حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام: 61]
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: قد بيَّنا: أنَّ معنى التفريط: التضييع فيما مضى قبل، وكذلك أوّله المتأولون في هذا الموضع. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: {وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ *} يضيعون.
وفي سورة يوسف: {وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ}[يوسف:80].
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: ومن قبل فِعْلتكم هذه تفريطُكم في يوسف، يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم في يوسف.
قال القاسمي ـ رحمه الله ـ: { فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ} قصَّرتم في شأنه.
وقال تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ *}[النحل:62].
قال سعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ: {وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ *} منسيون، مضيعون. وقال قتادة ـ رحمه الله ـ: (مضاعون).
وقال آخرون: إنهم معجَّلون إلى النار، مقدَّمون إليها، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب: أفرطنا فلاناً في طلب الماء: إذا قدموه لإصلاح الدلاء. وقيل غير ذلك، ورجَّح الطبري ـ رحمه الله ـ: أنَّ معنى (مفرطون): مخلفون، متروكون في النار، منسيُّون فيها.
وقال تعالى في سورة الكهف: {وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا *} [الكهف: 28] روي عن مجاهد رحمه الله ـ: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا *}: ضائعاً. وروي عنه: ضياعاً .
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ضياعاً، وهلاكاً، ومنه قولهم: أفرط فلان في هذا الأمر إفراطاً: إذا أسرف فيه، وتجاوز قدره، وكذلك قوله: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا *}معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا الرياء ، والكبر، واحتقار أهل الإيمان سرفاً قد تجاوز حدَّه، فضيع بذلك الحقَّ، وهلك.
وقال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: في الآية أربعة أقوال؛ أحدها: أنه أفرط في قوله.
والثاني: ضياعاً. والثالث: ندماً. والرابع: كان أمره التفريط. والتفريط: تقديم العجز.
وفي سورة الزمر: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ *}[الزمر:56].
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصَّرت في الدنيا في طاعة الله.
وقال القاسمي ـ رحمه الله ـ: {يَاحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} أي: قصرت { فِي جَنْبِ اللَّهِ}، أي : في جانب أمره، ونهيه.
هذا تفسير الآيات التي ورد فيها ما يدلُّ على التفريط، ومن خلال أقوال المفسرين تبيَّن: أنها تدل على الترك، والتهاون، والتقصير، والتضييع مع اختلاف بسيط بين مدلول هذه المعاني، وكلُّها في مقابل الإفراط، والغلوِّ.
ثانياً: الجفاء:
قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: الجيم، والفاء، والحرف المعتل يدلُّ على أصل واحد: نبو الشيء عن الشيء، من ذلك: جفوت الرجل جفوة، وهو ظاهر الجفوة، أي الجفاء، وجفا السرج عن ظهر الفرس، وأجفيته أنا. وكذلك كلُّ شيء إذا لم يلزم شيئاً، يقال: جفا عنه، يجفو.
والجفاء: خلاف البر. والجفاء: ما نفاه السيل، ومنه اشتقاق الجفاء.
وقال ابن منظور: جفا الشيء، يجفو جفاءً، وتجافى: لم يلزم مكانه، كالسرج يجفو عن الظهر وكالجنب يجفو عن الفراش، وفي التنزيل: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16]، وفي الحديث: «اقرؤوا القرآن، ولا تجافوا عنه». أي: تعاهدوه، ولا تبتعدوا عن تلاوته.
وفي الحديث : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء من النار».
وفي الحديث أيضاً: «من بدا جفا». بدا: بالدال المهملة: خرج إلى البادية، والجفاء غلظ الطبع. وفي صفته صلى الله عليه وسلم: ليس بالجافي المهين. أي: ليس بالغليظ الخلقة، ولا الطبع.
وقال الله تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً}[الرعد:17].
قال الطبري ـ رحمه الله ـ: زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة: أن معنى قوله: تنشفه {فَيَذْهَبُ جُفَاءً}، وقال: يقال: جفا الوادي، وأجفى: في معنى: نشف.
وقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16] قال الطبري رحمه الله ـ: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بايات الله الذين وصفت صفتهم، وترفع عن مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم، ولا ينامون.
تتجافى: تتفاعل من الجفاء، والجفاء: النبوُّ. وإنما وصفهم ـ تعالى ذكره ـ بالتجافي في جنوبهم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلاً بالصلاة.
ثم قال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأنَّ جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلاً منهم بدعاء ربهم، وعبادته، وخوفاً، وطمعاً، وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً... إلخ.
وبذلك يتضح: أن الجفاء هو النبو، والترك، والبعد، وهو غالباً ما يحدث خلاف الأصل والعادة، وأكثر ما تستعمل كلمة جفاء لما هو محرَّم منهي عنه كالجفاء بما يقابله الصلة والبر، والجفاء الذي هو من الشدَّة، والغلظة.
وهذه أمثلة يتضح فيها معنى التفريط، والجفاء:
1 ـ عقوق الوالدين جفاء.
2 ـ تأخير عمل اليوم إلى الغد ـ دون سبب ـ تفريط.
3 ـ إهمال تربية الأولاد تفريط.
4 ـ ترك الأخذ بالأسباب تفريط.
5 ـ رؤية المنكرات وعدم إنكارها مع القدرة على ذلك تفريط.
6 ـ الغلظة في المعاملة جفاء.
7 ـ تأخير الصلاة عن وقتها تفريط.
8 ـ السلبية مع واقع المسلمين، وشؤونهم، وشجونهم جفاء، وتفريط.
9 ـ عدم القيام بحقوق العلماء، وضعف الصلة بهم جفاء، وتفريط.
10 ـ قطع الأرحام، وعدم صلتهم جفاء، وتفريط.
وبهذا يتبين معنى التفريط، والجفاء، وأن بينهما عموماً، وخصوصاً، وهما يقابلان معنى الغلو، والإفراط.
وعند التأمل في استعمال العرب لهما يلاحظ:
ـ أنَّ الجفاء يستعل ـ غالباً ـ فيما فيه قصد الأمر من الترك، والبعد، وسوء الخلق. أما التفريط فمنشؤه ـ غالباً ـ التساهل، والتهاون.
ـ أنَّ كل أمر اتَّصف بالتفريط، أو بالجفاء فإنه يخالف الوسطيَّة، وبمقدار اتصافه بأيٍّ من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطيَّة، وتجافيه عنها.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/29.pdf