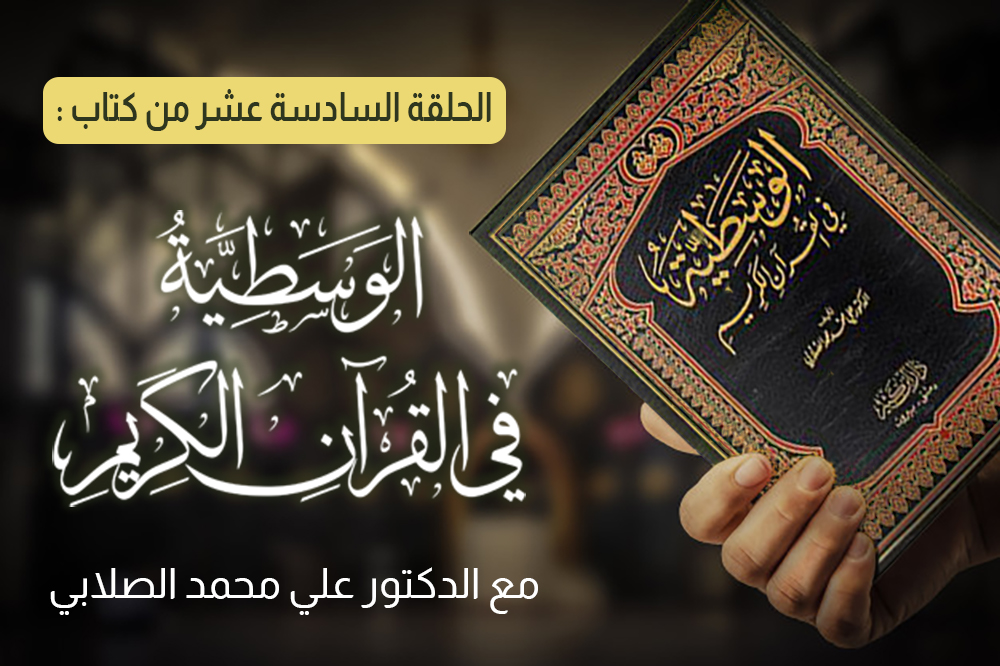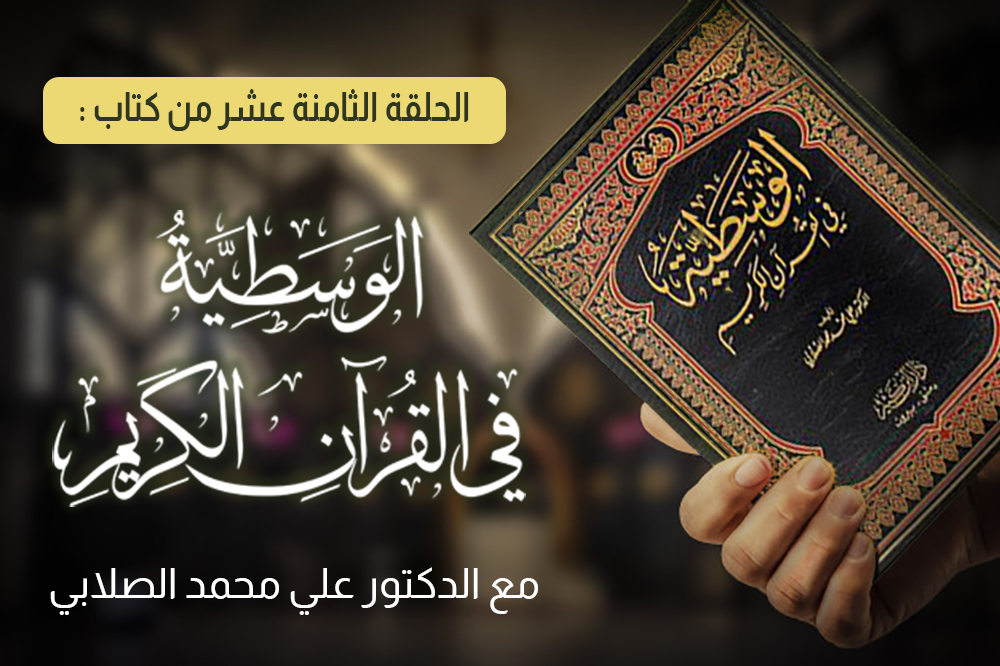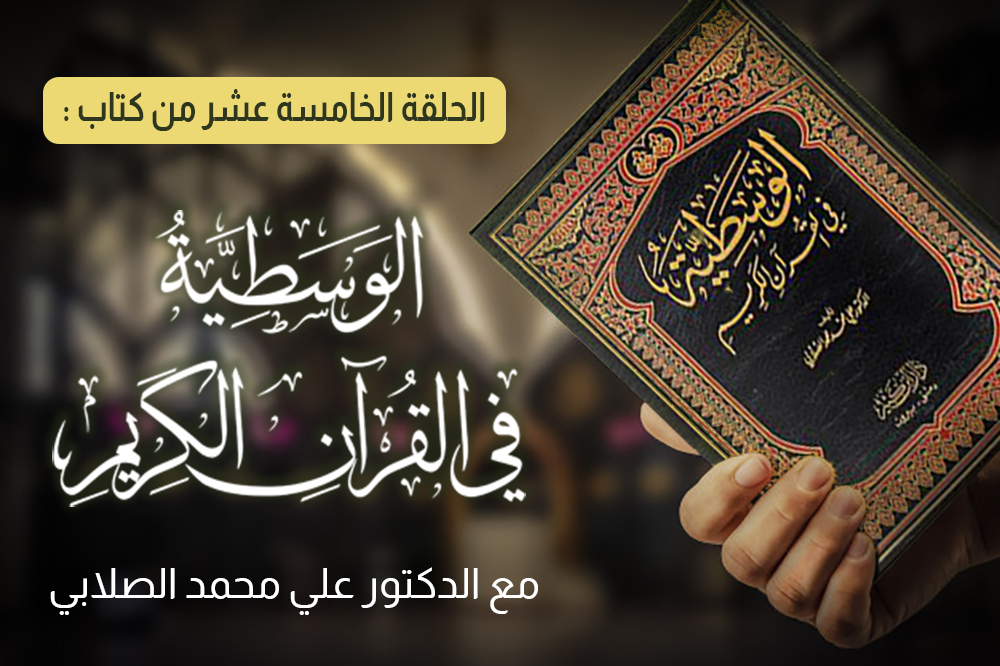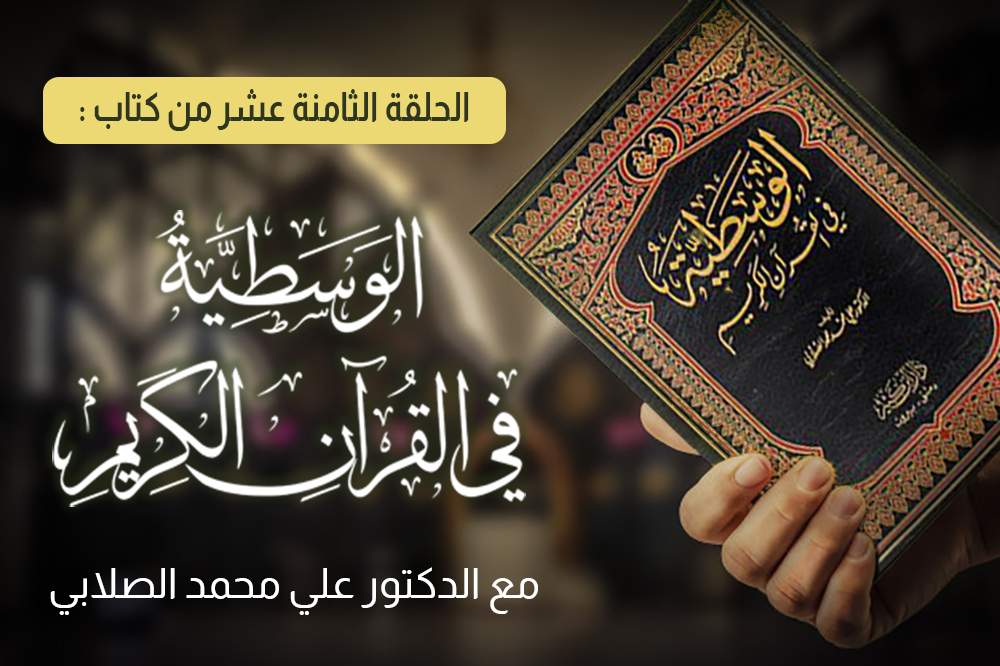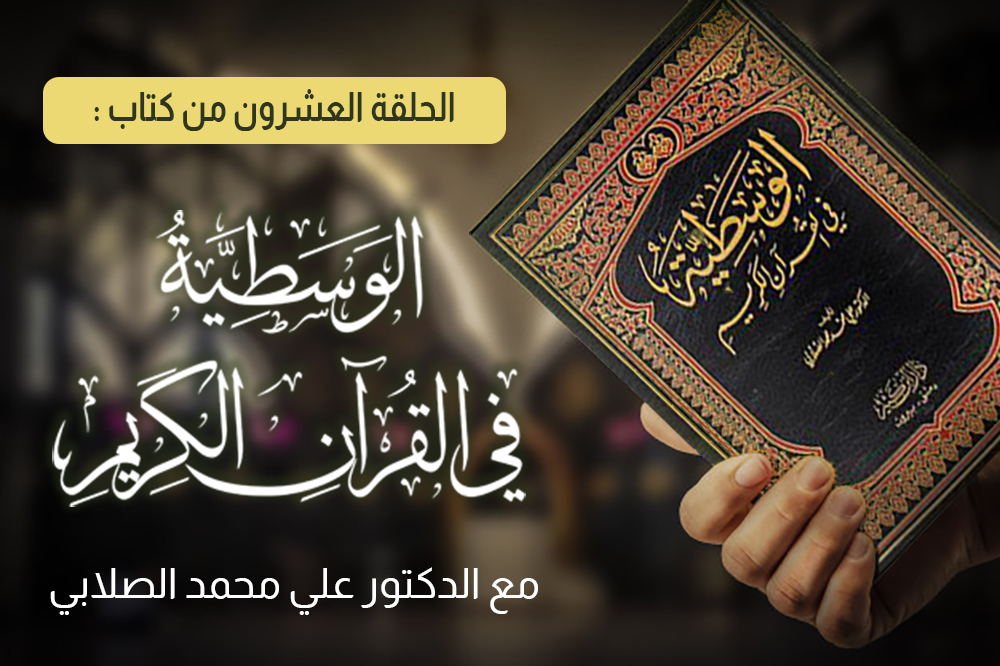من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
الحلم كركن من أركان الحكمة
الحلقة: السادسة عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
الحلم: بالكسر: العقل، وحلم حلماً: تأنَّى، وسكن عند غضب، أو مكروه مع قدرة، وصفح، وعقل ومن أسماء الله تعالى: (الحليم) وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقداراً، فهو مُـنْـتَهٍ إليه. والحلم: ضبط النفس، والطبع عن هيجان الغضب.
والحلم: هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب، والبلادة، فإذا استجاب المرء لغضبه بلا تعقل، ولا تبصر؛ كان على رذيلة، وإن تبلَّد، وضيَّع حقَّه، ورضي بالهضم، والظلم؛ كان على رذيلة، وإن تحلَّى بالحلم مع القدرة، وكان حلمه مع من يستحقه؛ كان على فضيلة.
وهناك ارتباط بين الحلم، وكظم الغيظ، وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلم: وهو كظم الغيظ، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة، لما في كظم الغيظ من كتمان، ومقاومة، واحتمال، فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس، وأصبح طبعاً من طبائعها؛ كان ذلك هو الحلم. والله أعلم.
وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدَّة مواضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *} [آل عمران: 155] ونلاحظ: أن الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة الحلم في الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطأ واقع، أو تفريط في أمر محمود، وهذا أمر يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً}[فاطر:45].
ونجد أيضاً: أنَّ عدداً من الآيات التي وصفت الله بالحلم قد قرن فيها ذكر الحلم بالعلم، كقوله تعالى: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ *} [الحج: 59] وهذا يفيد ـ والله أعلم بمراده ـ: أنَّ كمال الحلم يكون مع كمال العلم، وهذا من أعظم أركان الحكمة التي هي من أهم ملامح الوسطيَّة.
ومما يؤكد: أنَّ الحلم من أعظم أركان الحكمة ـ التي ينبغي للداعية أن يدعو بها إلى الله ـ مدح النبي (ص) للحلم وتعظيمه لأمره، وأنه من الخصال التي يحبُّها الله، قوله للأشجِّ: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة».
وفي رواية الأشجِّ: يا رسول الله! أنا تخلقت بهما، أم الله جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، ورسوله!
وسبب قول النبي (ص) ذلك للأشجِّ ما جاء في حديث الوفد: أنهم لما وصلوا المدينة؛ بادروا إلى النبي (ص) وأقام الأشجُّ عند رحالهم، فجمعها، وعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي (ص) فقرَّبه النبي (ص) وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي (ص): «تبايعون على أنفسكم وقومكم؟» فقال القوم: نعم، فقال الأشج:ُّ يا رسول الله! إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا؛ كان منا، ومن أبى؛ قاتلناه. قال: «صدقت! إنَّ فيك خصلتين...».
فالأناة: تربصه حتى ينظر في مصالحه، ولم يعجل، والحلم: هذا القول الذي قاله، الدال على صحة عقله، وجودة نظره للعواقب... ومما يؤكد: أن الحلم من أعظم أركان الحكمة، ودعائمها العظام: أنه خلق عظيم من أخلاق النبوة والرسالة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عظماء البشر، وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحين في الأخلاق المحمودة كافة.
وقد واجه كل واحد منهم من قومه ما يثير الغضب، ويغضب منه عظماء الرجال، ولكن حلموا عليهم، ورفقوا بهم حتى جاءهم نصر الله، وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم، وخاتمهم (ص) ولم يكن غريباً أن يوجهه الله تعالى إلى قمة هذه السيادة حين يقول له: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ *وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *}[الأعراف: 199 ـ 200]، {وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *}[فصلت: 34]، وقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} آل عمران: 159].
وقد بلغ (ص) في حلمه، وعفوه في دعوته إلى الله تعالى الغاية المثالية، والدلائل على ذلك كثيرة جدّاً، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 ـ عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنت أمشي مع النبي (ص) وعليه بردٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ، فجبذه بردائه جبذة شديدة؛ حتى نظرت صفحة عاتق النبي (ص) قد أثرت به حاشية الرداء من شدَّة جبذته، ثم قال: يا محمد! مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليَّ رسول الله (ص) فضحك، ثم أمر له بعطاء».
وهذا من روائع حلمه (ص) وكماله، وحسن خلقه، وصفحه الجميل، وصبره على الأذى في النفس، والمال، والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأس به الدعاة إلى الله، والولاة بعده في حلمه، وخلقه الجميل من الصفح، والإغضاء، والعفو، والدفع بالتي هي أحسن.
2 ـ وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ: «أنه غزا مع رسول الله (ص) قِبَل نجد، فلما قفل رسول الله (ص) قفل معه، فأدركتهم القافلة في وادٍ كثير العِضَاه، فنزل رسول الله (ص) وتَفرَّق الناس يستظلُّون بالشجر، فنزل رسول الله (ص) تحت شجرة، وعلَّق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول الله (ص) يدعونا، وإذا عنده أعرابيٌّ، فقال: «إن هذا اخترط عليَّ سيفي؛ وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: «الله» (ثلاثاً). ولم يعاقبه، وجلس.
وفي هذا دلالة واضحة على قوة يقينه بالله، وصبره على الأذى، وحلمه على الجهَّال، وشدة رغبته في استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في الإسلام، ولهذا ذكر: أن هذا الأعرابي رجع إلى قومه، وأسلم، واهتدى به خلق كثير. وهذا ممَّا يؤكد: أن الحلم من أعظم أركان الحكمة، ودعائمها.
3 ـ ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من اذاه من قومه، وقد كان باستطاعته أن يدعو عليهم، فيهلكهم الله، ويدمرهم، ولكنه (ص) حليم حكيم يهدف إلى الغاية العظمى، وهي رجاء إسلامهم، أو إسلام ذرِّيتهم، ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كأني أنظر إلى رسول الله (ص) يحكي نبيّاً من الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: «اللَّهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون!».
ومما يدلُّ على أن الحلم ركنٌ من أركان الحكمة ملازمةُ صفة الحلم للأنبياء قبل النبي (ص) في دعوتهم إلى الله تعالى.
فهذا إبراهيم أبو الأنبياء ـ عليه، وعليهم الصلاة والسلام ـ قد بلغ من الحلم مبلغاً عظيماً؛ حتى وصفه الله بقوله: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *}[التوبة:114].
فقد كان إبراهيم كثير الدعاء، حليماً عمَّن ظلمه، وأناله مكروهاً، ولهذا استغفر لأبيه مع شدَّة أذاه له في قوله: {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي ياإِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا *قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا *وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا *}[مريم: 46 ـ 48].
فحلم عنه مع أذاه له، ودعا له، واستغفر، ولهذا قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *}[التوبة: 114] وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين، كانوا من أعظم الناس حلماً مع أقوامهم في دعواتهم إلى الله تعالى.
ومن وراء الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يأتي الدعاة إلى الله، والصالحون من أتباعهم، وإذا كان الله ـ عز وجل ـ قد جعل محمداً (ص) مثلاً عالياً في الحلم، فقد أراد لأتباعه أن يسيروا على نهجه، وسنته، ولذلك يقول تعالى عن الأخيار من هؤلاء: {وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا *} [الفرقان: 63] فمن صفاتهم: أنهم أصحاب حلم ، فإذا سفه عليهم الجهال بالقول السيِّأى؛ لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون، ويصفحون، ولا يقولون إلا خيراً كما كان رسول الله (ص): ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً.
وينبغي أن يُعلم: أن الغضب لله يكون محموداً، ولا يدخل في الغضب المذموم، فالغضب المحمود يكون من أجل الله عندما تُرتكب حرماتُ الله، أو تترك أوامره، ويستهان بها، وهذا من علامات قوة الإيمان، ولكن بشرط ألا يخرج هذا الغضب عن حدود الحلم والحكمة، وقد كان رسول الله (ص) يغضب لله إذا انتهكت محارمه، وكان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله، لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادماً، ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وقد خدمه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عشر سنوات، فما قال له: أفِّ قطُّ، ولا قال له لشيء فعله: لم فعلت كذا؟، ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا.
وهذا لا ينافي الحلم، والحكمة، بل الغضب لله في حدود الحكمة من صميم الحلم والحكمة. وقوله: وقوله: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [البقرة: 231] وقوله : { لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ *}[آل عمران: 164].
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ *}[الجمعة: 2] وغير ذلك من الآيات...
وممَّن فسَّر الحكمة المقرونة بالكتاب وبالسنة: الإمام الشافعي، والإمام ابن القيم، وغيرهما من الأئمة.
يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي