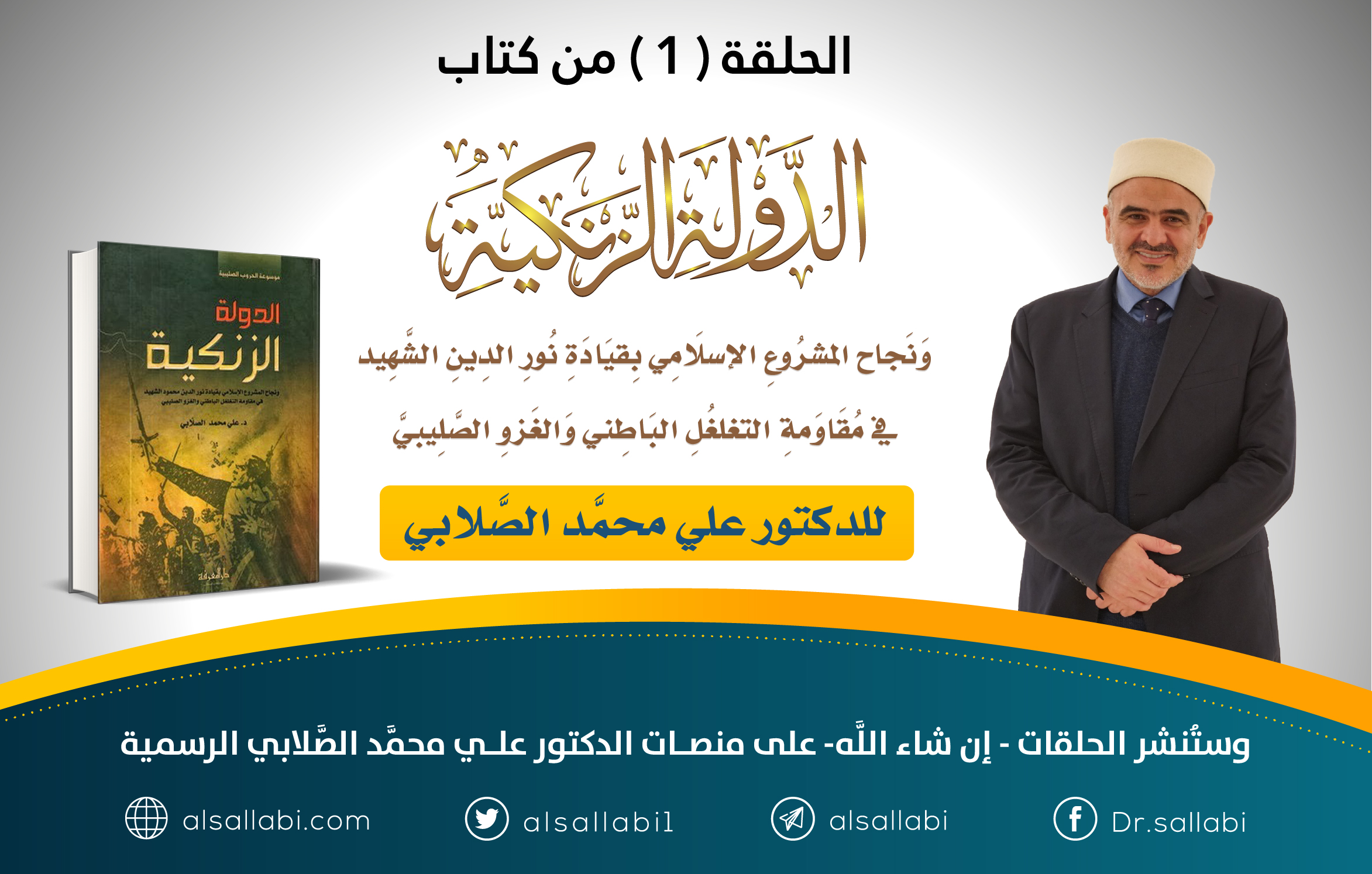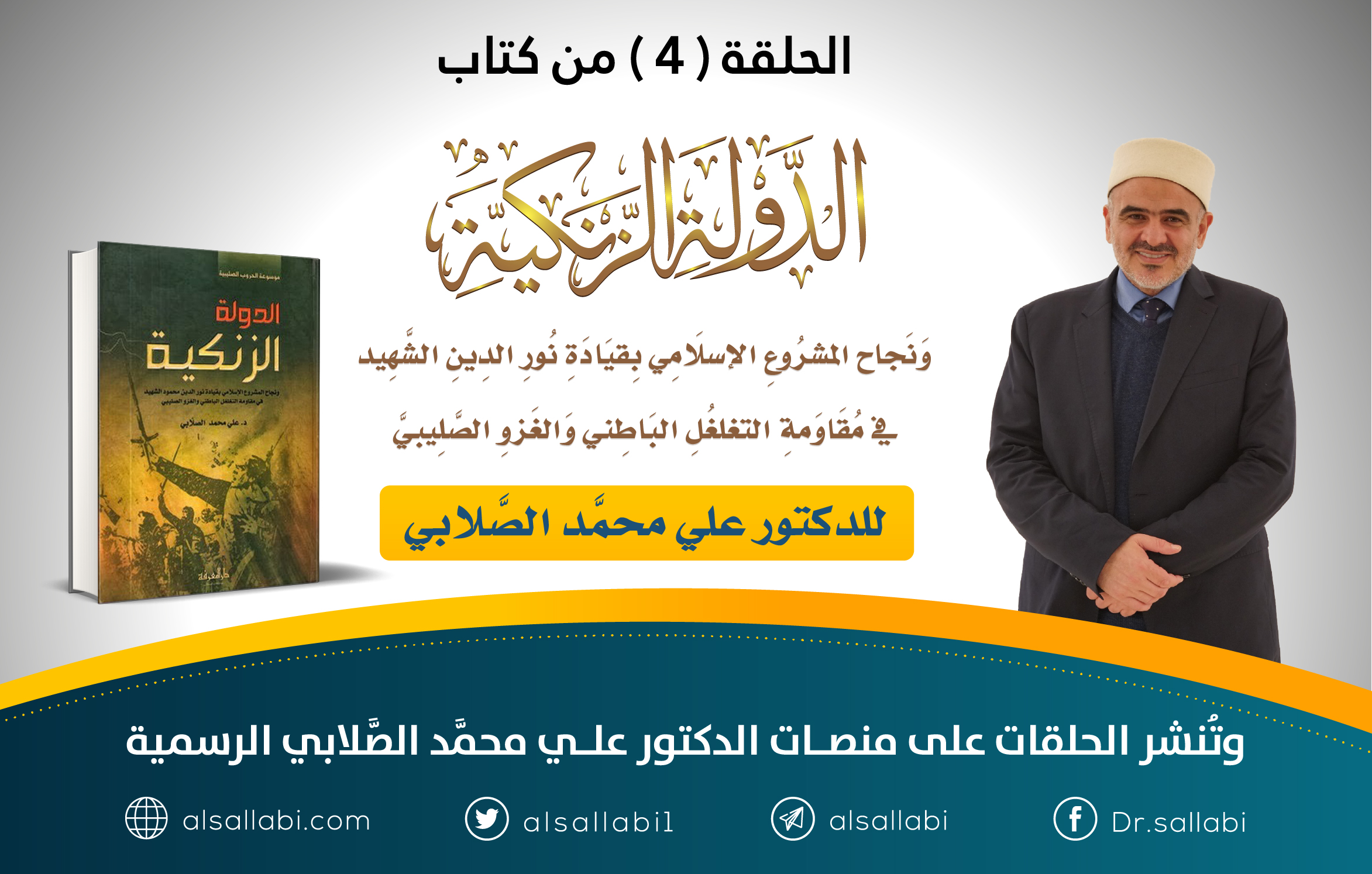(سياسة آق سنقر في حلب الداخلية)
الحلقة: 02
بقلم: د. علي محمد الصلابي
ذو الحجة 1443 ه/ يوليو 2022م
بدأت مع تولي آق سنقر الحكم في حلب مرحلة جديدة من حكم السلاجقة المباشر لهذه المدينة ، وانتهى حكم القبائل العربية لهذه الإمارة، وأزيحت عن مسرح الأحداث في شمالي بلاد الشام ، ويُعدُّ سُنْقُر أول حاكم سلجوقي لإمارة حلب بعدما كانت سنوات طويلة من التمزق والحروب بين القبائل العربية فيما بينها ، ثم بينها وبين التركمان القادمين من الشرق ، ودامَ حكمه ثماني سنوات تقريباً كانت مرحلة هامة في
تاريخ الإمارة والمنطقة بفعل: أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت كل جوانب الحياة ،(1) لقد تسلم آق سُنقر الحكم في ظل حالة من الفوضى التامة بفعل عاملين: داخلي ، وخارجي ، يتمثل الأول بصراع الحكَّام ، وتدبيرهم المؤامرات ، واستعانتهم بالقوى الكبرى في المنطقة كالخلافة العباسية في بغداد ، والدولة الفاطمية في مصر بالإضافة إلى الدولة السلجوقية الجديدة الطامعة في التوسع في المنطقة هي:
1 ـ قوة القبائل العربية البدوية وبخاصة الكلابيين العقيليين والمرداسيين لاستعادة نفوذها المسلوب.
2 ـ قوة التركمان المدمِّرة التي كانت تغير على المنطقة.
3 ـ قوة الدولة البيزنطية التي كانت تستغلُّ الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها المفقود.
شهدت حلب نتيجة ذلكَ أوضاعاً من عدم الاستقرار السياسي ، انعكسَ سلباً على الأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية ، والأمنية فيها في خضم هذه الصراعات ، وتغافل الحكام عن الاهتمام بالشؤون الداخلية للسكان ، كما أهملوا تطوير الحياة الاقتصادية ، مما أدَّى إلى تراجع واردات البلاد ، وعمدوا إلى استنزاف السكان بفرض ضرائب أخرى وأتاوات باهظة كلما أعوزهم المال ، حتى أثقلوا كاهلهم ، فتذمروا من سوء الأوضاع ، وكثر انتشار اللصوص وقطاع الطرق ، مما أدَّى إلى انعدام الأمن على الطرق ، فتعطلت الحركة التجارية ، وقلَّت السلعُ في الأسواق ، وتراجعت موارد الزراعة لعدم تمكُّن الفلاحين من القيام بالحرث والزرع وجني المحصول ، فبرزت في هذه الظروف الصعبة منظمة الأحداث التي أخذت على عاتقها رعاية مصالح أفرادها ومقاومة التعديات الخارجية ،(2) ووضع اق سنقر نصب عينيه هدفاً راحَ يعمل على تحقيقه ، تمثل في إعادة الأمور إلى نصابها ، ولذلكَ شرعَ في:
1 ـ إقامة الحدود الشرعية ، وطارد اللصوص وقطاع الطرق ، وقضى عليهم ، وتخلص من المتطرفين في الفساد ، كما قضى على الفوضى التي كانت متفشية في البلاد ، وعامل أهل حلب بالحسنى؛ حتى توارثوا الرحمة عليه إلى اخر الدهر».(3)
2 ـ كتبَ إلى عمال الأطراف؛ حيث ولم يكتفِ اق سنقر بحصر تدابيره الإصلاحية في حلب بل كتب إلى عمال الأطراف التي خضعت لحكمه أن يحذوا حذوه ، وتابع أعماله بنفسه.
3 ـ وأقرَّ قسيم الدولة مبدأ المسؤولية الجماعية ، فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في قرية ما ، أو إذا هوجمت قافلة أو نهبت؛ فإن أهل القرية التي جرت الحادثة فيها يكونون مسؤولين جماعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق بهؤلاء ،(4) ونتيجة لهذا المبدأ هبَّ سكان القرى لمساعدة الحكام في فرض الأمن ، فإذا وصل تاجر إلى قرية أو مدينة ، وضع أمتعته وبضاعته إلى جانبهِ ونام وهو مطمئن بحراسة أهلها ، وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ الأمن حتى أمنت الطرق ، وتحدث التجار والمسافرون بحسن تدبيره وسيرته.(5)
ونتيجة لاستتباب الأمن في كافة أرجاء إمارة حلب نشطت التجارة ، وامتلأت الأسواق بالبضائع الواردة إليها من كل الجهات ، واستقر الوضعُ الاقتصادي ، وتداعى الناس إليها للكسب فيها والعيشِ برغد.(6) وقد اعترف المؤرخون بحسن سياسة اق سنقر الداخلية ، والأمنية، وأجمعوا على مدحه:
قال ابن القلانسي: «وأحسن فيهم السيرة ، وبسط العدل في أهلها ، وحمى السابلة للمترددين فيها ، وأقام الهيبة ، وأنصف الرعية ، وتتبع المفسدين ، فأبادهم ، وقصد أهل الشر ، فأبعدهم ، وحصل له بذلكَ من الصيت ، وحسن الذكر ، وتضاعف الثناء والشكر.. فعمرت السابلة للمترددين من السفار ، وزاد انتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار».(7)
وقال ابن واصل: «ورخصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة وأقيمت الحدود الشرعية ، وعمرت الطرقات ، وأمنت السبل ، وقُتِلَ المفسدون بكل فج ، وكان كلما سمع بمفسد أو بقاطع طريق؛ أمر بصلبه على أبواب المدينة».(8
وقال ابن الأثير: «وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسةً لرعيتهِ ، وحفظاً لهم ، وكانت بلادهُ بين رخص عام ، وعدل شامل ، وأمن واسع».(9)
وقال عنهُ ابن كثير: «بأنه كان من أحسن الملوك سيرة ، وأجودهم سريرة ، وكان الرعية في أمنٍ وعدل ورخص.(10)
وأما من حيث إنجازاته العمرانية؛ فقد جدَّد عمارة منارة حلب بالجامع عام (482 هـ/1089 م) واسمه منقوش عليها إلى اليوم ، وفي ذلكَ قصة لطيفة ذكرها ابن واصل مفادها: في سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة أسس القاضي أبو الحسن بن الخشّاب منارة حلب ، وكان بحلب بيت معبد نار ، قديم العمارة ، صار بعد ذلكَ أتون حمَّام ، فأخذ ابن الخشاب حجارته ، وبنى بها المنارة ، فأنهى بعض حُسَّاده إلى الأمير قسيم الدولة خبره ، فغضب على القاضي ابن الخشاب ، وقال: «هدمت معبداً هو لي وملكي» فقال: «أيها الأمير ، هذا معبد للنار ، وقد صار أتوناً ،(11) فأخذتُ حجارتهُ لأعمر بها معبداً للإسلام ، يُذكر فيه الله وحده لا شريكَ لهُ ، وكتبتُ اسمكَ عليه ، وجعلتُ الثوابَ لك ، فإن رسمت غرمت ثمنه لك ، ويكون الثواب لي؛ فعلتُ فأعجب الأمير كلامه ، واستصوب رأيهُ ، وقال: بل الثواب لي ، وافعل ما تريد ، فشرع في عمارة المنارة في سنة ثلاث وثمانين وأربعمئة.(12)
مراجع الحلقة الثانية:
(1) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص 209 ، تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص 46.
(2) دخول الترك الغز إلى الشام ، مصطفى شاكر ص 307 ، 314 ـ 315.
(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص 47.
(4) المصدر نفسه.
(5) الباهر: ص 15.
(6) مرآة الزمان (8/244).
(7) ذيل تاريخ دمشق ص 196.
(8 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/19).
(9) الكامل في التاريخ (8/368).
(10) البداية والنهاية (16/143).
(11) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/20).
(12) المصدر نفسه (1/20).
يمكنكم تحميل كتاب عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي
من الموقع الرسمي للدكتور علي الصَّلابي