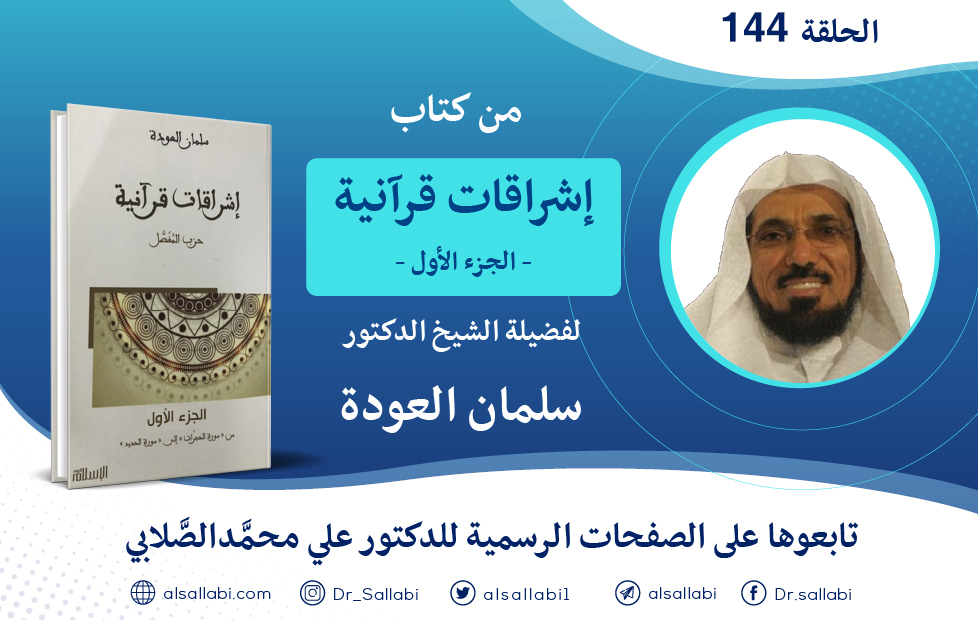من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:
سورة العصر
الحلقة 143
بقلم: د. سلمان بن فهد العودة
شوال 1442 هــ / يونيو 2021
* تسمية السورة:
اسمها: «سورة العصر»، وهو المثبت في معظم التفاسير.
وفي «صحيح البخاري»: «سورة {وَالْعَصْر}» بإثبات الواو على الحكاية.
وفي حديث أبي مَدِينة الدَّارمي قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا، لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: {وَالْعَصْر * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر}. ثم يسلِّم أحدهما على الآخر». وصحَّح إسناده غير واحد.
* عدد آياتها: ثلاث آيات، وهي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم، مع «الكوثر» و«النصر».
* وهي مكية عند أكثر المفسرين، ورُوي عن قتادة ومجاهد أنها مدنية.
واختيار الصحابة رضي الله عنهم هذه السورة لقراءتها عند لقياهم، لم يكن على سبيل التبرُّك؛ فإن القرآن كله فيه البركة والخير، وبكل حرف عشر حسنات، ولا مراعاة لفضيلة السورة فحسب، وإلا لاختاروا «سورة الإخلاص» التي تعدل ثلث القرآن، وإنما اختاروا «سورة العصر»؛ لمعانٍ تضمنتها السورة، فهي شاملة لمعاني الكمال العلمي والعملي في النفس وفي الغير، ومؤسِّسة للعلاقة الإيجابية الفعَّالة بين المؤمنين بما تضمنته من التواصي بالحق والصبر المبني على الإيمان والعمل الصالح.
قال الإمام الشافعي: «لو تدبر الناسُ هذه السورة لكفتهم، أو لوسعتهم».
* {وَالْعَصْر}:
القَسَم دليل على عظمة وأهمية الـمُقْسَم عليه.
أكَّد الـمُقْسَم عليه بالقَسَم، و«إن»، وهي حرف توكيد، وباللام، وهي حرف توكيد أيضًا، فما هو العصر؟ في تأويل ذلك أقوال:
1- هو الدَّهر أو الزمن، ونسبه ابن القيم للجمهور.
2- وقت العصر، الذي هو آخر النهار.
3- فترة من الزمن.
4- صلاة العصر.
ولعل هذه المعاني كلها داخلة في المعنى؛ لأن اللفظ عام، ولم يأت ما يخصِّص بعضها.
وقد كان الناس ينسبون ما يصيبهم إلى الزمن، كما في الحديث القدسي: «يؤذيني ابنُ آدم! يسبُّ الدهرَ، وأنا الدهرُ، بيدي الأمرُ، أقلِّب الليلَ والنهارَ». وفي لفظ: «لا تَسبُّوا الدهرَ».
ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التبعة والمسؤولية فيما يقعون فيه من أخطاء.
والأمر كما قال الشافعي:
نعيبُ زمانَنَا والعيبُ فِـيـنَـا * وما لزمانِنا عيـبٌ سِـوانـا
وقد نَهْجُو الزمانَ بغير جُرْم * ولو نطقَ الزمانُ بنا هَجانا
والقَسَم به يبرز أن ظرف الزمان محايد، والعبرة بما يصنعه الناس فيه، ولذا فالتعبير بفساد الزمان ليس جيدًا، إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمان، وحتى على هذا فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس.
فأقسم الله بالعصر تشريفًا وتعظيمًا لشأنه، فهو ظرف لأعمال الإنسان، وهذه مناسبة القسم به، وقد ذكر الله سبحانه الزمان والمكان، فقال: {قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ }، فذكر ما في السماوات وما في الأرض، وهو المكان، وفي الآية بعدها قال: {وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} [الأنعام: 12- 13]، فالليل والنهار زمان، والمكان والزمان ظرفان للحوادث، ولا يمكن أن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الظرفين.
وعلى أن المقصود بالعصر آخر النهار، فما وجه مناسبته للقَسَم على أن الإنسان في خُسر؟
ثَمَّة مناسبة لطيفة، وهي أنَّ عادة الناس في السعي إلى مكاسبهم أنها تكون من الصباح، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كلُّ النَّاسِ يغدُو، فبائعٌ نفسه فمعتقُها أو موبِقُها».
فالغُدو يكون أول النهار، ومنهم مَن يغدُو إلى خير وبِر، ومنهم مَن يغدُو إلى إثم وقطيعة رحم وشر.
فالقَسَم بالعصر إشارة إلى نهاية المطاف، ووقت الحصاد، حيث يكون الناس في نهاية أعمالهم، فالموظَّف يرجع إلى بيته، والطالب يرجع إلى أسرته، والعامل يرجع إلى أهله.
وبعضهم استخرج معنى لطيفًا في قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: 1-3] ، حيث أقسم سبحانه بالضُّحى على أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، وأن الله ما تركه ولا قَلَاه ولا أبغضه، فكان القَسَم بالضُّحى الذي هو بداية العمل والنشاط والانطلاق.
وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذين تجافوا عن سواء السبيل، وحاربوا رسول الله وآذوا أتباعه.
ويحتمل أن يكون العصر هو الزمن الذي تعيشه الآن، والمعاصرة هي العيش في العصر، ومنه سُمِّيت العصور السياسية والأدبية، ويكون في القسم بهذا الجزء من الزمن تنبيه على أهمية فهم العصر وما يجري فيه والقيام بأمر الشريعة وفق مقتضيات الواقع المعاش، وليس التنظير المحض.
وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أجلُكم في أجل مَن خَلَا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلُكم ومثلُ اليهود والنصارى، كمثلِ رجلٍ استعمل عمَّالًا، فقال: مَن يعملُ لي إلى نصف النهار على قيراطٍ؟ فعملت اليهودُ، فقال: مَن يعملُ لي من نصفِ النهار إلى العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: نحن أكثرُ عملًا وأقلُّ عطاءً؟ قال: هل ظلمتُكم من حقِّكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أُوتيه من شِئْتُ».
وعلى أن المقصود بالعصر: صلاة العصر، يكون تعالى أقسم بها، وهي ذات علاقة بما قبلها؛ لأنها تقع في آخر النهار، وهي صلاة فاضلة، بل هي الصلاة الوسطى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} [البقرة: 238]، وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن تركَ صلاةَ العصرِ، فقد حَبِط عملُه». وحبوط العمل: خسارته، وقال: «الذي تفوته صلاةُ العصر، كأنما وُتِر أهلَه ومالَه».
وأشد الخسارة: أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم جعل مَن فاتته صلاة العصر كأنما وُتر أهله وماله، وهذا يدل على أهمية صلاة العصر، والمحافظة عليها مع الجماعة، وأدائها في وقتها.
سلسلة كتب:
إشراقات قرآنية (4 أجزاء)
للدكتور سلمان العودة
متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: