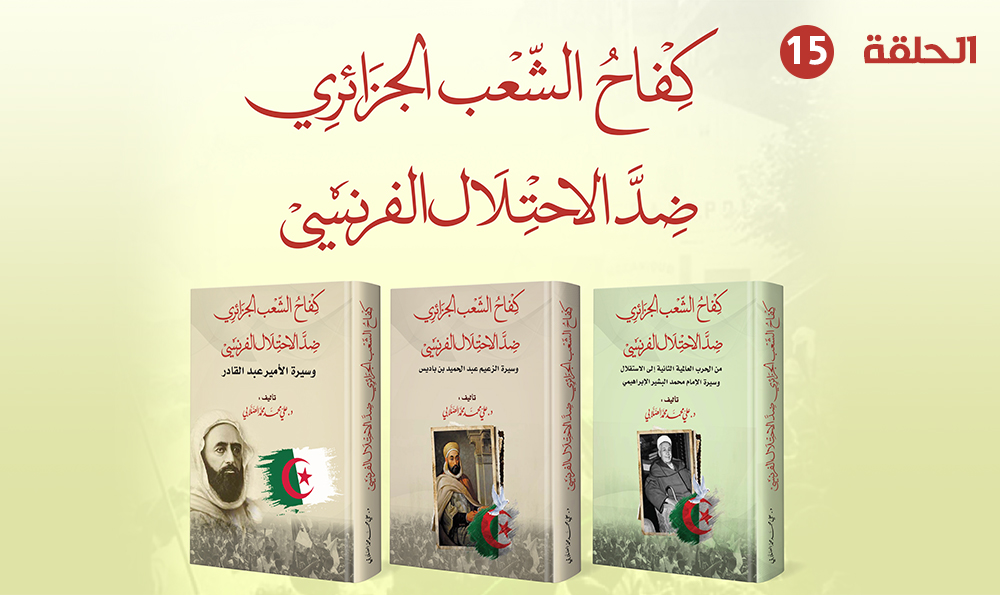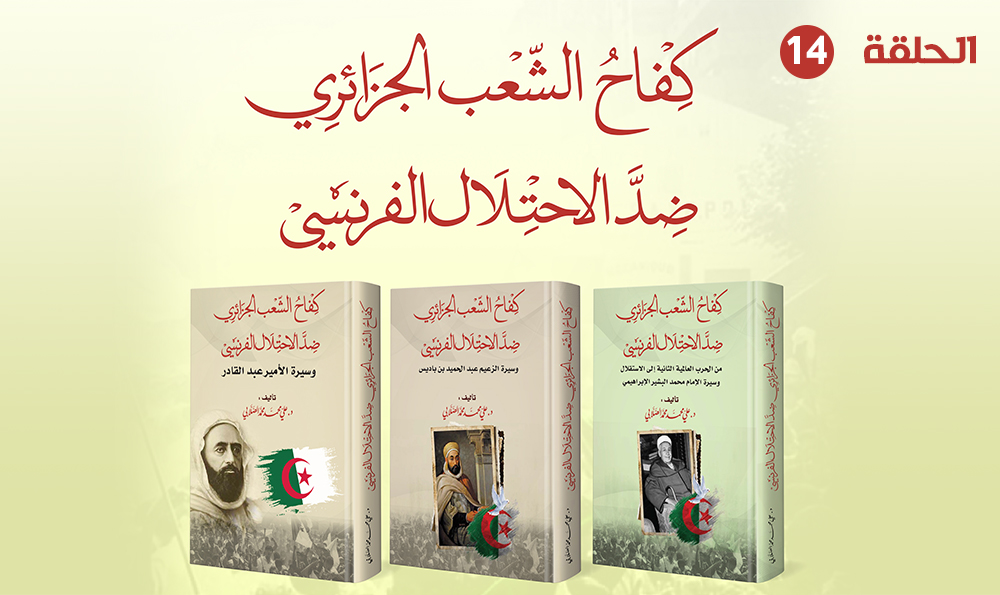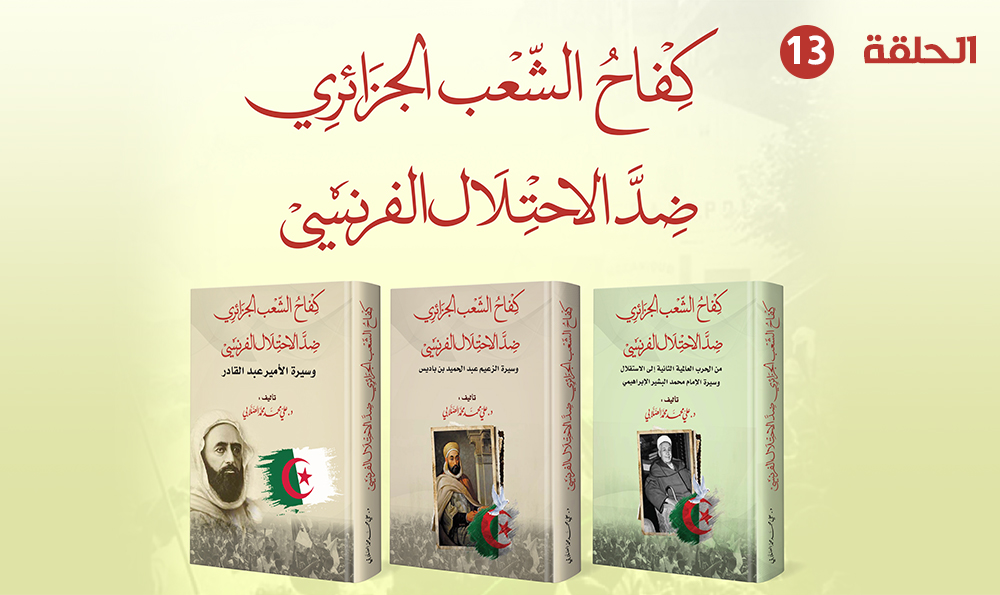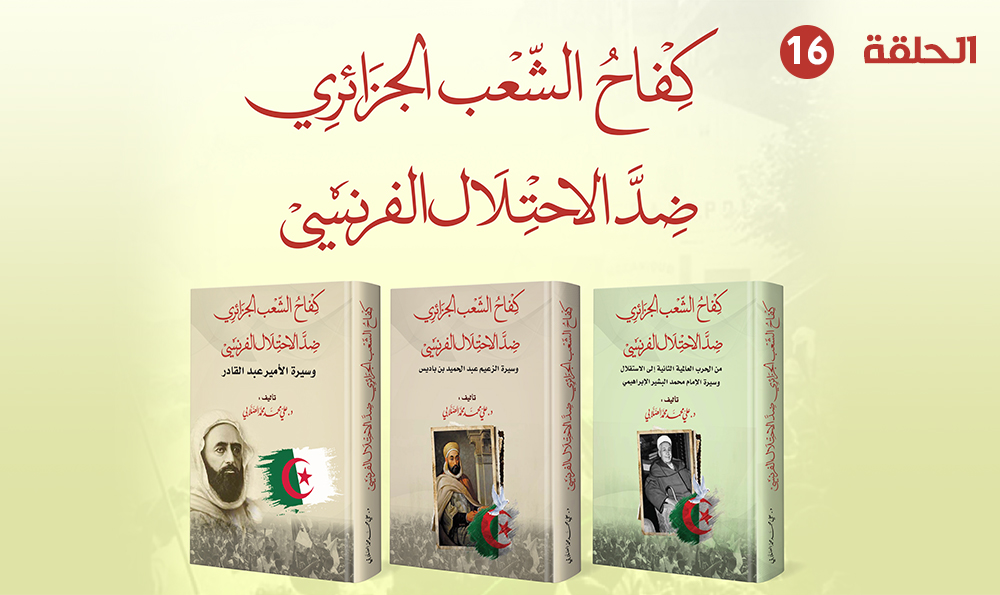من كتاب كفاح الشعب الجزائري بعنوان
حملة شرلكان على الجزائر (1541)
الحلقة: الخامسة عشر
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
صفر 1442 ه/ أكتوبر 2020
أراد شرلكان أن تكون هذه الحملة ضربة قاصمة للوجود العثماني في الشمال الإفريقي كله، وفي الجزائر خاصة. وقد ارتبطت هذه الحملة بعدة عوامل، أهمها:
أ ـ رغبة شرلكان في الانتقام للشرف الإسباني الذي لُطّخ بسبب الهزيمة العظيمة التي مُني بها الأسطول الإسباني في معركة بروزة سنة (1538م) . وازدياد العمليات العسكرية التي يقوم بها غزاة الجزائر على السواحل الأوربية في إيطاليا، وسردونيا، وجزر الباليار. حتى ضاق أهلها ذرعاً، وضجوا إلى ملكهم بالشكوى من غارات بحّارة الجزائر. فبعد انتصار بروزة، وطرد الإسبان من الجزائر فرض البحارة العثمانيون سيطرتهم على شرق وغرب البحر المتوسط، حتى صار شارلكان نفسه يصعب عليه السفر من برشلونة إلى نابولي.
ب ـ الانتصار السياسي الذي أحرزه الإسبان في تلمسان والغرب الجزائري، بفعل استمالتهم سلطان تلمسان، وتمكنهم من إخضاع الدولة الحفصية لسلطانهم بعد احتلالهم لتونس. فلم تبق لهم سوى مدينة الجزائر التي أصبحت قاعدة لغارات البحارة العثمانيين. ولذلك فإن احتلال الجزائر كان سيضمن لشرلكان السيطرة على غرب البحر المتوسط، ويؤمن له الطرق البحرية بين شطري إمبراطوريته، ويمكنه من فرض حصار محكم من الشرق والغرب والجنوب على فرنسا، وإخضاعها بشكل نهىء ي لسلطانه.
ج ـ وجود خير الدين في إسطنبول، وانشغاله بقيادة الأسطول العثماني، وما ترتب عليه من فراغ عظيم لا يمكنه ملؤه في الجزائر.
د ـ أن الجزائر لم يكن بها في ذلك الوقت من الجيش العثماني سوى العدد القليل حسب ما جاء في تقارير الجواسيس الإسبان، واعتقادهم أن القوات المحلية غير قادرة على الدفاع عن المدينة.
ه ـ يرى البعض أن الحملة كانت تهدف إلى تخفيف الضغط العثماني على النمسا وألمانيا. وذلك بفتح جبهة جديدة في الجزائر، حيث ستكون الدولة العثمانية مضطرة إلى إرسال قواتها إلى هناك.
1 ـ استعدادات الطرفين:
• القوات المرابطة في الجزائر (التركية والمحلية والأندلسية):
علم حسن آغا بخبر الحملة الإسبانية التي يعدّ لها الإمبراطور لغزو الجزائر. فشرع في إعداد العدّة لردّ العدوان. فقام بتحصين المدينة، وحشد القوات التركية والأندلسية المحلية للدفاع عن المدينة.
أما من الناحية العسكرية، فاستناداً إلى بعض الوثىء ق التي قام بتصويرها وترجمتها الأستاذ المدني من أرشيف سيمانكاس الإسباني، جاء تقرير سري مرسل من طرف حاكم بجاية، ومؤرخ في (29 مارس 1536م) ما يلي:
(إلى صاحبة الجلالة الملكة..
وهذه أنباء وردت إلينا من مدينة الجزائر، نقلها لنا ستة من العبيد المسيحيين الذين تمكنوا من الفرار يوم (27 فيفري)، وغادروا الجزائر فوق فلك، ووصلوا إلى مدينة بجاية.
يوجد الآن في مدينة الجزائر (2000) من الأتراك، و(7000) أو (8000) من مهاجري الأندلس في مدن الجزائر، ومليانة، وبقاع أخرى وضع بها بربروس حاميات. أما حاكم الجزائر اليوم فهو مرتد من سردينيا اسمه حسن اغا. وسكان المدينة في قلق شديد، لأنهم وصلتهم أنباء موثوق بها، تفيد تحرك أسطول جلالتكم.
وأخبرني الأسرى المذكورون أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت في فصل الشتاء قد هدمت سور المدينة من ثلاث جهات، وعلى مسافات شاسعة. وقد أقدم السكان على ترميم ما تحطم بكل سرعة. لكن العمل لم يتم إلى الان نظراً لعدم وجود البنىء ين العارفين. ويقولون هنا أنهم سيستعينون بـ (1500) من البدو المحيطين بالجزائر من أجل إكمال العمل.
أما مدينة قسنطينة، ففيها (1500) من الإنكشارية، يقودهم تركي اسمه القائد قلج علي (KilicAli) وبربروس هو الذي أرسل هؤلاء الإنكشارية.
وبما أن قلج علي هذا تابع لحكومة الجزائر، فلا ريب أنه سيقدم إلى مدينة الجزائر بمجرد علمه بتحرك أسطول جلالتكم).
من هذا التقرير يتبين لنا أن القوة التي كانت معدة للدفاع عن المدينة كانت تتراوح بين (9 و 10) آلاف جندي من الأتراك والأهالي والأندلسيين.
• القوات الإسبانية
يبدو أن شارلكان فكر في غزو الجزائر غداة احتلال تونس سنة (1535م). وقد ذكر صاحب الغزوات أنه أرسل إلى المغرب. جواسيسه للاطلاع على الطرق المناسبة التي تيسر له احتلال المدينة.
وفي سنة (1539م) وافق البابا على تقديم إعانة مالية لتجهيز الحملة. كما بعث شرلكان إلى حاكم جنوة يأمره بتجهيز ما عنده من السفن، وإعدادها للسفر. فجمع الإمبراطور في ميناء (ماهون) بجزيرة مينورقة أسطولاً ضخماً اختلف المؤرخون في تقدير عدد سفنه ومقاتليه. فذُكِر أنه كان مكوناً من (16) سفينة شراعية، (65) سفينة نقل عسكرية كبيرة تحمل (12330) بحاراً، (23900) جندياً بالإضافة إلى مئات القطع البحرية الصغيرة التي كانت ترافق الأسطول. وهي أكبر قوة عسكرية بحرية تشقّ عباب غرب البحر المتوسط في القرن السادس عشر. وقد شارك في هذه الحملة نبلاء من إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا كجنود متطوعين. كما اشترك فرسان مالطة، حيث كلف (140) منهم بقيادة فرقة عسكرية مكونة من (400) جندي مدربين تدريباً عالياً.
كان شرلكان يعلم أن دخول حسن اغا في مواجهة مع القوات الهىء لة التي حشدها شرلكان لاحتلال الجزائر، بدون وصول دعم من إسطنبول ؛ يعتبر انتحاراً لا شك فيه، ولذلك وقع اختياره للوقت الذي كان فيه خير الدين في إسطنبول، بينما خرج السلطان سليمان القانوني في حملته الهامايونية التاسعة لغزو المجر، حيث لا يمكن للعثمانيين أن يخوضوا معركتين كبيرتين في وقت واحد. وجعل ذلك موعداً لحملته الكبيرة على الجزائر.
حقيقة كان وضع الجزائر إزاء هذه الحملة في غاية الخطورة، وأصبح مصير المدينة متوقفاً على نتيجة هذه المعركة. وكان السلطان القانوني مدركاً لهذا الخطر، ولذلك أرسل من بودين بالمجر فرماناً همايونياً يأمر فيه خير الدين بإرسال الدعم اللازم إلى الجزائر.
بعد أن أنهى الأسطول الإسباني استعداداته انطلق من ميناء قرطجانة (Carthegene) في (15 و16 أكتوبر 1541م). فمر على وهران، حيث تزود من هناك بقوات إضافية، ثم تابع سيره إلى الجزائر التي وصلها في (19 أكتوبر)، فرسا الأسطول الإسباني قريباً من رأس ماتيفو في مقابل ميناء الجزائر، وبقي هناك يترقب حتى يوم الجمعة (21 أكتوبر).
2 ـ سير الحملة:
لقد لعب حسن اغا قبل المعركة دوراً رئيسياً في تنظيم وإدارة المقاومة. فاستدعى أعيان المدينة، ونظم اجتماعاً كبيراً دعا إليه العلماء والأعيان والقادة.
وجعل يسكِّنهم ويهون عليهم أمر الإسبان، وفي الوقت نفسه كان يستشيرهم في طريقة تنظيم المقاومة. ثم أمر بنصب المدافع على أبراج المدينة، كما أمر بقطع أشجار البساتين كلها كيلا يتستر بها النصارى في أثناء القتال. ثم فتح خزىء ن السلاح، ووزعه على أهالي المدينة مع ما يحتاجون إليه من البارود والرصاص، ولما اكتملت الاستعدادات خطب في الناس يشجعهم على الصمود، بينما كان يشرف بنفسه على عمليات تنظيم وقيادة المقاومة.
واشترك في الاستعداد لهذه المعركة المصيرية جميع سكان المدينة، وسكان الريف المحيط بها، والأندلسيون، والأتراك. كما بقيت قوات أخرى خارج المدينة ؛ لكي تقوم بحركات التفافية متوالية حول الجيش الإسباني، مهمتها تنظيم هجمات على أطرافه.
وفي صبيحة (23 أكتوبر) نزل الإسبان بمنطقة الحامة جنوب المدينة. فتصدى لهم المقاومون لمنعهم من النزول إلى البر، فأطلق عليهم النصارى قذىء ف المدفعية من البحر فأبعدوهم، وتمكنوا من إنزال الجنود والسلاح. بينما تركوا المؤونة والعتاد في السفن معتقدين أن الاستيلاء على المدينة سوف يتم خلال ساعات. ثم أرسل شرلكان رسالة تهديد يطلب فيها من حسن اغا تسليم المدينة، فرد عليه حسن اغا بجواب شديد اللهجة.
وعندما حل الظلام فتحت أبواب المدينة، وشنت فرقة من المسلمين هجوماً مفاجئاً على معسكر الجيش الإسباني، وعادت إلى المدينة بعد أن كبدت العدو خسىء ر كبيرة.
وفي صبيحة اليوم التالي تقدمت القوات الإسبانية على رأسها الإمبراطور شرلكان نحو المدينة. ثم أعطى أوامره بقصف المدينة، فرد عليه المدافعون عن المدينة بقذىء ف المدفعية التي كانت منصوبة على أسوارها. فاضطر معه الجيش الإسباني إلى الانسحاب إلى «رأس تافورة» قرب باب عزون على الساحل الشمالي الشرقي للمدينة. حيث استأنف القصف من هناك. فبادر المسلمون بالرد عليهم. فشعر الإمبراطور بخيبة أمل كبيرة لعدم قدرته على احتلال المدينة.
ثم شنت فرقة من الأهالي هجوماً خاطفاً على الجناح الأيسر للجيش الإمبراطوري، قرر على إثره الإمبراطور الاستيلاء على المرتفعات المشرفة على المدينة، للتحصن بها من مثل هذه الهجمات المفاجئة، وحتى يتمكن من مراقبة سير العمليات العسكرية. وبالفعل تمكن من الاستيلاء على المرتفع المعروف بـ «كدية الصابون» وجعل منه قاعدة لعملياته. ومن هناك اتجهت القوات الإسبانية في الساحل حيث تمكنت من احتلال التلال المجاورة لكدية الصابون. وهكذا توزع العدو على المناطق الاستراتيجية. تضاعفت المقاومة الجزائرية بقصف السفن الإسبانية بالمدفعية. كما وجهوا مدافعهم في الوقت ذاته إلى قواعد الجيش الغازي المعسكر في البر. واستمر تبادل القصف حتى خيم الظلام على ميدان المعركة.
وفي يوم (25 أكتوبر) بدأت الأمطار بالهطول. وفي المساء ازداد المطر غزارة، ورافقه هبوب رياح عنيفة هددت الأسطول بالغرق.
وقد وصف صاحب كتاب الغزوات هذه العاصفة بقوله: «هاجت الريح وساقت السحاب أمثال الجبال، وأمطرت السماء كالطوفان، وهاج البحر، واشتدت أمواجه وكثر اضطرابه بما لم يعهد مثله..».
فقطعت هذه العاصفة حبال السفن، وساقت عدداً منها إلى البر حيث ارتطمت بالصخور. فلم تمض سوى ساعات قليلة حتى كانت (140) سفينة قد تحطمت تماماً، ولم تنج إلا السفن الكبيرة التي تضررت بنسبة قليلة بفضل مهارة قباطنتها، وثقل حجمها.
كان في بعض السفن التي ألقتها العاصفة إلى الساحل عدد من الأسرى المسلمين من الأتراك والجزائريين. بعضهم من الجزائر، وبعضهم من تونس. فبلغ عددهم ما يقارب (1400) أسيراً. كانت العاصفة سبباً في خلاصهم، إذ تمكنوا من فك قيودهم، والنجاة بأنفسهم. وفي الوقت ذاته وقع عدد من الجنود الذين تمكنوا من النجاة من الغرق في قبضة الأهالي الذين جاؤوا من النواحي. «فاستأصلوهم قتلاً وأسراً». فضاق الأمر بالإسبان، ولم يستطيعوا استعمال أسلحتهم النارية للدفاع عن أنفسهم.
أما الجيش المحاصر للمدينة، فقد كان وضعه أكثر سوءاً. فقد أصبح الجنود يتّقون العاصفة والأمطار بالتفاف بعضهم حول بعض بعدما اقتلعت الرياح خيامهم.
اعتبر أهل الجزائر هذه العاصفة عوناً من الله على أعدىء ه، فخرجوا من المدينة في هجوم شامل على أطراف القوات الإسبانية التي أربكت العاصفة نظامها، وفقدت القيادة السيطرة على الوضع. وقتل في هذه المعركة أكثر من (4000) من الإسبان، و(200) من المسلمين.
وفي صبيحة (26 أكتوبر) تيقّن شرلكان أنه لن يستطيع اقتحام المدينة أو إخضاعها. فكان غاية ما يأمله هو أن ينجو من هذه الورطة. فأمر قواته بالشروع في الانسحاب، بعد أن سبقه قىء ده أندريا دوريا إلى رأس ماتيفو.
كان الانسحاب في غاية الصعوبة بسبب شدة الأمطار وكثرة الوحل في الطريق. بالإضافة إلى الهجمات التي كان الأهالي يشنونها على أطراف الجيش الإسباني.
نزل الإسبان في وادي الحراش جنوب شرق مدينة الجزائر. حيث باتوا هناك بعد أن أنهكهم التعب والجوع. فاضطروا إلى أكل (400) من الخيل. وفي صبيحة (27 أكتوبر) عبروا وادي الحراش بعد أن صنعوا من ألواح سفنهم المحطمة جسراً.
وأثناء انسحاب القوات الإسبانية، لم يتوقف الأهالي عن مهاجمة جانبي الجيش ومؤخرته، فقتل عدد كبير من الجنود الذين كانوا في المؤخرة. ومن تمكن من النجاة حاول الهرب من القتل بالغطس في الوادي فغرق عدد منهم بسبب شدة اندفاع المياه.
وهكذا لم يتمكن الجيش الإسباني من الوصول إلى رأس ماتيفو إلا يوم (29 أكتوبر). حيث قضى الإمبراطور هناك يومين للاستراحة. ثم أقلع الأسطول في أول نوفمبر متجهاً إلى إسبانيا.
ذكر كاتب جلبي أن عاصفة أخرى دفعت ما بقي من الأسطول الإسباني إلى بجاية التي كانت حتى ذلك الحين قاعدة إسبانية.
وصل الإسبان إلى بجاية في (4 نوفمبر 1541م) فوجدوها محاصرة، والجوع يفتك بمن فيها من الجنود. فقام الإسبان بالاعتداء على الجالية اليهودية هناك، واستولوا على أموالهم، وكل ما يملكون.وبعد أيام غادر شرلكان بجاية، فوصل إلى ميورقة، ومنها إلى قرطاجنة التي دخلها في (2 ديسمبر 1541م) .
يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي: