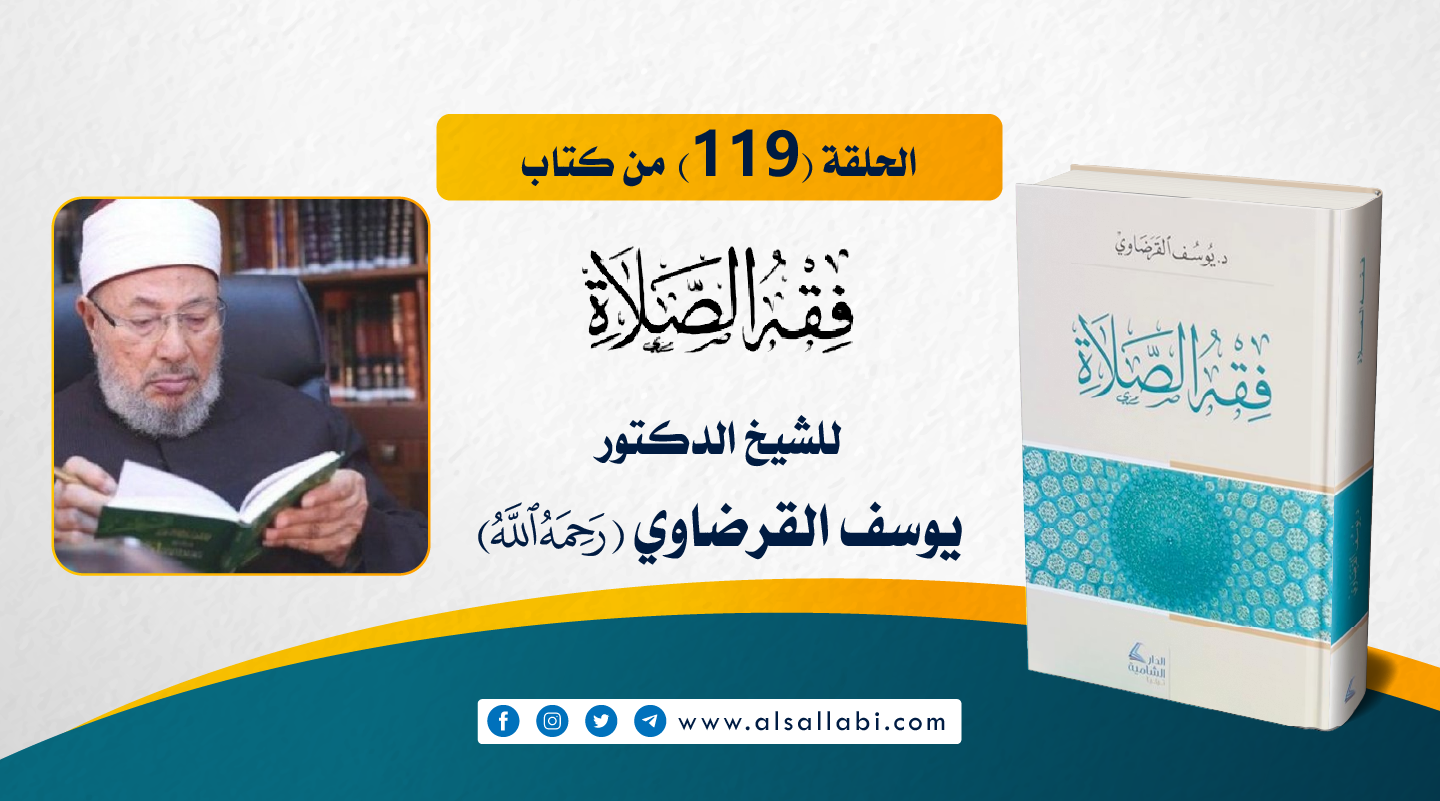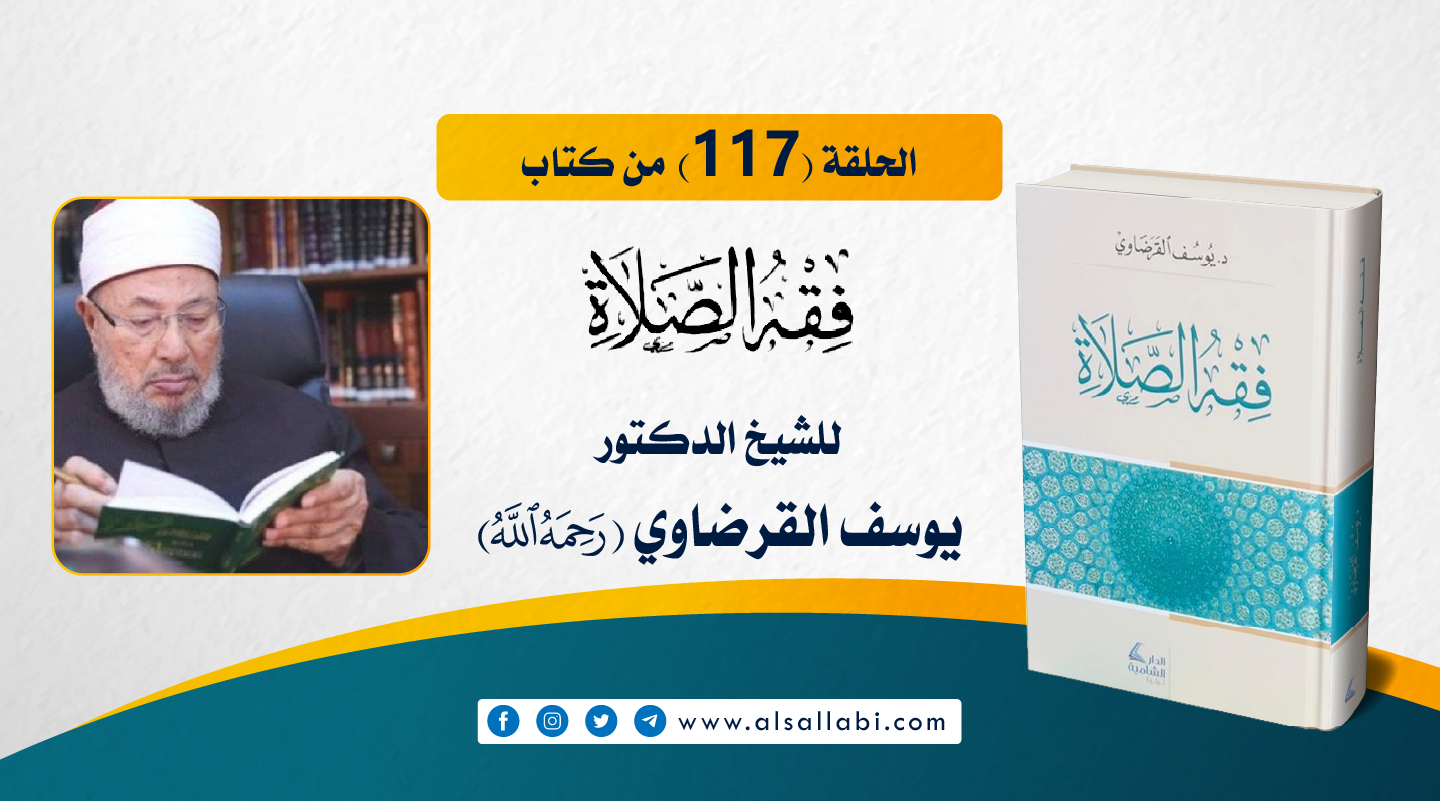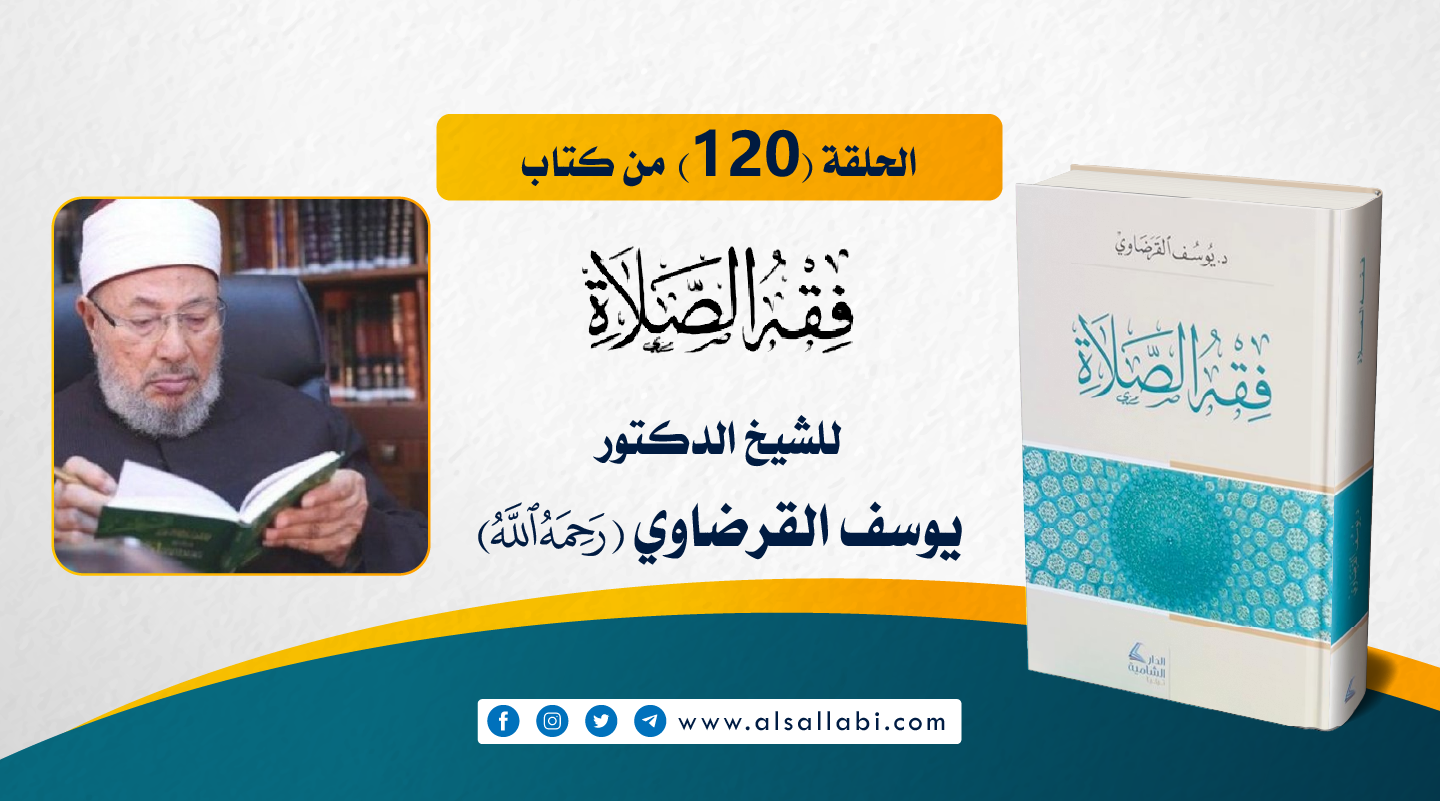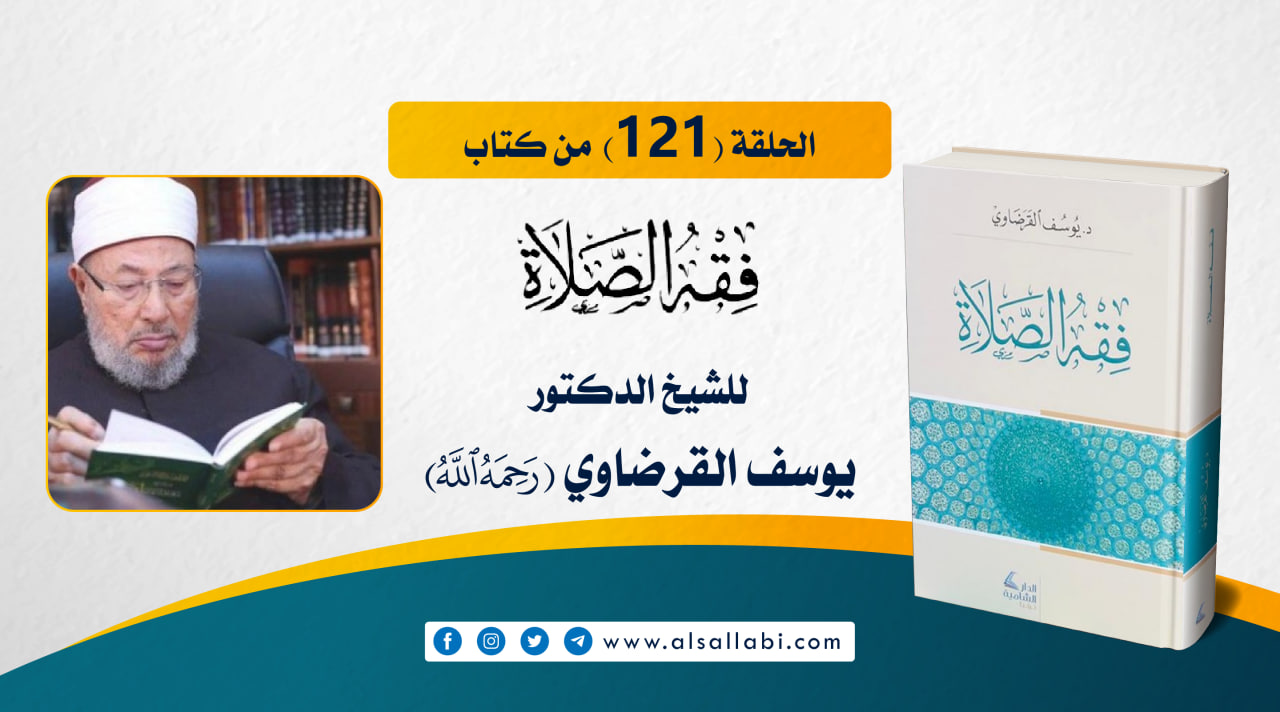(تأملات إيمانية في صلاة التراويح)
اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)
الحلقة: التاسعة عشر بعد المائة
1 ذي القعدة 1444ه/ 21 مايو 2023م
جعل الله لعباده مواسم للخير، في مناسبات شتى، يتسابق فيها أولو الجد، ويسارع إلى اغتنامها أصحاب القلوب المؤمنة، والأنفس الزكية، ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي اختاره الله من بين شهور العام، ليكون سوقًا رائجة لعبادة الله، تهب فيها نفحات الهدى والنور، لتثير لواعج الشوق والحبِّ عند المتسابقين في الخيرات، الساعين للصلوات، المؤدين للصدقات، الذين أجاعوا البطون بترك الشهوات، وأعطشوا أنفسهم، ليدخلوا الجنة من باب «الريَّان» الذي لا يدخله إلَّا الصائمون.
وإذا كان نهار رمضان قد حَظِيَ بالصوم، وصفاء النفس، فقد نعم ليله بالتراويح، يجتمع المسلمون في مساجدهم لأدائها، لعلهم يَسعدون في ليالي رمضان بثواب ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر. لذا خصصنا قيام رمضان بحديث منفصل.
الترغيب في قيام رمضان:
وقيام رمضان أو صلاة التراويح سنة مؤكدة، فلقد فرض الله تعالى صيام أيام رمضان، وسنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".
قال النووي: «معناه لا يأمرهم به أمر تحتيم وإلزام، وهو العزيمة، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله».
ومعنى "إيمانًا": أي تصديقًا بوعد الله تعالى، ومعنى "احتسابًا": أي طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه.
قال ابن حجر: «اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح».
ومن صلَّى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.
لماذا سمي قيام رمضان بالتراويح؟
التراويح: جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة من العناء، وهي زوال المشقة والتعب. والترويحة: في الأصل اسم للجلسة مطلقًا، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
والتراويح في الاصطلاح الفقهي: هي تلك الصلاة المأثورة التي يؤديها المسلمون جماعة في المسجد، بعد صلاة العشاء في شهر رمضان.
حكم صلاة التراويح:
صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، وهي عند العلماء سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة.
وقد سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاثًا، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا، فصلاها الصحابة فرادى، حتى جمعهم عمر على الصلاة خلف أُبَيِّ بن كعب.
فعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة- أي من رمضان- من جوف الليل، فصلَّى في المسجد، فصلَّى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدَّثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلَّوا معه، فأصبح الناس، فتحدَّثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلُّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، فتشهد ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخْفَ عليَّ مكانُكم، لكني خشيت أن تُفرض عليكم، فتعجِزوا عنها".
وقد ورد تعيين الليالي التي قامها النبي صلى الله عليه وسلَّم بأصحابه في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى بقي سبع. قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. قال: فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر. قلنا: يا رسول الله، لو نفَّلتنا بقية هذه الليلة؟ فقال: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته"، فلما كانت الرابعة لم يقُم بنا، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال الراوي: قلنا: وما الفلاح؟ قال: السُّحور.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين، حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحورَ: الفلاح.
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فرادى، والرجل بالرجل وبالرجال، وكذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر.
روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلِّي الرجل لنفسه، ويصلي الرجلُ، فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أُبيِّ بن كعب، ثم خرجتُ معه ليلة أُخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نِعْمت البدعة هذه! والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعنى آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
وقول عمر: نعمت البدعة هذه. لا يعني «البدعة الاصطلاحية» التي يراد بها استحداث أمر في الدين لا يندرج تحت أصل شرعي، إنما أراد المعنى اللغوي للبدعة، باعتبار أنها أمر لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر من قبل.
روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح، وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكَّدة، ولم يُخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدِعًا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهدٍ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سنَّ عمر هذا، وجمع الناس على أبيِّ بن كعب، وصلَّاها جماعة متواترون، منهم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وطلحة، والعباس، وابنه، والزبير، ومعاذ، وأُبَيّ، وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وما رد عليه واحد منهم، بل ساعدوه، ووافقوه، وأمروا بذلك.
لم يكن عمر رضي الله عنه مبتدعًا فيما فعله؛ لأنَّه وافق الهدي النبوي، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وراءه ثلاث ليال في المسجد، ولولا خشية افتراضها عليهم وعجزهم عنها، لاستمر في الصلاة بهم، وقد زالت هذه الخشية، بإكمال الدين وانقطاع الوحي، واستقرار الشرع، وكان عمر مسدَّدًا في عمله هذا، لما فيه من مظهر الوحدة، واجتماع الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلِّين، ولا سيما إذا كان حسن القراءة.
هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) ص315-318