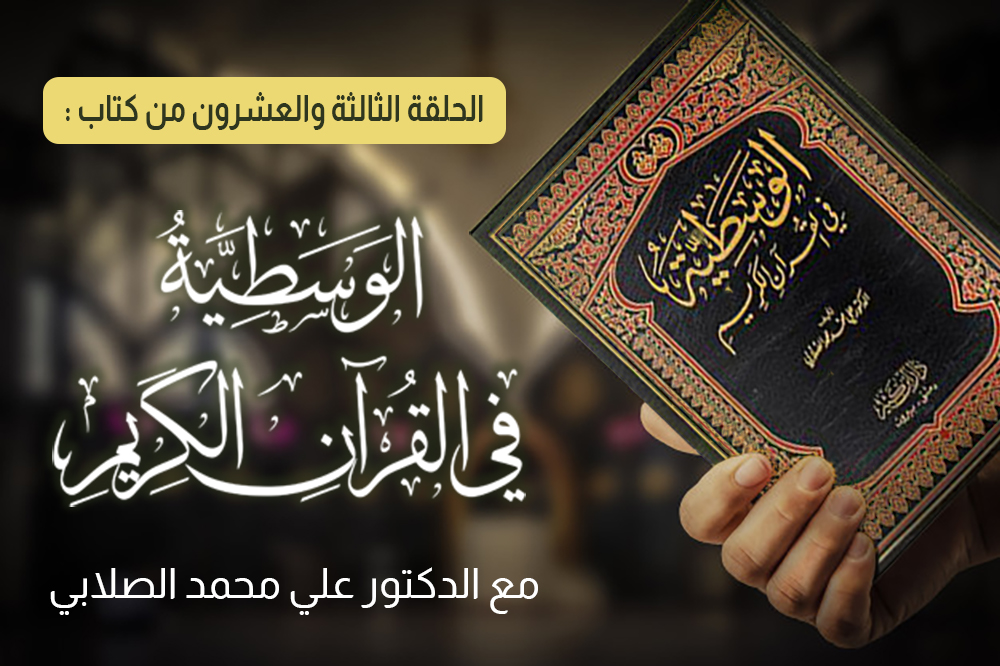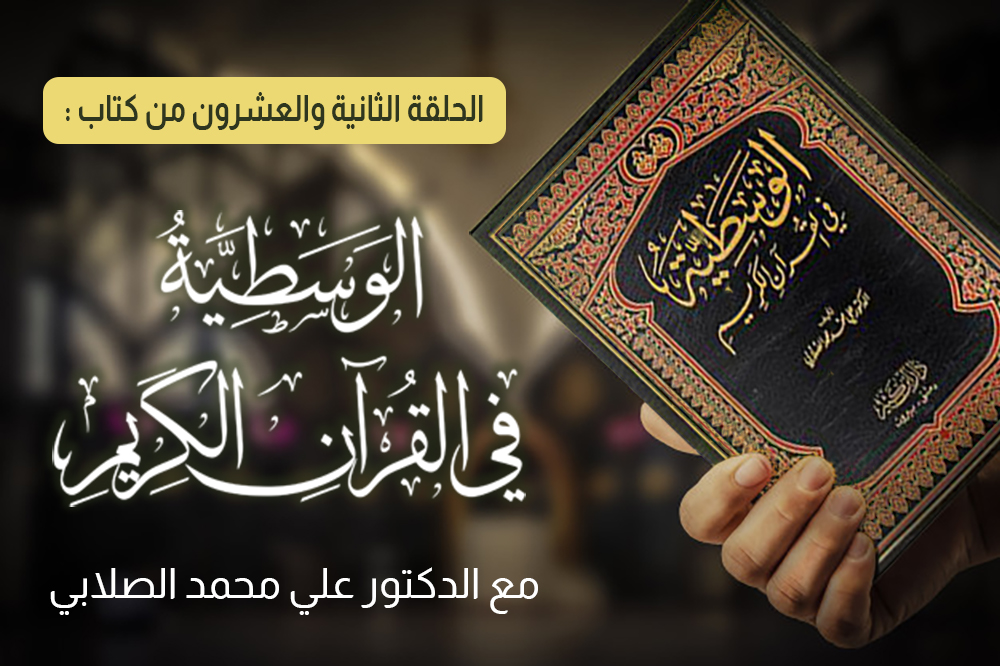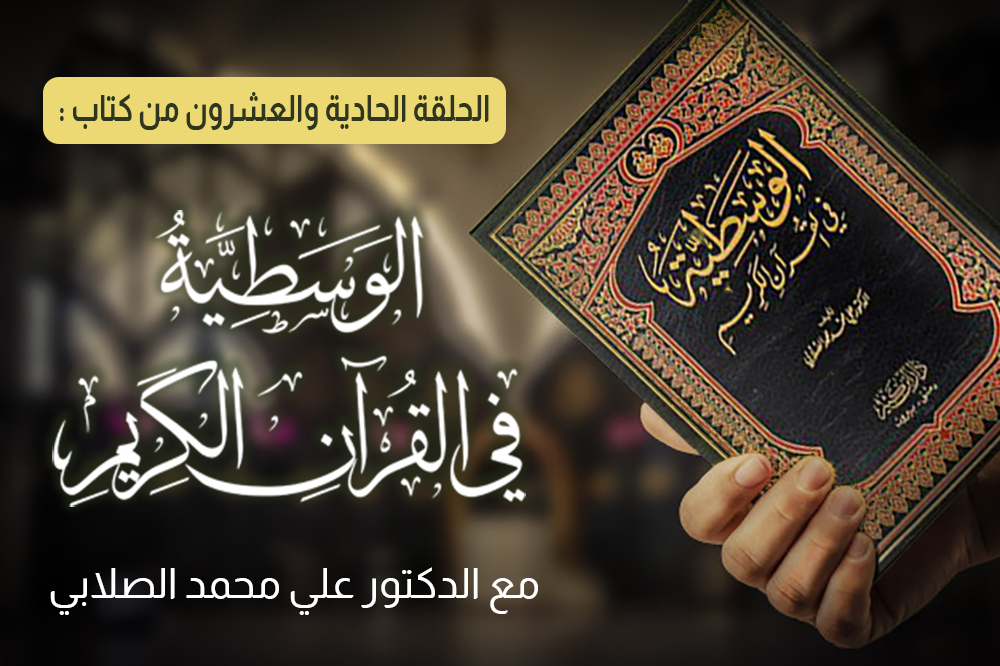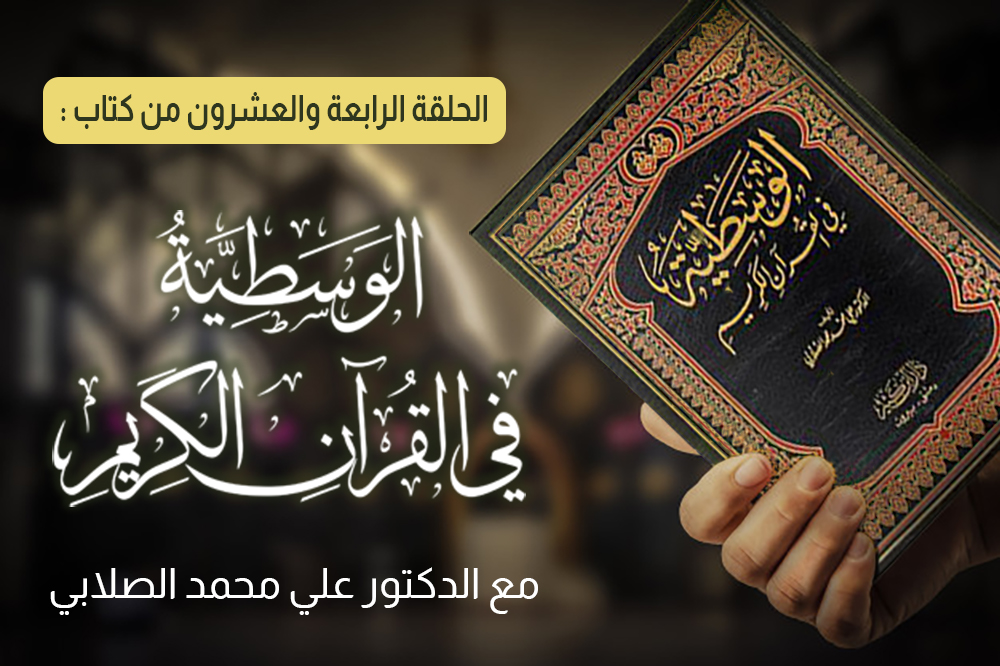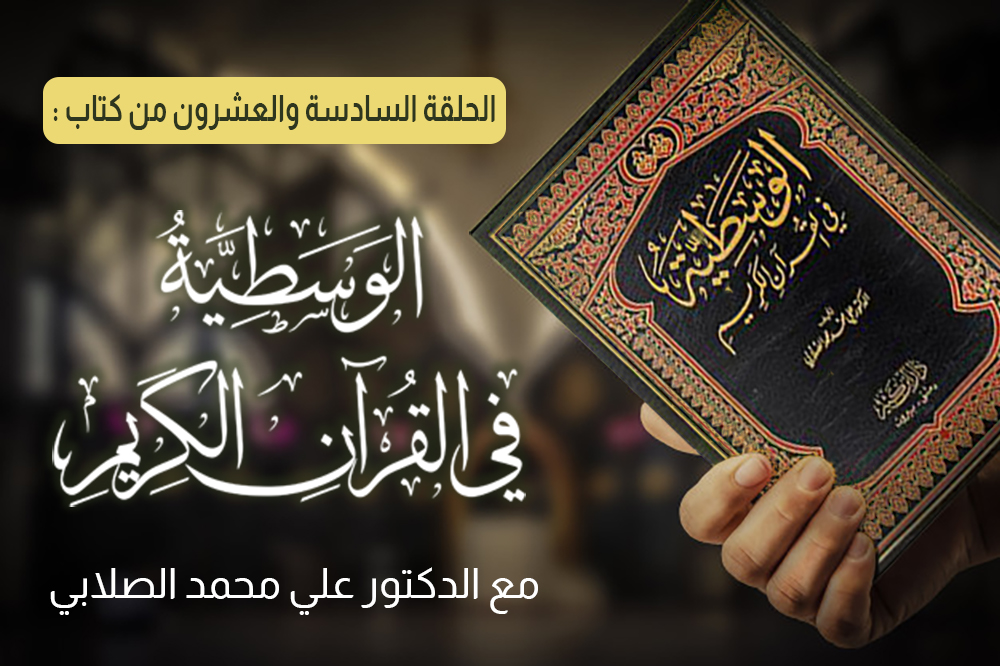من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
(وسطية القرآن في العقيدة)
الحلقة: الثالثة والعشرون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ربيع الأول 1442 ه/ أكتوبر 2020
أولاً: التعريف بالعقيدة:
أ ـ العقيدة لغة (من العقد، وهو الربط، والشدُّ بقوَّةٍ، ومنه: الإحكام، والإبرام، والتماسك، والمراصة، والإثبات، والتوثق).
ب ـ العقيدة في الاصطلاح: كلمة العقيدة لم تكن موجودة في الكتاب، والسنة، ولا في أمهات المعاجم، وإنَّ أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها: (عقائد) هو القشيري سنة 437 هـ في كتاب الرسالة، وهي كلمة مولدة لم تكن في الصدر الأول.
وقد عرفها الدكتور ناصر العقل فقال: (الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في ألوهيته، وربوبيته، وأسمائه، وصفاته، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الاخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة في أصول الدين، وأمور الغيب، وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم، والأمر، والقدر، والشرع، ولرسوله (ص) بالطاعة، والتحكيم، والاتِّباع).
يشمل التوحيد، والإيمان، والإسلام، والغيبيات، والنبوات، والقدر، والأخبار، وأصوله الأحكام القطعية، وسائر أصول الدين، والاعتقاد، ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع، وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة، والموقف منهم. ومن مسميات هذا العلم: العقيدة، والتوحيد، والسنة، وأصول الدين.
والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة؛ إذ الإسلام عقيدة وشريعة تعني التكاليف العملية التي جاءت في القرآن والسنة النبوية في العبادات، والمعاملات. والعقيدة هي أمور علمية يجب على المسلم أن يؤمن بها ؛ لأن الله أخبرنا بها عن طريق كتابه، أو عن طريق وحيه إلى رسوله (ص). وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي التي حددها الرسول (ص) في حديث جبريل المشهور بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الاخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى». فالعقيدة في ديننا هي التي تدور حول قضايا معينة، هي التي أخبرنا بها الله، ورسوله، وليست اعتقاد أي شيء! وحتى تصبح هذه عقيدة لابدَّ أن تصدق بها تصديقاً جازماً لا ريب فيه، فإن كان فيها ريب، أو شك؛ كانت ظنّاً لا عقيدةوالدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15] وقوله تعالى: {آلم *ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدَىً لِلْمُتَّقِينَ *} [البقرة: 1-2] وقال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ}[آل عمران: 9] وذم الله المشركين المرتابين بقوله: {وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ *} [التوبة: 45] والمسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية، ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3] فالله غيب، وكذلك الملائكة، واليوم الاخر، أما الكتب، والرسل فقد يتبادر: أنها تشاهد، وتنظر، ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله، أي: كون الرسل مبعوثين من عند الله، وأنَّ الكتب منزلة من عند الله، وهذا أمر غيبيٌّ.
ثانياً: العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة
العقيدة ليست مختصة بالإسلام، بل كل ديانة، أو مذهب لابدَّ لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم، وهذا ينطبق على الجماعات، والأفراد، والأمم، والشعوب. والعقائد منذ بدء الخليقة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي قسمان:
الأول: يمثل العقيدة الصحيحة، وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل الكرام في أيِّ زمان ومكان، وهي عقيدة واحدة ؛ لأنها منزلة من العليم الخبير الحكيم العزيز.
والقسم الثاني: يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها، وتعدُّدها، وفسادها ناشأى من كونها نتاج أفكار البشر، ومن وضع مفكريهم، وعقلائهم، وعلمهم محدود، ومقيَّد بقيود بشرية متمثلة في عادات، وتقاليد، وأفكار.
وأحياناً يأتي فساد العقيدة من تحريفها، وتغييرها، وتبديلها، كما هو الحال بالنسبة للعقيدة اليهودية، والنصرانية في الوقت الحاضر، فإنهما حُرِّفَتا منذ عهدٍ بعيد، ففسادهما كان من هذا التحريف، وإن كانت عقيدتها سليمة الأصل.
ثالثاً: أين العقيدة الصحيحة اليوم؟
العقيدة الصحيحة لا توجد إلا في كتاب الله وسنة رسوله (ص)، لأنهما محفوظتان لحفظ الله لهما. قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} [الحجر: 9] والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها قليلٌ من الحق؛ فإنها لا تمثل الحقَّ، ولا تجليه.
فالعقيدة الصحيحة السليمة لا توجد في اليهودية، ولا في النصرانية، ولا في كلام الفلاسفة.. وإنما توجد في الإسلام في أصليه: الكتاب، والسنة نَديةً، طريةً، صافيةً، مشرقة، تملأ الفؤاد إيماناً، ونوراً، وحياة، ويقيناً: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ} [الشورى: 52] وتقنع العقل بالحجة والبرهان: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [الرعد: 4] وتنسجم مع الفطرة: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}[الروم:30].
رابعاً: ماذا تعني العقيدة؟
العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان؛ لأنه بدونها تائه ضائع يفقد ذاته ووجوده، والعقيدة الإسلامية وحدها التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل وتحيره: من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الْمُوجِد؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ لماذا أوجدنا، وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون، وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوامل غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة؛ إن كان الجواب بالإيجاب؟ لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة، وكل من لم يعرف هذه العقيدة، أو لم يعتنقها فإن حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئاً:
جئتُ، لا أعلم من أينَ، ولكني أتيتُ
ولقد أبصرتُ قدَّامي طريقاً فمشيتُ
وسأبقى سائراً إن شئتُ هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟
لستُ أدري
أجديدٌ أم قديمٌ أنا في هذا الوجود
هل أنا حرٌّ طليقٌ أم أسيرٌ في قيود
هل أنا قائدُ نفسي في حياتي أم مقودُ
أتمنَّى أنني أدري ولكنِّي
لست أدري
وطريقي ما طريقي؟ أطويلٌ أم قصير
هل أنا أصعد أم أنا أهبط فيه وأغور
أأنا السائر في الدَّرب أم الدَّرب تسير؟
أم كلانا واقفٌ والدَّهر يجري
لست أدري
ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين
أتُراني كنت أدري أنَّني فيه دفينُ
وبأني سوف أبدو وبأني سأكون
أم تُراني كنت لا أدرك شيئاً؟
لست أدري
أتراني قبلما أصبحتُ إنساناً سويَّا
كنت محواً أو محالاً أم تُراني كنت شيئا
ألهذا الُّلغز حلٌّ؟ أم سيبقى أبديَّا
لست أدري.. ولماذا لست أدري
لست أدري
وهذا الشاعر الملحد فَقَدَ معرفة الحقائق الكبرى، فأصبح في هذه الحيرة، والقلق، والشك، والأمراض النفسية، وأين هو من المسلم الذي يدري، ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه الحقائق، فإذا به يجد برد اليقين، وهدوء البال، وإذا به يسير في طريق مستقيم إلى غاية مرسومة يعرف معالمها، ويدري غايتها.
قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الروم: 40] وقال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] واستمع إلى الشاعر البائس يتحدَّث عن الموت، والمصير:
إن يك الموت قصاصاً أيُّ ذنب للطهارة؟
إن كان ثوباً، أيُّ فضل للدَّعارة
وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة
فلم الأسماء إثم وصلاح
لست أدري
إن يك الموتُ رقاداً بعده صحوٌ طويل
فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل
ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرَّحيل
ومتى ينكشف السِّتر فيدري؟
لست أدري
إن يك الموت هجوعاً يملأ النفس سلاما
وانعتاقاً لا اعتقاداً وابتداءً لا ختاما
فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحِماما؟
ولماذا تجزع الأرواح منه
لست أدري
أوراء القبر بعد الموت بعثٌ ونشور؟
فحياةٌ، فخلودٌ، أم فناء فدثور؟
أكلام الناس أصدق أم كلام الناس زور؟
أصحيحٌ أنَّ بعض الناس يدري
لست أدري
إن أكن أبعث بعد الموت جثماناً وعقلا
أتُرى أُبعث بعضاً أم ترى أُبعث كلاَّ
أتُرى أبعث طفلاً أم تُرى أبعث كهلا؟
ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي؟
لست أدري
(لست أدري) تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة وليست هي مقولة شاعر فحسب، (فسقراط) الفيلسوف الذي يعدُّ من عمالقة الفلاسفة، يقول بصريح العبارة (الشيء الذي لا أزال أجهله جيداً: أنني لست أدري) بل إنَّ اللاأدرية مذهب فلسفي قديم.
إنَّه الضلال: الضلال عن الحقيقة، إنَّه الشقاء، شقاء القلب، وتعاسة النفس، وضياع الضمير المثقل المكدود، وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال، بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته، وحيرته، وبعضهم يحسُّ، ويعاني، وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية.
بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري، يدري من أين جاء، وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود؟ وما دوره في هذه الحياة؟ قال تعالى: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *} [الملك: 22] إنَّ البشرية تخبطت في دياجير الظلام، وانتكست في مهاوي الشرك، وضلت عن سواء السبيل، انحرفت عن منهج التوحيد، الذي جاء به الأنبياء، والرسل، فأصيبت البشرية في عقلها، وفكرها، وقلبها بالشرك، وما ينبثق عنه من ضياع في المنهج، والفكر، والعقيدة، والأخلاق، فانحرفت اليهودية عن التوحيد الذي جاء به موسى ـ عليه السلام ـ على دراية من أحبارهم، وعلمائهم، ولذلك غضب الله عليهم، وأضاعت النصارى الحقَّ الذي جاء به عيسى، عليه السلام، فضلوا سواء السبيل.
فأصبحت البشرية في ظلمة شديدة قبل نزول القرآن، وبزوغ فجر الإسلام، كانت البشرية قبل نزول القرآن تعجُّ بركام العقائد، والتصورات المنحرفة في ذات الله، وفي الكون، وفي الحياة، وفي الإنسان، وفي الموت، وفي الجزاء، وفي الحساب، وفي الكتب السماوية، وفي رسل الله، وفي أقدار الله وقضائه، وأصبحت البشرية بين إفراط وتفريط بعيدة عن الصراط المستقيم، فحادت عن الوسطيَّة والاعتدال والاستقامة، فبعض البشر زعم: أن الملائكة بنات الله، ثم عبدوا الملائكة، كما فعل مشركو العرب، وبعضهم قالوا: عزير ابن الله، كما فعلت اليهود، ووُصِف المولى عز وجل بصفاتٍ لا تليق به من صفات النقص، وشُبّه بمخلوقاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
وشاعت بين البشرية عبادة الأصنام، إما بوصفها تماثيل للملائكة، وإما بوصفها تماثيل للأجداد، وإما لذاتها، وكانت الكعبة التي بنيت لعبادة الله وحده تعج بالأصنام؛ إذ كانت تحتوي على ثلاثمئةٍ وستين صنماً غير الأصنام الكبرى في جهات متفرقة.
ومما يدلُّ على أن اللات، والعزى، ومناة كانت تماثيل للملائكة ما جاء في القرآن الكريم في سورة النجم: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى *وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى *أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى *تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى *إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى *أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى *فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى *وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى *إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى *وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا *}[النجم: 19 ـ 28].
وانتشرت بين الناس عبادة الكواكب، وكانت قبيلة حمير تعبد الشمس، وكنانة القمر، ولخم، وجذام المشتري، وطيأى سهيلاً، وقيس العبور، وأسد عطارد.
وقد جاء عن هذا في سورة فصلت: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }[فصلت: 37] وجاء في سورة النجم: { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى *}[النجم: 49] وكثرت الإشارات إلى خلق النجوم، وربوبية الله سبحانه لها كبقية خلائقه، وذلك لنفي ألوهية الكواكب، وعبادتها، لقد سادت الصورة المشوهة للتصورات في الجزيرة العربية حيث بلاد الشام، والرومان حيث النصرانية المحرفة، واليهودية المغضوب عليها، وأصبحت البشرية شرقاً وغرباً، وجنوباً وشمالاً تعج بركام من بقايا العقائد السماوية المحرفة، ويجثم على ضمير البشرية في كل مكان، والذي كانت تنبثق منه أنظمتهم، وأوضاعهم، وادابهم، وأخلاقهم.
من ثم كانت عناية الإسلام الكبرى موجهةً إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقرُّ عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية، وعلاقتها بالخالق، وعلاقة الخالق بها.. فتستقر عليها نظمهم، وأوضاعهم، وعلاقتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وادابهم، وأخلاقهم كذلك، فلا يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها إلا أن تستقر الألوهية، وتتبين خصائصها، واختصاصاتها.
وعُنِيَ الإسلام (في أصليه: الكتاب، والسنة) بإيضاح طبيعة الخصائص والصفات الإلهية المتعلقة بالخلق والإرادة والهيمنة والتدبير.. ثم بحقيقة الصلة بين الله والإنسان.. فلقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه العقائد، والفلسفات مما يتعلق بهذا الأمر الخطير الأثر في الضمير البشري، وفي الحياة الإنسانية كلها.
فالذي يعرف الجاهلية هو الذي يدرك قيمة الإسلام، ويعرف كيف يحرص على رحمة الله المتمثلة فيه، ونعمة الله المتحققة به. إنَّ جمال هذه العقيدة، وكمالها، وتناسقها، وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها.. إن هذا كله لا يتجلى للقلب، والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية ـ السابقة للإسلام، واللاحقة ـ عندئذ تبدو هذه العقيدة رحمة.. رحمة حقيقية.. رحمة للقلب، والعقل. ورحمة بالحياة، والأحياء، رحمة بما فيها من جمالٍ، وبساطة، ووضوحٍ، وتناسق، وقربٍ، وأنس، وتجاوبٍ مع الفطرة مباشرٍ عميق.
خامساً: هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟
يرى كثير من الباحثين الغربيين: أنَّ الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها عليه اليوم مرة واحدة، ولكنها ترقَّت، وتطورت في فترات وقرون متعاقبة، ولا عجب أن يقول بهذا الإفك من لم يمنحهم الله كتابه، الذي بيَّن فيه تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه، إلا أنَّ الغريب أن يسلك هذا المذهب رجال يعدون أنفسهم ويعدهم غيرهم باحثين مسلمين.
ومن أمثال أولئك عباس محمود العقاد الذي يرى في كتابه (الله) ـ وهو كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية ـ: أنَّ الإنسان ترقى في العقائد، ويرى أن ترقي الإنسان في العقائد موافقٌ تماماً لترقيه في العلوم.
يقول: (كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه، وصناعاته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان، والعبادات، وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى).
بل يرى: أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشقَّ من تطور العلوم، والصناعات، ويقول: وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات ؛ لأن حقيقة الكون الكبرى أشقُّ مطلباً، وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعاجلها العلم تارة، والصناعة تارة أخرى.
ويرى: أن الحقيقة الإلهية لم تتجلَّ للناس مرة واحدة. يقول: (فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين، ولا على أنها تبحث عن محال، كلُّ ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد).
ثم أخذ يستعرض اراء الباحثين في تاريخ العقيدة، فمنهم من يرى: أن السبب في نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من قوى الطبيعة والأحياء، بعضهم يرى: أن العقيدة الدينية عبادة (الطوطم)، كأن تتخذ بعض القبائل حيواناً (طوطميّاً) تزعمه أباً لها، وقد يكون شجراً، أو حجراً يقدِّسونه إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان الباحثين الغربيين.
ومع الأسف فقد سرت هذه النظرية إلى بعض الكتاب مثل مصطفى محمود في كتابه (الله) واعتنقها جملةٌ من الدارسين، وقد أوقع هؤلاء في هذا الخطأ عدة أمور:
الأول: أنهم ظنُّوا: أن الإنسان اهتدى إلى العقيدة بدون معلم يعلمه، ومرشد يوضح له، فما دام الأمر كذلك، فلابد أن يترقى في معرفته بالله كما ترقى في العلوم، والصناعات.
ثانياً: أنهم قدَّروا: أن الإنسان الأول خلق خلقاً ناقصاً غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان.
الثالث: أنهم عندما بحثوا في الأديان؛ ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أمامهم إلا تلك الأديان المحرفة، أو الضالة، فجعلوها ميدان بحثهم، فأخضعوها للدراسة، والتمحيص، وأنَّى لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل انحراف الإنسان في فهم العقيدة.
سادساً: القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة
ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكاً وافياً لأسباب:
الأول: إنَّ ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل خمسة الاف عام قليل، أما ما نعرفه قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك يعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئاً ؛ لذا فإن كثيراً من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني.
الثاني: إنَّ الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف، والدجل، والتحريف، وممَّا يدلُّ على ذلك: كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتدُّ إلى فجر البشرية؟
الثالث: إنَّ قسماً من التاريخ المتلبِّس بالعقيدة لم يقع في الأرض، بل في السماء لذا كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ *}[ آل عمران: 5].
تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الكريم:
أعلمنا الله ـ سبحانه ـ: أنه خلق آدم خلقاً مستقلاً سويّاً متكاملاً، ثم نفخ فيه من روحه، وأسكنه جنته، وأباح له أن يأكل هو وزوجه منها كيف يشاء إلا شجرة واحدة، فأغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة، فأطاع عدوَّه، وعصى ربه، فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض، وقبل الهبوط وعده الله سبحانه بأن ينزل عليه وعلى ذريته هُداه كي يعرف الإنسان بربه، ومنهجه، وتشريعه، ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا، والسعادة في الاخرة، وتوعد الله المستكبرين بالمعيشة الضنكى في الدنيا، وبالشقاء في الاخرة: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *}[البقرة: 38 ـ 39]. وفي سورة طه يقول سبحانه: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى *وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى *قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا *قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى *}[طه: 123 ـ 126].
سابعاً: الجيل الأول كان على التوحيد
هبط آدم إلى الأرض، وأنشأ الله من ذريته أمَّةً كانت على التوحيد الخالص، كما قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} أي: على التوحيد، والدين الحق، فاختلفوا {فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}[البقرة:213].
وفي حديث أبي أمامة: أن رجلاً سأل الرسول (ص) قال: يا رسول الله أنبيٌّ كان ادم؟ قال: «نعم، مكلَّم»، قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». وذكر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلُّهم على الإسلام.
ومقدار القرن مئة سنة وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة، وقد تكون المدة أكثر من ذلك؛ إذ قيَّد ابن عباس هذه القرون العشرة بأنها كانت على الإسلام، فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير الإسلام. وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس قال تعالى: وقوله: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ *} [الإسراء: 17] وقوله:{ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ *} [المؤمنون:31].
يمكنكم يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/29.pdf