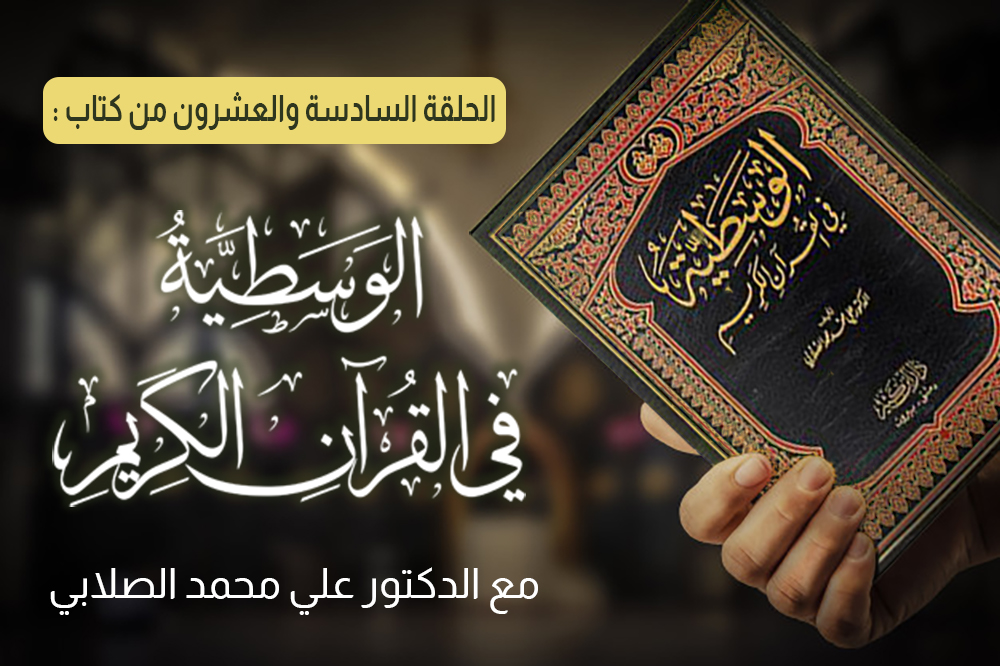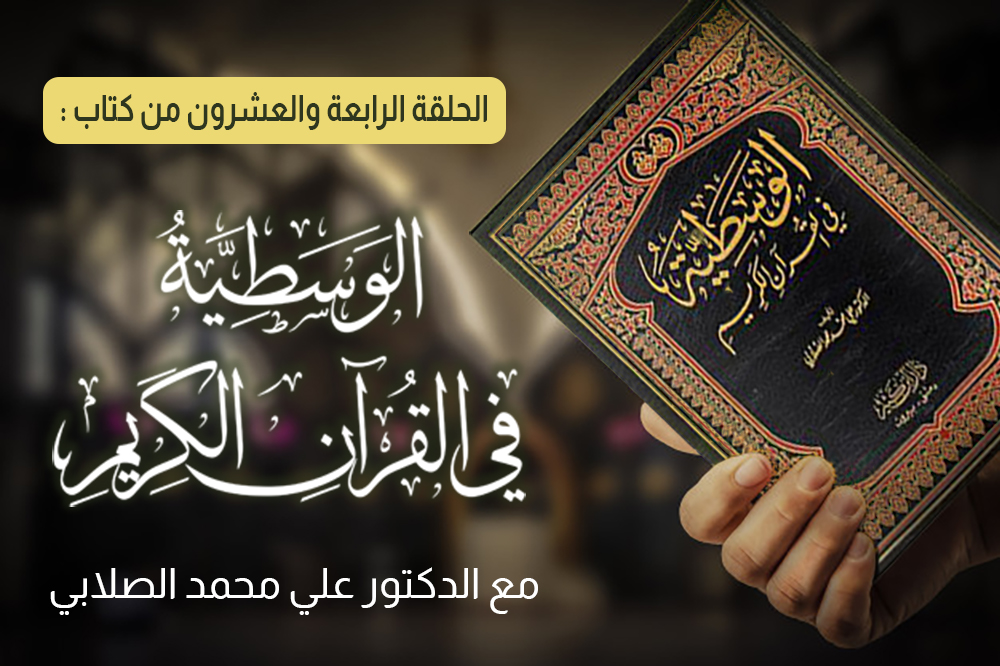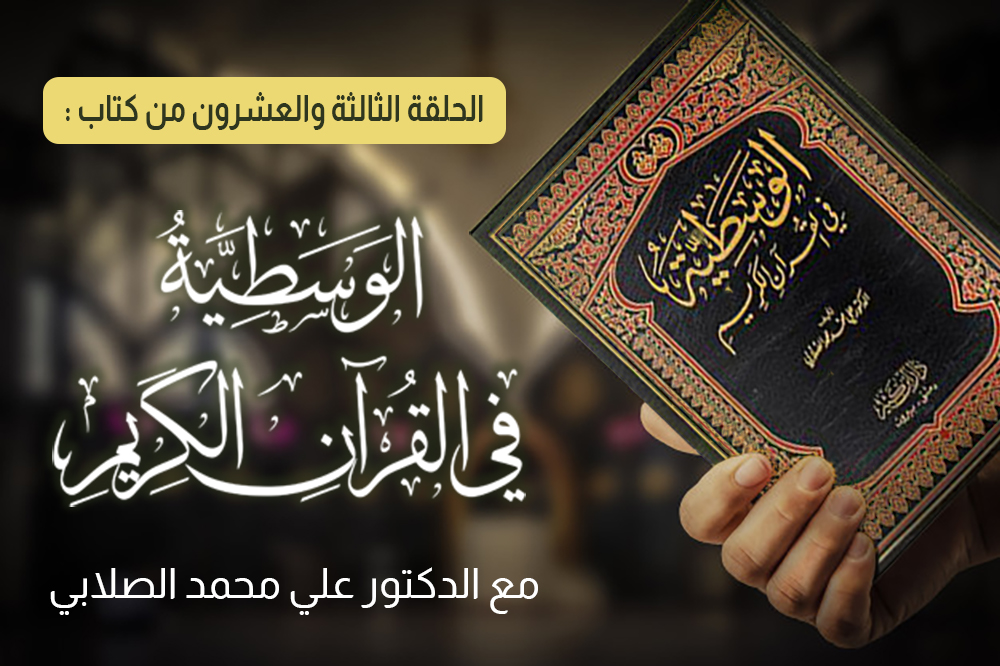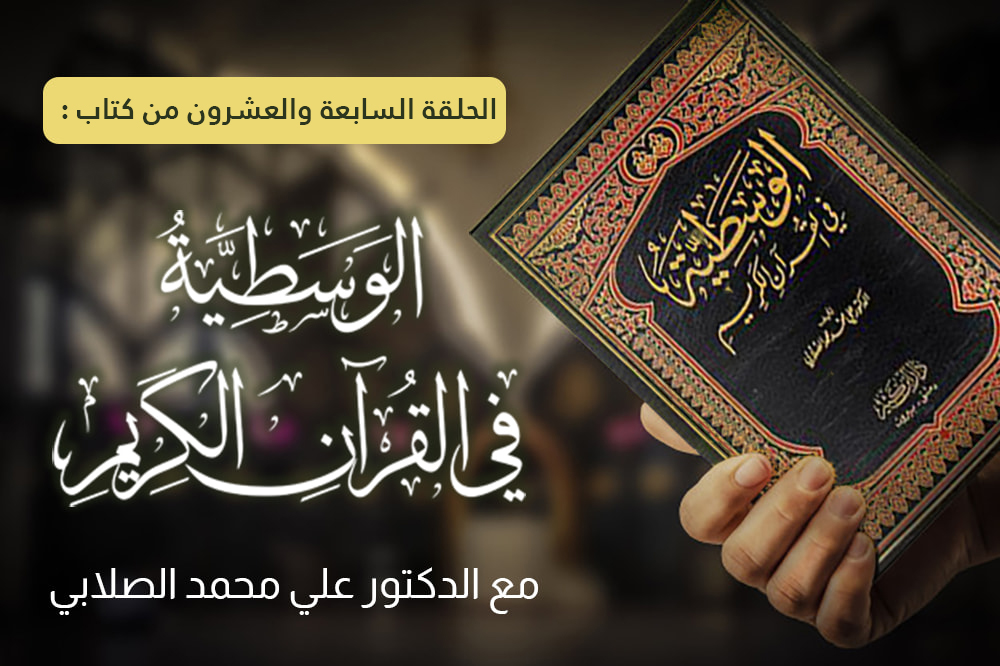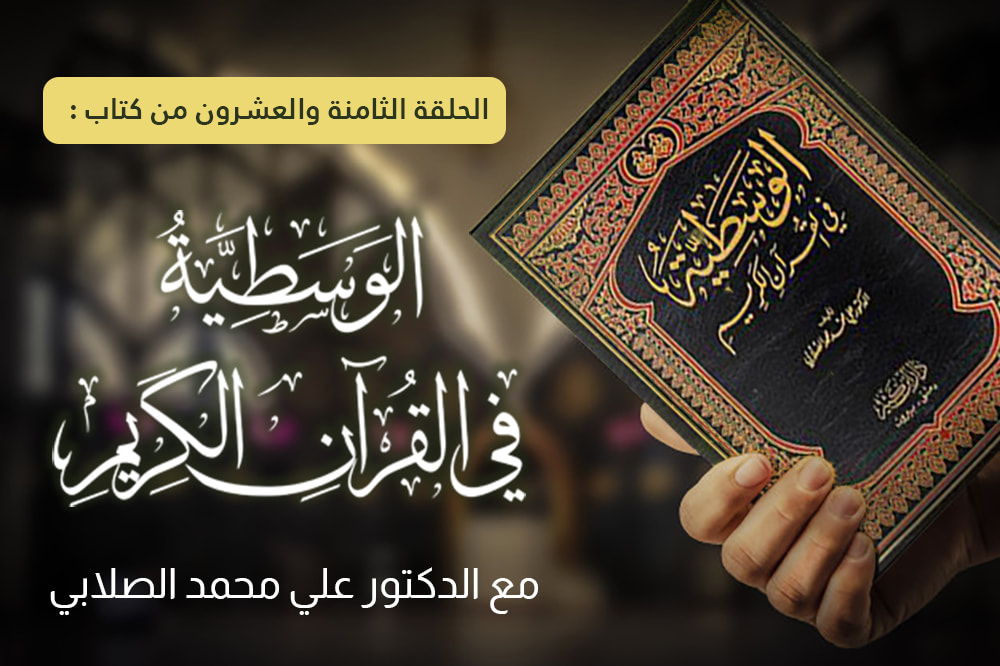من كتاب الوسطية في القرآن الكريم
(منهج القرآن في الأمور التي يستمدُّ منها الإيمان)
الحلقة: السادسة والعشرون
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
ربيع الأول 1442 ه/ نوفمبر 2020
بما أن الإيمان أعظم المطالب، وأهمها، وأعمُّها؛ لذلك جعل الله له مواد كبيرة تجلبه، وتقويه، كما أنه له أسباب تضعفه، وتوهيه.
والمواد التي تجلبه، وتقويه أمران: مجمل، ومفصل، أما المجمل؛ فهو: التدبر لايات الله المتلوة: من الكتاب والسنة؛ والتأمل لاياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق؛ فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم.
وأما التفصيل: فالإيمان يحصل، ويقوى بأمور كثيرة، منها ـ بل أعظمها ـ:
الأول: معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب، والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبُّد لله فيها: قـال تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [الأعراف: 180] فالتأمل في أسمائه، وصفاته ـ سبحانه وتعالى ـ من منهج الوسطيَّة، والإلحاد في أسمائه، وصفاته خروجٌ عن منهج الوسطيَّة الذي رسمه القرآن : {قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110] والذين يصفون الله بغير وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يلحدون في آيات الله، وهذا انحراف عن الصراط المستقيم: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا}[فصلت: 40] ولذلك فإنَّ الحرص على معرفة أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها يزيد الإيمان.
فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً ـ مئة إلا واحداً ـ من أحصاها؛ دخل الجنة» أي: من حفظها، وفهم معانيها، واعتقدها، وتعبَّد الله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فاعلم: أن ذلك أعظم ينبوع، ومادة لحصول الإيمان، وقوته، وثباته. معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها.
ومعرفتها تتضمَّن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء، والصفات، وهذه الأنواع هي رُوْحُ الإيمان ورَوْحُه، وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته؛ ازداد إيمانه، وقوي يقينه، فينبغي للمؤمن: أن يبذل مقدوره، ومستطاعه في معرفة الأسماء، والصفات، وتكون معرفته سالمةً من داء التعطيل، ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل تكون المعرفة متلقاةً من الكتاب والسنة، وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه، وقوة يقينه، وطمأنينة في أحواله.
ويعجبني في هذا المقام كلام نفيس للعلامة ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ حيث يقول: (ومشهد الأسماء والصفات من أجَلِّ المشاهد، والمطَّلع على هذا المشهد يعرف: أن الوجود متعلق خلقاً، وأمراً بالأسماء الحسنى، والصفات العلى، ومرتبط بها، وأنَّ كل ما في العالم بما فيه من بعض اثارها ومقتضياتها، فاسمه الحميد المجيد، يمنع ترك الإنسان سدىً مهملاً معطلاً، لا يؤمر، ولا يُنهى، ولا يثاب، ولا يعاقب، وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى ذلك، وهكذا فكلُّ اسم من أسمائه له موجبات، وله صفات لا ينبغي تعطيلها عن كمالها، ومقتضياتها، والرب تعالى يحبُّ ذاته، وأوصافه، وأسماءه، فهو عفو يحبُّ العفو، ويحبُّ المغفرة، ويحبُّ التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال.
وكان تقدير ما يغفره، ويعفو عن فاعله، ويحلم عنه، ويتوب عليه، ويسامحه بموجب أسمائه وصفاته، وحصول ما يحبه، ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه، ويحمد به أهل سماواته، وأهل أرضه، وما هو من موجبات كماله، ومقتضى حمده، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده، ومجده يقتضيان اثارهما، ومن اثارهما: مغفرة الزلات، وإقالة العثرات، والعفو عن السيئات، أو المسامحة عن الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق، والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته، وحكمته، كما قال عيسى عليه السلام في القرآن : {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *} [المائدة: 118] أي: فمغفرتك عن كمال قدرتك، وحكمتك، لست كمن يغفر عجزاً، ويسامح جهلاً بقدر الحق؛ بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به، فمن تأمل سريان اثار الأسماء، والصفات في العالم، وفي الأمر؛ يتبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو في كمال الأسماء، والصفات، والأفعال، وغايتها أيضاً مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته، وإلـهيته، فَلِّله في كل ما قضاه وقدَّره الحكمة البالغة والآيات الباهرة.
والله سبحانه دعا عباده إلى معرفته بأسمائه، وصفاته، وأمرهم بشكره، ومحبته، وذكره، وتعبدهم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى ؛ لأن كل اسم له تعبُّـدٌ مختص به علماً، ومعرفةً، وحالاً، وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء، والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا يحجبه اسم عن اسم آخر، كما لا يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم) أو يحجبه عبودية اسمه (المعطي) عن عبودية اسمه (المانع) أو عبودية اسمه (الرحيم، العفو، والغفور) عن اسم (المنتقم) أو التعبد بأسماء (البر، والإحسان، واللطف) عن أسماء العدل: والجبروت، والعظمة، والكبرياء. وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن . قال تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبدوهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها.
فالله تعالى يحبُّ موجب أسمائه، وصفاته، فهو عليم يحبُّ كلَّ عليم وهو (جواد) يحب كل جواد، (وتر) يحب الوتر (جميل) يحب الجمال (عفو) يحب العفو، وأهله (حيي) يحب الحياء وأهــله (بر) يحب الأبرار (شكور) يحب الشاكرين (صبور) يحب الصابرين (حليم) يحب أهل الحلم، فلمحبته سبحانه للتوبة، والمغفرة، والعفو، والصفح خلق من يغفر لهم، ويتوب عليهم، ويعفو عنهم، وقدَّر عليهم ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له ؛ ليترتب عليه المحبوب له المرضي له.
وظهور أسماء الله، وصفاته في هذه الحياة، وفي النفس البشرية، وفي الكون كله واضحٌ لا يحتاج إلى دليل، إلا أن الاهتداء إلى تلك الاثار، أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله تعالى، بل إن التوفيق نفسه من اثار رحمته التي وسعت كل شيء، فلو فكر الإنسان في هذا الكون الفسيح، وفي نفسه؛ لرجع من هذه الجولة الفكرية بعجائب، واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بها، ولو تأملنا هذه الآيةالكريمة؛ لرأينا أموراً نعجز عن التعبير عنها. قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ *فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ *}[المؤمنون: 115 ـ 116] وممَّا يدلل، ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماء الله، وصفاته في قلب المؤمن من زيادة الإيمان، ورسوخ في اليقين، وما تجلبه له من النور، والبصيرة التي تحفظه من الشبهات المضللة، والشهوات المحرمة.
فهذا العلم إذا رسخ في القلب؛ أوجب خشية الله لا محالة، فلكل اسم من أسماء الله تأثير معين في القلب، والسلوك، فإذا أدرك القلب معنى الاسم، وما تضمنه، واستشعر ذلك؛ تجاوب مع هذه المعاني، وانعكست هذه المعرفة على تفكيره، وسلوكه، ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، فالأسماء الحسنى، والصفات العلى مقتضية لاثارها من العبودية، وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبودية التي على القلب، والجوارح. فمثلاً: عِلْمُ العبد بتفرد الرب تعالى بالضرِّ، والنفع، والعطاء، والمنع، والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً، وعلمه بسمعه تعالى، وبصره، وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه، وجوارحه، وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطناً، ويثمر له الحياءُ اجتنابَ المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه، وجوده، وكرمه، وبره، وإحسانه، ورحمته توجب له سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه.
وكذلك معرفته بجلال الله، وعزه تثمر له الخضوع، والاستكانة، والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله، وجماله، وصفاته العلى توجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية إلى مقتضى الأسماء، والصفات، وارتبطت بها.
وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال، وأجل وصف يتصف به القلب، وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية، فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين !
لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن.
وقد يظنُّ بعض الذين يدعون العلم، وممن لا حظَّ لهم من علوم الشريعة: أن معرفة أسماء الله، وصفاته لا تؤثر في الإيمان بالله من حيث الزيادة، والنقصان، ولا تؤثر في القلوب، ولذلك لا فائدة من معرفتها أو جهلها أو إثباتها أو إنكارها، وقد توسع في هذا الجانب الفلاسفة الذين وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم، وأنكروا، وجحدوا ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحرفوا عن منهج الوسطيَّة، ووقعوا في الإفراط والتفريط، وابتعدوا عن الصراط المستقيم ومنهج الاعتدال الذي بيَّنه القرآن الكريم.
ومما لا ريب فيه: أنه ليست هناك صفة لله في القرآن أو في السنة إلا وقد ساقها الله تعالى لحكمة ومنفعة وغاية، ولولا ذلك؛ لما ساقها، ولما ذكرها ؛ لأن كلامه وكلام رسوله ينزه عن العبث واللغو والحشو. ومن ظن: أن الله يحشو كلامه بما لا فائدة في ذكره، أو لا غاية من ورائه، أو لا أهمية له؛ فقد اتهم الله بالنقص، واللغو.
ولبيان: أنَّ لكل صفة من صفات الله أثراً في قلب المؤمن سنبيِّن ذلك ببعض التفاصيل، من حيث إن لكل صفة في القلب أثراً يتضح في السلوك البشري، فلا توجد صفة من صفات الله إلا ولها أثرٌ وفائدة، وإنما الذي ينكر الأثر هم الجهلة والجاحدون، أما علماء أهل السنة والجماعة؛ فبينوا ذلك الأمر بياناً أوضح من الشمس في رابعة النهار.
أثر صفة العظمة:
وهذه الصفة مشتقة من اسمه تعالى العظيم، والعظمة صفة من صفاته لا يقوم لها خلق، والمقصود: أنَّ عظمة الله سبحانه لا يمكن أن يتصف بها أحد من خلقه، والله خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضاً، فمن الناس من يُعظَّم لِمَال، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنىً دون معنىً، والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف حق عظمته سبحانه أّلا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله.
فإذا شعر العبد بعظمة الله؛ خاف مولاه، واتقاه، ورغب في مرضاته سبحانه وتعالى، والحديث الدال على صفة العظمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول تبارك وتعالى: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحداً منهما؛ قذفته في النار».
أثر صفة يد الله:
ومن الصفات التي جحدتها قلوب النفاق، وأنكرها الزنادقة قديماً وصف الله نفسه سبحانه بأن له يَدَيْن، وهذا ما قد مدح الله به نفسه في آيات كثيرة من كتابه، وقد مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهي تدخل في صفات الله الذاتية، وقد بين سبحانه في الآيات والأحاديث عظمة عطائه وسعة فضله، وأن يده الكريمة ـ جل وعلا ـ دائمة العطاء والإنفاق، وفي مجال قوته، وجبروته، وبطشه، وكمال قدرته، وبيان عظمته: أن السمـوات والأرض يوم القيامة تكون بيمينه: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ *}[الزمر:67].
ولاشك أن أثر الإيمان بهذه الصفة في قلب المؤمن عظيم ؛ لأنه يورث القلب المهابة لله، والخوف منه، وتعظيم أمره وشأنه، وأنه الملك الذي قهر الملوك، وأنه لا مفر من قبضته، ولا ملجأ منه إلا إليه.
أثر اسم الله الحميد:
وهذا الاسم يتضمن لصفة الحمد بكل أنواعه، فهي صفة ذاتية لله ـ عز وجل ـ لا تنفك عنه، وتظهر اثارها باستمرار في كل لحظة، ومعناها: أنه سبحانه مستحق لكل أنواع الحمد ؛ لأنه المحمود في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وليس ذلك لأحد سواه سبحانه، كما يبدو لي: أن العبد لابد أن يسلك في حياته سلوكاً يحمد عليه ؛ لأن أعماله جميعاً يجب أن تكون خالصة للحميد، ولو أن كل فرد تحرى أن يكون عمله حميداً؛ لصلح أمر الناس في الدنيا والاخرة، ولاختفت المنازعات فيما بينهم، والخصومات ولعاشوا جميعاً إخوة في الله متحابِّين.
أثر اسم الله المهيمن:
ومن اثار هيمنته سبحانه: أنه يملك أن يتصرف في خلقه كيف يشاء؛ لأنه مَلِكُهم، والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف، من نماذج هذه التصرفات ما ذكره الله تنبيهاً، وتذكيراً باستمرار، وشمول هيمنته على خلقه سبحانه وتعالى».
قال تعالى:
{قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ *قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ *قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ *}[الأنعام: 63 ـ 65] وإذا شعر القلب بهيمنة ربه عليه؛ لجأ إليه، وطلب العون منه لدفع ضر أو جلب نفع. والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أثر صفة العلو في قلب العبد:
إذا أيقن العبد: أن الله تعالى فوق السماء، عالٍ على عرشه بلا حصر، ولا كيفية، وأنه الان في صفاته كما كان في قدمه؛ كان لقلبه في صلاته، وتوجهه، ودعائه إشراقٌ أيُّما إشراق!
ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه، فإنه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده، ولكن ربما عرفه بسمعه، وبصره، وقدمه، وتلك بلا هذا معرفة ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة، وكبر، وتوجه قلبه إلى جهة العرش منزهاً له تعالى، مفرداً له كما أفرده في قِدَمِه، وألوهيته، واعتقد: أنه في علوه قريب من خلقه، وهو معهم بعلمه، وسمعه، وبصره، وإحاطته، وقدرته، ومشيئته، وذاته فوق الأشياء، وفوق العرش، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان، وعكفت أشعة العظمة على قلبه، وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره، وقوي إيمانه، ونزَّه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينئذٍ شيئاً من أذواق السابقين المقربين.
أثر صفة السمع:
قال تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ *} [المجادلة :1].
وعن عائشة ـ رضي الله ـ عنها قالت: (الحمد لله وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادِلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه؛ وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }.
أقول: لو أن دارس الأسماء والصفات، ومدرسيها تأمَّلوا ما دلت عليه هذه الصفات، وأشْعَرَ المرء نفسه: أنه مراقب في جميع أحواله، وأن ما ينطق به لسانه يسمعه خالقه من فوق سبع سماوات في حينه، وأنه سيجازيه على ذلك؛ لانعكس على سلوكه، وأخلاقه، وأعماله، وسيرته في مجتمعه، ولظهرت الأخلاق الربانية، وأصبح الشخص لله وليّاً يمشي على وجه الأرض، ولشعرنا: أن الأخلاق الرفيعة ثمرة من ثمرات التوحيد، وبقدر ما يملك العبد من الإيمان والتوحيد ينعكس ذلك، ويظهر على أخلاقه.
ولابدَّ أن نراعي قواعد السلف عند تأملنا، وتفكرنا في أسماء الله وصفاته التي تزيدنا إيماناً بالله العلي العظيم، ويعجبني في هذا المقام أن أكتب ما كان يقوله، ويكرره شيخي الفاضل عبد المحسن العباد في دروسه بالمدينة النبوية (المذهب الحق وسط بين الطرفين في قضية الإثبات، فلا نفي، ولا تأويل، وفيه التنزيه، فلا تشبيه، ولا تمثيل، وكل من المشبهة، والنفاة جمعوا بين إساءة وإحسان).
فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا، فلم ينفوا الصفات، وأساؤوا إذ شبهوا، ومثلوا، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين، وسلموا من الإساءتين، فالإحسان الذي عند الطرفين عندهم، وليس عندهم ما عند كلٍّ من الإساءة، وذلك: أنهم أثبتوا ما أثبت في الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوا الله عن مشابهة خلقه، وكما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [الشورى: 11] فأول الآيةتنزيه، وآخرها إثبات، فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقابلين كالَّلبن السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرث ودم.
الثاني: تدبر القرآن على وجه العموم:
فإن المتدبّر لا يزال يستفيد من علوم القرآن، ومعارفه ما يزداد به إيماناً، كما قال تعالى: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *} [الأنفال: 2] وكذلك إذا نظرنا في انتظامه وإحكامه، وأنه يصدِّق بعضه بعضاً، ويوافق بعضه بعضاً، ليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ تيقن: أنه تنزيل من حكيم حميد: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ *} [فصلت: 42] وأنه لو كان من عند غير الله؛ لوجد فيه من التناقض، والاختلاف أموراً كثيرة، قال تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا *} [النساء: 82] وهذا من أعظم مقويات الإيمان، ويقويه من وجوه كثيرة: فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله، ويعرف ما فيها من الأخبار الصادقة، والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله، وفهم مقاصده وأسراره؟! ولهذا كان المؤمنون الكُمَّل يقولون: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا} [آل عمران: 193].
الثالث: معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله:
كلها من محصِّلات الإيمان، ومقوياته، فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين، فقد وصف الله الراسخين في العلم، الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب، ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم، واحتج بهم على غيرهم من المرتابين، والجاحدين، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ } [آل عمران: 7].
فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا: امنا بالجميع، فكلها من عند الله. وما فيه، وما تكلم به، وحكم به كله صدق وحق. وقال تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ}[النساء: 162].
وقال تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *} [آل عمران: 18] ولعلمهم بالقرآن العلم التام، وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ *} [الروم: 56] وأخبر تعالى في عدة آيات: أن القرآن آيات للمؤمنين، وآيات للموقنين ؛ لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علماً وإيماناً ويقيناً.
الرابع: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه ـ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ـ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب، والسنة الحق، كما قال تعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ *}[المؤمنون: 69].
فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان بما لم يؤمن به، وزيادة الإيمان بما امن به. وقال تعالى حاثّاً لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ *}[سبأ:46].
وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول، وعظمة أخلاقه، وأنه أكمل مخلوق بقوله: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ *مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ *وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ *وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ *}[القلم: 1 ـ 4] فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داعٍ للإيمان في أوصافه الحميدة، وشمائله الجميلة، وأقواله الصادقة النافعة، وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم، والقدوة الأكمل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: 21]،{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7].
وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق: أنهم قالوا: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا } وهو هذا الرسول الكريم {يُنَادِي لِلإِيمَانِ}بقوله، وخلقه، وعمله، ودينه، وجميع أحواله {أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا}[ آل عمران : 193] أي: إيماناً لا يدخله ريب.
ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله؛ توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات، وينيلهم المطالب العالية، فقالوا: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ *} [آل عمران:193].
ولهذا كان الرجل المنصف ـ الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه ـ يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم بمجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف: أنه ليس بوجه كذاب، وقيل لبعضهم: لِمَ بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل : ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به.
فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته، وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان به ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به، وما ينهى عنه، استدل بذلك: أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافاً جليّاً، ولكن منعته الرئاسة، وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منعت كثيراً ممن اتضح لهم: أنه رسول الله حقّاً، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء، وأما أهل البصائر، والعقول الصحيحة؛ فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات، ولا يرون لها قيمة؛ حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع، المثمر للسعادة عاجلاً واجلاً. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقران حفظاً ومعرفة، والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيماناً ويقيناً من غيرهم، وأحسن عملاً في الغالب.
الخامس: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التي بيَّنها القرآن الكريم التفكر في الكون، وفي خلق السمـوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان، وما هو عليه من الصفات المتنوعة. قال تعالى:{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ *}[ آل عمران: 190] وقال تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ *}[الذاريات:21].
فإن التأمُّل والتفكر في الكون والنفس وايات الله المنظورة داعٍ قويٌّ للإيمان؛ لما في هذه الموجدات من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحيِّر الألباب الدال على سعة علم الله، وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله، وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره، واللهج بذكره، وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. وإذا تأملنا في مخلوقات الله كلها؛ نجدها مضطرة ومحتاجة إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصاً ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع، وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه، وكمال الثقة بوعده، وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان، ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وأصلها قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ *} [فاطر: 15] كذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين. كلُّ هذا يدعو إلى الإيمان.
ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين إلى شكره، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *} [البقرة: 172] فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكلٌّ منهما ملازم وملزوم للآخر.
السادس: ومن أسباب دواعي الإيمان التي بيَّنها القرآن الكريم الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإنَّ الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويغذيها، وينميها، وكلما ازداد العبد ذكراً لله؛ قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي: الإيمان، بل هي روحه. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } [الأحزاب: 41] وقال تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا *}[الأحزاب: 21].
السابع: ومن الأسباب الجالبة للإيمان التي بيَّنها القرآن الكريم السعي، والاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى خلقه. قال تعالى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [لقمان: 22] وقال تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}[البقرة:83].
فعلى العبد: أن يعبد الله كأنه يشاهده، فإن لم يقوَ على هذا استحضر: أنَّ الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل، وإتقانه، ولا يزال يجاهد نفسه؛ ليتحقق هذا المقام العالي، وبالتالي يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين، وطريق المحسنين كما جاء في القرآن بيان صفاتهم، قال تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ *آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ *كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ *وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ *}[الذاريات: 15 ـ 19]. وقال تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *}[ آل عمران: 134].
وبذلك يتضح لنا صفات المحسنين، ويكون الإحسان إلى الخلق بالقول، والفعل، والمال، والجاه، وأنواع المنافع هو من الإيمان، ومن دواعي زيادته، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله، وأوصل إليهم من برِّه ما يقدر عليه؛ أحسن الله إليه أنواعاً من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير، والتقرب إلى ربه، وإخلاص العمل له.
الثامن: ومن الأمور التي تقوِّي الإيمان، وتزيده ما ذكره الله تعالى في سورة المؤمنون من قوله: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لأِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ *أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ *}[المؤمنون: 1 ـ 10] فهذه الصفات الثمانيَّة، كل واحدة منها تثمر الإيمان، وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم، فحضور القلب في الصلاة، وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله، ويفعله من القراءة، والذكر، والدعاء فيها، ومن القيام والقعود، والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه.
وقد سمَّى الله تعالى الصلاة إيماناً بقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } [البقرة: 143] {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] الفحشاء والمنكر ينافيان الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان، وينميه؛ لقوله: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ *} [العنكبوت: 45] والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، فرضها، ونفلها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كونها برهاناً على إيمان صاحبها فهي تغذي الإيمان، وتنميه، والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه، وكل فعل لا خير فيه لاشك: أنه من الإيمان، ويزداد به الإيمان، ويثمر.
ولهذا كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة، أو تشعث إيمانهم؛ يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة» فيذكرون الله، ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية، فيتجدَّد بذلك إيمانهم، وكذلك العفَّة عن الفواحش خصوصاً فاحشة الزنى. ولا ريب: أن هذا من أكبر علامات الإيمان، ومنمياته.
فإن المؤمن ينهى النفس عن الهوى إجابة لدواعي إيمانه، وتغذية له، كما أن رعاية العهود، والأمانات، وحفظها من علامات الإيمان، وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد، ودينه؛ فانظر حاله: هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية، أو أمانات الحقوق؟ وهل يرعى الحقوق، والعهود، والعقود التي بينه وبين الله، والتي بينه وبين العباد؟ إذا لم يكن كذلك؛ نقص من دينه، وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. وحتماً بالمحافظة على الصلوات حدودها، وحقوقها، وأوقاتها يزداد الإيمان؛ لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري في بستان الإيمان، فيسقيه، وينميه، ويؤتي أكله كل حين.
التاسع: ومن دواعي زيادة الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله، وإلى دينه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد بنفسه، ويكمل غيره، ألم ترَ: أنَّ الله تعالى أقسم بالعصر: أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع، هي: الإيمان، والعمل الصالح اللذين تكمل بهما النفس، والتواصي بالحق ـ الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، والدين الحق ـ وبالصبر على ذلك كله يكمل غيره.
وذلك: أنَّ نفس الدعوة إلى الله، والنصيحة لعباده من أكبر مقومات الإيمان، وصاحب الدعوة لابد أن يسعى بنصر هذه الدعوة، ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوصل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ *وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ *وأمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *}[فصلت: 33 ـ 36] وَمَنْ حرص على نصح الناس، ودعوتهم إلى دين الله لابدَّ أن يجازيه الله، ويؤيده بنور منه، ورَوْح، وإيمان، وقوة توكُّلٍ، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل بهما النصر على الأعداء من شياطين الإنس، وشياطين الجن قال تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *} [النحل:99] والمتصدِّي لنصرة الحق لابدَّ أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه.
العاشر: ومن أهم مواد الإيمان، ومقوماته توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأسباب المقوية المنمية للإيمان، ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك بيَّن المولى ـ عز وجل ـ الموانع، والعوائق، وأرشد إلى دفعها، وهي: الإقلاع عن المعاصي، والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان، فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير، ومحبته، والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حُفِظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات، وفتن الشهوات؛ تمَّ إيمانه، وقوي يقينه.
فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه، والتحقق بها علماً وعملاً وحالاً. والثاني: السعي في دفع ما ينافيها، وينقصها، أو ينقضها من الفتن الظاهرة، والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، وتدارك الأمر قبل فواته. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *} [الأعراف: 201] أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه، والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان، الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، فإذا أبصروا؛ تداركوا هذا الخلل بسدِّه، وهذا الفتق برتقه، فرُدُّوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيراً ذليلاً.
وكذلك إخوان الشياطين:{يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ *} [الأعراف: 202]. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم، وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم، والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك، ويحق عليهم الخسار، والبوار.
وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم الإيمان تبين: أن ما جاء به القرآن، ووضحه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، والاستقامة، والاعتدال بعيداً عن ما وقع فيه الملاحدة من الزور، والبهتان، ووقع فيه الفلاسفة من تصوراتٍ خاطئة مريضة في أسماء الله، وصفاته، وأفعاله، وذاته.
ولقد وقع الناس بين إفراط وتفريط، وانكسار وغلو، فأكرم الله البشرية بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ففي جانب الإيمان بالله تعالى جاء القرآن بالمنهج الوسط الذي تجسَّدت فيه ملامح الوسطيَّة من حكمة، واستقامة، واعتدال، وعدل، وبينيَّة.
وقبل الانتهاء من مبحث الإيمان وأسباب زيادته رأيت من باب الفائدة والحث على استيعاب وفهم هذا الموضوع المهم في حياة الناس أن أتطرق إلى فوائد الإيمان، وثمراته كما جاءت في القرآن، موضِّحاً الاثار، والفوائد، والثمرات العاجلة والاجلة في القلب، والبدن، والراحة، والحياة الطيبة في الدنيا والاخرة، وذكر القرآن الكريم لهذه الفوائد والثمار يرسم لنا الصورة اليانعة الحية في وسطية القرآن في قضية الإيمان.
يمكنكم يمكنكم تحميل كتاب :الوسطية في القرآن الكريم
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: