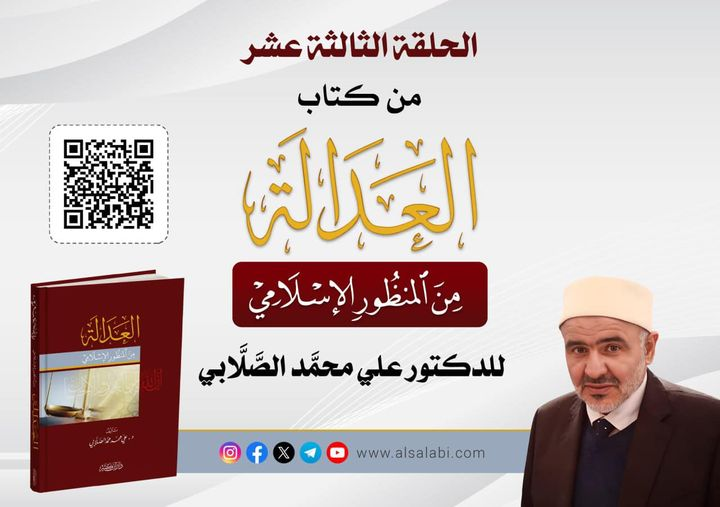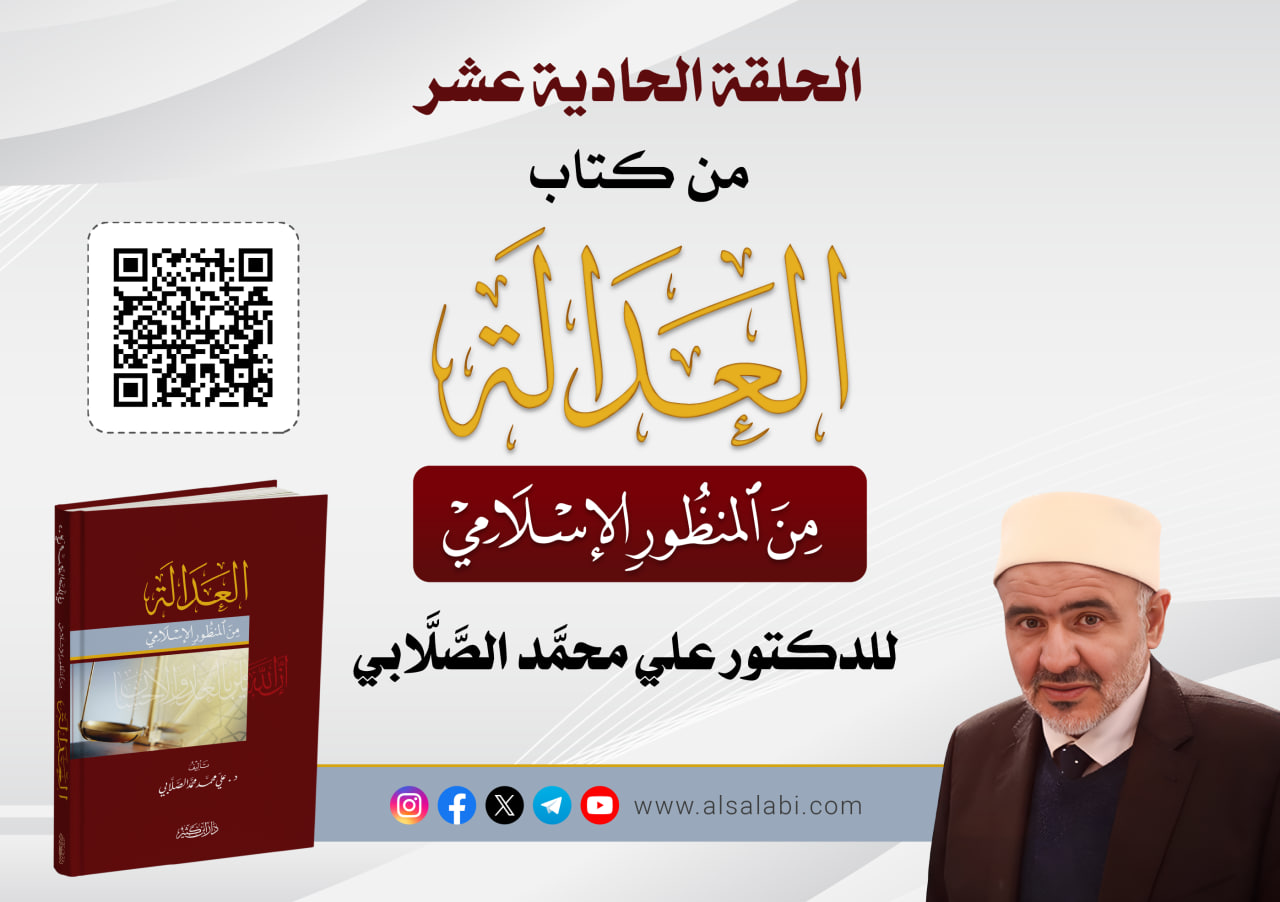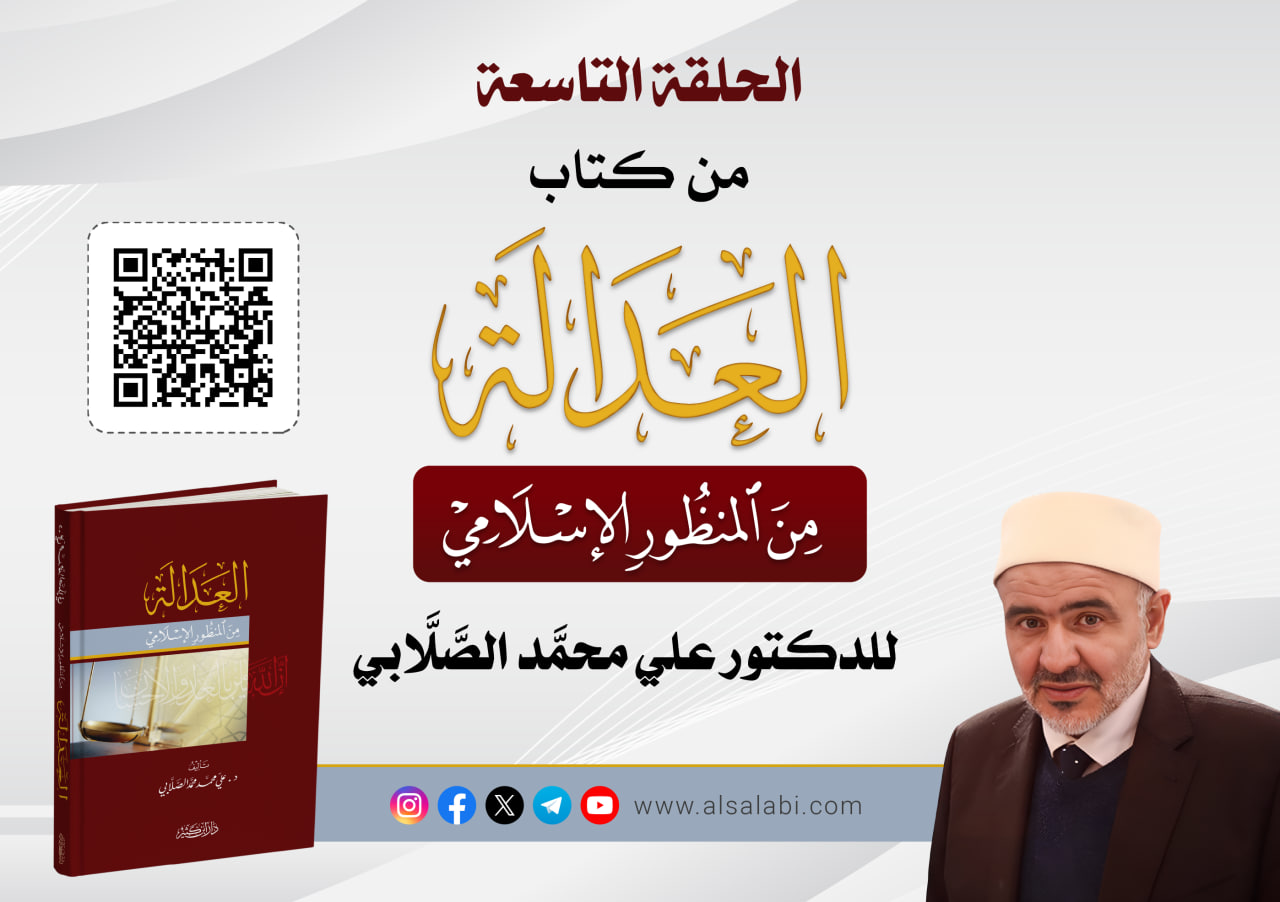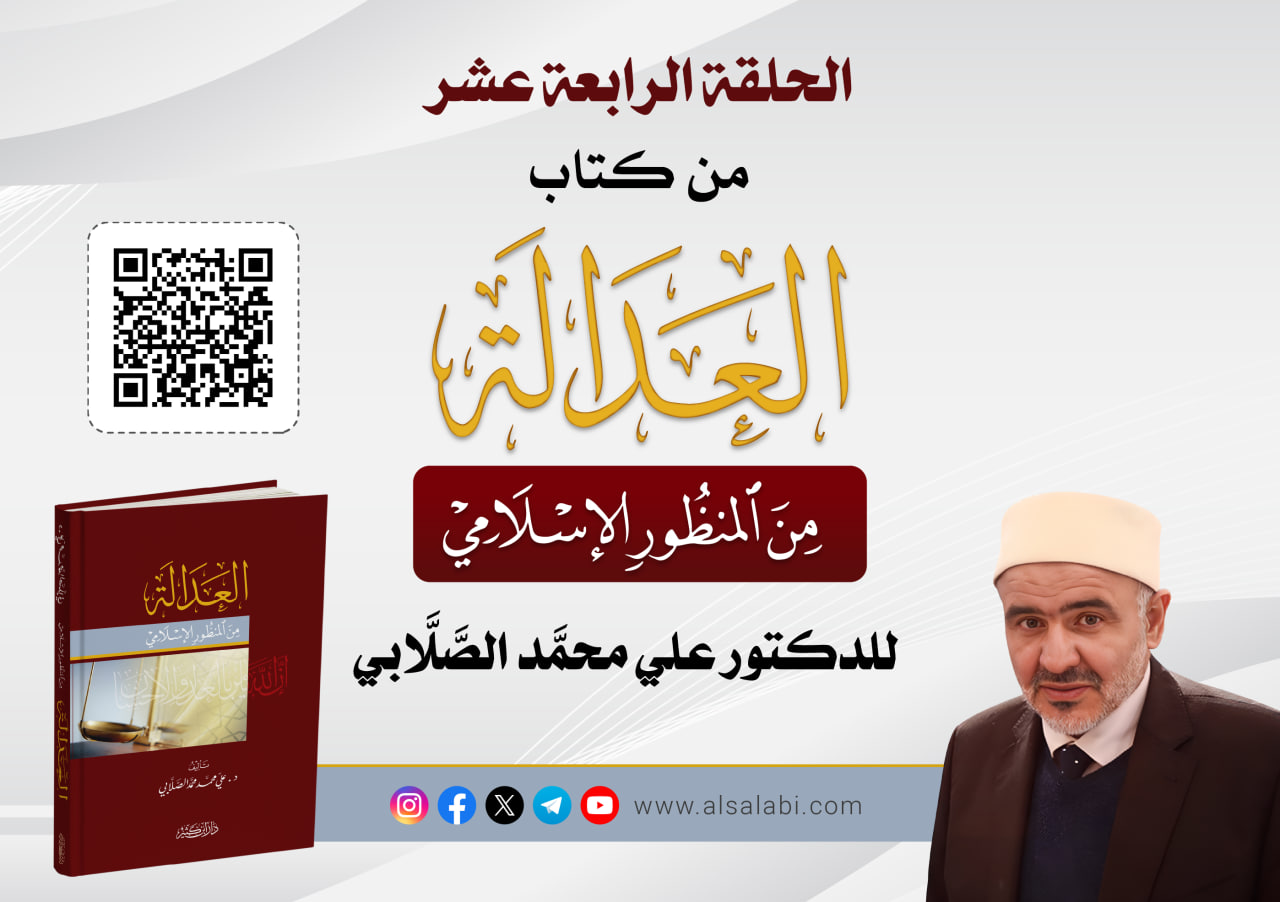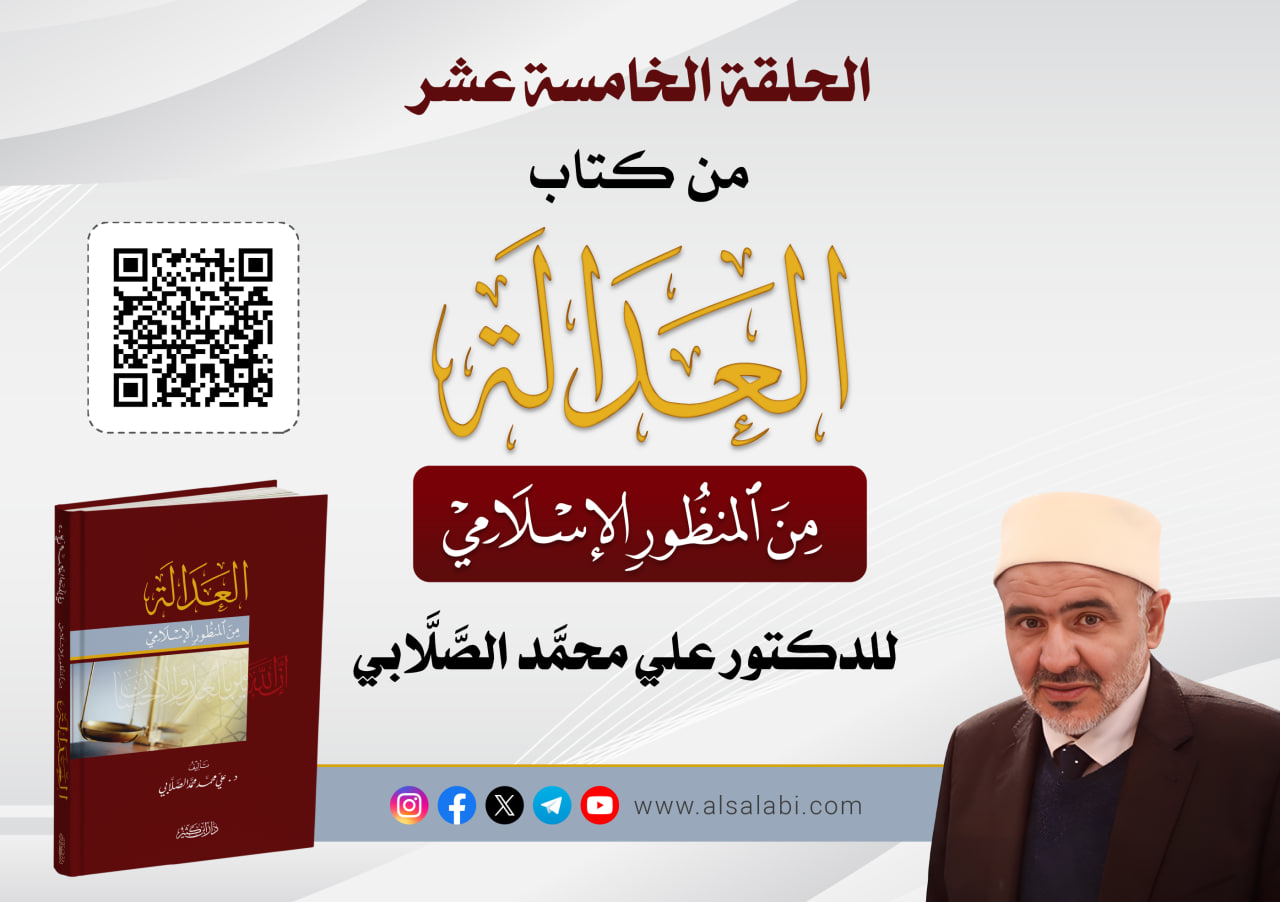مكـانـة العـدل في القرآن الـكـريـم
مختارات من كتاب العدالة من المنظور الإسلامي
بقلم: د. علي محمد الصلابي
الحلقة (13)
تحدث القرآن الكريم عن قيمة العدل، وجعلها من مقاصده، والكلمات التي دعت للعدل في القرآن الكريم مترادفة ومتفاوتة، فتارة تدعو بلفظ العدل، أو تارة أخرى بلفظ القسط، وأحياناً بالأمر بإيفاء الكيل والميزان أو الوزن بالقسطاس المستقيم، وهكذا.
1 ـ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ *} [النحل: 90 ـ 91].
بعد أن حدثنا الله تعالى في كتابه أنه بيان لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين يأتي قوله: ِ في كل شيء... في أداء الحقوق والقيام {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، فيحدد الحقوق، ويحدد الواجبات في السياسة الاقتصاد والاجتماع، فلا عدل إلا ما أمر به، ولا يتحقق العدل في الحياة البشرية إلا بإقامة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان، وهو معنى زائد على العدل، فالعدل في كل شيء حسن، والإحسان فعل الأحسن.
2 ـ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا *}[النساء: 58].
وفي تفسير قول الله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ} َ فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملاً َ [بَيْنَ النَّاسِ] جميعاً لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب، ولا عدلاً مع أهل الكتاب، دون سائر الناس، وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه إنساناً. فهذه الصفة ـ صفة الناس ـ هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني، وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعاً: مؤمنين وكفاراً، أصدقاء وأعداء، سوداً وبيضاً، عرباً وعجماً، والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل ـ متى حكمت في أمرهم ـ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط ـ في هذه الصورة ـ إلا على يد الإسلام، وإلا في حكم المسلمين وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية، والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعماً قط، في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعاً لأنهم «ناس».
3 ـ قال تعالى: َ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *}[ المائدة 8].
أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنان، ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى في حال من الأحوال، العدل المنبثق من القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات والشعور برقابة الله وعلمه بخفايا الصدور، ومن ثم فهذا النداء: َ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *} [المائدة 8 ].
لقد نهى الله الذين امنوا من قبل أن يحملهم الشنان لمن صدوهم عن المسجد الحرام، على الاعتداء. وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم، فها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشنان على أن يميلوا عن العدل، وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق، فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل، مع الشعور بالكره والبغض.
إن التكليف الأول أيسر؛ لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء، فأما التكليف الثاني فأشق؛ لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين.
والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة، فيقدم له بما يعين عليه: َ ويعقب عليه بما يعين عليه أيضاً: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *}
إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المُرتقى قط، إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله حين تقوم لله متجردة عن كل ما عداه، وحين تستشعر تقواه، وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق، ويثبتها عليه وما غير القيام لله، والتعامل معه مباشرة والتجرد من كل اعتبار آخر يملك أن يستوي بهذه النفس على هذا المرتقى.
وما مِن عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين، كما يكفله لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر، وأن يتعاملوا معه متجردين عن كل اعتبار، وبهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً ـ معتنقيه وغير معتنقيه ـ أن يتمتعوا في ظله بالعدل، وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه يتعاملون فيها مع ربهم مهما لاقوا من الناس من بغض وشنان، وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية، مهما يكن فيها من مشقة وجهاد.
ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة، وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام. ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصايا، ولا مجرد مثل عليا، ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية، واقعاً لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد، ولم تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة.. والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجاً في عالم الواقع، يؤدي ببساطة، ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة، إنها لم تكن مثلاً عليا خيالية، ولا نماذج كذلك فردية، إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقاً آخر سواه.
وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها، وكل ديارها ـ بما فيها جاهلية العصور الحديثة ـ ندرك المدى المتطاول بين منهج يضعه الله للبشر، ومناهج يضعها الناس للناس، ونرى المسافة التي لا تعبر بين اثار هذه المناهج، واثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة.
إن الناس قد يعرفون المبادأئ، ويهتفون بها، ولكن هذا شيء وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر، وهذه المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي ألا تتحقق في عالم الواقع، فليس المهم أن يُدعى الناس إلى المبادأئ، ولكن المهم هم من يدعوهم إليها، المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة، المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر.
يهتف ألف هاتف بالعدل وبالتطهر وبالتحرر وبالتسامي وبالسماحة وبالحب وبالتضحية وبالإيثار، ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس، ولا يفرض نفسه على القلوب؛ لأنه دعا ما أنزل الله به من سلطان. ليس المهم هو الكلام، ولكن المهم من وراء هذا الكلام، ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ـ مجرد من سلطان الله ـ ولكن ما أثرها؟ إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم، تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس، فلا يكون لها على فطرتهم من سلطان، ولا يكون لها في كيانهم من هزة، ولا يكون لها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر.
ثم إن قيمة هذه الوصايا في الدين، أنها تتكامل مع «الإجراءات» لتكييف الحياة، فهو لا يلقيها مجردة في الهواء، فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا، وإلى مجرد شعائر، فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق، كما نرى ذلك الآن في كل مكان.
إنه لابد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين، وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه، ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات، وهذا هو الدين في المفهوم الإسلامي دون سواه... الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة.
وحين تحقق «الدين» بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة، والتي لا تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة، كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية القديمة. وحين تحول الدين إلى وصايا على المنابر، وإلى شعائر في المساجد، وتخلى عن نظام الحياة لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة.
4 ـ قال تعالى: َ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *} [ الآنعام 152].
بيَّنت الاية الكريمة على من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم، فيصونه وينميه حتى يسلمه له كاملاً نامياً عند بلوغه أشده، أي: اشتداد قوته الجسمية والعقلية ليحمي ماله، ويحسن القيام عليه، وبذلك يكون المجتمع قد أضاف إليه عضواً نافعاً، وسلمته حقه كاملاً.
َ. وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، والسياق يربطها بالعقيدة؛ لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة. والذي يوصي بها ويأمر هو الله، ومن هنا ترتبط بقضية الألوهية والعبودية، وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة، وعلاقتها بكل جوانب الحياة.
وقد كانت أقوام قبل الإسلام - وحتى يومنا هذا ـ تفصل بين العقيدة والعبادات، وبين الشرائع والمعاملات؛ من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيد}[هود:87]
مراجع الحلقة:
- العدالة من منظور إسلامي، علي محمد الصلابي، دار المعرفة، بيروت، ص 37-42.
- الأساس في التفسير ـ سعيد حوى (6/2988).
- في ظلال القرآن، سيد قطب، (2/414-853).
لمزيد من الاطلاع ومراجعة المصادر للمقال انظر:
كتاب الأنبياء الملوك في الموقع الرسمي للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي: